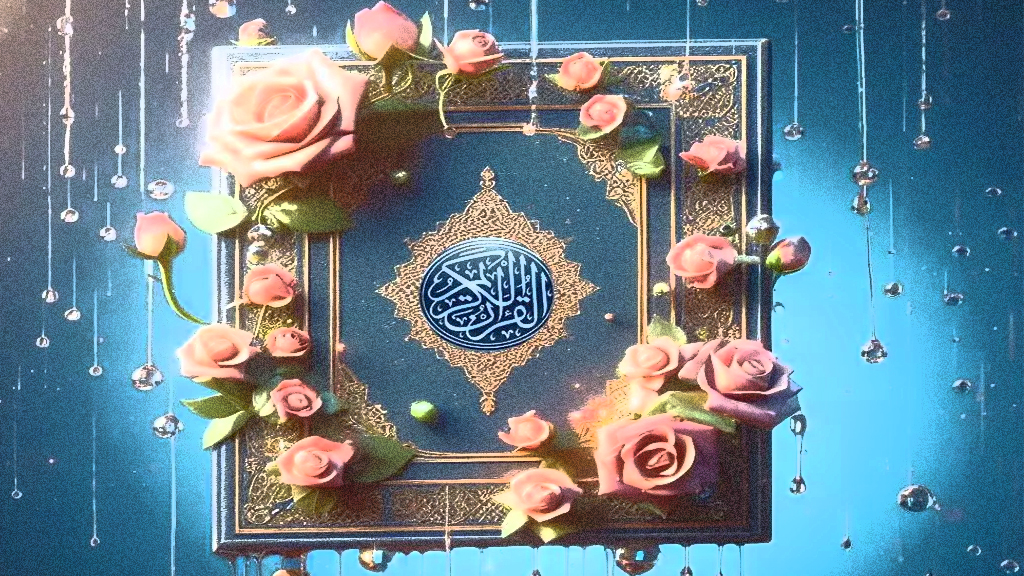علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.تساؤلات حول العقل المرجعي في الدراسات الدينية

إنّ الحديث عن موقع ودور العقل المرجعي في الدراسات الدينية؛ سوف يضعنا أمام إشكاليتين تتعلق أولاهما بتحديد المقصود من العقل، أما الثانية فبالمقصود من الدراسات الدينية.
فإذا ربطنا دلالات المعنى اللغوي مع الاصطلاحي للعقل، ثم استعرضنا طبيعة النظرة إليه فإننا سنحصل تارةً على تعاريف ومحدّدات تتناول العقل على إطلاق الكلمة، وأخرى بما هي مقيدة، وهو ما سيفتح الباب واسعًا أمام الحشد الهائل من الجمل المعبّرة عن معنى العقل.. إذ تارة يتم الكلام عن جوهر وذات اسمها العقل، وأخرى، عن ملكة غريزية، وثالثة، بمعنى الفهم والبيان وتحليل الأشياء وعالم الخطاب، ورابعة، عن بصيرة هادية لتمييز الحق عن الباطل.
وبطريق آخر هناك حديث عن عقل مسلم وآخر غير مسلم، وعقل ديني ولا ديني، وأسطوري وعلمي.
وداخل الانتماء الواحد: عقل تحديثي وآخر إحيائي.. وثالث سلفي، ورابع عقيدي، أو فقهي، أو أخلاقي، إلى آخر انتسابات السلسلة.. مما جعل الميل البحثي يتجه نحو وجود مادة العقل، وصيغة العقل، وهما اللذان يشكّلان مصدرية الانتساب إليه، ثم هناك المقاصد الجدّية نحو فهم الأشياء وربطها؛ مما يبرز معنى الإضافات للعقل.. وهذا ما سيسمح بالبحث عن مناطق الثبات والتغيّر، أو النسبية في متعلقاته؛ وبالقول: إن العقل هو الذات منظورًا إليها بفعاليات ارتباطاتها المنتجة للإضافات والنسب، وتراكم المعرفة وتشعّب العلوم والإدراكات…
أما الدراسات الدينية، فلا يخفى وجود ثلاثة اتجاهات تتحدث عن تحديدها..
الاتجاه الأول: الاتجاه السائد، وهو الذي عبّرت عنه الحوزات العلمية عبر تاريخها الممتد، والذي أدخل صيغة معيارية للعلم الديني اعتمدت إما على الحديث الشريف: “إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل”[1].
وعلى تبني كل علم يمثل موضوعه توسّطًا بين الوحي في مراداته، والناس المخاطبين. فكان الفقه والأخلاق وعلم الكلام وغيرها.. ثم أدخلوا معيارًا آخر ألا وهو العلوم الآلية الموصلة إلى تلك العلوم التوسطية.
ولا يخفى ما تركته هذه المعايير على أهميتها من توظيفات شكّلت انضواءات مذهبية فردانية مهجوسة بالخوف الدائم على الهوية، وبالتالي كانت تستقوي بنفي الآخر وإخراجه من دائرة الشرعية.
أما الاتجاه الثاني، فهو ذاك الذي حاول أن يستفيد من دراسات حديثة ومعاصرة، وعمل، وما زال، على أن يجد لها المبرّر والمسوّغ لتكون ضمن دائرة الدراسات الدينية.. وإذا كان الاتجاه الأول قد جعل الوحي أصلًا أول في مرجعية الدراسات الدينية، وحكم على العقل ذاتًا وفعالية وصدقية من خلاله؛ فإن الاتجاه الثاني اعتمد المنهج كسلطة لفعالية العقل تحمل قدرة استثنائية على فرض سطوتها على كل منتوجات الوحي النصوصية ومحاكمتها محاكمةً نقدية، معتبرة أن العقل كمصدر مرجعي، إن لم يكن بعرض واحد مع الوحي، فإنه يسبقه أولوية في النظام الطولي.
لذا، فكل منهج أو منتوج معرفي له نحو ربط بالوحي؛ هو ضمن دائرة الدراسات الدينية، ولو بتقسيم منهجي أطلق عليه اسم العلاقة بين الداخلديني والخارجديني.
الاتجاه الثالث، يكاد أن يقارب الاتجاه الثاني في توسيع دائرة الدراسات الدينية، أو ذات الصفة الدينية، لكن على غير أرضية ومرجعية العقل الاستثنائية، بل على قاعدة العامل النفسي والشعور الإيماني… إذ ذهب ليعتبر أن كل ما يضع الإنسان في عداد الخاشعين الذين يخشون ربهم هو مؤهل لتصح نسبة المشروعية له، واستندوا بذلك إلى الآية: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[2]، فلا فضل لعلم على علم إلا بمقدار ما ينتج من خشية؛ لذا يمكن لنا أن نفترض على ضوء هذا الاتجاه المستلزمات التالية:
أولًا: العلوم التي لا بدّ منها للحياة الإيمانية، كالأخلاق، والفقه، والقرآنيات، والسير، والعرفان.. هي من ثوابت الدراسات الدينية.
ثانيًا: العلوم التي يبدو أنها تحمل صفات موضوعية بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، وتقريب المرء إليه.. سمة من سمات الموضوع المدرج بالدراسات الدينية.
وهنا يكون الحاكم هو الهدف والغاية، لا الموضوع، لترشيد اعتبار هذا العلم أو ذاك.. من ضمن الدراسات الدينية.
ثالثًا: كل ما يحفظ مناخات العقيدة والحياة الإيمانية والأهداف والمقاصد الإلهية في حياة الإنسان.. يمكن إدراجه بشكل أو بآخر ضمن الدراسات الدينية أو المحببة دينيًّا.
والإيمان هو صلاح وتمام العقل بالصلاح، فالعقل ليس ذاتًا لا تتحرك؛ بل هو فعالية تحقق مصالح الإنسان والحياة، وبهذا المعنى تكون مرجعيته.
وإني لأظن قويًّا أن مثل هذا الاتجاه، يتسم بقابلية تجاوز الحدود المذهبية والمدرسية الضيقة، وعقدة الهوية أو المعاصرة بالمعنى الحداثوي، ويتعامل مع العقل كما الوحي، كمصدر لتحقيق سعادة الإنسان، محور تشريعات الأديان وعلومها.. وهو اتجاه لو قيّض له، فإنه ينطوي على قابلية تحفظ التوازن بين المباحث الوجدانية والعقيدية والتشريعية والاجتماعية والتطبيقية الصرفة.
إذ ليس الهدف نفس العلم والموضوع، فكلها طرق إذا كانت توصل لتحقيق رضا الإله كانت نافعة.. والعلم الديني هو العلم النافع.
ثم إن العقل هو الخبرة، والخبرة التي لا تتأسس على قاعدة الوحي تكون جربزة.. كما أن الخبرة التي لا تراعي المتحول في الحركة والتطور والزمان، تكون ألفة وعادة وجهلًا وإجحادًا…
عليه، إننا أمام تحدٍّ مع العقل، وبالعقل في مواجهة الأسئلة الصعبة، التي لا تستثني شيئًا، والتي منها أن العقل المسلم بما هو عقل مضاف، هل ما زال قادرًا على الاستمرار أم أنه قد استنفذ أغراضه؟
وأن الوحي هل هو عقل إلهي مفارق؟ أم أنه عقل النبي المبدع الملهم؟ أم أنه عقل الكون والوجود بكل تعرجات الاكتساب المعرفي؟
علينا الاعتراف – ومهما كانت الأجوبة على تلك الأسئلة – أن من أكثر ما ضيعنا وجعلنا عشاق الفراغ، هو ذاك اللهاث خلف جدل التحديدات بطريقة اجترارية لم تمتلك إلى الآن جدية البحث عن الآليات اللازمة لأي وجهة قد توصلنا إليها أجوبة أسئلة العصر. [والتي توقع لها الشهيد المطهري يومًا، أن تطيح بكل شيء ما لم نتدارك الأمر، وآنذاك كانت النار عند الجار، أما اليوم فإن النار تلتهم أثوابنا والجلود، وأخشى ما أخشاه أن تتحول إلى نار موقدة تطلع على الأفئدة المسترخية الغافلة… فتكون لا سمح الله من الأخسرين أعمالًا…].
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشيخ الكليني، الكافي، الجزء1، الصفحة 32.
[2] – سورة فاطر، آية 28.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 أهمّيّة علم الأخلاق
أهمّيّة علم الأخلاق
الشيخ حسين مظاهري
-
 صفات الباحث
صفات الباحث
الشيخ عبدالهادي الفضلي
-
 الفرق بين التّفسير والتّأويل
الفرق بين التّفسير والتّأويل
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 متى تحرّر سلمان الفارسيّ؟ (2)
متى تحرّر سلمان الفارسيّ؟ (2)
السيد جعفر مرتضى
-
 مكانة المرأة في الدين الإسلامي
مكانة المرأة في الدين الإسلامي
الشهيدة بنت الهدى
-
 معنى قوله تعالى:{ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}
معنى قوله تعالى:{ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}
الشيخ محمد صنقور
-
 حفاظًا على الأنوثة حفاظًا على البقاء
حفاظًا على الأنوثة حفاظًا على البقاء
السيد عباس نور الدين
-
 عشر سمات لذوي الذكاء العاطفي العالي
عشر سمات لذوي الذكاء العاطفي العالي
عدنان الحاجي
-
 دين الخروج من الدّين
دين الخروج من الدّين
حيدر حب الله
-
 تساؤلات حول العقل المرجعي في الدراسات الدينية
تساؤلات حول العقل المرجعي في الدراسات الدينية
الشيخ شفيق جرادي
الشعراء
-
 الدّقيقة بعد الدّقيقة
الدّقيقة بعد الدّقيقة
عبد الوهّاب أبو زيد
-
 الشّعر إزميلي
الشّعر إزميلي
ناجي حرابة
-
 السيدة المعصومة: مِحرابُ آمالِ الراجِين
السيدة المعصومة: مِحرابُ آمالِ الراجِين
حسين حسن آل جامع
-
 طريق أقصى
طريق أقصى
فريد عبد الله النمر
-
 لا يؤمن الدّهر الخؤون على أحد
لا يؤمن الدّهر الخؤون على أحد
الشيخ علي الجشي
-
 هنا روحي
هنا روحي
جاسم بن محمد بن عساكر
-
 نفث على زجاجة المعراج
نفث على زجاجة المعراج
أحمد الماجد
-
 في المسجد النّبويّ
في المسجد النّبويّ
عبدالله طاهر المعيبد
-
 طابع بريد السلام
طابع بريد السلام
ياسر آل غريب
-
 حنجرةُ الشوق
حنجرةُ الشوق
زهراء الشوكان