علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ عبدالهادي الفضليعن الكاتب :
الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي، من مواليد العام 1935م بقرية (صبخة العرب) إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق، جمع بين الدراسة التقليدية الحوزوية والدراسة الأكاديمية، فنال البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم درجة الدكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، له العديد من المؤلفات والمساهمات على الصعيدين الحوزوي والأكاديمي.rnتوفي في العام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.الوحدانية (1)

الدكتور عبد الهادي الفضلي ..
الوحدانية: - لغة - هي: «مصدر صناعي من الوحدة بزيادة الألف والنون للمبالغة»(1).
واصطلاحاً هي: «صفة من صفات اللّه تعالى، معناها: أن يمتنع أن يشاركه شيء في ماهيته، وصفات كماله، وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة ولا مؤثر سواه في أثرها عموماً»(2).
وباختصار الوحدانية ترادف التوحيد الذي يعني نفي الشريك وبطلان تعدد الآلهة.
وقد ورد استعمال هذا المصطلح وبمعناه العلمي في كلام للإمام الحسين (عليه السلام) في التوحيد، قال: «استخلص الوحدانية والجبروت، وأمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعلم بما هو كائن»(3).
وتعني هنا البحث في إثبات وحدانية اللّه تعالى أو إثبات أنه تعالى واحد.
وفي معنى (الواحد) - لغة - يقول أبو إسحاق الزجاج: «وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما»(4).
أما معناه في الاصطلاح فيقول الزجاج: «وفائدة هذه اللفظة في اللّه - عز اسمه - إنما هي تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد، واللّه تعالى هو الواحد في الحقيقة، ومن سواه من الخلق آحاد تركبت»(5).
ويعرّفه المعجم الفلسفي بـ (ما لا يقبل التعدد بحال)(6).
وفي مفردات الراغب يعرف: ب(الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكثر)(7).
يقول الإمام امير المؤمنين (عليه السلام): «من ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله»(8).
ويقول أيضاً: «واحد لا بعدد».
ولعل منه أخذت مؤديات التعريفات المذكورة.
وقد ورد استعمال هذا الاسم صفة للّه تعالى في القرآن الكريم على لسان بني يعقوب : {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } [البقرة: 133].
كما وصف اللّه تعالى نفسه في قوله: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } [البقرة: 163].
دليل المتكلمين:
واستدل المتكلمون على وحدانية اللّه تعالى بأن قالوا:
إننا إذا افترضنا وجود إلهين وكانا مستجمعين لشرائط الإلهية التي منها القدرة والإرادة.
فإننا نفترض أيضاً جواز تعلق إرادة أحدهما بإيجاد المقدور وتعلق إرادة الآخر بعدم إيجاده، وذلك لأن الاختلاف في الداعي ممكن.
وعليه نقول: إذا أراد أحدهما إيجاده فإما أن يمكن من الآخر إرادة عدم إيجاده أو تمتنع.
وكلا الأمرين - الإمكان والامتناع - محال.
وترجع استحالة إمكان تعلق إرادة الآخر بعدم إيجاده مع تعلق إرادة الأول بإيجاده إلى أنه يستلزم منه وقوع إيجاده وعدم إيجاده معاً. وهو من اجتماع النقيضين. أو يستلزم لا وقوعهما معاً، وهو من ارتفاع النقيضين. وكلاهما محال. كما أنه يلزم منه أيضاً عجزهما، وهذا خلف. أما وقوع مراد أحدهما دون الآخر، فيستلزم أن يكون الذي لم يقع مراده عاجزاً، وهذا خلف. وقالوا في محالية امتناع تعلق إرادة الآخر بعدم إيجاده مع تعلق إرادة الأول، بإيجاده: إن ذلك المقدور بما أنه ممكن يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين وإرادته به. وعليه يكون المانع من تعلق إرادة الآخر به هو تعلق إرادة الأول فيكون الآخر عاجزاً، هذا خلف.
والنتيجة: هي بطلان تعدد الآلهة، وعنده يثبت أن الإله واحد، وهو المطلوب.
ويعرف هذا الدليل ب(برهان التمانع) لما رأيناه من أن تعلق قدرة كل منهما بالمقدور تمنع من تعلق قدرة الآخر به ، والتمانع هو حصول المنع من كل طرف من الطرفين.
دليل الحكماء:
أما الحكماء فخلاصة دليلهم أن قالوا:
إن الواجب لذاته - بما أنه كذلك - يمتنع أن يكون أكثر من واحد.
وذلك لأنه لو كان هناك واجبان للزمهما التمايز لامتناع الاثنينية بدون الامتياز بالتعين.
ويجب أن يكون امتياز كل واحد عن غيره بغير هذا المعنى المشترك فيه، وهو الوجوب.
ولأن المجتمع من هذا المعنى المشترك فيه والمعنى الذي به الامتياز لا يكون واجباً لذاته، فيلزم منه أن يكون كل واحد من المتصفين بوجوب الوجود غير متصف به، وهذا محال.
في القرآن الكريم:
ونلمس مفاد دليل التمانع الذي برهن به الكلاميون على وحدانية اللّه تعالى في الآية الكريمة: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].
فهي تعني: أنه لو كان في السموات والأرض آلهة غير اللّه لبطلتا وفسدتا، لما يكون بين الآلهة من الاختلاف والتمانع.
وكذلك في الآية الاخرى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91].
ونرى انعكاس هذا المفاد القرآني في قول الإمام امير المؤمنين (عليه السلام): «واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبداً، ولم يزل».
وينسق على البحث في موضوع (الوحدانية) البحث في كيفية خلقه الخلق وصدور هذه الكثرة عنه تعالى، وهو ما يعرف بـ :
نظرية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد:
مؤدى هذه النظرية: أن الفاعل إذا كان واحداً لا يمكن أن يصدر عنه من جهة واحدة إلا معلول واحد.
وقد ذهب جلّ متكلمة وفلاسفة المسلمين إلى انطباق وتطبيق هذه النظرية على المبدأ الأول لأنه واحد، ولا تكثر فيه، فقالوا: لا بد أن يكون الصادر الأول عنه واحداً وفي سلسلةٍ تتكثر فيها الجهات لتعطي الكثرة.
ولما للموضوع من أهمية رأيت أن أكون معه في سخاء البحث أكثر من لداته، فأبدأ معه منذ نشوء النظرية متعرفاً سبب النشأة ثم ما طرأ على النظرية من تطور وما وجه لها من نقد.
وأجلى وأخصر عرض تاريخي أبان عن نشأة النظرية وسببها - فيما لدي من مراجع - هو ما ذكره ابن رشد في كتابه (تهافت التهافت).
ولهذا فضّلت أن أنقله هنا بنصه مكتفياً به مع التصرف اليسير بحذف زوائده اختصاراً.
يقول ابن رشد : «وهذه القضية القائلة : (إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، هي قضية اتفق عليها القدماء من الفلاسفة حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص الجدلي وهم يظنونه الفحص البرهاني.
فاستقر رأي الجميع منهم على :
- أن المبدأ واحد للجميع.
- وأن الواحد يجب أن لا يصدر عنه إلا واحد . فلما استقر عندهم هذان الأصلان طلبوا من اين جاءت الكثرة ؟ ! وذلك بعد أن بطل عندهم الرأي الأقدم من هذا، وهو أن المبادئ الأول اثنان : أحدهما للخير والآخر للشر.
فلما تقرر بالآخرة عندهم أن المبدأ الأول يجب أن يكون واحداً، ووقع هذا الشك في الواحد أجابوا بأجوبة ثلاثة :
- فبعضهم زعم أن الكثرة إنما جاءت من قبل الهيولى.
- وبعضهم زعم أن الكثرة إنما جاءت من قبل كثرة الآلات.
- وبعضهم زعم أن الكثرة إنما جاءت من قبل المتوسطات.
وأما المشهور اليوم فهو ضد هذا، وهو أن الواحد الأول صدر عنه صدوراً أولاً جميع الموجودات المتغايرة.
وأما الفلاسفة من أهل الاسلام كأبي نصر (الفارابي) وابن سينا فلما سلموا لخصومهم : أن الفاعل في الغائب كالفاعل في الشاهد، وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد.
وكان الأول عند الجميع واحداً بسيطاً، عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه، حتى اضطرهم الأمر أن لا يجعلوا الأول هو محرك الحركة اليومية.
بل قالوا : إن الأول هو موجود بسيط، صدر عنه محرك الفلك الأعظم.
وصدر عن محرك الفلك الأعظم الفلك الأعظم ومحرك الفلك الثاني الذي تحت الأعظم، إذ كان هذا المحرك مركباً من ما يعقل من الأول وما يعقل من ذاته.
وهذا خطأ على أصولهم، لأن الفاعل والمفعول هو شيء واحد في العقل الإنساني فضلاً عن العقول المفارقة.
وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو، فإن الفاعل الواحد الذي وجد في الشاهد يصدر عنه فعل واحد، ليس يقال مع الفاعل الأول إلا باشتراك الاسم.
وذلك أن الفاعل الأول الذي في الغائب فاعل مطلق، والذي في الشاهد فاعل مقيد.
والفاعل المطلق لا يصدر عنه إلا فعل مطلق، والفعل المطلق ليس يختص بمفعول دون مفعول».(9).
ونستخلص من هذا النص النقاط التالية :
1 - قدم النظرية، ذلك أنها ترجع في تاريخ نشوئها إلى عهود الفلسفة الإغريقية.
2 - أن سبب نشأتها يرجع إلى أن الفلاسفة اليونانيين كانوا يذهبون إلى ثنائية المبدأ الأول فيعتقدون بإله للخير وإله للشر، ثم قالوا بوحدانية المبدأ الأول، وبالمقارنة بين وحدته وكثرة العالم المخلوق له جاء سؤال : (كيف تصدر هذه الكثرة عن تلك الوحدة) يفرض نفسه عليهم، فذهبوا يلتمسون له الإجابة.
3 - ثم تسربت النظرية من عالم الفلسفة اليونانية إلى عالم الفلسفة الإسلامية، فقال بها أبو نصر الفارابي (ت 339 هجري) وابن سينا (ت 428 هجري).
4 - ثم تطورت النظرية في عصر ابن رشد (ت 595 هجري) إلى أن الواحد الأول صدر عنه مباشرة وبلا واسطة جميع الموجودات المتغايرة.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعجم الوسيط : مادة : وحد.
(2) م . ن .
(3) تحف العقول 175 .
(4) تفسير اسماء اللّه الحسنى 57.
(5) م . ن .
(6) مادة: واحد.
(7) مادة: وحد.
(8) نهج البلاغة: الخطبة 1.
(9) تهافت التهافت 296 - 302.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (منّ) في القرآن الكريم
معنى (منّ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 معرفة الإنسان في القرآن (4)
معرفة الإنسان في القرآن (4)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 أبو طالب: كافل نور النّبوّة
أبو طالب: كافل نور النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
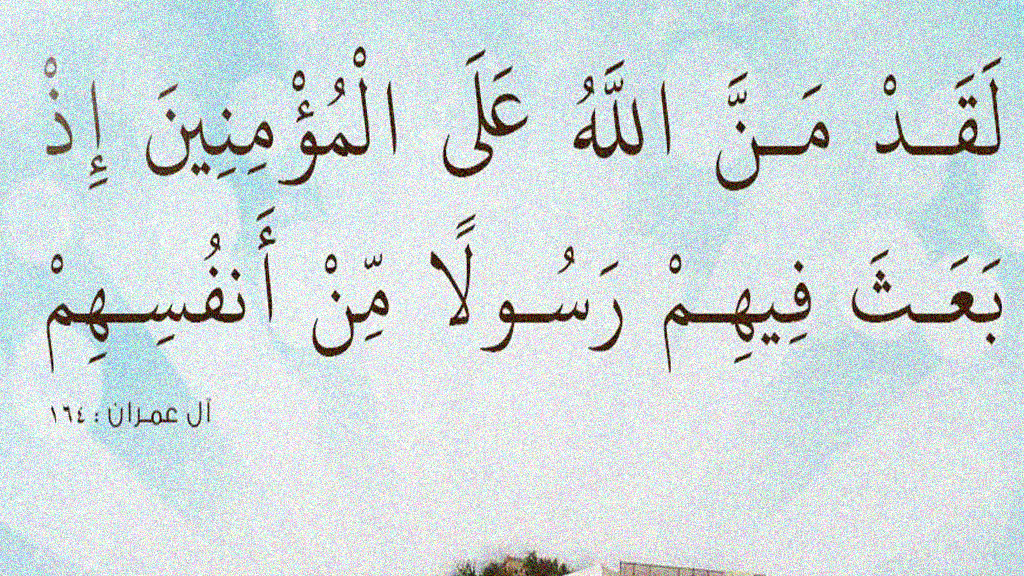
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)
-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
-
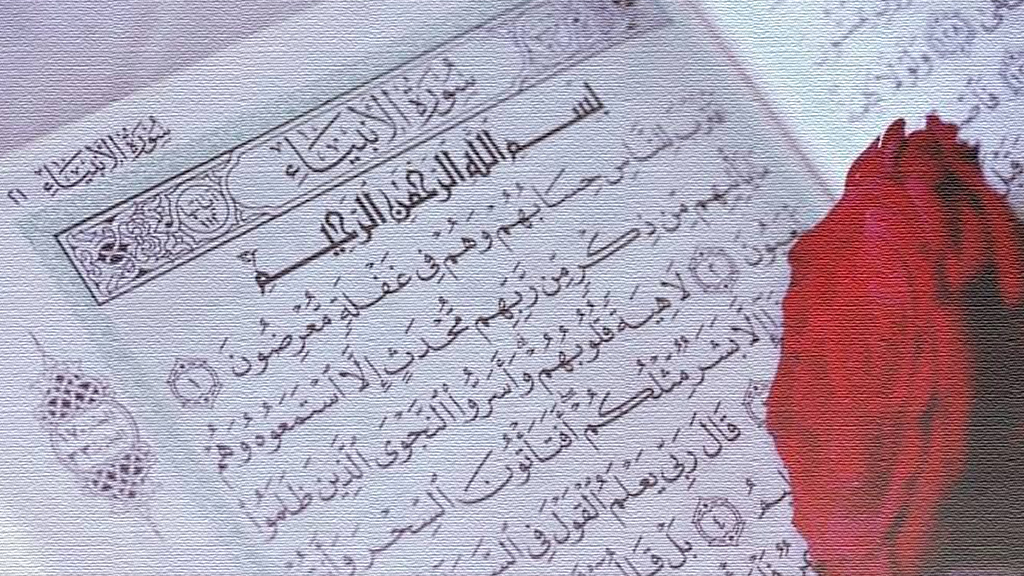
معرفة الإنسان في القرآن (4)
-

شرح دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك
-

كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الجسم؟
-
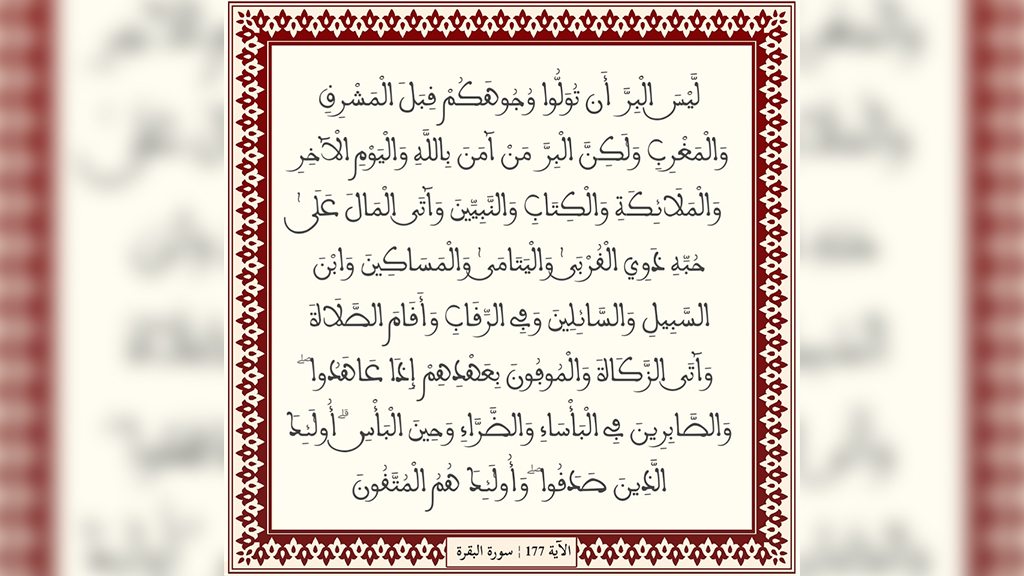
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
-

شروط استجابة الدعاء










