من التاريخ
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد صنقورعن الكاتب :
عالم دين بحراني ورئيس مركز الهدى للدراسات الإسلاميةصلح الحسن (ع) وثورة الحسين (ع).. الباعث والمنطلق (2)

تحدَّثنا فيما سبق حولَ مسألةِ الصُلح، وقلنا إنَّ الباعثَ على اختيارِه هو مقتضياتُ الظروف التي لم تكنْ تسمحُ بغير اعتمادِ هذا الخيار، لأنَّ المحاذيرَ المترتِّبةَ على سلوكِ غيرِ هذا الخيار كارثيَّة.
ولكي يتبيَّن أنَّ خيارَ الصلحِ هو الخيار المتعيِّن من بين الخيارات الأخرى نشيرُ بنحوِ الإيجاز إلى عددٍ من الأمور:
جيش الشام يزحفُ نحو العراق:
الأمرِ الأول: هو أنَّه وبعد استشهاد أمير المؤمنين (ع) في الشهور الأخيرة من سنةِ الأربعينَ من الهجرة عبَّأتِ الشام جيشاً قِوامُه على تقديرِ الـمُقِلِّ من المؤرِّخين يصلُ إلى ستينَ ألف مقاتل، وقد أنهى بعضُهم عددَ جيشِ الشام إلى مائة ألفٍ أو يزيدون، وكان جيشاً متماسكاً يخضعُ إلى قيادةٍ مركزيَّةٍ واحدة، أوامرُها ناجزةٌ ونافذة، وقد صدرت الأوامرُ له بالزحفِ نحوَ العراق، فإنْ وجدَ جيشاً خاض معه حرباً، وإن لم يجد صار بوسعه الهيمنة على العراقِ دون مقاومة، وبذلك تسقطُ الخلافة الإسلاميَّة والتي كان مركزُها في الكوفة.
الأمرِ الثاني: بعد استشهاد أميرِ المؤمنين (ع) في شهر رمضان من سنة الأربعينَ للهجرة بايعَ الناسُ عدا بلادِ الشامِ الكبرى الإمامَ الحسنَ المجتبى (ع) فأصبحَ هو الخليفةَ الرسمي للمسلمين، فكانَ عليه العملُ على إحكام الاستقرارِ في عموم الحواضر الإسلاميَّةِ المتراميةِ الأطراف، فالعديدُ منها كانت مضطربةً، ولم تكن تدينُ بالولاء الكامل للخلافة المركزيَّة، وبعضُها أصبح بحكم الخارج عن نفوذِ الخلافة المركزيَّة مثل بلاد مصر التي قتلتْ سرايا الشام الوالي عليها وهو محمد بن أبي بكر، وتمَّ اغتيالُ مالكِ الأشتر الذي بعثَه الإمامُ أميرُ المؤمنين (ع) ليكون والياً عليها، واستُشهد أميرُ المؤمنين (ع) قبل إرجاع مصرَ إلى نفوذِ الخلافة الإسلامية، وكذلك فإنَّ اليمن أصبحتْ بحكم الخارجة عن نفوذ الخلافة الإسلاميَّة بعد أنْ غزتها سرايا الشام وهرب الوالي عليها، وأمَّا البصرة فهي وإنْ كانت قد بايعت الإمامَ الحسنَ (ع) إلا أنَّ أكثر عشائرها تدينُ بالولاء للشام، فكأنَّها قطعةٌ من بلاد الشام، وهكذا هو الشأن في الحجاز فلم تكن خالصة، فقد غزتْها الشام بقيادة بسر بن أرطاة وأرعبها وقتل من قاوم من رجالها وسلب الكثير من أموالها، ولذلك كان على الإمامِ الحسنِ (ع) أنْ يُعيد الاستقرار إلى عامَّةِ الحواضرِ الإسلامية، وذلك ما يسترعي جُهداً ليس باليسير، ووقتاً ليس بالقصير.
واقع جيش الحسن (ع) وسير الأحداث:
الأمرِ الثالث: في الوقت الذي كان على الإمام الحسن(ع) أنْ يُعيد الاستقرارَ إلى عامَّة الحواضرِ الإسلاميَّة كان عليه أن يُعبِّأ جيشاً كبيراً لصدِّ جيشِ الشام الذي كان يُسابقُ الزمن ليصلَ إلى أطراف العراق.
لذلك أعلنَ الأمامُ (ع) النفيرَ العام وبذل مع المخلصِين من أصحابِه جهوداً مُضنية من أجل تعبئة جيشٍ يتمكنُ من صدِّ جيش الشام إلا أنَّهم لم يتمكنوا -على التحقيقِ- من تعبئةِ أكثرَ مِن عشرينَ ألفَ مقاتل، فالجيشُ الذي أعدَّه أميرُ المؤمنينَ (ع) قبل استشهادِه والذي كان قوامُه يصلُ -كما قيل- إلى أربعين ألفاً قد انفضتْ فلولُه بعد استشهادِ الامامِ عليٍّ(ع) وصارَ من العسيرِ تعبئةُ هذا العددِ بفعل المثبِّطين من زعماءِ العشائر والوجهاءِ والقادةِ العسكريين، والذين كاتب الكثيرُ منهم قيادةَ الشام سرَّاً وقدَّموا لها رسومَ الطاعة والولاء وأكَّدوا على استعدادِهم للانقلابِ على الإمام الحسنِ (ع) والانضمامِ إلى صفوفِ الجيش الشامي متى ما وصلَ إلى حدودِ العراق.
فلم يتهيأ للإمام الحسن (ع) سوى تعبئةِ عشرينَ ألفَ مقاتل، ومثلُ هذا العددِ غيرُ قادرٍ على حسمِ المعركة لكنَّه قد يتمكَّن من الصدِّ والمقاومة الى وقتٍ ربَّما تتحسَّن بعده الظروف، هذا لو كان هذا الجيش متماسكاً ويتحلَّى بمعنوياتٍ عالية ومؤمناً بضرورة التصدِّي للمواجهة ويخضعُ لقيادةٍ مركزيَّةٍ واحدة إلا أنَّ الأمرَ لم يكن كذلك، فهذا الجيش عبارة عن مجاميعَ متنافرةٍ ومتباينةٍ في أغراضِها وأهوائِها وعقائدِها كما وصفهم الإمام (ع) في بعض ما أثر عنه: "لا يثقُ بهم أحدٌ أبداً إلا غُلب، ليس أحدٌ منهم يوافقُ آخرَ في رأيٍ ولا هوى، مختلفين لا نيّة لهم -أي لاعزم لهم- في خيرٍ ولا شر"(4).
وعلى أيِّ تقدير فإنَّ الإمامَ الحسنَ (ع) زحفَ بهذا الجيش الذي كان يضمُّ جميعَ الـمُخلصين مِن شيعته من الصحابة وأبناءِ المهاجرين والأنصار وخيرةِ رجال عليٍّ (ع) وساروا حتى بلغوا موقعاً يقالُ له (دَيْر عبد الرحمن) هناك أمرَ الأمام (ع) اثني عشر ألفاً منهم أن يتقدَّموا ويُعسكروا في منطقةٍ يُقال لها مسكن حيثُ ستكونُ الموضع الذي يلتقي فيه الجيشان، وأمَّر عليهم عبيدَ الله بن العباس فإذا أُصيب فالقيادةُ تكونُ لقيسِ بنِ سعد بنِ عبادة (رحمه الله) وسار الإمامُ (ع) ببقية الجيش إلى المدائن، وعددُهم يقربُ أو يزيدُ قليلاً على الثمانيةِ آلافِ مقاتل، وعسكرَ هناك ينتظر المدَد ليلتحقَ بمسكن إلا أنَّه لم يصل إليه مَدَدٌ يُذكر، وأمَّا ما كان من الطلائع التي بعثها الإمام (ع) إلى مسكن بقيادةِ عبيدِ الله بن العباس فحينَ استقرَّتْ في ذلك الموضع وأخذَ الجيش مواقعَه فيها بانتظار ابتداءِ المعركة حيثُ إنَّ الإمام (ع) أعطى أوامره بأنْ يخوضوا الحربَ إذا بدأهم جيشُ الشام، في ذلك الموضع، وفي تلك المرحلةِ الحرجة تفاجأ جيشُ الإمام الحسن (ع) باختفاء قائدِهم عبيدِ الله بن العباس ونما إلى علمِهم أنَّه قد انحازَ إلى قيادةِ الشام أو انسحب وتركَ مقرَّه إلى وِجهةٍ مجهولة بعد أنْ وصلتْه من قائدِ جيش الشام وعودٌ وعطايا ومِنح، وعلى إثرِ هذا النبأ الصادم اضطربَ جيشُ الإمامِ الحسن (ع) وأُشيع في وسطِه كذباً أنَّ الإمامَ الحسنَ (ع) قد صالحَ أهلَ الشام، وحينها بذل قيسُ بن سعد والمخلصون جهوداً مضنية من أجل الإمساك بزمام الجيش إلا أنَّهم لم يُفلحِوا فانسحب على إثر ذلك ثمانيةُ آلاف، انضمَّ الكثيرُ منهم إلى صفوفِ جيش الشام وتفرَّق آخرون ولم يتمكَّن قيسُ بنُ سعد من الاستمساك بأكثرَ من أربعةِ آلاف مقاتل هم بقية المخلصِين من رجال عليٍّ (ع) ورغم ذلك قرَّر قيسٌ (رحمه الله) أن يخوضَ بهم المعركة متى ما بدأت، وذلك في مقابلِ ستينَ ألف مقاتلٍ أو يزيدون.
وأمَّا ما كان من شأنِ الثمانيةِ آلاف الذين عسكروا في المدائن بقيادة الإمام الحسن (ع) فقد بلغهم أنَّ عبيدَ الله بن العباس قد انحازَ إلى جيشِ الشامِ وأنَّ ثمانيةَ آلاف قد انضمُّوا إلى جيش الشام، وأنَّ قيسَ بن سعد قد قُتل، فاضطربَ جيشُ الإمام (ع) في المدائن وبذل الإمامُ (ع) والمخلصون جهوداً من أجل تهدئته والاستمساك به إلا أنَّه ظلَّ على اضطرابه، فكان الكثيرُ أو الأكثر منهم يضغطُ من أجل إبرام عقد الصلح، ثم إنَّ جماعةً كبيرة من جيش الإمامِ الحسن (ع) قد اقتحموا في إحدى ليالي المدائن المعسكرَ الذي كان يقيمُ فيه الإمامُ (ع) وأثاروا فيه اللَّغط وسلبوا ما أُتيح لهم سلبُه، وكان غرضُهم اغتيالَ الإمام (ع) حيث أصابه أحدُهم بطعنةٍ غائرة من خنجرٍ مسموم في فخذه بلغتِ العظم.
فكانت هذه هي بعض بوادرِ الجيش الذي يُراد له أنْ يخوضَ معركةً شرسة مع جيش الشام المتماسِك والذي يربو عددُه على الستين ألفَ مقاتل.
مثلُ هذا الجيشِ لا يُمكنُ لقائدٍ أنْ يجازف فيخوض به معركة، خصوصاً وأنَّه قد نما إلى علمِ الإمام (ع) بالشواهد القطعيَّة أنَّ عدداً ليس بالقليل من المندسين من أتباع زعماء العشائر كانوا مكلَّفين باغتيال الإمامِ الحسن (ع) أو تسليمِه متى ما التحمَ الجيشان.
فجيشُ الإمام (ع) علاوة على قلَّته في مقابل جيش الشام فإنَّه كان خليطاً من مجاميعَ متباينة في الأغراضِ والأهواء، فكان فيهم الخوارجُ الذين كانوا يتحيَّنون الفرصةَ لأخذ الثأر من الحسن (ع) والمخلصين من أصحابه لقتلاهم في النهروان، وكان فيهم المندَّسونَ من أتباعِ زعماء العشائر التي كانت تضمر الولاء لجيشِ الشام، وفيهم الكثيرُ ممن سئم الحربَ ويطمحُ في العافية وكان التحاقُهم بصفوف جيش الإمام (ع) نشأ عن اعتبارات مختلفة، وفيهم المتردِّدون الذين تتلون مواقفُهم حسبَ اختلاف الظروف.
وقد أجملَ الإمامُ الحسن (ع) في إحدى خطبه الواقعَ المتردِّي الذي كان عليه جيشُه فقال (ع) مخاطباً لهم: "إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شكٌّ ولا ندمٌ وإنَّما كنا نقاتلُ أهلَ الشام بالسلامةِ والصبرِ فشِيبتِ السلامةُ بالعداوة والصبرَ بالجزع، وكنتم في مسيرِكم إلى صفين، ودينُكم أمامَ دنياكم. وأصبحتم اليومَ ودنياكم أمام دينِكم. وأنتم بين قتيلينِ، قتيلٍ بصفينَ تبكونَ عليه، وقتيلٍ بالنهروانِ تطلبونَ بثأره. فأمَّا الباقي فخاذل، وأمَّا الباكي فثائر .."(5).
فالحرصُ على الدنيا هو الجامع بين مجاميع جيش الإمام (ع) فإمَّا هو حرصٌ على البقاء والعافية أو هو حرصٌ على تحصيل المزيد من الـمُتع والامتيازات كما شأنُ المندسين أو هو حرصٌ على الانتقام وإرواء الغليل، ثم قال الإمام (ع): "وأنتم بين قتيلين" أي أنَّكم صنفان: صنفٌ لا يُبارح خلدَه مَن قُتل من أهلِه وعشيرتِه في صفِّين، وصنفٌ منكم لا يُبارِحُ خلدُه مَن قُتل من أهلِه وعشيرتِه في النهروان، أمَّا الصنفُ الأول فيبكونَ على قتلاهم في صفِّين بمعنى أنَّهم لا يريدون المزيدَ من القتل وقد جزعوا من الحرب ويُحبون العافية، فهذا هو معنى "قتيلٍ بصفينَ تبكون عليه"، وأمَّا الصنف الثاني فهم الخوارج الذين تغلي قلوبُهم غيظاً على أميرِ المؤمنين (ع) والمخلصين من أتباعه الذين قتلوا أصحابَهم في النهروان، فهؤلاءِ إنَّما دفعَهم للالتحاق بجيش الإمام (ع) لأنَّ في ذلك فرصةً سانحةً لأخذ الثأر من الإمام الحسن (ع) والخلَّصِ من أصحابِه إذا التحم الجيشان، وهذا هو معنى "وقتيلٍ بالنهروان تطلبونَ بثأره"، وأمَّا الباقي فخاذل وهم المندَّسون والمنافقون الذين يُضمرون الولاء لقيادة الشام ويطمحونَ في عطاياها وامتيازاتها، وكذلك المتردِّدون الذين تتلوَّن مواقفُهم بحسبِ اختلاف الظروف.
الحكيم لا يُجازف فيخوض حرباً بمثل هذا الجيش:
فمثلُ هذا الجيشِ الفاقدِ لأبسط مقوِّمات الثبات لا يُجازف قائدٌ حكيم فيَخوضُ به معركة، فإنَّه ما إنْ تبدأَ الحربُ حتى تتحولَ صفوفُه إلى فُوضى عارمةٍ يكون ضحيتها قائدُ الجيش والخُلَّصُ من رجالِه، فينهزمُ طلابُ العافيةِ وهم الأكثرُ، ويعملُ المندَّسون وطلابُ الثأر على تصفيةِ خصومِهم، وهم قائدُ الجيش والمخلصونَ من رجاله، وبذلك تُحسم المعركةُ لصالح العدوِّ بقليلٍ من الخسائر.
وهنا قد يُقال إنَّ الخيار العقلائي في مثل هذا الفرض يُحتِّمُ على القائدِ الحكيم العملَ على تأجيلِ خوضِ الحرب إلى أنْ يتهيأَ له تنقيةُ صفوفِه من المندَّسين وتعبئةُ المزيدِ من المقاتلين، إلا أنَّ الإمامَ الحسنَ (ع) لم يكن يسعُه ذلك، فجيشُ الشامِ على مشارفِ العراق وهو ماضٍ في طريقِه، فإمَّا أنْ يعترضه جيشُ مِن العراق فيخوض معه حرباً وإنْ لم يعترضْه جيشٌ فسيدخلُ العراقَ ويبسطُ نفوذَه عليها، وبذلك تسقطُ الخلافةُ الإسلاميَّة ويُصبحُ الخليفةُ ورجالُه في قبضةِ الجيشِ أسارى.
تعيُّن خيار الصُلح من بين الخيارات:
فالإمامُ الحسنُ (ع) كان أمامَ خياراتٍ ثلاثةٍ لا رابعَ لها، فإما أنْ يتركَ جيشَ الشام يدخلُ العراقَ ويبسطُ نفوذَه عليها دون مقاومةٍ، وبذلك تسقطُ الخلافة الإسلامية ويُصبحُ الإمامان الحسنُ والحسينُ (ع) والخُلَّصُ من شيعة عليٍّ (ع) في قبضة الجيش أسارى، أو يتمُّ قتلُهم ثم يُتَّهم به بعضُ أفراد الجيش وأنَّهم تصرَّفوا دون أوامر وبذلك يضيعُ دمُ الإمامين (ع).
والخيار الثاني: هو أنْ يدخلَ الإمام (ع) بجيشِه المهترئِ والمتهالكِ حرباً مع جيشِ الشام، وبذلك تُحسمُ المعركةُ سريعاً لصالحِ جيشِ الشام، وُيقتل الإمامُ الحسن (ع) ولن يُقتلَ الإمامُ الحسن (ع) حتى يقتلَ الحسين (ع) ولن يقتلَ الحسين ُ(ع) حتى تُقتلَ الصفوةُ من رجال عليٍّ (ع) فلن يُفوِّتَ جيشُ الشام هذه الفرصةَ السانحة للإجهاز الكامل على البقية الباقية من رجال عليٍّ (ع) وبذلك تتمُّ الإبادة الكاملة لحملَة الإسلام المحمديِّ الأصيل، فلا يبقى في الأمَّة سوى حملَةِ النسخةِ القرشيةِ المشوَّهةِ للإسلام. وقد أشار الإمامُ الحسن (ع) إلى ذلك في مواضعَ عديدة.
ثم إنَّه لن يكونَ لاستشهادِ الإمامِ الحسنِ (ع) أثرٌ معنويٌّ فيكونُ طريقاً للهداية، لأنَّ المؤرِّخين وعامَّةَ الناس سيقولون إنَّ الخليفةَ خاضَ حرباً هو اختارها لتثبيتِ خلافتِه إلا أنَّ الحربَ حُسمت لصالح المعارضة فقتل الخليفةُ كما يُقتلُ أي مقاتلٍ في الحروب، فلم يكن الحسن (ع) -وكذلك الحسين (ع)- ثائراً على الظلم والعدوان بل كان خليفةً رسمياً يعملُ وأخوه على تثبيتِ خلافتِه في مقابل معارضةٍ ترفع شعار الانتصار للخلافة الراشدة، فلعلَّ الحقَّ أو بعضَه معها.
وربَّما يُقتلُ الإمامُ الحسن (ع) وكذلك الحسين (ع) غيلةً على يد رجالٍ من صفوفِ جيش الحسن (ع) أو هكذا تُنسب التُّهمة إليهم من قِبَل جيش الشام وتكونُ الداهيةُ حينذاك أشدَّ وأنكى.
وربَّما لا يُقتل الحسن (ع) وإنَّما يتمُّ أسرُه بمعونةٍ من المندَّسين في جيشه وهم كثيرون، وقد خطَّطوا لذلك طويلاً كما نصَّت على ذلك الأخبار، وبهذا يُصبحُ الإمامُ أسيراً في يدِ قائدِ جيش الشام، فإمَّا أنْ يقومَ بتصفيتِه ولو من طريق الخوَنة المندَّسين في صفوف الإمام (ع) وإمَّا أنْ يمنَّ عليه فيُطلقُ سراحَه فيكونُ ذلك سبَّةً إلى آخر الدهر ووهناً عظيماً على الإسلامِ وآل بيت الرسول، وقد أشار الإمام (ع) إلى ذلك في بعضِ ما أُثر عنه قال (ع): "يزعمون أنَّهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي، وأخذوا مالي، واللهِ لو قاتلتُ معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلَماً، فوالله لئنْ أسالـمَه وأنا عزيزٌ خيرٌ من أنْ يقتلني وأنا أسيرُه أو يمنَّ عليَّ فتكونَ سبّةً.. إلى آخر الدهر"(6) ويقول (ع): "والله .. ولو وجدتُ أنصاراً لقاتلتُه ليلي ونهاري حتى يحكمَ اللهُ بيني وبينه"(7).
والخيار الثالث: هو أنْ يختار طريقَ الصلح يفرض فيه شروطَه فإنْ التزم بها ففي ذلك خيرٌ كثير، وإمَّا أنْ لا يفي بها وبذلك ينكشفُ زيفُه ويُفتضح غشُّه للمسلمين، ويكونُ للحسنِ (ع) أو الحسين (ع) حقُّ النهوضِ في وجهه، ويكونُ ذلك مبرَّراً يتفهَّمُه التأريخ، وبالصلحِ يظلُّ خطُّ الإمامةِ قائماً يأوي إليه مَن يبتغي الهدى، ويظلُّ الصفوةُ من أتباعه يعملونَ على تأصيله وامتدادِه: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾(8) فلولا الصلحُ لانقطع السبيلُ على الأجيال للوصول إلى الإسلام بنسختِه الصافية والنقيَّة.
ونختم بما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أبي سعيد عقيصا قال: قلتُ للحسنِ بن عليٍّ يا ابن رسول الله: لم صالحتَ؟ فقال: يا أبا سعيد ألستُ حجةَ الله تعالى ذكرُه على خلقِه وإماماً عليهم بعد أبى (ع)؟ قلتُ بلى قال: ألستُ الذي قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله لي ولأخي: الحسنُ والحسينُ إمامان قاما أو قعدا؟ قلتُ بلى، قال فإنا إذن إمامٌ لو قمتُ وأنا إمامٌ إذ لو قعدتُ، يا أبا سعيد علَّةُ مصالحتي لمعاوية علةُ مصالحةِ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف مِن الحديبية أولئك كفارٌ بالتنزيل وهذا وأصحابُه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد إذا كنتُ إماماً من قبل الله تعالى ذكرُه لم يجبْ أن يُسفَّه رأيي فيما أتيتُه من مهادنة أو محاربة وإنْ كان وجهُ الحكمةِ فيما أتيتُه مُلتبساً، ألا ترى الخضر (ع) لما خرق السفينةَ وقتلَ الغلامَ وأقامَ الجدارَ سخط موسى (ع) فعلَه لاشتباهِ وجهِ الحكمةِ عليه حتى أخبرَه فرضي، هكذا أنا، سخطتُم عليَّ بجهلِكم بوجهِ الحكمةِ فيه، ولولا ما أتيتُ لما تُرك من شيعتِنا على وجهِ الأرض أحدٌ إلا قتل"(9).
وهذا هو مرادنا من أنَّ العزم كان منعقداً على استئصال حملَة الإسلام المحمَّدي الصافي عن جديد الأرض فلا يبقى باستئصال أهل البيت (ع) وشيعتهم من الإسلام إلا الإسلام بنسخته المشوَّهة القرشية وبذلك يتعذَر على الأجيال الوقوف على الإسلام بنسخته الصافية النقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- الكافي -الكليني- ج5 / ص369.
2- دعائم الإسلام -القاضي النعمان- ج1 / ص56، الكافي -الكليني- ج2 / ص669.
3-الكافي -الكليني-ج2 / ص99.
4- الكامل في التاريخ -ابن الأثير- ج3/ 407.
5- تاريخ مدينة دمشق ج13 / ص268، الكامل في التريخ -ابن الأثير- ج3 / ص406.
6- بحار الأنوار -المجلسي- ج44 / ص30.
7- الاحتجاج -الطبرسي- ج2 / ص12.
8- سورة الأنفال / 42.
9- علل الشرائع -الصدوق- ج1 / ص211.
10- سورة النصر / 1-3.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (منّ) في القرآن الكريم
معنى (منّ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 معرفة الإنسان في القرآن (4)
معرفة الإنسان في القرآن (4)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 أبو طالب: كافل نور النّبوّة
أبو طالب: كافل نور النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
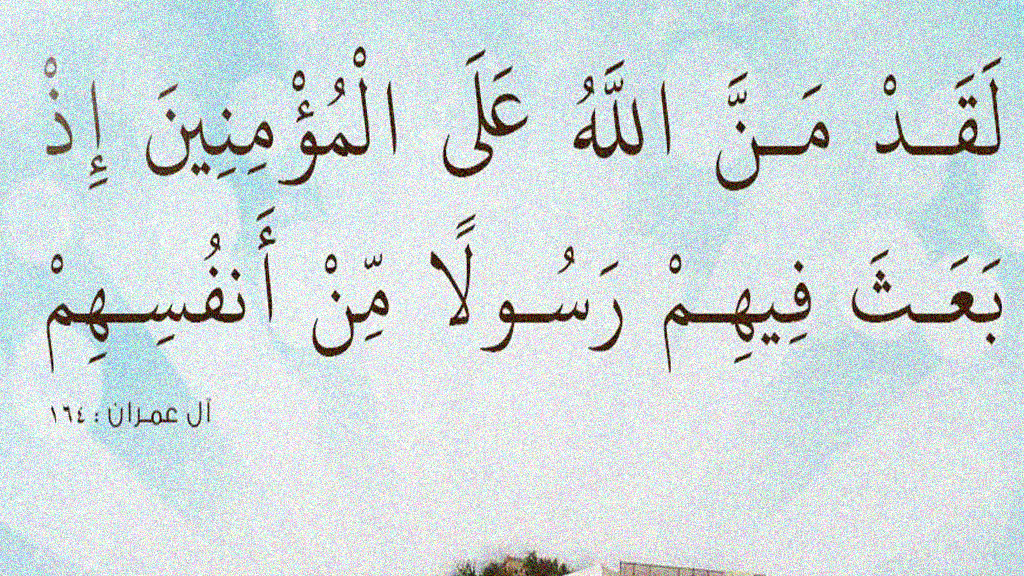
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)
-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
-
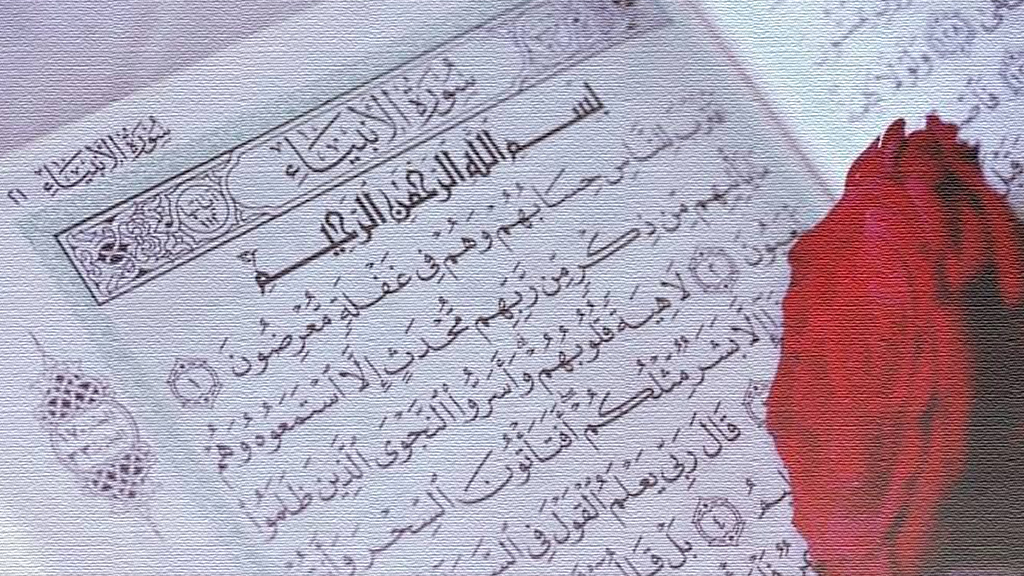
معرفة الإنسان في القرآن (4)
-

شرح دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك
-

كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الجسم؟
-
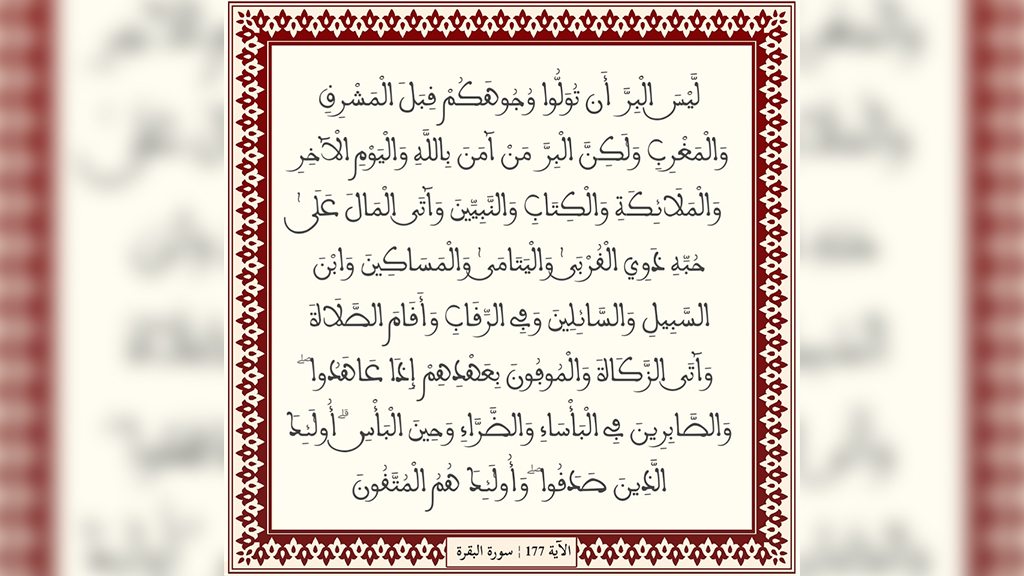
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
-

شروط استجابة الدعاء









