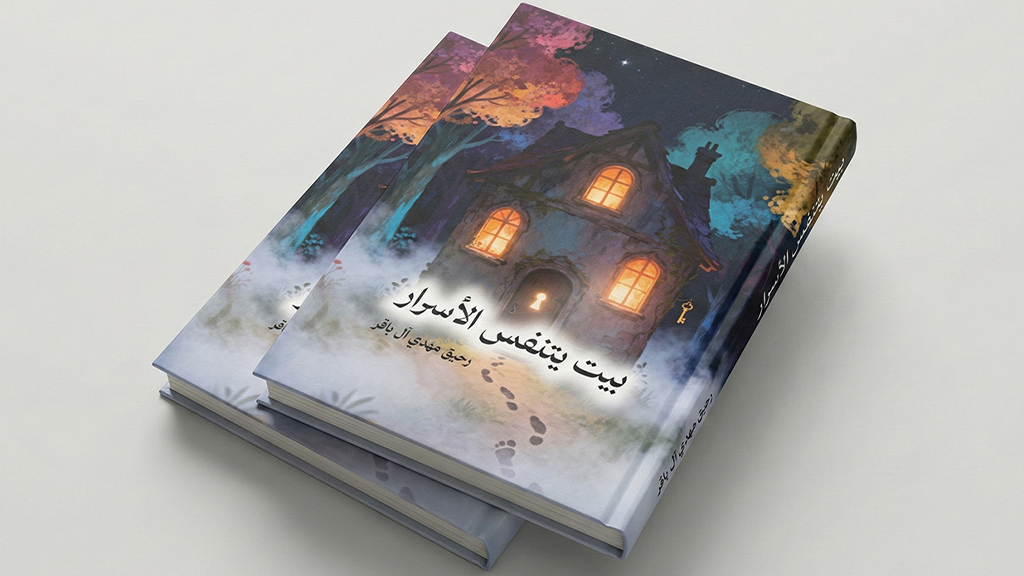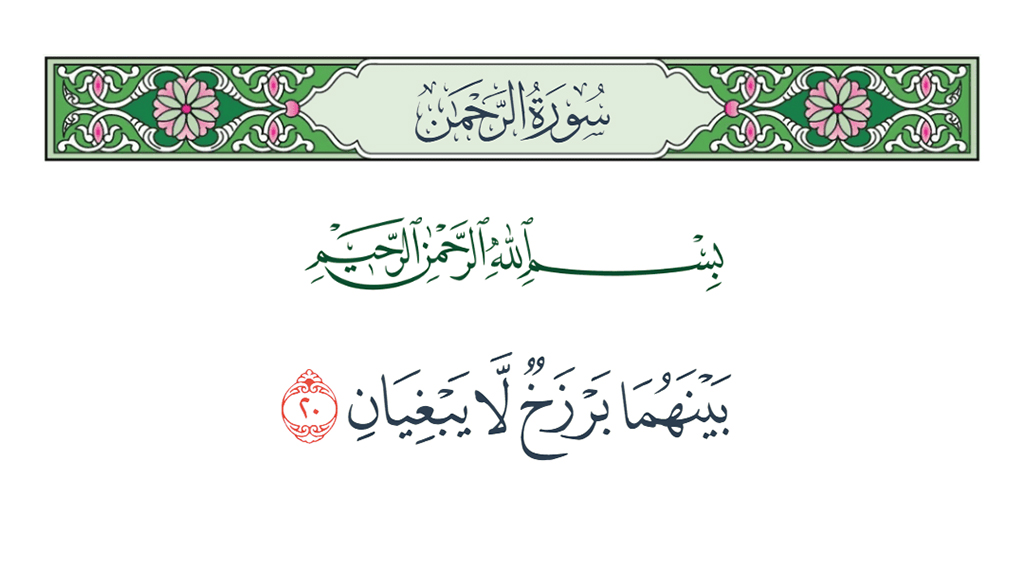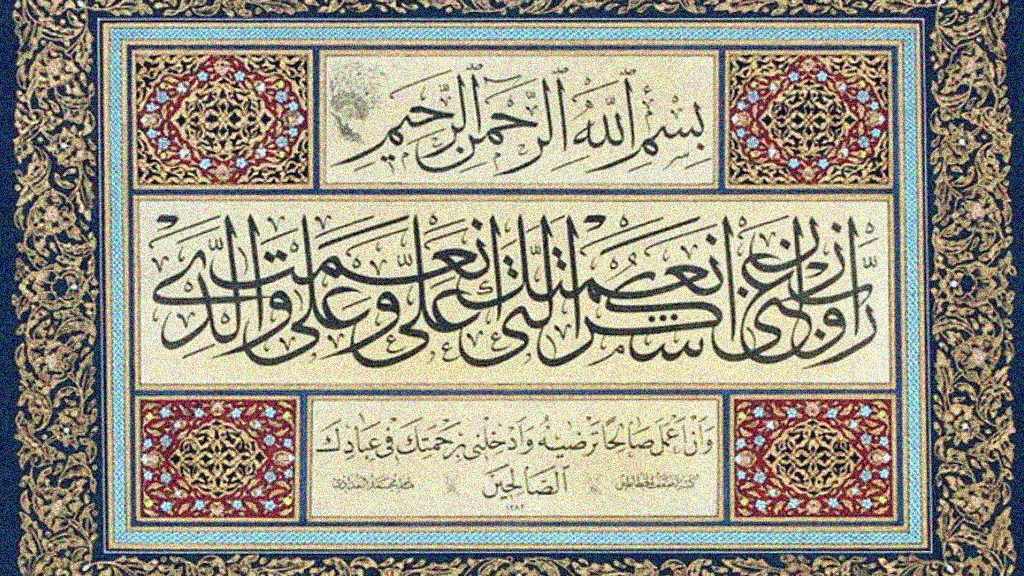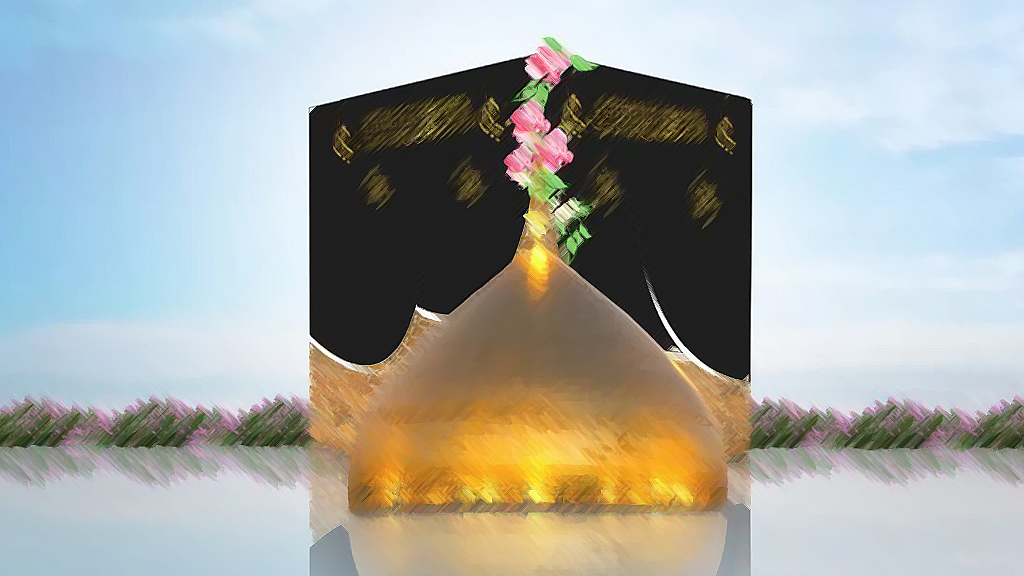علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا العلم الذكيّ (1)

الفيزياء الكوانتية، الفلسفة، والعقل الفائق: هل يعود المطلق ليحكم العلم؟
عُدَّ التساؤلُ عن إمكان وجود صلة بين القوانين الحاكمة على الطبيعة وعوالم ما بعد الطبيعة، أحد أبرز العلامات الدالَّة على المعضلات التي سعى العقل الفلسفيُّ للوقوف عليها، واستخراج المبادئ المنطقيَّة المناسبة لها. وإذا كان هذا التساؤل لا يني يقضُّ سكينة المفاهيم منذ الحقبة الإغريقيَّة إلى أزمنة الحداثة، فقد جاء العلم الذكيُّ بحادثاته وانعطافاته الكبرى، ليقارب الإجابة من محلٍ غير معهود. فلقد بدا بما لا يقبل الرَّيب، كما لو أنَّ هذا العلم هو الذي سيفترض على الفلسفة القيام بمهمَّة الكشف عن تلك الصِّلة الغائمة بين الفيزياء والميتافيزياء. تلقاء هذا، نرانا بإزاء استفهام داهم عمَّا سيؤول إليه الحال، حين يسائلُ العلم الذكيُّ الفلسفةَ ماذا صنعت، فيما هو فخورٌ بما صار إليه اليوم من عظيم الذكاء وعلياء الفطنة؟
ربَّما تأَتَّى الجوابُ أدنى إلى خطبٍ جليلٍ لم يكن وقوعه محسوبًا في تفكيرنا المعاصر. منطقيٌّ أن تنشأ مساءلةٌ تبادليَّةٌ بين الفلسفة والعلم. لكن منسوب المساءلة قد يزيد متى عرفنا أنَّ للعلم حجَّةً على الفلسفة لكونه الواسطة البَدئيَّة في تأسيس معرفتها بالكون. لهذا المعتبر رأينا كيف قامت المقالة الفلسفيَّة الأولى على العناصر الأربعة (النار والماء والأرض والهواء)، ثم ليتشكَّل منها الجذرَ الكوزمولوجي لـ«ميتافيزيقا» الإغريق. نظير ذلك، سنلاحظ كيف احتجَّت الفلسفة على العلم ـ وإن على استحياء ـ من بعد أن تمكَّنت غزواته من إقصاء التأمُّل الميتافيزيقيِّ، واستنزال التفلسف من متعاليات التجريد إلى أرض الفينومينولوجيا الفسيحة؟
لكنَّ المسألة لا تتوقَّف لدى هذه الحدود. فسيظهر بصورة لا لَبس فيها، كيف انبرى منظِّرو الحداثة إلى الإمساك بناصية الفلسفة قصْدَ تطويعها، وتحويلها إلى علم كسائر العلوم الإنسانيَّة. فلمَّا أن أفلح هؤلاء بما انبروا إليه – وفي طليعتهم إيمانويل كانط – وجدنا كيف انحصرت مهمَّة الفلسفة الحديثة بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل، والنظر- إلى هذه البنية – باعتبارها المرجع الوحيد الذي ينبغي الاستناد إليه لفهم الأساس الحقيقيِّ للمعرفة اليقينيَّة بالعالم.
العلم الذكيُّ وتحدّيِ «معرفة الشيء في ذاته»
بظهور العلم الفائق الذكاء، سيكشف الديالكتيك الداخليُّ لهذا العلم حقائق غابت عن العقل الفلسفيِّ من نسخته الإغريقيَّة إلى وقائعه المستحدثة. هذه الحقائق التي أطلقتها الفيزياء الكوانتية سوف تجعل الفلسفةَ أمام حرجٍ عظيم، قوامه الخشية من تقويض أحد أمتن أركانها الأنطولوجيَّة، وهو استحالة التعرُّف على «الشيء في ذاته».
هنا لست أخفي الذي استشعِرهُ بين حين وحين، أنَّ الفيزياء الحديثة ربَّما جاوزت نباهة التقليد الفلسفيِّ لمَّا أخرجت هذا البعض اليسير عن صلته الوثيقة بحقيقة ذلك المكنون الأصيل الذي يُسمَّى «الشيء في ذاته». ولكن حين أحكمت الفيزياء الحديثة دربتها، وفقًا لوحدة مكوِّنات الكون، راحت تتعامل مع تعدُّد مكوِّناته وتنوُّع أجناسها كنفسٍ واحدة. ثمَّ طفقت ترسم خطوط سيرها على واحديَّة لا انفصام لها بين الشيء المحتجب بذاته والأشياء البادية للعيان. ثمَّ لتقرِّر من بعد التجربة والملاحظة أنَّ كلَّ شيء من أشياء الكون يسري بلا انقطاع او انفصال، من نفسه الباطنة إلى نفسه الظاهرة وبالعكس. ثم ماذا كذلك؟..
لو نظرنا من داخل حقول الفيزياء المستحدثة، سوف تطلُّ علينا فرضيات تقول بوجود قوانين غير مرئية للأذهان، بل هي ذات وجود مستقلٍّ بمعنى من المعاني. من الأسئلة التي سُئلت حيال تلك الفرضيات: ما شكل وطبيعة ذلك الوجود الذي يحملنا على أن ننسب إلى شيء مجرَّد جدًّا، وسديميٍّ جدًّا، بأنَّه من قوانين الطبيعة؟. بعض فيزيائيّي الكَمِّ المُحدَثين وجدوا أنَّ ثمَّة ما يفيد بأن ليس جميع الأشياء التي يُقال عنها إنَّها موجودة هي ملموسة مثل الإسمنت. الذرَّات مثلًا، صغيرة جدًّا، ولا يمكن رؤيتُها أو لَمْسُها، أو الإحساس بها مباشرة بأيِّ شكل من الأشكال. أما معرفتنا بها فتأتي بشكل غير مباشر، وعبر معدَّات وسيطة. كما أنَّ البيانات التي تأتي منها يجب أن تُعالج وتفسَّر. لدى ما تعدِ به ميكانيك الكوانتم ما يجعل الأمر أكثر سوءًا. إذ ليس ممكنًا – مثلًا – أن ننسب مكانًا محدَّدًا أو حركة محدَّدة إلى ذرَّةٍ ما في الوقت ذاته. فالذرَّات، والجزيئات ما دون الذرّيَّة تسكن عالمًا ظِلِّيًّا ذا نصف وجود. [بول ديفز ـ التدبير الإلهي ـ الأساس العلميّ لعالم منطقي ـ ترجمة: محمد الجورا ـ مراجعة: جهاد العلم ـ دار الحصاد، دمشق ـ ط1 2009 ـ ص90].
خلاصة ما يذهب إليه هؤلاء يتمثَّل في تساؤلهم الحائر عمَّا إذا كان لقوانين الفيزياء وجودٌ متعالٍ. فيزيائيّون كثيرون يعتقدون أنَّ الأمر هو كذلك. بل إنَّهم يتحدَّثون عن اكتشاف قوانين الفيزياء وكأنَّما هذه القوانين كانت موجودة هناك في مكان ما. في حين أنَّ ما نسمّيه اليوم قوانين الفيزياء، هي فقط مقاربة تجريبيَّة لمجموعة فريدة من قوانين حقيقيَّة.
بالطَّبع، قد لا يشعر أكثر الفيزيائيين – بل جلُّ فلاسفة العقل الأدنى – بالارتياح تجاه فكرة قوانين متعالية. وما ذاك إلَّا لارتيابهم من الإقرار بالجنبة الَّلاهوتيَّة لتلك القوانين. بعض هؤلاء يشيرون إلى أنَّ علماء، مثل علماء الرياضيَّات، ينطلقون من فرضيَّة تقول إنَّ لحقائق موضوعاتهم وجودًا مستقلًّا… أو كأنَّ ثمَّة مجموعة واحدة من القوانين يسير الكون وفقها بكلِّ واقعيَّة وبمعزل عن هذا العالم الذي تحكمه. ولو استقرأنا تاريخ العلم لألفيناه حافلًا بالشواهد عمَّا كان يُعدُّ ذات يوم حقائق أساسيَّة لا يمكن الاستغناء عنها، ثمَّ اتَّضح من بعد ذلك أنَّها كانت محدودة، ويمكن الاستغناء عنها. والمثل واضحٌ لنا لمَّا عُدَّت الأرض مركز الكون، وبقيت كذلك قرونًا حتى اكتشف العلماء عكس ذلك.
سوف يصل الجدل بين علماء الفيزياء الحديثة إلى درجة تستثير الدهشة. قد يكون الأبرز والأكثر إثارة فيه، الإقرار بوجود صِلاتٍ وثيقةٍ بين الفيزياء والميتافيزياء. اللاّفت في إقرار كهذا، هو أنَّ القوانين بذاتها لا تصف العالم تمامًا، فالهدف الكلّيُّ من صياغتهم للقوانين هو ربط أحداث فيزيائيَّة مختلفة في ما بينها. ولأجل أن تكتمل اجراءات الربط، لا مناص من التناغم بين القوانين الكلّيَّة والشروط البَدئيَّة المناسبة لوضعيَّة وخصوصيَّة كلِّ حالة. فالقوانين –كما يقررون- هي ضربٌ من أقوال حول نوع من الظواهر، والشروط البَدئيَّة ضربٌ من أقوال حول أنظمة محدَّدة لكلِّ ظاهرة. ولكي يقوم عالم الفيزياء بتجربةٍ ما، فإنَّه يختار – غالبًا – أو يفترض شروطًا بدئيَّة محدَّدة. على سبيل المثال، في تجربته الشهيرة على سقوط الأجسام، حرَّر غاليليو كتلتين غير متساويتين حجمًا في وقت واحد، لكي يبرهن على أنَّهما سوف تصدمان الأرض في الوقت ذاته. بالمقابل لا يستطيع العالم أن يختار القوانين (لأنَّها معطى إلهيّ)، وهذه الحقيقة تضع تلك القوانين في مكان أعلى بكثير من الشروط البدئيَّة التي تُعدُّ عرضيَّة، وقابلة للتعديل، بينما القوانين أساسيَّة وأبديَّة ومطلقة. وعليه، ينظر معظم الفيزيائيّين إلى الشروط الأوَّليَّة الكونيَّة على أنَّها واقعة خارج مدى العالم تمامًا، ويجب قبولها مثل القوانين كحقائق صرفة. بل حتى تلك التي لها إطار عقليٌّ دينيٌّ فإنَّها تتوجَّه إلى الله لتفسيرها.
من المغري – كما يعرب هؤلاء – أن نفترض أنَّ الشروط البدئيَّة لم تكن عشوائيَّة، بل إنَّها ملتزمة بمبدأ ما أساسيّ. في نهاية المطاف، يتمُّ قبول فكرة أنَّ قوانين الفيزياء ليست عشوائيَّة، بل بالإمكان توضيبها في علاقات رياضيَّة ذكيَّة. ومن الأهميَّة بمكان أن ندرك أنَّ قانون الشروط البدئيَّة لا يمكن البرهنة على صحَّته أو خطأه، أو أن نستمدَّه من قوانين فيزيائيَّة موجودة. ذلك أنَّ جدوى أيِّ قانون كهذا تكمن في قدرته على التنبُّوء بنتائج قابلة للملاحظة والاختبار، كما هو الحال مع جميع المقترحات العلميَّة.
والاعتقاد الغالب هو أنَّ المقترحات حول قوانين الشروط البدئيَّة تدعم بقوَّة الفكرة الأفلاطونيَّة القائلة: إنَّ القوانين متعالية على الكون الفيزيائيّ، وإنَّ قوانين الفيزياء أتت إلى الوجود مع الكون، وأنَّها في الآن عينه لا تستطيع أن تفسِّر أصل الكون،لأنَّها لم تكن موجودة إلَّا حين وُجد الكون. وهذا واضحٌ جدًّا عندما يتعلَّق الأمر بقانون الشروط البدئيَّة، لأنَّ قانونًا كهذا يسعى ليفسِّر بكلِّ دقَّة كيف أتى الكون إلى الوجود، وبالشكل الذي أتى به. من أجل ذلك، يقرِّر الفيزيائيّون أنَّ احتمال التشكُّل العشوائيِّ لمادَّة الكون ضعيفٌ جدًّا. ولقد توصَّلوا بنتيجة بحوث كثيرة إلى استنتاج أنَّ: الكون الماديَّ، والفراغ، والزمن، والحياة، والكائنات العاقلة على الأرض، والكواكب الأخرى.. كلَّها من صنع عقلٍ فائقٍ التدبير. ما يعني ـ بحسب توصُّلات الفيزياء الحديثة ـ أنَّها مجتمعة على نظام حركة وحياة واحدة، وأنَّ الكون مبرمجٌ قبل نشوئه لكي تظهر فيه موادُّ حيَّة، وكائناتٌ عاقلة. فالتقصّيات العمليَّة والنظريَّة الجديدة للعلماء توفِّر الأسس التي ستقوم عليها الرواية العلميَّة التالية لخلق العالم.
يؤكِّد العلماء أيضًا وجود نظريَّة فيزيائيَّة جديدة، وضعت نتيجة لتطوُّر تصوُّرات أ. آينشتاين، وقد ظهر فيها مستوى معيَّن من الحقيقة وتمتلك كلَّ علامات الألوهيَّة، وهي النظريَّة التي يُطلق عليها عبارة «العدم المطلق». والعدم المطلق الذي يرومونه قد يكون هو نفسه «الشيء في ذاته»، والذي منه يبدأ كلُّ شيء… هذا «العدم» لا يكتفي بخلق المادَّة –كما يقرر العلماء- وإنَّما يضع لها مخطَّطات ومقاصد وغايات». ولقد ألمح آينشتاين – ذات يوم – إلى فكرة أكثر أهميَّة، لخَّصها في التساؤل عمَّا إذا كان لدى الله أيُّ خيار في خلق العالم على غير ما هو عليه. قد لا يكون صاحب نظريَّة النسبيَّة متديِّنًا بالمعنى التقليديِّ للكلمة، إلَّا أنَّه غالبًا ما استطاب استخدام كلمة الله للتعبير عن أسئلة وجوديَّة عميقة. ومع أنَّ هذا التساؤل أغضب في حينه أجيالًا من العلماء والفلاسفة والَّلاهوتيّين، إلَّا أنَّه استولد أسئلة مستأنَفة ليس بمقدور أحد من هؤلاء الإعراض عنها أو تجاهل الإجابة عليها.
أبرز هذه الأسئلة وأكثرها تحدّيًا للفلسفة والفيزياء معًا، تلك المتعلِّقة بالعقل الفائق ومكانته التدبيريَّة في إرجاع مظاهر الأشياء إلى اصول ذواتها الخفيَّة. لم يكن التفكير بحاضريَّة العقل الفائق التدبير مجرَّد مقترح لاهوتيٍّ شاع أمرُه في مجادلات القرون الوسطى، بل هو حصيلة اختبارات شاقَّة ومديدة في محراب الفيزياء الدقيقة. مع الأسئلة التي خرجت بها الفيزياء الحديثة، سوف يتضاعف منسوب التحدّي في أوساط العلماء والفلاسفة سواءً بسواء. لم يعد التفكير على سيرته الأولى حيال الفرضيَّة التقليديَّة التي ترى أنَّ الأشياء، كما هي عليه، هي نتيجة لضرورة منطقيَّة أو حتميَّة. كذلك ما عاد أمرًا هيِّناً -بالنسبة إلى هؤلاء- إقصاء المشيئة والإرادة الإلهيَّتين من أصل القضيَّة، كما فعلت ميتافيزيقا الإغريق ورهطٌ وازنٌ من فلاسفة الحداثة.
لكن لو افترضنا أنَّ هؤلاء كانوا على صواب في ما زعموا، فذاك يعني أنَّ العالم بات نظامًا مغلقًا، وكلُّ شيء فيه جرى تفسيره ولا بقي منه سرٌّ مستتر. يعني ذلك أيضًا، أن لاحاجة بنا – فعليًّا - لأن نراقب العالم كي نكون قادرين على فهم شكله ومحتواه. ذلك لأنَّ كلَّ شيء يُستتبعُ من ضرورة منطقيَّة، هو من منتوج العقل وحده ولا شيء سواه.
غير أنَّ الفلسفة الإقصائيَّة للألوهيَّة، التي ميَّزت عصور الحداثة في الغرب، ستجد نفسها أمام تحدّيات حاسمة أطلقها العلم الذكيُّ والتحوُّلات الكبرى في الفيزياء الحديثة. فعندما تحدَّثوا عن مطلق يُعدُّ مصدرًا لكلِّ شيء موجود، فقد رموا بذلك إلى أنَّه في قلب أيِّ جسيمة من المادَّة وُضِعَ الأساس الحيُّ لـ «قطعة» خاصَّة من المطلق، تُعدُّ رفيعة التطوُّر، وواعية، ومصدرًا للمعلومات، وقادرة على إدراك ذاتها بذاتها. ويُطلق على هذه «القطعة» أحيانًا شرارة الإله. فالوعي موجود في كلِّ جسيمة أوليَّة، وفي كلِّ كمٍّ (كوانتي)، وفي كلِّ ذرَّة.
زيادة على ذلك، كل ما يمكن أن يكون - وأيًّا تكُن صفته - يصبح متميّزًا وله وعيُه الخاصّ. ثمَّ إنَّ وجود مثل هذه المواضيع، كالفكرة، وشكل الفكرة، والخطَّة التي تنطوي عليها، فضلًا عن الانفعالات التي تصاحبها، هي أيضًا لها وعيُها الخاصّ، بل إنَّها غير ممكنة من دون مصادقة المطلق، الذي يعطي الحياة لهذه الوقائع على شكل وعي. تأسيسًا على هذه الفرضيَّة، تصير الفكرة المترافقة بالوعي، هي الروح. والروح هي روح صرفة، غير مرتبطة بأيِّ كائن حيّ. ولا تقوم بشيء ولا تسعى إلى شيء.
إنَّها بكلمة: موجودة ببساطة. وإذا كان الكثير من الفلاسفة القدماء يقولون إنَّ عالم الأفكار موجود، فإنَّ علماء الفيزياء النظريَّة والتطبيقيَّة يعتقدون أنَّ: عالم الأفكار – هو حقيقةٌ ما، وهذه الحقيقة بالنسبة إلى المادَّة، هي الأكثر استقرارًا، وتشكِّل عالم الحقيقة الأعلى، وأساس كلِّ شيء. وقد أثبتوا أنَّ طبيعة هذه الحقيقة المفارقة (مادّيَّة ولا مادّيَّة) في الآن نفسه. لقد نشأت من فعل فاعلٍ شاءها بعقلٍ مدبِّر، ثمَّ من بعد ذلك أخذت المادَّة الفظة المألوفة لدينا بالظهور والتحيُّز في الزمان والمكان. فعلى سبيل المثال، يقرِّر القائلون بواقعيَّة عالم الأفكار، أنَّ الَّلفظ والتدوين وفاعليَّة الفكرة في حقل التأثير، هي العناصر إياها التي تمنح هذه الحقيقة المفارقة صورتها المادّيَّة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (برزخ) في القرآن الكريم
معنى (برزخ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (1)
حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (1)
الشيخ محمد صنقور
-
 شكر النّعم
شكر النّعم
الشيخ مرتضى الباشا
-
 هو بحقّ عبد الله
هو بحقّ عبد الله
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 كرّار غير فرّار
كرّار غير فرّار
الشيخ محمد جواد مغنية
-
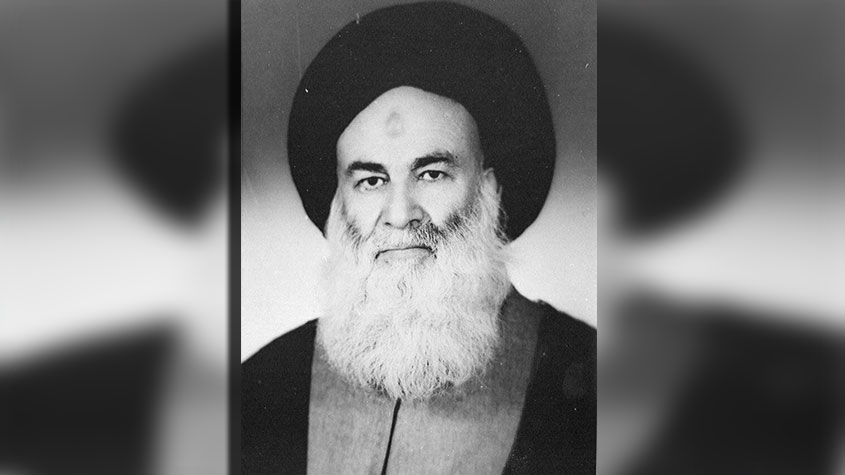 لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
السيد محمد حسين الطهراني
-
 الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الشهيد مرتضى مطهري
-
 المشرك في حقيقته أبكم
المشرك في حقيقته أبكم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الصبر والعوامل المحددة له
الصبر والعوامل المحددة له
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 الحوراء زينب: جنازة على كاهل الغربة
الحوراء زينب: جنازة على كاهل الغربة
حسين حسن آل جامع
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
الشيخ علي الجشي
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب