علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
د. حسن أحمد جواد اللواتيعن الكاتب :
طبيب وكاتب ومترجم، صدر له كتاب (المصمم الأعظم: قراءة نقدية في كتاب التصميم العظيم للبروفيسور ستيفن هوكنج)، كما ترجم الرواية الفلسفية (البعد الضائع في عالم صوفي) للمؤلف محمد رضا محمد اللواتي ونشرت الرواية في الولايات المتحدة الأمريكية. [email protected]العالِمُ العاقل

د. حسن أحمد جواد اللواتي ..
بالرغم من أن الهدف العملي للعلوم الطبيعية والأبحاث التي تجري فيها هو رفد وتغذية التقنيات والصناعة وتطوير سبل الحياة العصرية من خلال المنتجات التقنية والأجهزة وتشخيص وعلاج الأمراض ورفع مستوى الإنتاج في كل المجالات المادية إلا أن جانبًا من أهداف البحث العلمي الطبيعي لا يمكن تجاهله على مستوى أعلى من مستويات الحاجة الإنسانية للمعرفة والفكر والحصول على إجابات لأسئلة طالما شغلت ذهن الإنسان قديمًا وحديثًا.
الفكر والمعرفة العامة هي حاجة للإنسان بعد استيفائه لحاجاته المادية والمعنوية الأخرى وإن لم يشملها هرم ماسلو للحاجات الإنسانية، والبحث العلمي الطبيعي يقدم للإنسان مادة غنية ودسمة تعينه على تنمية المعرفة الفكرية لديه حيث أنها تزوده بما نسميه بالأصول الموضوعة للبحث الفكري، وكما نعلم فإن الأصول الموضوعة هي تلك المسّلمات التي نستقيها ونعتمد في صحتها على علوم أخرى بحيث أنها تفيدنا كمقدمات صغرى في عمليات البرهان الأرسطي وفي حالة ثبوت خطأ في الأصول الموضوعة لاحقًا فإن الملامة لا تقع على كاهل البحث الفكري وإنما تكون مسئولية العلم الآخر الذي قدم لنا تلك المعلومة.
ولكن هل الأصول الموضوعة هي الحلقة الضعيفة الوحيدة في عملية إنتاج المعرفة الفكرية؟ الجواب بالطبع لا، فالعملية الفكرية تتطلب إلمامًا وإتقانا لممارسة عناصر وعمليات التفكير الصحيح وهي التي نسميها بالمنطق، وهناك مجال كبير جدًّا للوقوع في أخطاء فادحة جدًّا نتيجة إهمال المنطق أو عدم التمكن من ممارسته عمليًّا أثناء إنتاج المعرفة الفكرية، ولأن المنطق الأرسطي يشمل عمليات تندرج في كثير من الأحيان تحت مسمى (الحس الشائع) ونمارسها في حياتنا اليومية بشكل غير واع فإننا قد لا ندرك مدى اعتمادنا وحاجتنا للمنطق الأرسطي للتفكير، ومن ناحية أخرى قد لا ندرك أيضًا مدى حجم الأخطاء والمغالطات التي نقع فيها جراء عدم ممارستنا للمنطق بشكل صحيح، كما أن وجود المنطق بشكل شبه خفي في خلفية تفكيرنا أثناء ممارستنا للبحوث العلمية الطبيعية يجعلنا أحيانًا نعتقد أن المعرفة التي ننتجها في تلك البحوث العلمية الطبيعية هي نتاج صاف لتلك البحوث الطبيعية من غير حاجة إلى أي منطق أو فلسفة أو بحث عقلي آخر، فترانا ننسب كل معرفة علمية إلى البحث الطبيعي فحسب، بل الأدهى من ذلك قد نرى الباحث الطبيعي بعد أن استقى معارف فكرية من البحث العلمي الطبيعي وبعد استخدام لا شعوري للعمليات المنطقية في الخلفية الذهنية المستترة لديه يخرج باستنتاجات تناقض أبسط بديهيات العقل وأكثرها يقينًا كأن ينكر الواقعية أو ينكر مبدأ العلية والسببية أو ينكر استحالة اجتماع النقيضين!
وبذلك يتضح لدينا أن المعطيات العلمية الطبيعية لا تكفي لوحدها إطلاقًا لإنتاج أية معرفة فكرية، بل قد تتحول تلك المعطيات إلى عائق أمام الباحث إن قرر التخلي عن عناصر التفكير السليم ولجأ إلى خلط الأوراق المنطقية في بحثه الطبيعي، عندها لا يكون ما ينتجه ذلك الباحث الطبيعي إلا مزيجًا من الحقائق والاستنتاجات الصحيحة مع المغالطات والأخطاء الفادحة التي تجعل من الصعب التمييز بين الغث والسمين في كلام ذلك الباحث.
ومن هنا نستطيع أن نقول أنه لكي تكون عالـمًا في أي مجال من المجالات فلا بد أن تكون قبل ذلك عاقلًا، ونعني بذلك أنه يجب أن تتقن استخدام العمليات العقلية التي تعتمد على البديهيات اليقينية قبل أن تطأ سماط البحث العلمي الطبيعي أو غيره لأنه بغير ذلك فإنك ستكون كالسائر بلا هدى والمسافر بلا خريطة فلا تزيدك سرعة البحث إلا تخبطًا.
وحيث قد قلنا ذلك، فيمكننا أن نأخذ النقاش إلى مستوى أكبر، ما هي الأسئلة التي يحق للعلوم الطبيعية الإجابة عليها؟ هل يحق للعلوم الطبيعية أن تقصي المباحث العقلية الفلسفية من ميدان الإجابة على بعض الأسئلة الكبرى؟ في كتابه (وهم الإله) طرح ريتشارد دوكينز وهو عالم أحياء تطورية نقاشًا عمن يحق له الإجابة على السؤال: هل الله موجود؟ فكانت الخيارات التي بحثها تنحصر بين العلوم الطبيعية وبين المدارس اللاهوتية الدينية من خلال النصوص الدينية المقدسة، ولا أدري هل كان ذلك الحصر حصرًا عقليًّا مانعًا جامعًا؟ (الحصر المانع يعني استثناء كل ما لا ينتمي لما يتم حصره، أما الحصر الجامع فيعني شمول كل ما ينتمي لما يتم حصره، وحين نقول الحصر الجامع المانع فيعني أن الحصر شمل كل ما ينتمي واستثنى كل ما لا ينتمي للمجموعة المحصورة) فهل يا ترى انحصر الأمر بين المدرسة الدينية وبين العلوم الطبيعية للإجابة على السؤال عن وجود الله؟ الأمر يبدو وكأن دوكينز قد رتب للأمر مسبقًا ليبدو الأمر للقارئ وكأن الإجابة واضحة تمامًا، إذ كيف يمكن الاستدلال على وجود الله من خلال كتب ونصوص دينية يفترض بها أن تكون نازلة من عنده؟ وهو بالطبع دور واضح وضوح الشمس، وعليه فإن البديل الوحيد الباقي هو الاستعانة بالعلوم الطبيعية لتقديم الإجابة المرجوة، نرى هنا بوضوح حجم الأخطاء التي يمكن أن نصل إليها إن تم تجاهل المنطق في التفكير سهوًا أو عمدًا.
ولكي نتناول هذا الأمر بشيء من التفصيل نرجع خطوة للوراء، وقبل أن نحدد المسئول عن الإجابة على السؤال عن وجود الله مثلًا سنحاول أن نحدد المسئول عن الإجابة على أسئلة من البحث العلمي الطبيعي نفسه، نعم سنقتحم عقر دار البحث العلمي الطبيعي ونرى إن كان العلم التجريبي يستطيع أن يقيم لنفسه قائمة بدون الاستعانة بالبحث العقلي المنطقي الفلسفي، لنحاول البحث عن شيء بسيط مثل: سبب غليان الماء وهي ظاهرة شائعة جدًّا نراها كل يوم ونحن نحضر الشاي أو القهوة أو نحضر الطعام في المطبخ، حسنًا، ما الذي تقدمه لنا التجربة والمشاهدة الحسية؟ إننا نلاحظ:
1- وجود مصدر حرارة (النار أو جهاز التسخين الكهربائي مثلًا) بوضعية معينة بالقرب من عينة من الماء
2- ثم نجد بعد فترة أن الماء يبدأ بالغليان عند درجة حرارة معينة
هل تقدم لنا هذه التجربة أكثر من ذلك؟ هل تستطيع التجربة أن تخبرنا أن هناك علاقة بين مصدر الحرارة وبين حدوث الغليان؟ إن الحس والمشاهدة يلتقطان التعاقب بين المشاهدتين أي أننا نرى شيئًا ثم نرى شيئًا آخر يعقبه، ولكن هل التعاقب لوحده كاف ليربط بين الشيئين؟ لو كان كذلك لكان هناك ربط من هذا النوع في تعاقب الليل والنهار، ولكننا نعلم (على الأقل أنا أعلم ذلك وأفترض من باب حسن الظن أنك أيضًا تعلم ذلك) أنه ليس في تعاقب الليل والنهار علاقة من قبيل علاقة حدوث الغليان بعد تعرض الماء لمصدر الحرارة بوضع معين، ولكننا معًا كباحثين يجريان تجربة غليان الماء نعلم أن مصدر الحرارة "سبب" ارتفاع درجة حرارة الماء والذي بدوره "سبب" حركة جزيئات الماء والهواء في العينة بشكل نسميه بالغليان.
ما الذي جعلنا نعتقد أن هناك سببية بين النار مثلًا وبين ارتفاع حرارة الماء وما الذي جعلنا نعلم أن هناك سببية بين ارتفاع حرارة الماء والهواء وبين حركة الغليان التي شاهدناها؟ هل رأينا بالمشاهدة الحسية تلك السببية؟ ما هو شكل السببية؟ ما هو لونها؟ كم هي كتلتها؟ هل لها شحنة كهربائية؟ هل لها أي من خصائص المواد؟ بالطبع لا فبالرغم من أن السببية أمر موجود حقيقة في الواقع وله مفهوم فلسفي مثله مثل مفاهيم الحركة والوجود إلا أن وجود السببية ليس من النوع المادي الذي تستطيع التجربة والمشاهدة الحسية أن تلتقطه بالحواس أو بالأجهزة المساعدة للحواس، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تأتى للتجربة التي قوامها الحس والمشاهدة الحسية أن تتعرف على السببية بين النار الحرارة وبين الحرارة والغليان؟
إننا هنا نجد أنفسنا أمام وضع يجبرنا على الاعتراف بأن هناك أداة أخرى من شأنها التعرف على السببية بين الظاهرتين، وهذه الأداة الأخرى ليست سوى العقل، العقل هو الذي أدرك وجود السببية بين الحرارة والغليان وهو نفسه الذي أدرك عدم وجودها في تعاقب الليل والنهار، وعلى هذا فإن العقل هو من منح لتلك المشاهدة الحسية قيمتها المعرفية ولولاه لكانت المشاهدات الحسية ليست إلا مجرد بيانات متفرقة لا يربط بينها رابط معرفي مفيد.
لننتقل الآن إلى الخطوة الثانية من السلم المعرفي للبحث الطبيعي، لنقل أننا علمنا بشكل ما أن تلك النار (أو مصدر الحرارة المحدد في تلك التجربة) كان سببًا في ارتفاع حرارة تلك العينة من الماء بالذات، بالطبع هذه النتيجة غير كافية إطلاقًا للباحث التجريبي، فما الذي سينفعه أن يعلم خصائص العينة التي بين يديه إن لم يستطيع تعميم تلك النتيجة على مجموعة كبيرة من المياه في العالم فذلك في النهاية هو الهدف من إجراء التجارب، أليس كذلك؟
إذن، كيف نعلم أن بقية مصادر الحرارة في الكون ستؤدي إلى ارتفاع بقية عينات الماء فيه؟ وكيف نعلم أن بقية عينات الماء الحارة إلى درجة معينة ستغلي؟ هل هناك شيء في المشاهدة الحسية يستطيع تعميم حكم العينة المفردة (أو حكم مجموعة محددة من العينات) على بقية العينات من نفس النوع؟ هل التعميم أمر يمكن لمسه أو مشاهدته أو تذوقه أو شمه أو سماعه؟ لا أظن ذلك، وعلى ذلك فإننا أمام هوة أخرى وهي الهوة بين عينات محدودة أجريت عليها التجارب وبين بقية العينات الأخرى التي لم تجر عليها أية تجربة، وهذه الهوة لا يقوى الحس أو التجربة على اقتحامها، فما الحل؟
الحل مرة أخرى يكمن في جعبة العقل، فبموجب قاعدة العلية والسببية التي تعلمناها من العقل فإن وجود العلة مستلزم لوجود المعلول دائما وأبدًا، أي كلما تواجدت العلة فلا بد من تواجد المعلول معها وإلا لم تكن العلة لتكون علة ولا كان المعلول ليكون معلولًا، وهذا التلازم الواجب بين العلة والمعلول يمكن صياغته في شكل قاعدة أسهل فهما مفادها (حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد)، أي أنه لو كان لدينا شيئان متماثلان فإن ما يجوز لأحدهما يجوز للآخر منهما وما لا يجوز لأحدهما لا يجوز للآخر أيضًا، وبالتالي فإن ما يجوز لعينة الماء في التجربة يجوز لأية عينة أخرى في الكون إن تماثلت ظروفهما وهذا من بركات ونتائج قانون العلية الرائع.
هل انتهت مشاكل المعرفة من خلال التجربة؟ بالطبع لا، فلا زال لدينا جبل شاهق آخر يجب علينا تسلقه للوصول إلى أية معرفة من خلال التجربة والحس، علمنا أن الحرارة تسبب الغليان في الماء أينما كان، ولكن، كيف نعلم أنه في الوقت الذي تسبب فيه الحرارة غليانا فإنها لا تسبب غليانا؟ كيف نعلم أن (الماء) هو في ليس في نفس الوقت (لا ماء)، وكيف نعلم أن (الحرارة) في نفس الوقت ليست (لا حرارة)؟ هل تعتقد أن هذه هي أسئلة سخيفة؟ إن كنت تعتقد ذلك فأنت تختلف مع مدرسة فكرية تسمى بالديالكتيكية المادية التي آمنت ليس فقط في إمكانية اجتماع النقيضين، بل آمنت أن اجتماع النقيضين واجب وضروري حتى تتحقق الحركة! ولست هنا بصدد مناقشة الديالكتيك في فساد هذا الرأي وإنما ذكرته لأشير إلى أننا نحتاج أن نتفق منذ الآن وإلى الأبد أن اجتماع النقيضين مستحيل، فهل تستطيع التجربة أن تقدم لنا ذلك؟ مهلا هل تستطيع (التجربة/لا تجربة) أو (الحواس/لا حواس) تقديم ذلك؟ كيف يمكن لها ذلك وهي في نفسها تحتاج لقاعدة استحالة اجتماع النقيضين، وبالطبع فإن العقل هو الذي يقدم لنا هذه القاعدة على طبق من بديهة يقينية أولية، بديهة لأنها لا تعتمد على تفكير مسبق وأولية لأنها أول ما نحتاج إليه حتى نصل لأي علم ويقينية لأن الشك لا يتجرأ أن يقترب قيد أنملة منها.
يا سيدي الفاضل والباحث التجريبي، إن العقل كما رأينا يخدم التجربة والمعرفة العلمية الطبيعية في الإجابة على أبسط سؤال تجريبي يبحث عن علاقة الحرارة بالغليان، وهي تجربة كما ذكرت نجريها كل يوم آلاف المرات ونحن نحضر كوبًا من الشاي أو القهوة لنحتسيه قبل قراءة كتاب مثل كتاب (وهم الإله) لريتشارد دوكينز، فهل يا ترى لا زلت تعتقد أن التجربة تستطيع إقصاء العقل والفلسفة والمنطق خارج سماط البحث الفكري والعلمي والمعرفي؟ إن كنت تعتقد ذلك فلعلك تحتاج إلى كوب من القهوة لتعيد لك بعض التركيز وحاول أن تكون عاقلًا قبل أن تحاول أن تكون عالـمًا.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 حبط الأعمال
حبط الأعمال
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

مكاسب رمضانية
-

معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
-

حبط الأعمال
-
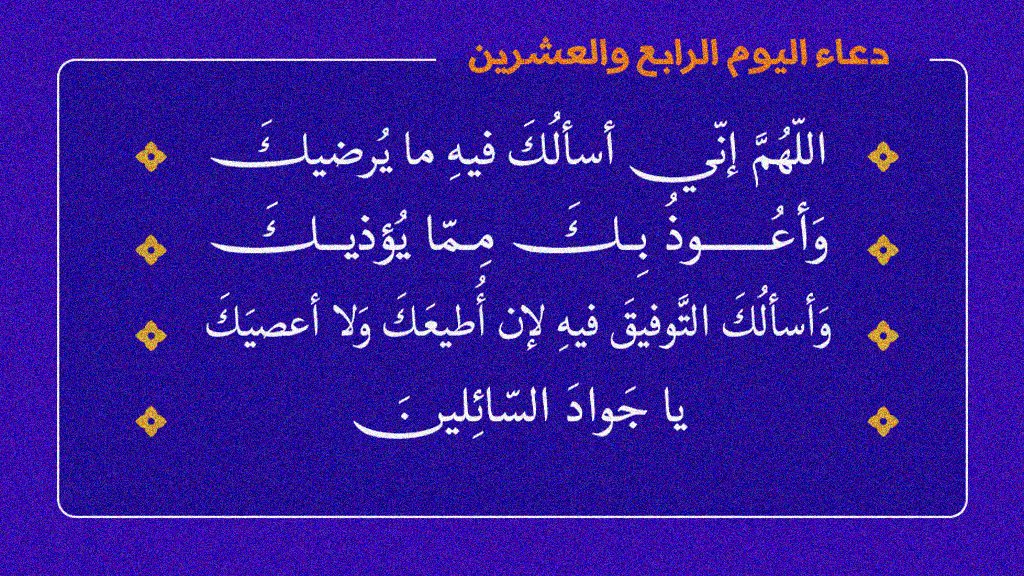
شرح دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة
-

المساواة في شهر العدالة
-
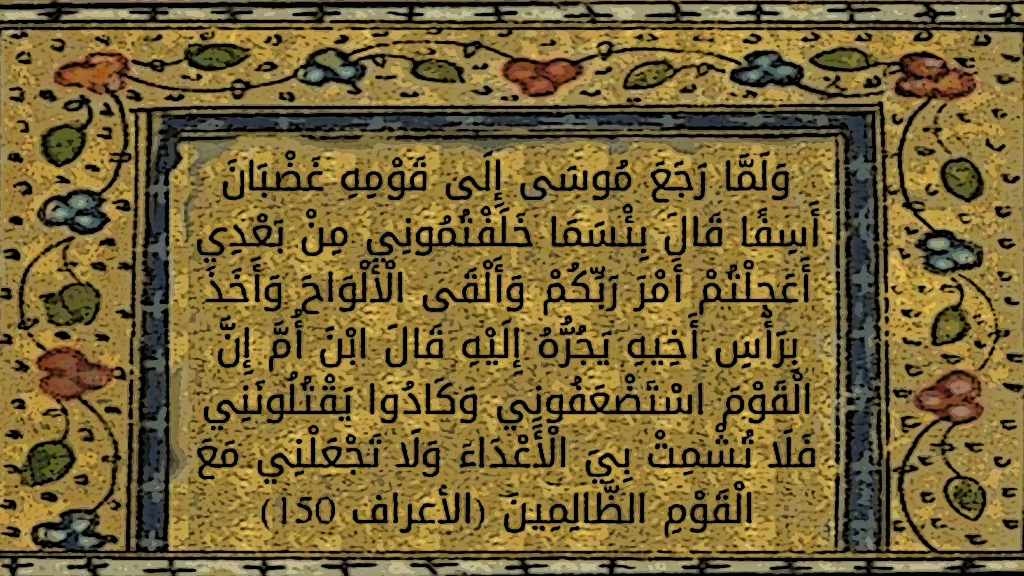
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟










