قرآنيات
سياسة نبي الله شعيب في الدعوة

السيد موسى الصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ / وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ / وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ / قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ / قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ / وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ / فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ / الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ / فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾(1).
هذه الآيات تنقل الحوار الذي جرى بين نبي الله شعيب وبين قومه، أو بين الملأ من قومه. ومن الطبيعي أنّ القرآن، بوصفه كتاب دين، يهتم بالتربية، وعندما ينقل حادثة أو حواراً أو واقعة، لا يقصد قصة أو تسلية، بل إنما يقصد مفهوم الحكاية، ونتائج هذه الحادثة بمفهومها الشامل.
ولذلك، فالحادثة يجب أن تُدرس بمفهوم أوسع من الاعتبارات الخاصة بالحادثة. وتطبق على حياتنا العادية، على حياتنا الاجتماعية، على أوضاعنا الاجتماعية دائماً.
بالنسبة لشعيب، كما يؤكد القرآن الكريم أنه كان نبياً، وأُرسل إلى مدين، ودعا إلى الله وقال: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ عبادة الله وحده، والتنكر للآلهة. والإله، في المصطلح القرآني، عبارة عن قدس الأقداس. الدافع الأصيل للإنسان، كما يُفهم من نص آية أخرى عندما يقول القرآن: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾(2) الذي يتخذ إلهه هواه، لا يعني أن يصلّي لأجل هواه، بل إنّ هواه وأنانيته هي التي تحركه وتكون قدس الأقداس، وسبب الأسباب لنشاطاته. ينطلق الإنسان دائماً من مبدأ، هذا المبدأ الأصيل، هو في المصطلح القرآني، إلـه. يطلب القرآن الكريم أن يكون قدس أقداسنا، هو الله. الواجب الذي يجمع جميع صفات الكمال. فعندما يكون الله وحده دافعنا، فهو دافعنا نحو الكمال، وموحدنا في نفس الوقت.
وشعيب أيضاً، طلب من الناس أن يتنكروا لآلهة الأرض، لا أن يتجاهلوا وجود عواطف ومشاعر وحاجات لا يعتبرونها آلهة، بل وسائل لمعالجة الحاجات. فالمال، أو الجاه، أو العمل، خير ونعمة، ولكنه ليس إلهاً يُعبد من دون الله.
كان شعيب يطلب التنكر لآلهة الأرض، للظالمين، للطغاة، لآلهة المال، لآلهة الشهوات. وكان يؤكد أيضاً على العدالة في الكيل والميزان، وعدم بخس الناس أشياءهم. المشكلة أنّ الإنسان يجعل لكل شخص كيلاً وميزاناً. فالإنسان يكيل ويوزن عمل نفسه بميزان، وعمل أصدقائه وأرحامه، وجماعته بميزان آخر. ويكيل عمل الآخرين، المحايدين أو الخصوم، بميزان آخر. وهنا يختلّ التوازن، وينحاز الإنسان، ويبتعد عن الحق. بينما يجب أن يكيل الإنسان كل شيء بميزان واحد. فالحق واحد، والعدل واحد، لا يختلف عند صديق أو عدو، عند الذات وعند الآخرين.
وماذا كان مصير شعيب عندما كان يدعو الناس الى عبادة الله، والى الوفاء بالكيل، وإلى عدم الإفساد في الأرض؟
الناس، أو على حد تعبير القرآن "القوم"، كانوا مطمئنين لهذا الطلب، وكانوا مسرورين بهذه الدعوة. ولكن المنتفعين، أو على حد تعبير القرآن الكريم {الملأ المستأثرين}، هؤلاء وجدوا في دعوة شعيب خطراً على مصالحهم، وعلى منافعهم. لأنهم، أي المستأثرين، يصطادون في الماء العكر. يستفيدون من الإنحياز، يستفيدون من عدم تطبيق القوانين على الجميع، يربحون من التفاوت بين الناس والتصنيف للناس. لذلك، عبادة الله الواحد، ووحدة الكيل والميزان، تضرّان الملأ المحتكرين، المستأثرين، المستعمرين، المسيطرين على الناس. أو على حد تعبير القرآن المستضعِفين للناس.
هؤلاء وجدوا أنّ مصالحهم في خطر، كيف يعالجون مشكلة شعيب، قالوا له: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾.
استعانوا بالعادة، استعانوا بقوة الاستمرار، استعانوا بتمسك الإنسان بما ورثه من السابقين.
مع العلم أنّ شعيباً كان يدعو لخير الناس، ولكنهم لم يريدوا ذلك، بل أرادوا التمسك بما كان موجوداً من قبل، حتى يستمروا في استثمارهم وطغيانهم على الناس.
رد شعيب كان على هذا الاحتجاج، وهذا الطلب أيضاً الاستمرار بالدعوة، وطلب من الله بقوله: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾.
طلب من الله (سبحانه وتعالى) أن يساعده على فتح أعين القوم، أي الشعب، لكي يعرفوا أنّ دعوة شعيب، هي من مصلحتهم. وأنّ دعوة الملأ، دعوة النخبة المستأثرة، المستفيدة من الوضع الحاضر، ليست مصلحة الناس. بل هي مصلحتهم أنفسهم. ولذلك، أصروا مؤكدين على شعيب: ﴿وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ﴾. ولكن الخاسر الحقيقي، هم لا الناس. فالناس كانوا يربحون من دعوة شعيب. والنتيجة أنّ الله (سبحانه وتعالى) يضيف قائلاً: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾.
من الطبيعي أنّ الناس إذا لم يسمعوا لدعوة المصلحين، لدعوة الناس الذين يدقون ناقوس الخطر، ويؤكدون على أخطار الاستمرار في التجاهل لمصالح الناس، والسكوت على مصالح المستأثرين. بالنتيجة انفجار المجتمع. وهكذا حصل لدى قوم شعيب.
من هذه الحادثة نجد أنّ كل مصلح أمامه هذا الحوار المضني بصورة أو بأخرى، فهناك بعض الأحيان يستعمل الكلام، أو الإتهام، أو الضغوط الأخرى، أو الإخراج، أو العنف بالنسبة إلى الدعاة المصلحين، ولا علاج إلاّ إذا فتح الله بينهم وبين قومهم بالحق، فيفتح عيونهم وعقولهم، لكي يحسوا مصالحهم ومنافعهم. عند ذلك فهم الرابحون، والملأ هم الخاسرون، أي المستأثرون، هم الذين يخسرون المعركة بالنتيجة.
على هذا الأساس، فكل دعوة لخدمة الناس لا لخدمة الملأ، تصطدم بمصالح الملأ. فالملأ يدافعون عن مصالحهم، والناس يسكتون. أما إذا وقف الناس مع الدعوة الصالحة، فالخير لهم وللدعوة، وللملأ بالنتيجة. هذه هي الحقيقة، التي يعبّر عنها القرآن الكريم، بصورة أو بأخرى. والتي تتلخص في نهاية هذه الآيات بالقول المعجز: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾(3).
ففي الإيمان والتقوى، فتح لبركات معنوية، من علم وتقوى، وراحة وطمأنينة. وبركات الأرض، أي خير المال، ونشاط في التجارة، واتساع في الأمن، وازدهار في البلد. ولكن عندما يكذّبوا: ﴿وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾(4). فالله (سبحانه وتعالى) لا يعذّب انتقاماً من الناس، بل أعمال الناس هي التي تؤدي إلى النتائج السيئة التي يعانيها الناس. فما من حالة مزعجة وسير سيئ، وأوضاع اجتماعية متدهورة، إلاّ وهي نتيجة عمل الناس. كما يؤكد ذلك القرآن الكريم، في آيات متعددة وفي مواضع عديدة. مؤكداً أنّ المسؤولية لتدهور الأوضاع على الملأ المستأثر، وعلى الشعب، أو القوم الساكت، والذي لا يفتح عينه لمعرفة حقيقة مصالحه.
ــــــــــــ
1- الأعراف/85 ? 93.
2- الجاثية/23.
3- الأعراف/96.
4- نفس المصدر.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
الشيخ محمد صنقور
-
 (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة
-

المساواة في شهر العدالة
-
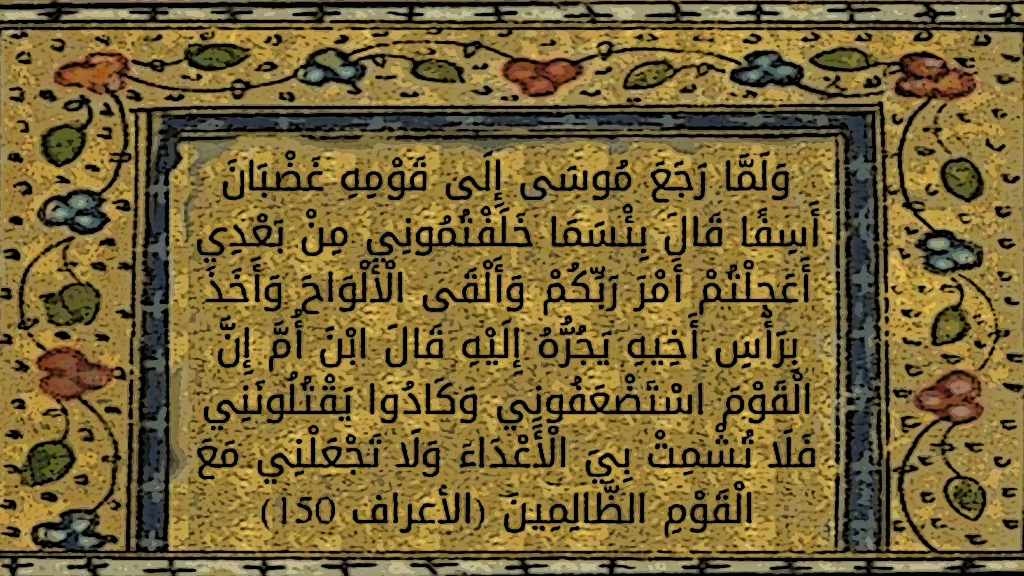
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
-
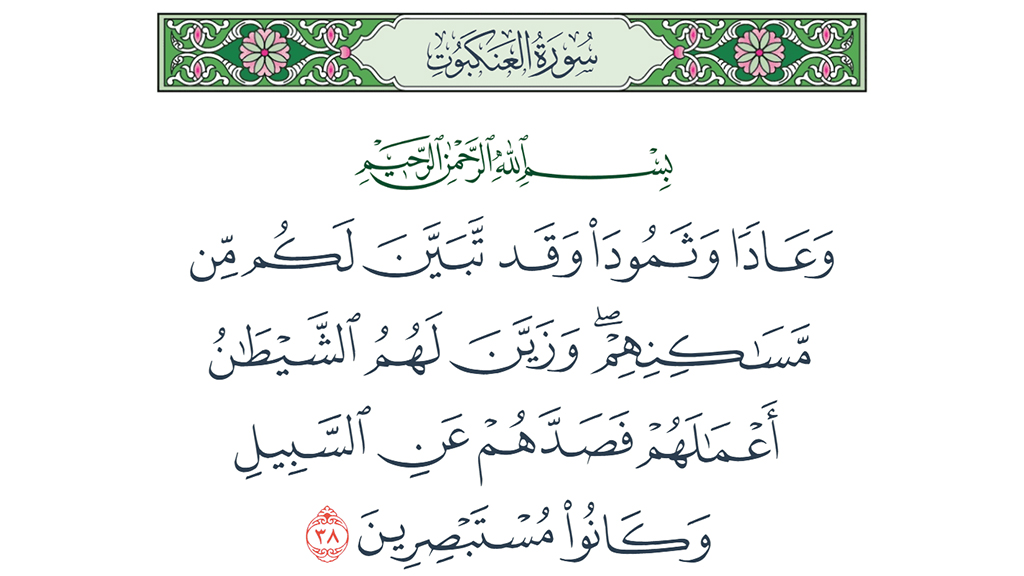
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
-

شرح دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
-

ما هي ليلة القدر
-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟









