قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد جعفر مرتضىعن الكاتب :
عالم ومؤرخ شيعي .. مدير المركز الإسلامي للدراساتالقرآن في معركة التحدّي

بعد أن نزل القرآن الكريم في عصر الفصاحة والبلاغة، وأبهر العقول ببديع نظمه وعذوبة ألفاظه وبليغ عباراته، قام أعداء الإسلام بتوجيه عدّة اتهامات لهذا الكتاب العظيم، فقالوا بأنّه شعر وسحر وغير ذلك، فتحدّاهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن، فلمّا عجزوا تحدّاهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، فعجزوا عن ذلك أيضاً، ثمّ صعّد تحدّيه لهم، وطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فلو أنّهم استطاعوا أن يأتوا ولو بقدر سورة الكوثر، التي هي سطرٍ واحد، لثبت بطلان هذا الدين الجديد من أساسه، ما دام أنّه هو قد قبل بهذا التحدّي مسبقاً، ولكانوا قد وفّروا على أنفسهم الكثير من الويلات، التي أقدموا عليها بإعلانهم الحرب على النبي الأعظم (ص)، والتي أدّت إلى إزهاق النفوس الكثيرة، وهدر الطاقات العظيمة، وغير ذلك من مصائب وكوارث، انتهت بهزيمتهم، وانتصار الإسلام وقائده الأعظم (ص).
فما هي تلك الخصيصة التي في القرآن، التي جعلتهم يعجزون عن مجاراته، وحتى عن أن يأتوا ب {بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [سورة البقرة، 23]؟!.
بل ما هي تلك الخصيصة التي سوّغت التحدّي بالقرآن للإنس والجنّ معاً، دون اختصاص بزمان دون زمان، قال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [سورة الإسراء، 88].
ربما يقال: إنّها إخباراته الغيبية الصادقة، سواء بالنسبة إلى الماضين كقوله تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا} [سورة هود، 49]. أو بالنسبة لتنبؤاته المستقبلية، كقوله تعالى: {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [سورة الروم، 1-3]. وكإخباره بنتائج حرب بدر العظمى، وغير ذلك [راجع: البيان للسيد الخوئي، ص81 - 84].
وربما يقال: إنّه لتضمّن القرآن للمعارف العلمية، التي تنسجم مع العقل والبرهان، وإخباراته عن سنن الكون وأسرار الخليقة، وأحوال النظام الكوني، وغير ذلك من أمور لا يمكن الوصول إليها إلا بالعلم والمعرفة الشاملة والواسعة، الأمر الذي لم يكن متوفراً في البيئة التي عاش فيها النبي (ص) كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [سورة الحجر: 22] وغير ذلك من الآيات التي تُشير إلى دقائق وحقائق علمية، في مختلف العلوم والفنون.
وربما يقال: إنّ إعجازه إنما هو في نظامه التشريعي الذي جاء به، والذي لا يمكن لرجل عاش في بيئة كالبيئة التي عاش فيها الرسول الأعظم (ص) وعانى من الظروف والأحوال الاجتماعية، ومستوى الثقافة في ذلك العصر، أن يأتي بمثل ذلك مهما كان عظيماً في فكره، وذكائه، وسعة أفقه.
ولربما نجد الإشارة إلى هذين الرأيين في قوله تعالى: {قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [سورة يونس، 16].
وأخيراً، فلربما يقال: إنّ إعجاز القرآن هو في عدم وجود الاختلاف فيه، ولذلك ترى أنّه قد تحدّاهم بذلك فقال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [سورة النساء، 82]. وثمّة إشارات أخرى لجزئيات ربما يدخل أكثرها فيما قدّمناه.
ولعل فيما ذكرناه كفاية. وثمّة قول آخر، أكثر شيوعاً ومعروفية ولا سيما بين القدماء، وهو إعجاز القرآن في الفصاحة والبلاغة، وقد كتبوا في هذا الموضوع الشيء الكثير قديماً وحديثاً. أما نحن فنقول: إن هذا الأخير هو السرّ الأعظم في إعجاز القرآن الكريم حقّاً، وهو يستبطن سائر الجوانب الإعجازية المذكورة آنفاً وغيرها ممّا لم نذكره.
ونقصد ب "البلاغة" معنى أوسع ممّا يقصده علماء المعاني والبيان، وهذا المعنى يستبطن جميع وجوه الإعجاز وينطبق عليها، وبيان ذلك يحتاج إلى شيء من البسط في البيان فنقول: إنّه إذا كان الرسول (ص) قد أرسل للناس كافّة، فلا بدّ أن تكون معجزته بحيث يستطيع كل من واجهها: أن يدرك إعجازها، وأنّها أمر خارق للعادة وأنّها صادرة عن قدرة عليا، وقوّة قاهرة، تهيمن على النواميس الطبيعية، وتقهرها، وإلا فإنّه إذا جاء شخص مثلاً إلى بلد، وادّعى أنّه يعرف اللّغة الفلانية، ولم يكن أحد في البلد يعرف شيئاً من تلك اللّغة، ولا سمع بها، فإنّهم لا يستطيعون أن يحكموا بصدقه ولا بكذبه، إذ ليس لهم طريق لإثبات هذا الصدق أو الكذب.
وأمّا إذا ادّعى أمراً لهم خبرة فيه، واستطاعوا أن يتلمّسوا فيه مواقع خرقه للنواميس الطبيعية فلا بدّ لهم من التسليم له والقبول بدعوته؛ لأنّ ذلك يكون قاطعاً لعذرهم، وموجباً لخضوع عقولهم لما يأتي به.
وبكلمة موجزة نقول: لا بدّ أن تكون معجزة النبي في كل عصر متناسبة مع خبرات ذلك العصر، ولكل من أرسل إليهم؛ ليمكن إثبات إعجازها لهم، وإقامة الحجة عليهم. وإذا كان القرآن قد تحدّاهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فلا بدّ أن يكون وجه الإعجاز فيه سارياً ليصل حتى إلى أصغر سورة فيه.
وإذا نظرنا إلى ما ذكروه آنفاً، فإنّنا نجد أنّ بعض السور لا تشتمل على شيء ممّا ذكروه، مع أنّ التحدّي به وارد. أضف إلى ذلك: أنّ الإخبار بالغيب مثلاً لا يمكن أن يكون قاطعاً لعذر من ألقي إليهم إلا بعد تحقّق المخبر عنه، وقد يطول ذلك إلى سنوات عديدة، أمّا من يأتون بعد ذلك فلربما يصعب عليهم الجزم بتحقّق ما أخبر به.
أمّا القضايا العلمية، فلربما لا يكون من بينهم من له الخبرات اللازمة في تلك العلوم؛ ليمكن إدراك الإعجاز فيها؛ فإنّ ذلك رهن بتقدّم العلم، وتمكّن العلماء من استجلاء تلك الحقائق من القرآن. وحتى لو أدرك ذلك بعضهم، فلربما يحمله اللّجاج، أو غير ذلك من مصالحه الشخصية (بنظره) على إنكار ذلك وإخفائه. كما كان الحال بالنسبة إلى أهل الكتاب، الذين كانوا يعرفون النبي (ص) كما يعرفون أبناءهم، ويجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.
ولكن الأحبار والرهبان أخفوا ذلك وأنكروه، لمصالح شخصية، أو لغير ذلك، ممّا وجدوا فيه مبرراً للإقدام على خداع أنفسهم، وخداع غيرهم، وهكذا يقال بالنسبة للإعجاز التشريعي، وغير ذلك من أمور.
ويبقى سؤال: ما هو وجه الإعجاز في القرآن إذاً؟
وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال نقول: بلاغة القرآن.
وقبل كل شيء ينبغي التذكير بأنّ ما ذكرناه آنفاً، لا يعني أنّ الإخبار بالغيب، وغير ذلك ممّا ذكرناه، وممّا لم نذكره، غير موجود في القرآن، بل هو موجود فيه بأجلى مظاهره وأعظمها، وهي معجزات أيضاً لكل أحد، ولكنّنا نقول: إنّ ذلك ليس هو الملاك الأوّل والأخير لإعجاز القرآن، وإنما ملاك الإعجاز فيه هو أمر يستطيع كل أحد أن يدركه وأن يفهمه، وهو أمر تشتمل عليه حتى السورة التي لا تزيد على السطر الواحد، كسورة الكوثر مثلاً. وهو أيضاً أمر يجده كل أحد، مهما كان تخصّصه، ومهما كان مستواه الفكري، وأيّاً كان نوع ثقافته، وفي أيّ عصر، وفي أيّ ظرف.
وأمّا كيف عجزت الإنس والجن، عن مجاراة هذا القرآن، وكيف أمكن اعتبار البلاغة القرآنية هي سرّ الإعجاز فيه؛ فإنّ ذلك يحتاج إلى توسّع في القول، وبسط في البيان، فنقول: إنّ لدلالة الكلام على المعنى في مقام التفهّم والتفهيم شروطاً:
منها: أن يكون اللّفظ الذي يلقيه المتكلّم قادراً على تحمّل المعنى المطلوب، بأيّ نحوٍ من أنحاء التحمّل، سواء من حيث مفردات الجملة، أو من حيث نوعية تركيبها، أو من جهة المقايسة بينها وبين غيرها.
ومنها: أن يكون المستوى الفكري والثقافي للمتكلّم بحيث يستطيع أن يقصد تلك المعاني التي يقدر اللفظ على تحمّلها.
ومنها: أن يكون ذلك المعنى منسجماً أيضاً مع نوعية اختصاص ذلك المتكلّم، ومع مراميه وأهدافه.
ومنها: قدرة المخاطب أو المخاطبين على استيعاب مقصود المتكلّم، ولو على امتداد الزمن.
هذه هي الشروط التي لا بدّ أن تتوفّر في عملية التفهّم والتفهيم بين كل متكلّم ومخاطب.
ولكن ذلك يحتاج إلى توضيح وتطبيق بالنسبة لما نحن بصدده، فنقول: إنّ اللغة العربية بما لها من خصائص ومميّزات أقدر اللغات إطلاقاً على تحمّل المعاني، فنجد أنّهم يذكرون للجملة المؤلّفة من كلمتين فقط عشرات الخصائص والمميّزات التي تشير كل منها إلى العديد من الآثار المحتملة، التي يمكن للفظ أن يتحمّلها بالنسبة للمعنى المدلول، حتى أنّهم ليذكرون العديد من الامتيازات لقوله تعالى: {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [سورة البقرة، 179] على ما كان أبلغ كلام عند العرب، وهو قولهم: «القتل أنفى للقتل».
ولا بدّ أيضاً من معرفة خصوصيات الألفاظ وأسرار اختياراتها لمواقعها. وقد روي: أنه لـمّا نزل قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [سورة الأنبياء، 98]. قال ابن الزبعرى: فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد عيسى (ع) فأخبر النبي (ص) فقال: يا ويل أمه، أما علم أنّ «ما» لما لا يعقل و «من» لمن يعقل إلخ [الاحتجاج، ج2، ص41 ؛ والبحار، ج45، ص296].
هذا، ولقدرة اللغة العربية على تحمّل المعاني الدقيقة والعميقة، نجد أنّ الله تعالى قد اختارها لتكون لغة القرآن، وقد نوّه بذلك، ووجّه إليه الأنظار والأفكار، ودعا إلى استخلاص المعاني الدقيقة من كتابه الكريم فقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [سورة يوسف، 2] وقال: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [سورة فصلت، 3] وقال: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [سورة الشعراء، 193 - 195] إلى غير ذلك من الآيات، فلننظر بدقّة إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} وإلى قوله: {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} وإلى قوله: {مُبِينٍ} فإنّه كلّه يُشير إلى ما ذكرنا.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 معرفة الإنسان في القرآن (8)
معرفة الإنسان في القرآن (8)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر
-

معنى (ستر) في القرآن الكريم
-

أداء الأمانة والنقد الذاتي في شهر رمضان
-

حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
-
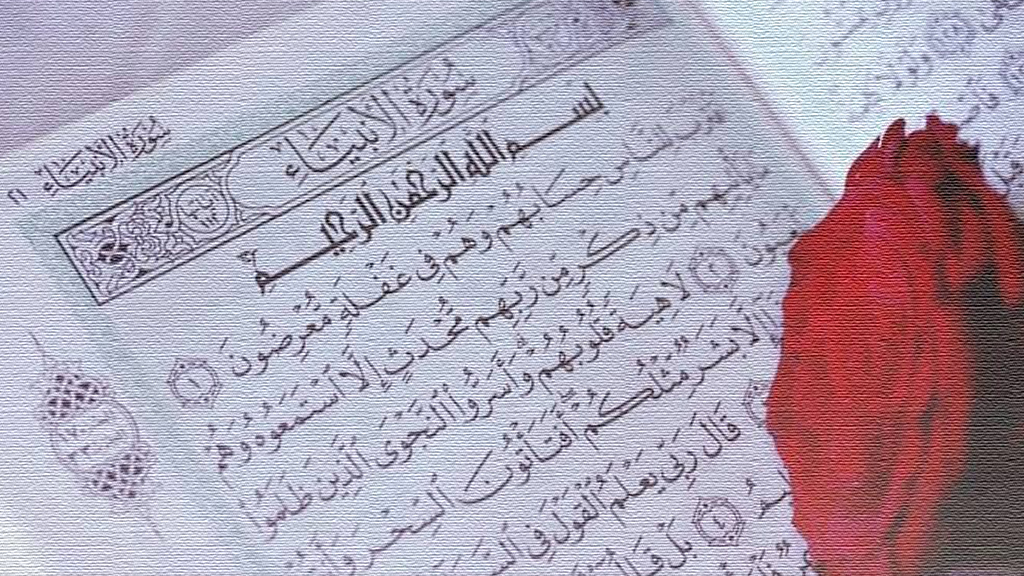
معرفة الإنسان في القرآن (8)
-

شرح دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان
-

خصائص الصيام (2)
-

الإرادة والتوكل في شهر رمضان
-
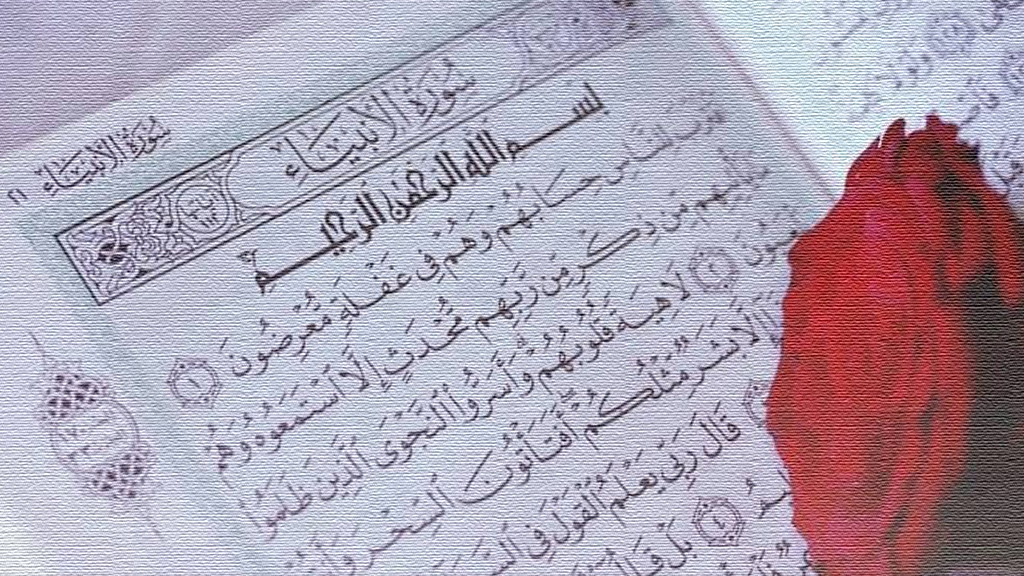
معرفة الإنسان في القرآن (7)









