من التاريخ
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.لماذا يجب أن ننظر إلى التشيّع بنظرة خاصّة؟

السيد عباس نورالدين
يُثبت العديد من علماء الشيعة أنّ مذهبهم قد تشكّل منذ الأيام الأولى لصدر الإسلام حين كان النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يركّز في بعض المناسبات على موقعية عليّ بن أبي طالب ومكانته السامية في الإسلام، ومن ثم يشير إلى شيعته من هذا الاعتبار؛ كما أشارت بعض الأحاديث إلى أنّ عليًّا وشيعته على منابر من نور أو أنّ عليًّا وشيعته في الجنة، وغيرها من الأحاديث التي تقارب هذا المعنى.
وأخال أنّه من الطبيعي جدًّا أن ينجذب عشّاق الفضيلة إلى شخصية هذا الإمام بمجرد أن يتعرفوا إليه، وبمعزل عن موقعيته السياسية وأحقيته بالخلافة. فقد كانت الخصائص الأخلاقية والمعنوية والعلمية والسلوكية، لهذا الشاب الذي تربى في حضن النبيّ الأكرم بارزة جدًّا، وكذلك إنجازاته المميزة على صعيد نصرة النبيّ والإسلام ومواقفه البطولية المجيدة، التي قلّما ظهر نظير لها على يد أحد الصحابة الأجلّاء؛ ولكن هل هذا يعني أنّه يُفترض بهؤلاء الشيعة المتابعين العاشقين الموالين لهذا الإمام أن يشكّلوا مذهبًا خاصًّا جنبًا إلى جنب المذاهب الأخرى؟ أم كان يُفترض لهذه القضيّة أن تبقى محض عُلقة عاطفية ومعنوية، قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى الموالاة والطاعة حين يكون هذا الإمام في موقع السلطة والقيادة؟
ربما يصل كل من تأمّل في معسكر الإمام علي عليه السلام ـ حين بويع للخلافة بعد تلك الثورة الشعبية العارمة ـ إلى استنتاج مفاده أنّ الأغلبية الساحقة من شيعة الإمام لم تكن تتصور أو تعي أي شيء له علاقة بالمذهب والمذهبية. فجميع المسلمين في تلك العصور كانوا يرون ما يحدث عبارة عن صراع على السلطة والخلافة، وإن كان بعضهم يراها حقًّا طبيعيًا للإمام، لما له من منزلة ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فعقلاء المسلمين آنذاك ما كانوا ليتوقفوا لحظة واحدة عند المقارنة بين علي ومعاوية، ليروا من هو الأفضل والأعلم.
لكن قضية الخلافة والأحقية سرعان ما أصبحت مثار جدل واسع حين بدأ الناس بإرجاع الحوادث المختلفة التي عصفت بالأمة المسلمة إلى تلك الحادثة التي جرت في سقيفة بني ساعدة بُعيد رحيل النبي الخاتم عن هذه الدنيا. وبدأت التحليلات تصب في إطار سلسلة من القضايا التي ترتبط بالدين والنبوة والوصية والانقلاب على الأعقاب. هنا بالذات دخل المستغلون من ذوي مآرب السلطة على خط هذه الخلافات في محاولة منهم لإضفاء الشرعية على حكوماتهم التي اقتنصوها بقوة السلاح والمال والقهر وسفك الدماء، ووجدوا أنّهم إن أيّدوا ما تعتقد به الأكثرية، فسوف ينالون الدعم المطلوب ويحصلون على الشرعية المفقودة.
وسرعان ما وجد هؤلاء الكثير ممّا يمكن أن يخدم مشروعهم السلطويّ هذا، وذلك عبر عملية إضفاء الصبغة والإطار المذهبي على مجموع الأفكار التي تساهم في منح المشروعية لحكم الظالم أو غير اللائق، الذي يقع مورد تشكيك المسلمين.
وقد عمدوا إلى تشكيل المذاهب المناسبة لهم، من خلال السعي الحثيث لإبراز الاختلاف العقائدي وتضخيم بعض التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تساهم في منح المذهب الذي اختاروه تلك الاستقلالية الخاصة؛ كل ذلك من أجل تشكيل نواة دينية تصلح لعسكرة الناس وتحزيبهم وراء حكوماتهم التي لم تكن تمت إلى قيم الإسلام بصلة. فمنذ متى كان الحكم في الإسلام قائمًا على التوارث العائلي وعصبة الدم!
إنّ تضخيم التفاصيل العقائدية جعل من بعض الفروع البسيطة في الرؤية الكونية ـ والتي لا يكاد الإنسان العادي ليدركها أو يعرف معناها ـ ترقى إلى مستوى الأصول؛ وحين نتحدث عن الأصول، فإننا ننتقل مباشرة إلى ظاهرة شديدة الخطورة ستتحول بعد قليل إلى أمضى سلاح في مواجهة المعارضين، وهي ظاهرة التكفير. فيصبح من لا يعتقد بالتوحيد الأفعالي (بمعنى أنّ الله يخلق أفعال البشر ـ وهو ما عُرف بمذهب الجبرية) كافرًا؛ وحين يجد الحاكم في الاعتقاد المقابل فرصة للنيل من مؤيدي الجبرية، الذين صادف أنّهم أصبحوا معارضين له، نراه ينتقل مباشرة إلى تأييد وشرعنة مذهبٍ آخر يقول بالتفويض المطلق للأفعال البشرية. وهذا ما حدث في زمن العباسيين، وأدى إلى ويلات وفجائع يندى لها جبين التاريخ، وأصبح عاملًا لتعزيز مذاهب الأشاعرة والمعتزلة.
ومع احتداد المعركة على السلطة، وفشل تقسيم الناس وفق المعايير الاعتقادية إلى حدٍّ ما، كان لا بد لهؤلاء الحكام من البحث عن أي نوع من الاختلافات الدينية لتعزيز التقسيم، فعمدوا إلى ساحة الأحكام الشرعية والفروع، حتى وصل بهم الأمر إلى تحديد المخالف بحسب طريقة الوضوء لا أصل الوضوء؛ وهذا ما جعلنا نسمع عن التقية في الوضوء.
إنّ فشل التقسيم على أساس العقيدة، يرجع بالدرجة الأولى إلى صعوبة فهم عامة الناس لتلك الاختلافات الدقيقة. فلئن سألت أكثر هؤلاء عن الفارق بين كون صفات الله قديمة أو حديثة لما دروا منه شيئًا، ولئن سألتهم عن معنى كون القرآن مخلوقًا لربما أجابوا بما ينسجم مع القول المخالف وهم لا يعلمون. فلجوء السلطات الحاكمة إلى مذهبة الناس على أسس فرعية بل فرع الفرعية (لأنّ الوضوء فرع وتفاصيله فروع له) كان يُعد مكيدة خبيثة لأجل تمييز المعارضين. ومن الطبيعي عندئذٍ أن يصبح المخالفون مذاهب بالاضطرار؛ ومن الطبيعي أيضًا أن توضع للمذاهب الأسماء وأن يبحثوا هم عن أسماء للتمييز والتميز. وربما يقع الكثيرون منهم في مصيدة المذهبية وشباكها، التي حاكتها أيدي السلطات من أجل تسهيل عزلتهم واحتوائهم.
إنّ ما ينبغي أن نعرفه هنا هو أنّ المذهبية التي نتصوّرها اليوم بشكلٍ ما، لم تكن في تلك الأزمنة سوى ظاهرة قام حكّام الجور وعبدة السلطة والرئاسة بإنشائها ورعايتها وتضخيمها، خصوصًا في عصور الأمويين والعباسيين؛ ومن ثمّ ورثها عنهم من احتاج إليها أكثر من المماليك والعثمانيين، وأي سلالة ملكية أخرى ستفتقر إلى الشرعية الدينية فيما بعد.
بالنسبة للشيعة، كان الانتماء إلى الإمام المعصوم، الذي كانوا يتعرّفون إليه بالعلامات والكرامات والدلائل الباهرات، هو المائز الأكبر لتديّنهم؛ ومعه كان رفضهم لحكومة من سواه؛ لكن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الشيعة لم تكن تلحظ العديد من الفوارق العقائدية والفقهية وربما القيمية التي كانت تميز أئمتهم، ولأجل ذلك لم يعتبروا أنّهم أتباع مذهب مغاير كما نتصور اليوم. وما حصل فيما بعد هو أنّ الذين طعنوا على الشيعة بعد غيبة إمامهم الثاني عشر بأنّهم لا يمتلكون مذهبًا ـ بمعنى أنّهم لا يمتلكون فقهًا خاصًّا ـ قد حملوهم على التعمّق والبحث عن المدرسة الخاصة التي ميزت أئمتهم بالعلم بالشريعة.
إنّ الطعن على هؤلاء الشيعة بأنّ أئمتكم لم يكونوا عالمين بالشرع هو الذي دفع أمثال الشيخ الطوسي (الذي عُرف بمؤسس الطائفة) إلى جمع التراث المروي عن أولئك الأئمة المعصومين، ليتبلور بفضل ذلك تراث كبير، ويظهر للمحبين والموالين أنّهم أتباع مدرسة قائمة بذاتها.
لكن هذا بالطبع لم يتحقق بين عشيةٍ وضحاها. فقد كان هذا المذهب على موعدٍ مع عملية تشكّل استمرت على مدى القرون الآتية. وإنّما تشكّل هذا المذهب ليصبح مذهبًا مستقلًّا ببنيته العقائدية والفقهية على يد العلماء، الذين قاموا بدراسة وتحليل هذا التراث وإظهار معالمه الخاصة. وهذا ما عُرف بالحركة الاجتهادية التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا.
لقد قام بعض علماء هذا المذهب بجهود كبيرة، كانت من العظمة والضخامة بحيث جعلت كل من سلك طريق الاجتهاد من بعدهم يظهر كمقلِّد أكثر منه مجتهدًا. ولهذا يمكن الوقوف عند عددٍ قليل من الشخصيات الاجتهادية البارزة على مدى الألف سنة، التي تلت غيبة إمام الشيعة.
لكن يجب الالتفات إلى أنّ الشيعة قد أجمعوا على أصلٍ واحد وثبتوه في أوساطهم، وهو ضرورة الاجتهاد في التراث، باعتبار أنّه أصل من أصول الإسلام وسر حيويته.
فالاجتهاد، وإن كان في مراتبه العليا خاصية قلّما قدر الناس عليها، لكنّه أمرٌ ضروريّ لكل مسلم؛ وهذا ما يعكس الواقع الطبيعيّ للتراث الإسلامي، بدءًا من القرآن ومرورًا بالسنة. فلا يمكن للمسلم أن يتفقّه في هذين المنبعين الأساسيين للدين وشريعته ما لم يبذل جهدًا علميًّا يتناسب مع ماهيتهما وحقيقتهما وأوضاعهما.
إنّ ثبوت هذا الأصل وسط طائفة من المسلمين تتناسب مع متطلبات القرآن والسنة، وذلك باعتبار أنّ الدين مشروعٌ إلهيّ ورسالة سماوية لكلّ مكانٍ وزمان، مهما اختلفت مقتضياته. وثبوت هذا الأصل كان أيضًا خروجًا على النظام الفكري والديني الذي أرسى دعائمه سلاطين الجور والاغتصاب. فلم يكن منع الاجتهاد وإيقافه ممّا يتناسب مع ذهنية المذاهب الإسلامية كافة؛ وكيف يكون كذلك، وقد قامت كل هذه المذاهب على قواعد الاجتهاد؟ وإنّما كان فرمانًا بقوّة السلاح والقهر والتنكيل.
لكن الذين اجترأوا على ذلك الاستبداد ووقفوا بوجهه كانوا قلة؛ وقد اشتهرت طائفة الشيعة من بين هؤلاء. وهكذا استطاع الشيعة على مرّ الزمان أن يؤمّنوا لاجتهادهم (الذي لا بدّ منه لفهم الإسلام وتطبيقه) بيئات خاصة. وفي ظلّ هذه البيئات، وبحسب طبيعتها، كان الاجتهاد يتشكّل ويتطوّر أيضًا من دون أن يبتعد عن تأثيراتها. وبحسب هذا الاجتهاد ونتائجه كان مذهب الشيعة يتبلور كذلك؛ فكلما ظهر مجتهد مجدِّد غير مقلِّد كان التشيع يظهر بمميزات إضافية. ولأجل ذلك، كان لا بد من القول بأنّ هذا المذهب كان ولا يزال مذهبًا في طور التشكل، مهما ترسّخ فيه من أصول مبادئ.
فكل شيء في ساحة الاجتهاد قابل للنقاش والبحث، بل ويخضع لذلك أيضًا. ولئن كان هناك ضرورات في الدين، فهي تبقى على ضرورتها، بعد مرور البحث الاجتهادي عليها.
لقد اختفت معالم المشروع السياسي لهذا المذهب على مدى التاريخ بحكم البيئة التي ترعرع فيها اجتهاده. فقد بقي معظم مجتهديه منفعلين تجاه الآخر في نظرتهم للسياسة والحكم، ولم يمتلكوا الجرأة أو القدرة الكافية لاكتشاف هذا المشروع واستنباطه من عمق تراثهم. وأصبح هذا الأمر مورد تعجّب الكثيرين في زماننا هذا بعد أن أظهر الاجتهاد الخميني مدى وضوحه وبداهته.
إنّ الخطأ الأكبر الذي يرتكبه أي باحث في مذهب التشيع ـ سواء كان منتميًا أو لا ـ هو الذي ينشأ من عدم فهم هذه العملية المستمرّة، وذلك حين يخلط بين الحقيقة المطلقة الكامنة في القرآن والسنّة، وبين اجتهاد المجتهدين الذين يتحرّكون في عملية الاستنباط والبيان من قدرات محدودة أو غير معصومة. فالأدلة العقلية المتضافرة تؤكّد وجود الحقيقة الكاملة في المصادر، لكنّها في الوقت نفسه لا تضفي أي نوع من العصمة واليقين على اجتهاد المجتهدين.
لم يكن الاجتهاد الشيعي ـ كما تشهد وقائع التاريخ والمصادر الكثيرة ـ عبارة عن انقلابات متتالية، كما يحدث في بعض أنظمة الحكم، بل كان عبارة عن حركة تكاملية بالعموم؛ ولهذا عبّرنا عنه بأنّه مذهب في طور التشكّل. وها نحن اليوم نعيش في زمنٍ لا يتصوّر معظمنا أنّه يمكن أن يأتي مجتهد قدير بشيء جديد، كما عاش الكثيرون من قبلنا في الأزمنة الماضية وهم يعتقدون بأنّه لن يكون هناك أفضل ممّا كان.
ويبدو أنّ مذهب التشيع على موعدٍ مع مجتهدٍ عظيم ينهض ذات يوم ليبلوره كمذهبٍ يتمتّع بنمطٍ خاصّ للحياة، وأسلوبٍ راقٍ للعيش لا يمكن أن يضاهيه أي مذهب آخر في العالم كلّه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
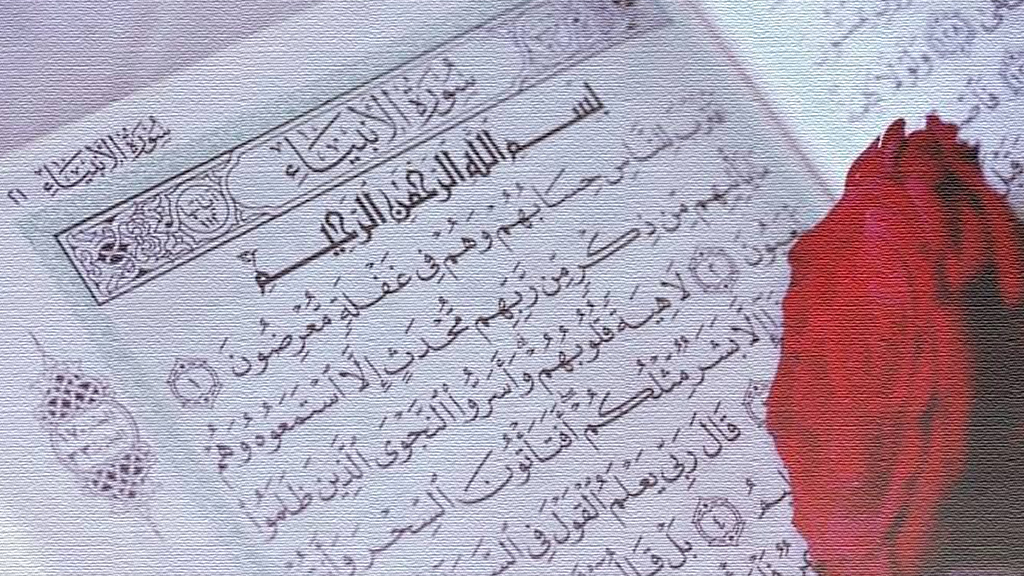
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










