من التاريخ
القرآنيّون تاريخهم نشأتهم وآراؤهم (2)

2 ـ القرآنيّون بالحدّ الأدنى
لهذا الاستخدام الثاني لتعبير (القرآنيون) حضورٌ في الوسط السنّي والشيعي معاً، بخلاف الاستخدام الأوّل الذي لا نكاد نجد له حضوراً في الوسط الشيعيّ الإمامي، وإنما يقتصر على الاتجاه السنّي.
يذهب القرآنيّون بالحدّ الأدنى إلى الإيمان بمبدأ: (الأيلولة والحكومة)، بمعنى أنّ على مختلف المرجعيّات المعرفيّة الأوبة إلى القرآن الكريم، وينبغي أن تأخذ شرعيّتها وحجيّتها منه، وأنّ القرآن حاكمٌ عليها جميعاً، فأيّ حديث يبلغنا لابدّ أن يأخذ حجيّته ومرجعيّته من الكتاب الكريم، وأيّ حديث يصل فلابدّ أن يحكمه القرآن، وليس العكس.
ويطلق على هؤلاء أحياناً عنوان: (القرآنيّون)، لكن ليس على غرار الاتجاه الأوّل الذي ينكر السنّة أو الحديث بالكامل، بل هم يؤمنون بالسنّة والحديث، لكنّهم يرون أنّ القرآن العزيز هو من يمنح الاعتبار والحجيّة لسائر مصادر المعرفة الدينيّة النقليّة، ولا يتقدّم على القرآن أيّ حديث أو رواية أو إجماع أو سيرة أو شهرة، بل هو مقدّم عليها جميعاً.
فالفرق بين (القرآنيّون) بالحدّ الأعلى و (القرآنيّون) بالحدّ الأدنى كبير؛ فالقرآنيّون بالحدّ الأدنى يؤمنون بحجيّة السنّة، ويؤمنون بحجيّة الحديث، ولا يحصرون الاجتهاد بالكتاب الكريم فقط، لكنهم يقولون: كلّ مرجع معرفيّ لابد من عرضه على القرآن قبل أن يُمنح الحجيّة، ولا يكفي أن يكون السند صحيحاً لصيرورته حجّةً، حتى يواجه القرآن لنقول بعد ذلك: إنّ القرآن قطعيّ الصدور وظنّي الدلالة، والحديث ظنّي الصدور والدلالة، فيكون كلاهما ظنّيّاً! الأمر الذي يفسح المجال لحاكميّة الحديث على القرآن أو مناظرته له.
إنّ هذه الطريقة مرفوضة تماماً، فلا يتوفّر الحديث الشريف على الحجيّة عند هؤلاء إلا بعد عرضه على كتاب الله؛ فإن لم يخالف كتاب الله ـ حتى وإن كانت دلالة كتاب الله ظنيّة ـ فهو حجّة بعد تماميّة سائر حيثيّات الحجيّة، وإن خالف كتاب الله فلا حجيّة له من الأساس.
فهذا الفريق من القرآنيّين يقدّم مفهوماً خاصّاً لعرض السنّة على الكتاب؛ حيث يقولون: إنّ الرواة لم يكونوا حمقى، وليسوا بسطاء كما نتصوّرهم، ولم يأتِ الراوي ليقول لك: لا تجب إقامة الصلاة، ولم يأت لك راوٍ آخر ويقول لك: حدّثني جعفر بن محمد الصادق أو حدّثني رسول الله عن عدم وجوب الصلاة مثلاً؛ فهم يعلمون أنّ الناس لن تصدّق بهذه الأكاذيب، ومن هنا ينبغي أن تمرّر الأكاذيب من خلال الحقائق وما بين سطورها، وبطريقة ذكيّة؛ فإذا أردت أن أعرف الحديث الكاذب من خلال عرضه فلا يكفي أن تكون نسبته مع القرآن نسبة التباين: (أقيمو الصلاة ولا تقيموا الصلاة)، وإنّما نلاحظ نسبته إلى مزاج القرآن وروحه العامّة، ففي التعارض نجد أن تظافر الآيات يؤسّس مفهوماً، بينما الرواية أو مجموعة من الروايات تؤسّس لمفهوم آخر غير منسجم مع المفهوم القرآني ولا يصبّ في سياقه.
وإذا ما أردنا أن نقرّب فكرة العرض على الكتاب من خلال مثال نذكّر بما اصطلحت عليه بحوث السيّد محمد باقر الصدر بمبدأ تكريم الإنسان في القرآن الكريم؛ فعلى أساس هذا المبدأ سوف يُردّ ذلك الصنف من الروايات التي صحّحها بعضهم سنديّاً، والناصّة على ضرورة التحذّر من التعامل مع الأكراد وأمثالهم، وأنّهم قوم من أقوام الجنّ.
ينبغي ردّ هذا الحديث؛ لكونه مخالفاً لمبدأ التكريم القرآنيّ، مع أنّ التعاطي الحدّي مع هذه النصوص الروائيّة لا يستلزم ردّها؛ لأنّ أقصى ما يمكن قوله فيها هو: إنّها مخصّصة للعموم القرآني، وهذا ما رفضه الصدر، ورأى أنّ المسألة لا يمكن حلّها بهذه الطريقة الفنيّة التي تُذكر في محلّه في الكتب الأصوليّة، وإنّما يتسنّى ذلك عن طريق وجود معارضة للمزاج القرآني العامّ وهو: (كرامة الإنسان)، وهذه النصوص تهين الإنسان لقوميّته أو عرقه فقط.
وعلى هذا الأساس نفهم أنّه ورغم إيمان القرآنيّين بالحدّ الأدنى بحجيّة السنّة والحديث، إلا أنّهم كانوا يطالبون دوماً بعرضهما على الكتاب، ثمّ يوسّعون من مفهوم العرض ولا يضيّقون، وهذا ما يُنتج عندهم أنّ فهم الدين يبدأ من القرآن، وإذا أراد الباحث أن يكون مجتهداً أو مستنبطاً لحكمٍ دينيّ معيّن، فعليه أن يبدأ من القرآن، ولكي يتمكّن من عرض نتيجة البحث الحديثيّ على القرآن عليه أن يفهم القرآن نفسه أولاً، ولا يمكن الخلط بين المصادر في عمليّة الاجتهاد؛ لأنّ الخلط بينها يعني فقدان القرآن استقلاليّته وصلاحيّته للبتّ والحكومة على سائر الأدلّة في هذا المجال.
وهذا النهج مخالف تماماً لتلك المقولة التي أطلقها جمهورٌ من المحدّثين، والتي تقول: إنّ السنّة قاضية على الكتاب، والكتاب غير قاضٍ على السنّة، فالأخيرة هي التي تحكم القرآن، ولها قدرة التدخّل والتصرّف والتوسعة والتضييق في الكتاب، فيما الكتاب الكريم ليس له قدرة التدخّل ولا التوسعة، ولا التضييق، ولا التصرّف في السنّة.
فالقرآنيّون يرون خطأ هذا المبدأ ويختارون العكس منه تماماً؛ لأنهم ينطلقون من أحاديث العرض على الكتاب، بينما يرفض بعض أهل السنّة أحاديث العرض؛ لأنّهم يرون أنّها موضوعة من قبل الخوارج لكي يُسقطوا قيمة السنّة؛ انطلاقاً من أنّ جعل الحديث تحت سلطان القرآن يُسقط الحديث في نهاية المطاف، وهذا بخلاف أحاديث العرض على الكتاب عند الشيعة الإماميّة؛ فإنها كثيرة، بل ادُّعي تواترها المعنوي، كما جاء في كلمات الشيخ الأنصاريّ.
هذا تعريف موجز بالقرآنيّين باتجاهيهم، لكنّنا سنتكلّم هنا عن القرآنيّين بالحدّ الأعلى فقط.
القرآنيون وتاريخ المصطلح
تعود حركة (القرآنيّون) إلى شبه القارة الهنديّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ففي نهايات القرن التاسع عشر، وخصوصاً في منطقة (البنجاب) كثيراً ما طُرحت أفكار القرآنيّين، حتى تحوّلوا إلى تيّار وليس أفراداً فحسب، وهذه خصوصيّة في القرآنيّين الباكستانيّين؛ لأنهم تحوّلوا إلى ظواهر لم تقتصر على فردانيّتها، أمّا القرآنيّون في العالم العربي أو تركيا أو إيران فهم أفراد في الغالب، وليسوا تيّاراً له تراتيبه الإداريّة وامتداده الشعبيّ.
العناصر المؤثرة في ظهور الحركة القرآنيّة
والذي أثّر في ظهور هذا التيار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أمران أساسيّان:
أ ـ أزمة العلاقة بين العلم والدين (دوافع للتشكيك المتني والسندي في السنّة)
لا يخفى على المتابع أن ما يُسمّى بحركة الإصلاح الدينيّ إنما بدأت من شبه القارّة الهنديّة؛ إذ كانت تلك المناطق نقطة انطلاق تاريخيّاً، وليس في مناطق العراق أو إيران أو غير ذلك من البلدان الأخرى التي ربما يتوافر فيها أفراد من هنا وهناك. ومن شبه القارّة الهنديّة انتقلت هذه الأفكار بالدرجة الأولى إلى مصر، ومنها تعمّمت إلى العالم الإسلاميّ.
لقد كان أحمد خان أحد أهمّ روّاد ما يُسمّى بحركة الإصلاح الدينيّ في القرن التاسع عشر، وكان يرى ضرورة التوفيق بين العلم والدين؛ حيث تمظهرت حركة التحدّي بين العلم والدين في ذلك العصر في التصادم بين الدين والعلوم الطبيعيّة، فما نواجهه اليوم من تحدٍّ هو التوفيق بين الدين والعلوم الإنسانيّة (الاجتماع، النفس، الاقتصاد، الأناسة..)، لكنّ التحدّي الأكبر الذي حمله القرن التاسع عشر كان هو التوفيق بين الدين والعلوم الطبيعيّة، أي يجب أن توافق معطيات الاجتهاد الإسلاميّ آخر منجزات العلوم الطبيعيّة في مجال الفلك والطبّ والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم وتطوّراتها.
هذا، وكان أحمد خان وأنصاره يقولون في بعض إشاراتهم ـ وهم يرومون إلغاء بعض المصادر المعرفيّة المتصادمة مع العلم ـ: إنّ في السنّة الشريفة مشاكل كثيرة تصادم العلم، وينبغي علينا أن نتخذ موقفاً منها، ومن هنا بدأ أحمد خان يدغدغ في قيمة السنّة، ويقول: السنّة ليست مصدراً موثوقاً لأسباب عدّة، سنأتي على ذكرها قريباً إن شاء الله.
من هنا ذهب السير أحمد خان وأنصاره إلى ضرورة التوفيق بين العلم والدين، وفي هذه النصوص الروائيّة ـ المنقولة إلينا بطرق غير موثوقة ـ أمور كثيرة تخالف العلم. هذا هو العنصر الأوّل.
ب ـ دور الحديث في تمزيق المسلمين (انطلاقة مشروع العودة للقرآن)
هناك تيّار واسع في العالم الإسلاميّ، ينتشر في أوساط المثقّفين، يعتقد أنّ سبب خلافاتنا هو الأحاديث، وأنّنا إذا رجعنا إلى القرآن العزيز وتركنا كتب الأحاديث فسوف تُحلّ مشاكلنا أو أكثريّتها الساحقة، من هنا نجد في خطاب حركة الإصلاح الدينيّ في شبه القارة الهنديّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تركيزاً على أن حلّ خلافات المسلمين وعودة نهوضهم لا يكون إلا بالتخلّي عن الحديث.
ومن رحم هذا المناخ ـ أعني مناخ ما يُسمّى بالإصلاح الدينيّ ـ ولدت هذه الفكرة التي تقول: إنّ الحديث ليس مرجعاً، وعلينا العودة إلى القرآن؛ فإنّ حلّ مشاكلنا لن يكون إلا بالعودة إليه.
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (11)
معرفة الإنسان في القرآن (11)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
حسين حسن آل جامع
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة
-

دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
-

إصداران تربويّان لصلة العطاء لترسيخ ثقافة النّعمة وحفظها
-

الصوم، موعد مع الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}
-
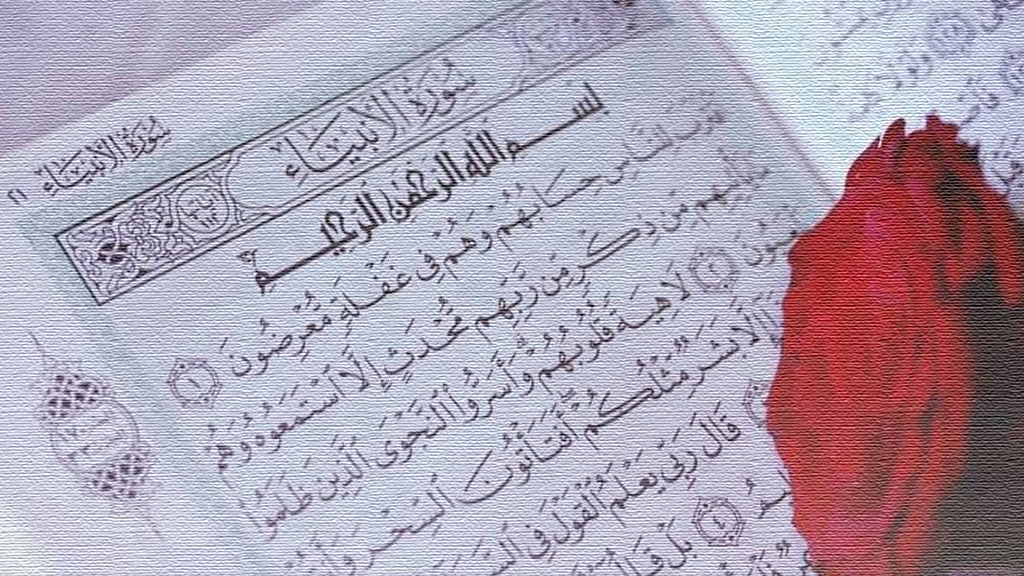
معرفة الإنسان في القرآن (11)
-
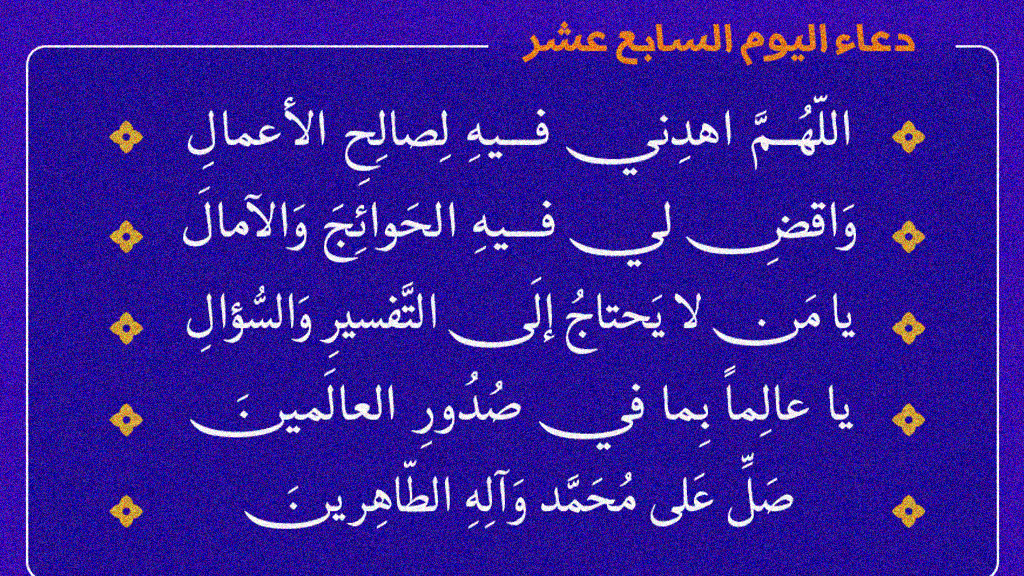
شرح دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان
-

معنى (نكل) في القرآن الكريم
-

مميّزات الصّيام
-

عن الصدق والصادقين في شهر رمضان









