مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.كيف نزيد من محبّة أهل البيت (ع)؟

السيد عباس نورالدين
كل حبّ يذوي أو يزول إن لم نزّوده بوقوده الحقيقيّ. وزاد الحبّ الأكبر ووقود العشق الأسمى هو وِصال المحبوب. ولا شيء يحكي عن الوِصال ويحقّقه مثل التعرّف إلى المحبوب وملاحظة تجلّياته.
حبّ الكامل أمرٌ فطريّ مغروز في أعماق البشر ومجبول مع طينتهم. وكلّما كانت الفطرة صافية، كان الانجذاب إلى المحبوب أشدّ والإقبال عليه أقوى.
إنّ الانجذاب إلى المحبوب الكامل هو انجذاب إلى كلّ ما يمثّله من فضائل وكمالات. إنّه السّعي الباطنيّ والاندفاع القلبيّ نحو الغاية التي خُلق الإنسان لأجلها. لذلك كان الحبّ أعظم أركان الوجود. ولم يكن الدين سوى الحبّ.
حين تشتعل شرارة الحبّ في الباطن، يكون الإنسان مستعدًّا للتدرّج حتّى يبلغ أسمى حالاته. فالشعلة الباقية علامة على وشك انفجار البركان.. ولا تبقى الشعلة ولا يزداد اللهيب إلّا بتحقّق الوِصال من الطرفين. فمن جهة الكامل هناك التجلّي بالجمال والكمال، ومن جهة الناقص هناك التعرّف والإقبال.
يمتلك شعبنا الاستعداد الفطريّ المناسب لتحقّق هذا الأمر الرائع، فهو يرتع وسط تراثٍ عظيم من تجلّيات أعظم خلق الله وأكملهم. ولا ينقصه شيء من النصوص التي تدلّ على عظمة مقاماتهم وحقائق مراتبهم؛ إلا أنّ المشكلة كانت، وما زالت، في إيصال هذه المعارف إلى الناس. لقد حثّ الإمام الرضا، حفيد النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أصحابه على القيام بهذا الدور، فقال لهم: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا، فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونا"،[1] ولا اتّباع للكامل إلّا بمحبّته. لأنّ الناس إمّا أن يتّبعوا أهل الدرهم والدينار، أو أصحاب الفضيلة والكمال. والأوّل أعرض عنه أهل بيت العصمة والطهارة وورثة الأنبياء، الذين قالوا: "إنَّ الأنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً ولا دِرْهماً وَلِكْن وَرَّثوا الْعِلْمَ".[2] وزهدوا فيه لأنّه ليس حقيقة الفضيلة. وإنّما كان لهم السبق في الفضائل الحقيقيّة والكمالات الواقعيّة وعلى رأسها العلم. ولهذا، لم يكن من تجلٍّ أجمل من تجلّي المحبوب بالعلم. ولولا العلم لما كان لكلّ الخصال الحميدة من جمالٍ أو ظهور.
فإذا أردنا أن نضخّ زاد الحبّ ووقود العشق في هذا المجتمع، ينبغي أن نعمل على إظهار محاسن من أوجب الله مودّتهم ونعرّف بكمالاتهم. ومع هذا الرصيد من طهارة المولد ونقاء الفطرة، يمكن أن يتحقّق ما يشبه المعجزات على صعيد التغيير الأخلاقي ونشر الفضيلة والكمال في المجتمع.
أجل إنّ هذا الكلام ليس بالأمر السهل البسيط؛ فأكثر الناس لا يندفعون نحو العلم بما هو كمالٌ ذاتيّ؛ وإذا طلبوه فإنّهم يطلبونه لأجل الدنيا والمال. فلا بدّ من تزيينه وتحسينه في أعينهم أو إظهار زينته الذاتية. ولعلّه لأجل ذلك، قال الإمام الرضا (عليه السلام): "علموا النّاس محاسن كلامنا". فبعض العلم قد يكون سببًا لنفور الناس وإعراضهم، لأنّه يخالف ما اعتادوا عليه. فالناس أعداء ما جهلوا. وقد رُوي عن الإمام السجاد (عليه السلام) أنه قال:
رُبّ جوهر علم لو أبوح به لقيل أنّك ممّن يعبد الوثنا
وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْم لَوْ بُحْتُ بِهِ لاَضْطَرَبْتُمُ اضْطِرَابَ الاْرْشِيَةِ في الطَّوِيِّ البَعِيدَةِ!"[3]
فما خفي وما سرّ من علوم أهل البيت قد يتسبّب بزلزالٍ في نفس من يجهله، ولا يكون مستعدًّا له.. فكان لا بدّ من نقطة بدءٍ نسير منها حتّى نصل ونتّصل ببحر علومهم النفيسة.
للبيئة الاجتماعية والثقافية أكبر الأثر في نجاح هذه العمليّة أو فشلها. ففي بيئة عاشت ردحًا طويلًا من الزمن وهي تستظلّ من التراث الشعريّ العرفانيّ، كإيران، يسهل الحديث عن كمالات الأولياء ومراتبهم العرفانيّة الملكوتيّة دون أن يحدث ذلك أي استهجان أو نفور. وربما لأنّ الخطوط الفاصلة بين الألوهية والعبودية قد ترسّخت على مدى تلك العصور، ولو بالمقدار المطلوب.
أمّا إذا كانت البيئة مُحاطة بعواصف الآراء والاتّهامات المختلفة بالغلوّ، فسوف تصبح مستنفرة فوق الحدّ، فتجدها مائلة إلى الإفراط من جهة أو التفريط من جهةٍ أخرى. ويصبح الحديث عن مقامات الكامل ومنزلته الروحيّة مغامرةً غير مأمونة العواقب. فالذين يعيشون تحت تأثير اتّهامات الغلوّ، وقد نال ذلك من عقيدتهم، وأثّر في شخصيّتهم هزالًا وعُقَدًا، سوف يستنكفون عن سماع ذلك، فتشمئزّ قلوبهم وتنفر، ولا يزيدهم الحديث عن المحبوب سوى بعدًا ونفورًا. والذين واجهوا اتّهامات الغلوّ بعصبية مذهبية أو بانتفاضة الرفض الأبيّة، قد تجدهم مائلين إلى تحميل تلك النصوص فوق ما تحمل.
هكذا كان الجاهل دومًا، لا تراه إلا مفرطًا أو مفرّطًا، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
وإذا كنّا بصدد العمل السليم على قضيةٍ بمثل هذه الأهمية والتأثير، يجب أن نراعي الذهنية السائدة والبيئة المحيطة والاستعدادات النفسية.
إذا كانت بيئتنا غير جاهزة لمثل هذا الخطاب العشقيّ، فمن الضروريّ العمل على مدّها بتلك المعارف والأفكار التي تساعدها على فهم حقيقة العشق ومعاني الكمال الإنسانيّ. ويستحضرني بهذا الخصوص عملٌ رائع للشهيد العلّامة المطهري، ظهر في كتابه حول الإمام عليّ (عليه السلام) وقوّتي الجذب والطرد فيه، نُشر قبل حوالي نصف قرن. فقد أحسن هذا العالم النحرير، وأجاد في التقديم لقضيّة الحب، وهيّأ النفوس من خلال التفسير الرائع لهذه الظاهرة وارتباطها بجوهر الدين. ولا ينبغي أن نتوقّع حصول الآثار المعنوية للحركة الفكرية بين عشيّة وضحاها، لأنّ طبيعة التغييرات النفسية الاجتماعية تتطلّب وقتًا مديدًا من العمل الفكريّ والتعليميّ.
وإذا أردنا تهيئة الاستعدادات لتقبّل هذا المستوى من الخطاب العشقيّ وللتفاعل معه كما ينبغي، فلا بدّ من رعاية ما يمكن أن نعبّر عنه بالتدرّج العاطفيّ.
إنّ المخاطَب الإيرانيّ في مجالس العزاء والمدح ـ وخصوصًا النوع الثاني الذي يتمحور حول مقامات المحبوب وكمالاته، بخلاف النوع الأوّل الذي يدور حول مظلوميّته والفاجعة ـ هو مخاطَب مستعدّ من الناحية النفسية، نظرًا لما يمتلكه من مخزونٍ، يمكن تحفيزه بسهولة. فأيّ وصفٍ يستخدمه الشاعر لذكر أهل البيت، سوف يستدعي مجموعة كبيرة من المعاني المتراكمة في مستودعات الذاكرة والنفس. فكأنّه هنا يضغط على زرٍّ يفتح أبوابًا عديدة لخزائن حَوَت الكثير ممّا عرفته النفس وعاشته في تلك البيئة الغنيّة بهذا التراث. ولهذا، قد تجد أنّ القيمة الفكريّة لبعض الأشعار ضحلة أو سطحية، فاقدة لما يمكن أن يوزن في مجال القيم أو يعبّرعن تميّز أهل البيت عليهم السلام عن سائر الناس؛ ومع ذلك، يدهشك عمق التفاعل وشدّته.
فوراء قوله "بطلٌ خيبر" مئات القصص، وخلف وصفه للإمام بـ "ضامن الغزال" عشرات المعاني التي تتدفّق مثل السيول الجارفة، إذا امتزجت ببلاغة البيان الشاعريّ وفنّ الأداء الجميل.
حين يُقال:"لماذا لا نجد مثل هذه المجالس المعنوية الحماسية الجيّاشة بروعة مشاعر الحبّ والودّ لأهل بيت العصمة والطهارة في أماكن أخرى؟"، ينبغي أن نبحث أوّلًا عمّا قدّمناه، على صعيد تعريف الناس والشباب بعظمة هؤلاء الكاملين. وحين نريد لمجالس المدح أن تنجح في تحريك العواطف النبيلة، ينبغي أن ننظر فيما إذا استطعنا أن نحقّق مثل ذلك التدرّج العاطفيّ، الذي هو شرطٌ أساسيّ. وما لم يكن الإنسان مهيّئًا من الناحية النفسيّة للتجلّيات العظمى، فقد يجمد وكأنّه صُعق. ولا بدّ لمنشد المدائح أن يمتلك النص العميق والفنّ الجميل، الذي يستطيع أن يبدأ مع المستمع من بيئته النفسية والذهنية، ثمّ يتدرّج معه موصلًا إيّاه إلى قمّة التفاعل مع تلك التجلّيات.
وفي بيئةٍ تعجّ بالمشاكل الفكريّة والأفكار المشوّشة حيال قضيّة عظمة أهل البيت وعظمة الإنسان الكامل ومقاماته، لا يبدو أنّ هذا العمل سهلٌ وميسّر. فيحتاج المنشد إلى تلك الأشعار والنصوص التي تدفع تلك الأمور المشوِّشة أوّلًا، وتطرد القلق الذي يعشعش في النفوس إزاء القضايا العرفانيّة ثانيًا، ليكمل سيره المعنويّ في مقامات المحبوب العظيم. وهذا ما يتطلّب نصوصًا إبداعيّة عصريّة عميقة وسلسة يفهمها الشباب ويأنسون بها.
إنّنا بحاجة إلى الأدب العرفانيّ، الذي يأخذ بعين الاعتبار المشكلات النفسية والفكرية، الذي ضجّ بها مجتمعنا وأضعفت تفاعله مع الخطاب العشقيّ الذي له أجمل الآثار التربوية.
ــــــــــــــ
[1]. عيون أخبار الرضا، ج1، ص 307.
[2]. أصول الكافي، المجلد الأوّل، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح1.
[3]. نهج البلاغة، ص 51.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
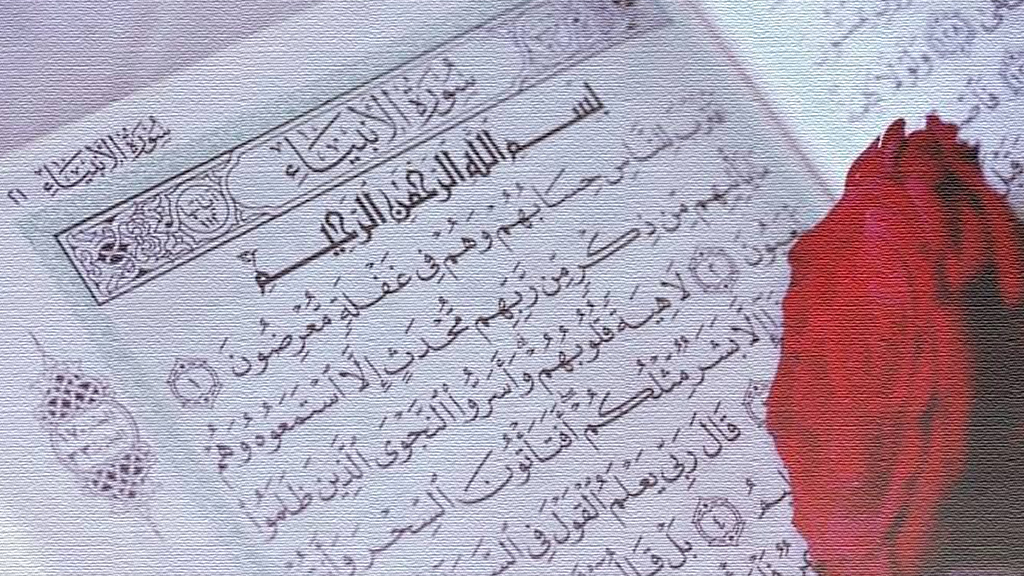
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










