قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :
فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.المعاد في القرآن الكريم
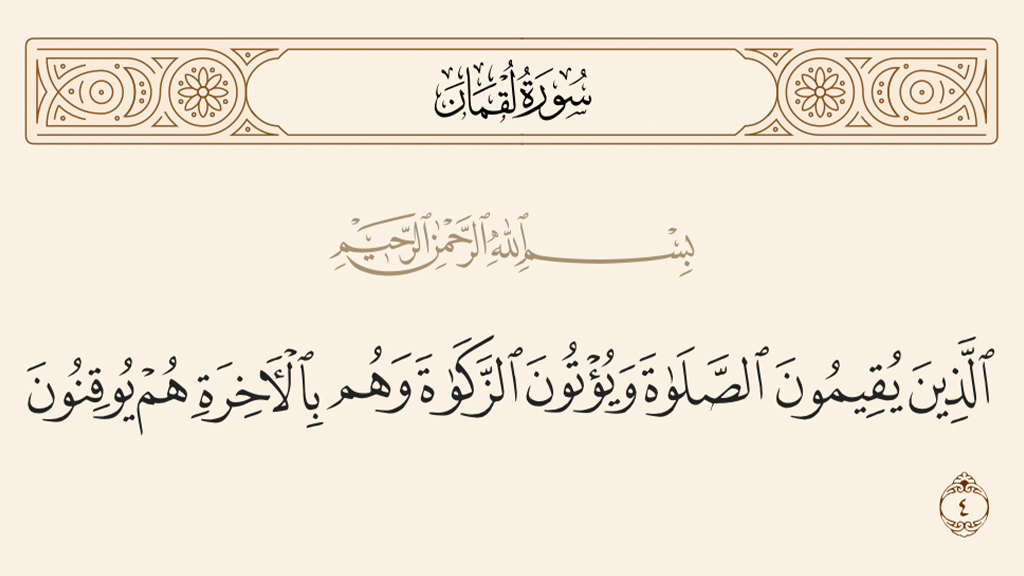
الملاحظ أنّ أكثرَ من ثُلث الآيات القرآنيّة، مُرتبطٌ بالحياة الأبديّة، وفي مجموعة من هذه الآيات أكّد القرآن الكريم لُزومَ الإيمان بالآخرة، منها:
1- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ البقرة:4.
2- ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ لقمان:4.
وفي مجموعةٍ أخرى، أشار تعالى إلى آثار إنكار المعاد ومضاعفاته:
1- ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الإسراء:10.
2- ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ الفرقان:11.
3- ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ سبأ:8،
4- ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾ المؤمنون:74.
وفي مجموعةٍ ثالثة، ذكر النِّعَمَ الأبديّة:
1- ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ * فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ الرّحمن: 46-48 إلى آخر السّورة.
2- ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ الواقعة:18 إلى الآية 38.
3- ﴿فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا * مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الإنسان:11-13 إلى الآية 21.
وفي مجموعةٍ رابعة، تعرّض القرآن الكريم إلى أنواع العذاب الأبديّ:
1- ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ الحاقّة:25-27.
2- ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ الملك:6-7 إلى الآية 11.
3- ﴿فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم﴾ الواقعة:42-44 إلى الآية 56.
كما أنّ هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنة والسّيّئة، مع تبيان نتائجها وآثارها الأُخرويّة، وكذلك أكّدت، بأساليب مختلفة، إمكانَ القيامة وضرورتها، وأجابت على شُبهات المُنكِرين، وقد بيّنت بعضُ الآيات أنّ السّبب في كثيرٍ من أنواع الضّلال والانحراف هو نسيان القيامة ويوم الجزاء أو إنكارهما:
1- ﴿..وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ص:26.
2- ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ السّجدة:14.
ومن خلال التّأمّل في الآيات القرآنيّة، نتوصّل إلى أنّ القسم الأكبر من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع النّاس كانت تدور حول موضوع المعاد، بل يُمكن القول بأنّ الجهود الّتي بذلوها لإثبات هذا الأصل كانت أكثر من جهودهم لإثبات التّوحيد، وذلك لأنّ أغلب النّاس كانوا يتّخذون موقفاً أكثر عناداً وتشدُّداً من هذا الأصل.
أسباب هذا العناد
يمكن أن نلخّص السّبب في عناد المُنكرين وتَشدُّدِهم هذا في أمرَين:
الأوّل: عاملٌ مُشتركٌ يتجسّدُ في إنكار كلّ أمرٍ غيبيّ وغير مَحسوس.
الثّاني: عاملٌ مُرتبطٌ بموضوع المعاد، وهو الرّغبة بالتّحلّل، وعدم الشّعور بالمسؤوليّة، ذلك أنّ الاعتقاد بالقيامة والحساب، يعتبر دعامةً قويّةً وصُلبةً للشّعور بالمسؤوليّة، ودافعاً قويّاً لتقبّل الكثير من الضّوابط على السّلوك والأفعال، والكفّ عن الظّلم والاعتداء والفساد والمعصية. وبإنكاره، سوف يُفتح الطّريق أمام شَرعَنة التّصرفات المُتحلّلة، وعبادة الشّهوات والأنانيّات، والانحرافات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العامل في قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ * بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ القيامة:3-5.
هذه الحالة النّفسية من الامتناع عن الاعتراف بالمعاد بمعناه الحقيقيّ يُمكن أن نلاحظها - اليوم أيضاً - عند أولئك الّذين يحاولون في أقوالهم وكتاباتهم، تطبيق مفهوم (البَعث)، ومفهوم (اليوم الآخر)، وسائر التّعبيرات القرآنيّة عن المعاد على ظواهر هذا العالم الدّنيويّ، فتراهم يتحدّثون عن (بَعث) الأُمَم والشّعوب، وإقامة المجتمع غير الطّبقيّ، وبناء الجنّة الأرضيّة، أو أنّهم يفسّرون (عالَم الآخرة) والمفاهيم المرتبطة به، بمفاهيم اعتباريّة، وأُسطوريّة: ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ النّمل:68.
﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الأحقاف:17.
وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من (شياطين الإنس) و(أعداء الأنبياء) لأنّهم يحاولون، بأحاديثهم المُضَلِّلة والمُنمَّقة، تشويهَ الأذهان، وخداعَ القلوب، وإقصاء النّاس عن الإيمان والاعتقاد الصّحيح، والتزامِ الأحكام والتّعاليم الإلهيّة. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ الأنعام:112-113.
أجوبةُ القرآن الكريم عن شُبهاتِ المُنْكرين للمَعاد
يمكننا الإشارة إلى أربع شُبهات رئيسيّة:
1- شبهة إعادة المعدوم
لقد أجاب القرآن الكريم، أولئك الذين كانوا يقولون (كيف يحيى الإنسان من جديد بعد أن يضمحلّ ويتلاشى بدنُه؟)، بما مفاده: أنّ هويّتكم قائمةٌ بروحكم، لا بعظام بدنكم التي تتفرّق في الأرض، ﴿وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ * قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ السّجدة:10-11.
ويمكن أن نستفيد من هذا الحديث: أنّ الدّافع لإنكار الكفّار المعادَ، هو تلك الشّبهة الّتي يعبَّر عنها في الفلسفة بـ (استحالة إعادة المعدوم)، أي أنّ هؤلاء كانوا يعتقدون بأنّ الإنسان هو هذا البدن المادّيّ الّذي يتلاشى وينعدم بالموت، واذا رُدَّت له الحياة من جديد بعد الموت، فهو إنسان آخر، إذ إنّ إعادةَ المعدوم أمرٌ محالٌ ومُمْتنع، وليس لها إمكان ذاتيّ.
إذاً، يتّضح الجواب عن هذه الشّبهة في القرآن الكريم، حيث إنّ الهويّة الشّخصيّة لكلّ إنسانٍ وحقيقته مُتمثّلة بروحه، وبعبارة أخرى: إنّ المعاد ليس إعادةَ (المعدوم)، بل عودة (الرّوح الموجودة).
2 - شبهة عدم قابليّة البدن للحياة الجديدة
الشّبهة السّابقة كانت مرتبطة بالإمكان الذّاتيّ للمعاد، أمّا هذه الشّبهة فهي ناظرة لإمكانه الوقوعيّ، بمعنى: أنّ عودة الرّوح للبدن، وإن لم تكن محالاً عقليّاً، ولا يلزم التّناقض من افتراضها، ولكنّ وقوع العودة فعلاً وخارجاً مشروط بقابليّة البدن، ونحن نرى أنّ حصول الحياة منوطٌ بشروطٍ وأسبابٍ خاصّة، لا بدّ من توفّرها تدريجاً. فمثلاً: لا بدّ من أن تستقرّ النّطفة في الرَّحِم، ولا بدَّ من توفُّر شروط مناسبة لنموّها وتكاملها، لتصبح جنيناً متكاملاً بالتّدريج، ولتكون بصورة إنسان، ولكنّ البدنَ الّذي يتلاشى يفقد قابليّتَهُ واستعدادَهُ للحياة.
والجواب عن هذه الشّبهة: إنّ النّظام المشهود في عالم الدّنيا، ليس هو النّظام الممكن وحده، والشّروط والأسباب الّتي نتعرّف عليها من خلال التّجربة ليست أسباباً وعِلَلاً منحصرة، والشّاهد على ذلك وقوعُ بعض الظّواهر والحوادث الحياتيّة الخارقة للعادة في هذا العالم نفسه، أمثال إحياء بعض الحيوانات أو النّاس. ويمكن التّوصّل لمثل هذا الجواب من ذكر بعض الظّواهر الخارقة للعادة في القرآن الكريم.
3 - الشّبهة في مجال قدرة الفاعل
الشّبهة الأخرى: أنّه يُشترط في وقوع أيّ ظاهرة من الظّواهر وتحقُّقها - إضافةً للإمكان الذّاتيّ وقابليّة القابل - قدرةُ الفاعل على ذلك، وهذه الشّبهة الضّعيفة، إنّما تطرح من قبل أولئك الّذين يجهلون قدرة الله غير المتناهية.
والجواب عنها: إنّ القدرة الإلهيّة ليس لها حدود، وتتعلّق بكلّ شيءٍ مُمكن الوقوع، كما هو الملاحظ بأنّه تعالى خلق هذا الكون الواسع بكلّ ما يتمتّع به من عظَمة مُثيرة للدّهشة والإعجاب:
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الأحقاف:33، [وانظر أيضاً: سورة (يس): 81، و(الإسراء): 99، و(الصّافّات): 11، و(النّازعات): 27]
إضافةً إلى أنّ الخَلق الجديد ليس أكثر صعوبةً من الخَلق الأوّل، ولا يحتاج إلى قدرةٍ أكبر، بل من المُمكن القول إنّه أهونُ وأسهل، إذ ليس فيه إلّا إعادة الرّوح الموجودة: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ..﴾ الرّوم:27. ﴿..فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ..﴾ الإسراء:51. [وانظر أيضاً: (العنكبوت): 19 - 20، و(ق): 15، و(الواقعة): 62، و(الحجّ): 5، و(الطّارق): 8]
4 - الشّبهة في مجال علم الفاعل
الشّبهة الأخرى هي ما يقال: إنّه إذا أراد الله إحياءَ النّاس، ومجازاتهم على أعمالهم - ثواباً أو عقاباً – فيلزم: من جانبٍ: أن يميّزَ بين الأبدان الّتي لا تُعدّ ولا تحصى، ليُعيد كلّ روحٍ إلى بدنها. ومن جانبٍ آخر: لا بدّ من أن يتذكّر جميع الأعمال الحسنة والسّيّئة، ليجازي كُلّاً منها بما تستحقّه من الثّواب أو العقاب.
ولكن كيف يمكن التّمييز والتّعرّف إلى الأبدان الّتي تحوّلت إلى تراب، واختلطت ذرّاتها وأجزاؤها؟ وكيف يُمكنه أن يضبط ويتذكّر أعمالَ البشر كلّها خلالَ الآلاف، بل الملايين، من السّنين ليحاسبها؟ وهذه الشّبهة طرحها أولئك الّذين يجهلون العلم الإلهيّ غير المتناهي، حيث قاسوا العلم الإلهيّ بعلومهم النّاقصة المحدودة.
والجواب عن هذه الشّبهة: إنّ العلم الإلهيّ ليس له حدود، وله إحاطة بكلّ شيء، ولا ينسى اللهُ تعالى أيَّ شيءٍ. وينقل القرآن الكريم عن فرعون قوله لموسى عليه السّلام: ﴿..فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ طه:51، فقال موسى عليه السّلام: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ طه:52.
﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ * أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ ق:2-4.
وقد ذكر تعالى في آيةٍ أُخرى الجوابَ عن الشّبهتَيْن الأخيرتَيْن: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ يس:79.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الرُّشْد، الرَّشَد، الرَّشَاد
الرُّشْد، الرَّشَد، الرَّشَاد
الشيخ حسن المصطفوي
-
 التأسيس القرآني لقواعد سير الإنسان
التأسيس القرآني لقواعد سير الإنسان
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الإيمان: كماله بالتّقوى، وثمَرتُه الطّاعات
الإيمان: كماله بالتّقوى، وثمَرتُه الطّاعات
الشيخ جعفر السبحاني
-
 أخوّة إلى الجنّة
أخوّة إلى الجنّة
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 حرّيةُ الإنسان: لا حرّيّة أمام كلمة الحقّ
حرّيةُ الإنسان: لا حرّيّة أمام كلمة الحقّ
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
 من وصايا الفَيض الكاشانيّ (قدّس سرّه)
من وصايا الفَيض الكاشانيّ (قدّس سرّه)
الفيض الكاشاني
-
 وصف الله بالحكيم ليس متوقفاً على نفي العبث
وصف الله بالحكيم ليس متوقفاً على نفي العبث
الشيخ محمد صنقور
-
 زيادة الذاكرة
زيادة الذاكرة
السيد عادل العلوي
-
 متى وكيف تستخدم الميلاتونين المنوم ليساعدك على النوم؟
متى وكيف تستخدم الميلاتونين المنوم ليساعدك على النوم؟
عدنان الحاجي
-
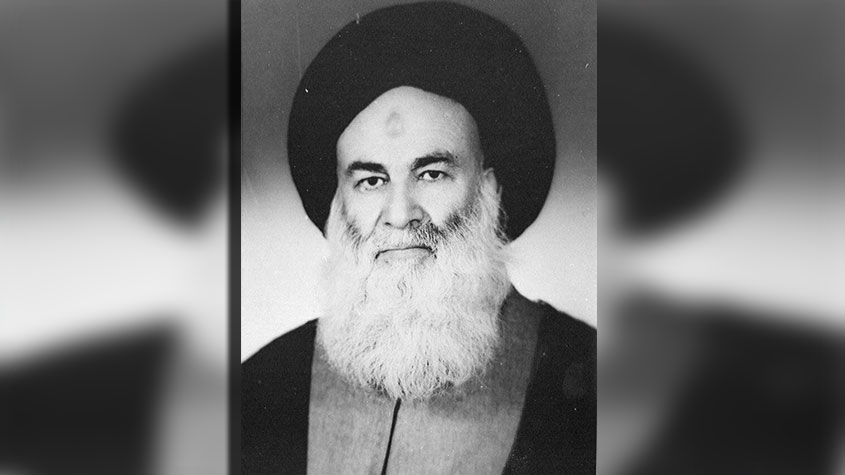 كيف نحافظ على آثار شهر رمضان؟
كيف نحافظ على آثار شهر رمضان؟
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 والتّين والزيتون
والتّين والزيتون
عبد الوهّاب أبو زيد
-
 تحكي لك الأبوابُ
تحكي لك الأبوابُ
فريد عبد الله النمر
-
 القدس
القدس
جاسم الصحيح
-
 بعين الله
بعين الله
حبيب المعاتيق
-
 وقضى إمام المتقين
وقضى إمام المتقين
الشيخ علي الجشي
-
 شهيد المحراب والصلاة (3)
شهيد المحراب والصلاة (3)
حسين حسن آل جامع
-
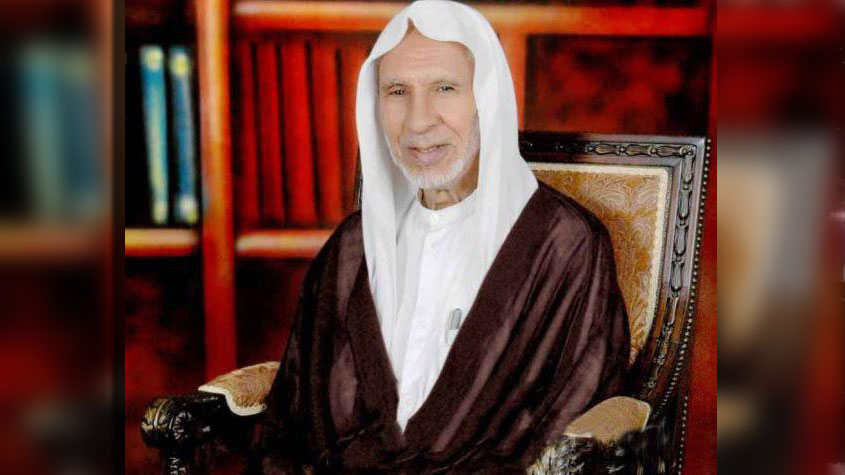 مولد الفضل
مولد الفضل
الشيخ عبد الحميد المرهون
-
 كان موتًا مجازًا (بين المتنبّي وقاتله)
كان موتًا مجازًا (بين المتنبّي وقاتله)
ناجي حرابة
-
 سيرة الجسر
سيرة الجسر
عبدالله طاهر المعيبد
-
 كانت الأحلام
كانت الأحلام
جاسم بن محمد بن عساكر
آخر المواضيع
-
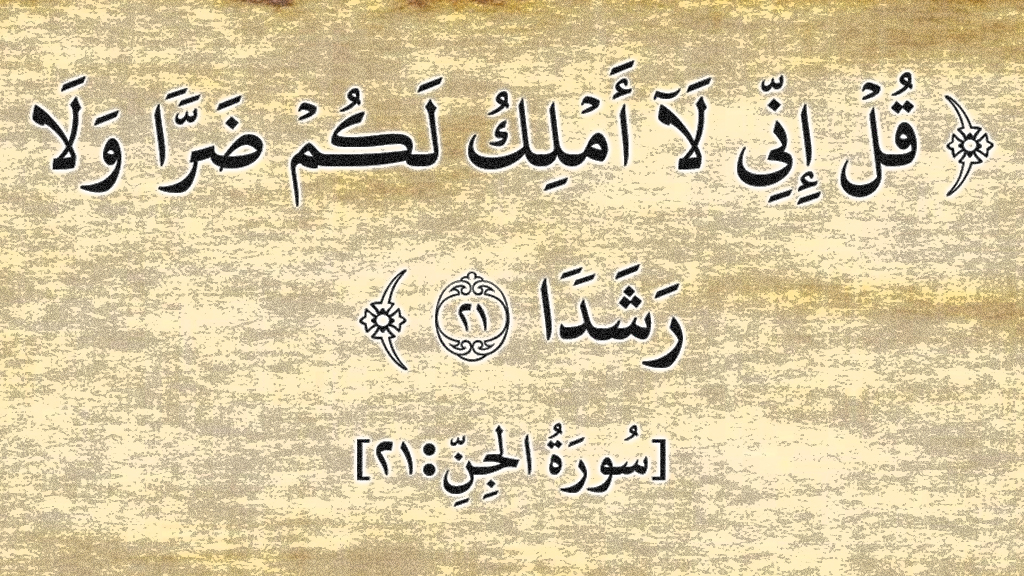
الرُّشْد، الرَّشَد، الرَّشَاد
-
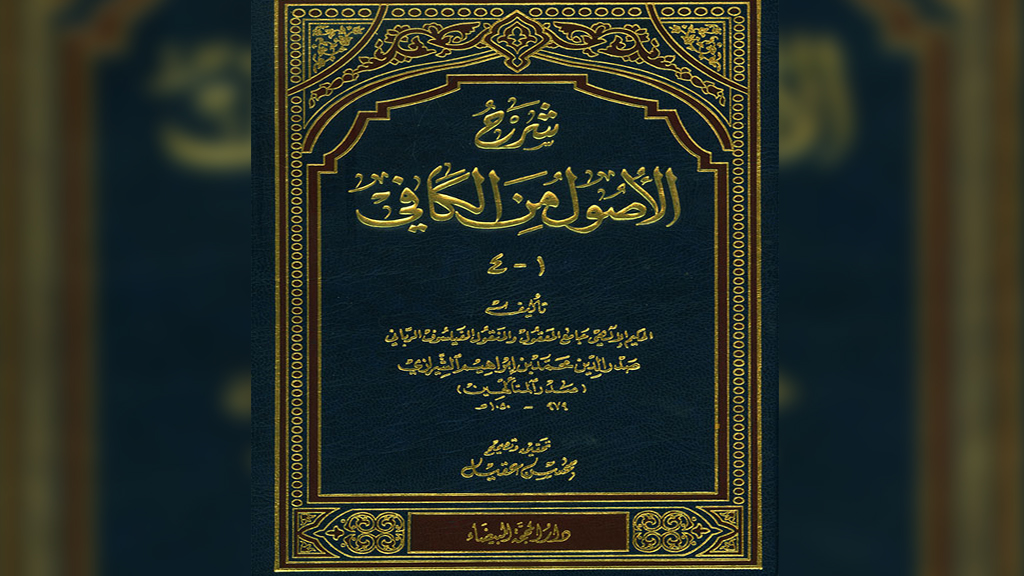
ملّا صدرا شارحاً (الأصول من الكافي) للكليني
-
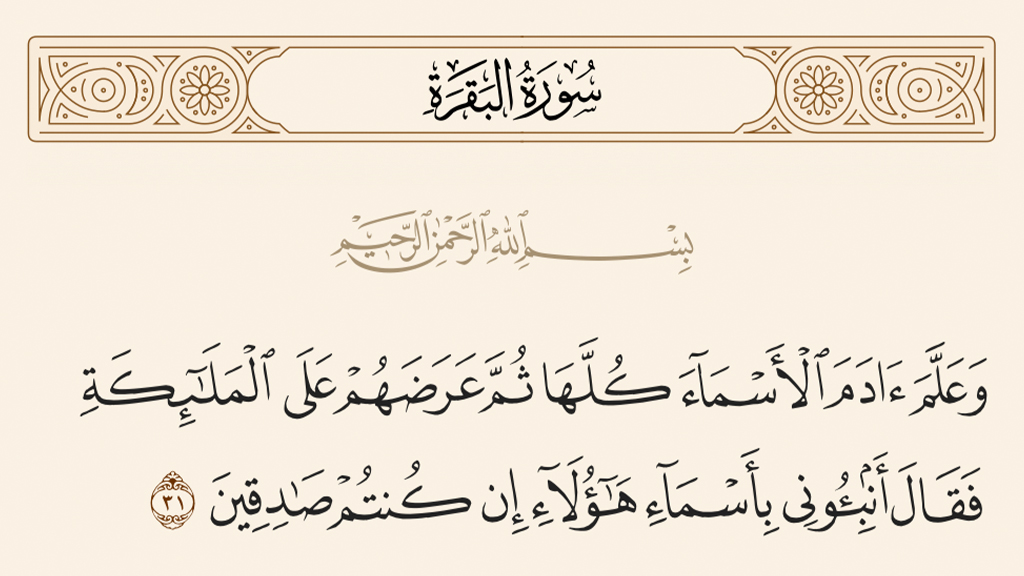
﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾
-

التأسيس القرآني لقواعد سير الإنسان
-

ناصر الرّاشد: نحو تربية أسريّة إيجابيّة
-
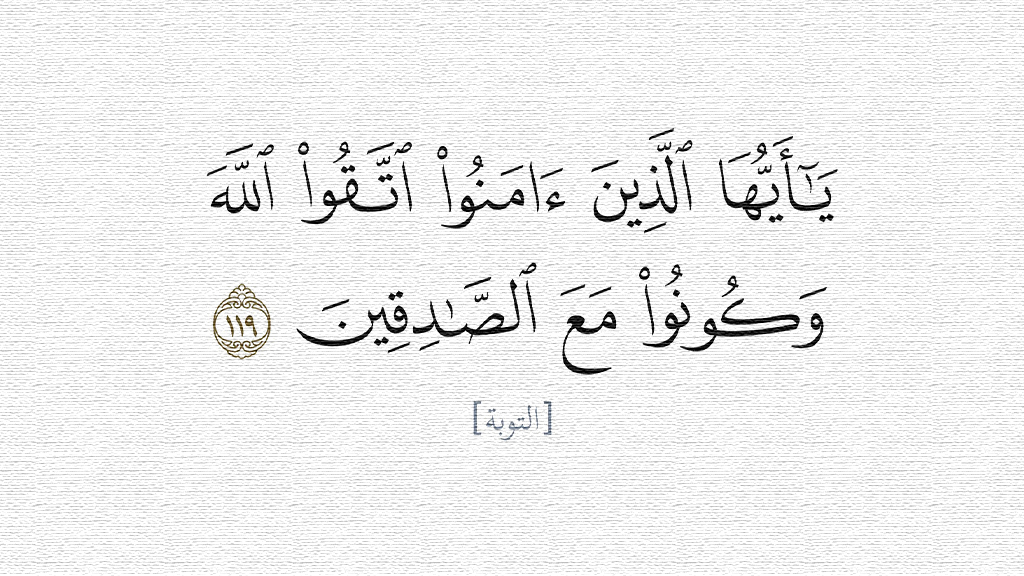
الإيمان: كماله بالتّقوى، وثمَرتُه الطّاعات
-
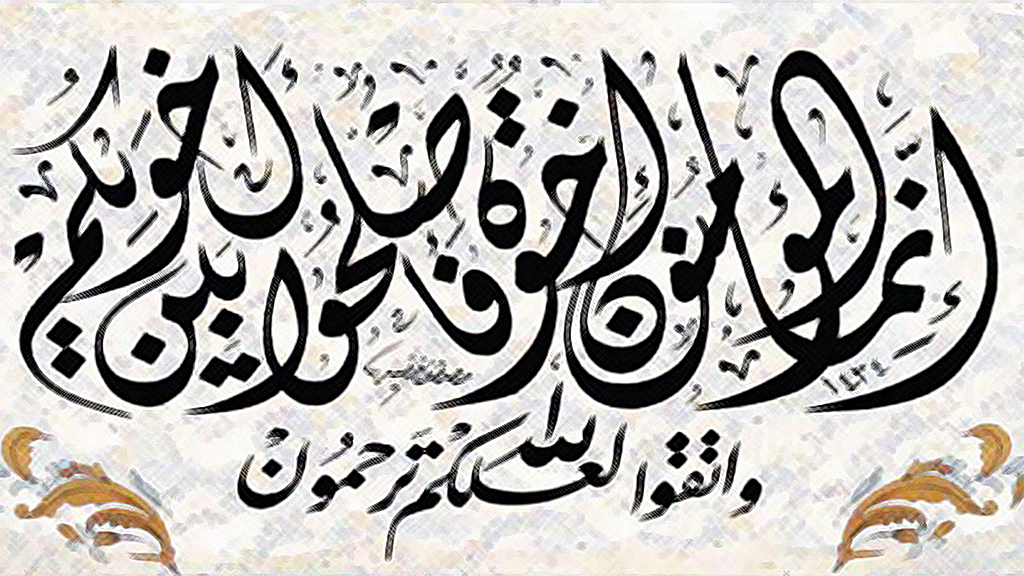
أخوّة إلى الجنّة
-
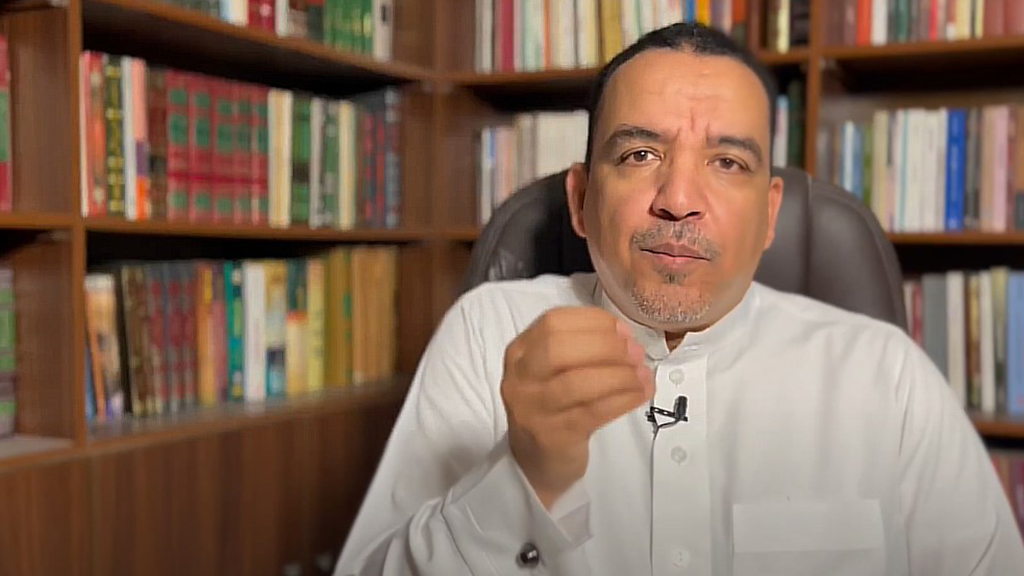
زكي السّالم: حين تصدر كتابًا.. احذر هذا الخطأ القاتل
-

حرّيةُ الإنسان: لا حرّيّة أمام كلمة الحقّ
-
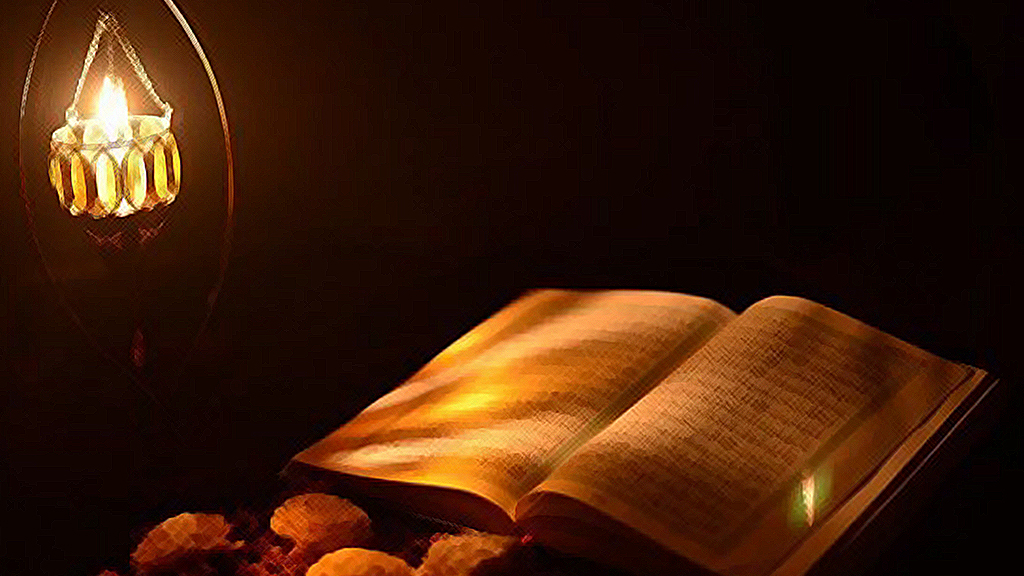
ألفاظ القرآن الكريم: وجوه المعاني وأنواعها









