علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.إدارة الظنّ
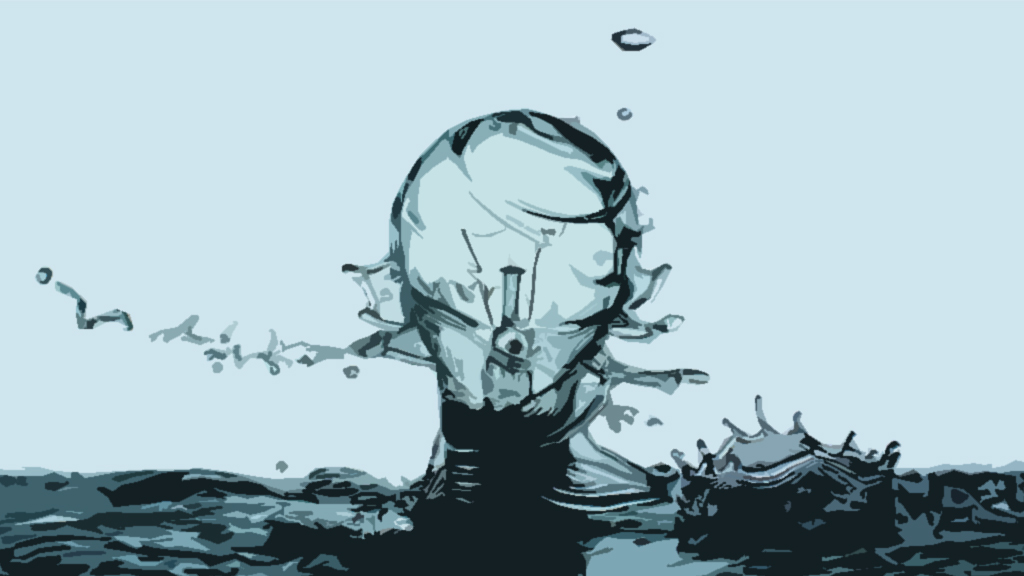
﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[1]
تتحكّم الانطباعات في مواقف الإنسان من كثير أمور الحياة والنظرة إليها، بل إن انطباعاتنا الأولية اتجاه الأشخاص والأشياء لطالما تأخذ دور الموجِّه لنا في سياق مساراتنا اليومية دون أن نتريث غالبًا. والتريث هو الحافة الأولى لتجاوز ساحة الانطباع إلى ساحة التفكُّر. وما هذه الحافة الأولى من التريث إلّا الظن الذي يعترينا. فما سر الانطباع والتريث والتفكّر بمراتبه المتنوعة المتعددة الذي يملأ حياتنا اليومية والعميقة؟
مثلًا نفورٌ أو حبٌّ من نظرة أولى.. انجذاب للون على بقية الألوان، أو الإحساس بالانقباض منه. حصول حركة أو حدث يثير فيك التشاؤم أو التفاؤل، وكل هذا وليد انطباع. إنه تماس بين أمر خارجي وبينك، أو تماس مع زمن وخاطرة عابرة لامست فيك أمرًا.
المتمركز في الانطباع أنت.. إنه شيء فيك يرتبط بالحاسة وما خلفها، وقد يمتد إلى قعر عميق من لا شعور يحركّك بفعل ما ألفته من تربية أو معتقد أو غير ذلك.
لكن الأهم من كل ذلك، هو نحوٌ من الفرادة غير المفهومة؛ الملغّزة التي اعتبرتها الأفلاطونية أنها تعود إلى ما قبل تنزّل الأرواح على الأبدان. فالانطباع نافذة عودة التواصل بين ما ائتلف أو اختلف في عالم الأرواح والمثل، لكنه تواصل أولي قد يغيب عنك مجدّدًا، وقد يُبنى عليه لتظهر الصورة بوضوح أكثر في عالم الحضور.
فالسر يتبدّى كومضة خيال خاطف يستفز ولا يستقر. ويرسل رسالة خاطفة إلى النفس والوعي ليتحركا بجد بين ازدحامات ما تراكم من معطيات وأخبار وأحوال وأحداث وأوضاع لا حصر لها، وبين إشارة مستجدّة لطالما تضيع وسط ضجيج ازدحام النفس، فتصبح رنة بلا دلالة، ومعنى غير ملتقط في عالم من تيه المعاني، وفراغ الدلالات، لكن أهم ما فيه أنه يُحدث بعضًا من القلق؛ لأن طبيعته مختلفة وغير مألوفة. وأعظم محرِّض على الوعي والدلالة هو ذاك اللامألوف. إنه ما لا عينٌ رأت من قبل، أو كأنه كذلك، ولا أذن سمعت من قبل أو كأنه كذلك، لكن الأكيد إنه ما خطر من قبل على قلبك وصفحات وعيك.
وهنا يبدأ سؤال الحقيقة من هو؟ ما هو؟ ما حصل؟ لتبدأ رحلة طويلة من احتمالات واسعة تعيشها ولا تتعايش مع أي منها بفعل الشك. وهل الشك في وجودك إلا شراع قارب في بحر تسوقه ريح فوضى الاحتمالات؟ كثيرون هم أولئك الذين سلبتهم اللحظة إرادة وعي الحق. فوقفوا عند الملمح الأول للانطباع، لحظة الرغبة، فطافوا يفتكون بكل معنى ليعيشوا نحوًا من متاع الدنيا، كذلك يمثّل لهم بصورة قتل رمزي لكل من حولهم بالكذب والخديعة والاستعلاء، يُسقطون في حقيقة الأمر شعورهم العميق بالفراغ الذاتي على كل ما يحيط بهم ساخرين منه ومن قدره، يمتطون كل سبيل بغصبهم الكرامة الإنسانية وجمال الطبيعة ليتسيَّدوا عليهم ولو بكذبة من هنا، ومكر من هناك، وفساد هنالك.
وما هذا إلا بفعل الظن، فالظن وهمٌ قاتل للمعنى والحقيقة، يبدأ من حيث يستلذ ويرتئي ولو من زاوية عزة الإثم. وتأخذهم عزة الإثم إلى حيث لا يتوقعون، ولا تحتمله إرادة في هذه الأرض. وجودي كإنسان لا يتقوَّم دومًا على وفق ما أختار؛ فلوازم ما نختار هي خارج كل إرادة. إنها كمن اختار السقوط عن شاهق حتى إذا فعل باختياره ذهبت به لوازم سنن الطبيعة وقوانينها إلى حيث الهلاك، وأول الهلاك انتزاع خيار التراجع وإرادة التوقف.
وهكذا فِعل الظن، يتحول إلى إرادة مسلوبة في موضوعية النظر إلى الأشياء والأمور والأشخاص عندما يقلّل من قيمتها عن عمد، مما يفتح له باب الافتراء الذي هو في حقيقته وليد الازدراء، حتى إذا ما تحول عند صاحبه إلى إدمان ذهني ونفسي سار به نحو مهاوي الخصومة والتفكّر لكل محمدةٍ أو فعل جميل، أو قول سليم، بل واليأس من خير الحياة وغايات الوجود.
وكأي خُلق نفسي أو موقف عملي، فإنّ الظن يحتاج إلى إدارة تربوية سليمة تمنع عن صاحبه الشك القاتل، والنظرة السوداوية لتصاريف الحياة، وذلك بالتأدّب بنزعة الثقة التي يسبقها سليقة التثبّت من الأشياء، وأن يفرّق الواحد منا بين الحذر، وبين الظن السلبي؛ فالحذر طريق السلامة في كل ما يلاقيك من أحداث وتفاعلات مع من تلتقيهم وتشاركهم العشرة والحديث والصداقة، أو ما يقع أمامك من آراء وخواطر وأفكار.
وإذا كانت كثيرة هي الحالات التي يسيطر فيها عليك وسواس الشك والخوف وما يقع خلف المستور، فنحتاج إلى عون المشورة أو العلاج. فإن مفترق الطريق هو الإقرار بأنك لست في حال سويّ من الأمر، وبأنك تحتاج إلى غيرك، إلى من تصارحه وتبعث في محضره خوالج نفسك، وتتكاشف معه بأنه فضلًا عن كونه يتفهمك فهو يرشدك؛ طبيبًا كان أو صديقًا، أو مرشدًا يحمل صفة المعرفة النفسية بلبوس علمي أو معرفي أو ديني، أو أنه جهة مؤهلة لذلك كما في مكاشفة الداعي ربه حينما يقف بين يديه مقرًّا بالخطأ والظروف القاسية التي يمر بها المرء ولا يعرف ما سرّها؛ ومتكئًا عليه بالتوكل والرجاء وطلب تفهّم الظروف القاسية، وأنه لطيف خبير رحيم.
إن الموغل في الظن هنا يبلغ درجة من اليقظة الوجودية التي تتعدّى في عمقها البعد الأخلاقي، هو يمارس نحوًا من جدل الذات مع الظن، ويعمل على استبعاد ذات قلقة رخوة، لطالما كانت رهينة السوء في التقدير والموقف. ويبحث عن قاعدة لاستعادة أو توليد ذات أكثر جرأة وقدرة على اقتراف الحكمة والسِواية.
وإذا كان في الحالة الأولى من الرخاوة والقلق قطّاعًا ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لاَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً﴾[2] فإنه في الحالة الثانية حاضرُ السؤال الباحث عن وجوه الأمور وطبائعها وحقائقها، فبدل وما أظن الساعة قائمة، تصبح الصيغة: وهل الساعة قائمة؟ وهل إذا ما انقلبت إلى ربي على مثل حالي سأجد خير العاقبة؟
إن حسن إدارة الظن بالسؤال والحذر كفيل بفتح الطريق نحو تحرُّر الذات من التباسات القلق العيني اللابس لبوس اللذة والإشباع السطحي. وقد يلاحقك في السؤال تعب اليقظة حائلًا بينك وبين نوم شبيه بالعدم، ملتحفًا بالغفلة والغفوة. وقد يطاردك الخوف ليكون مهمازك نحو الرجاء، وقد يملأ الصمت والضجيج جدل عقلك وحياتك وعلاقاتك، لكن لذة الحرية وبهجة الثقة إذا ما تجلّت على نفسك حوّلت فيك الألم إلى حياة وولادة جديدة. حتى الدموع التي تحفر في المآقي والخدود مسالكها تتحول إلى نفثة لمهموم وضع رحله عند بوابة الراحة والوطن.
ولعلها من أجمل التصاوير لهذه الحالة الوجودية للذات الباحثة عن سبيل الخروج من كهف سوء الظنون ذاك القول الداعي: تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك؟ فبعد هذه الرحلة من العجيب أن تلامس نار العذاب الذات؛ لأن قلبًا عرف الحق، حقّ له أن لا يذوق إلّا العذب من الحب، وإن بدا على صورة من قساوة الحال. فما قساوة المحب إلا عرضًا لفرصة إثبات مضمون ما في الفؤاد… وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. وهنا تتبدّى ثمار مراحل إدارة الذات والحياة على صورة من الأمل، عندما ينقلب سوء الظن إلى حسن ظن، بل يقين بتبعات الرجاء.. هيهات أنت أكرم من أن تضيِّع من ربيته، أو تشرّد من آويته. بلحظة تحوُّل إشراقي يتجلّى على الذات فينقلب الشك سؤالًا يبحث عن المصير، عن حفظ الذات في حرم الوجود ليضيء كلمعة ضوء خاطفة في محيط من الظلمات يستهدي بها السائل السالك سبل الطريق فيسير. كما ينقلب الظن من كونه ترهات حياة فكرية وروحية فارغة تُقصي كل ما يقابلها إلى حسن ظن يعمر بالأمل ويستهدي بالرجاء.
ولا تتوقف الرحلة في إدارة الظن عند هذا الحد، بل يسري بسلوك نابع من النظرة للوجود في مصدره، وإلى الناس بل الخلائق أنهم نفحة رحمة ضيَّقت عليها شقوة الحياة وفعل الذات في هواها ورغباتها الجامحة. نفحة رحمة تحتاج إلى محفّز أو مهماز يقسو حينًا ويلين أخرى، ليحقق توازن التأديب في شراكة التأدّب بأخلاق الأصالة الإنسانية، ولا يعني هذا أن السبيل مفتوح على خط واحد خيِّر، بل هو تحقيق لأصالة الخير في عالم يسوده وهم سوء الظن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة يونس، الآية 36.
[2] سورة الكهف، الآية 36.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
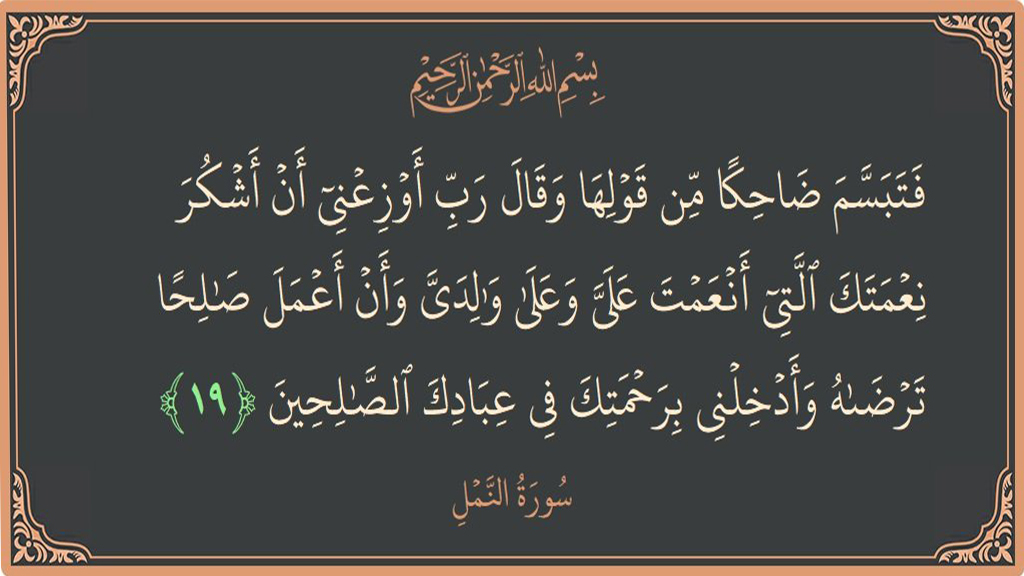
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-

معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
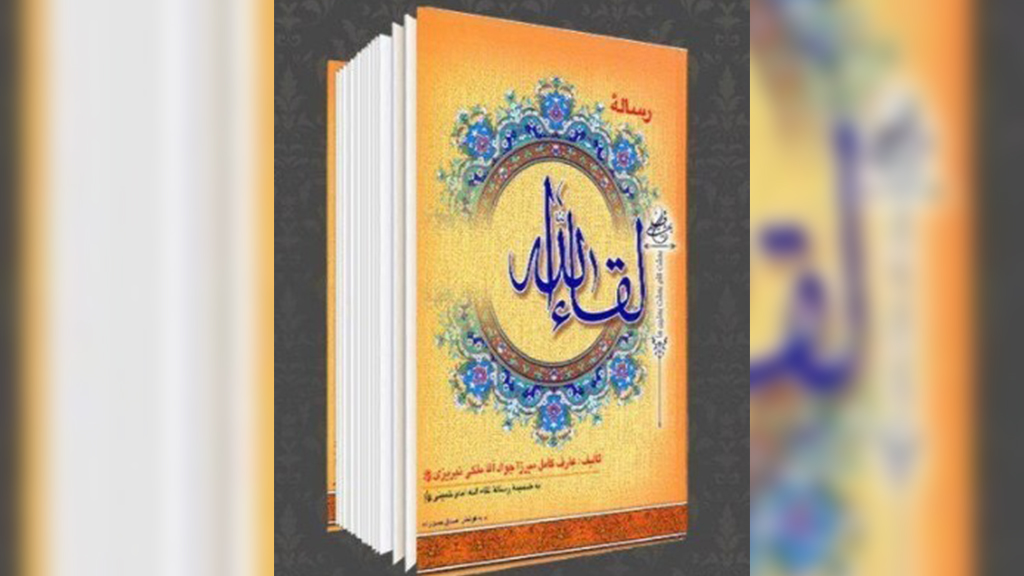
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
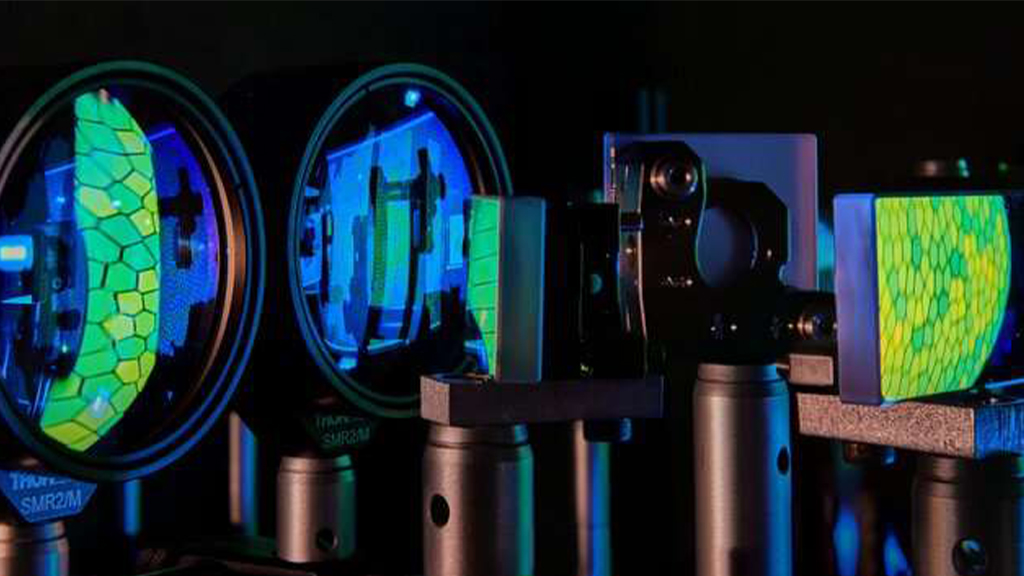
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










