علمٌ وفكر
علاقة الإنسان بالقضاء الإلهي

الشهيد مرتضى مطهري ..
ميزة الإنسان1
إنّ الأعمال والأفعال الإنسانيّة هي من تلك الحوادث والأفعال التي ليس لها قضاء وقدر حتمي، لأنّها ترتبط بآلاف العلل والأسباب، ومنها أنواع الإرادات والاختيارات التي تحصل للإنسان. وإنّ كلّ الإمكانات المتوافرة في مجال الجمادات والنباتات والأفعال الغريزية للحيوان موجودة في أفعال الإنسان، إذ توجد في نمو شجرة ما، أو حصول عمل غريزي لحيوان ما آلاف من الشرائط الطبيعية الممكن لها أن تحصل، وهذه الشرائط كلّها موجودة في أفعال الانسان وأعماله بالإضافة إلى كون الإنسان قد منح عقلاً وشعوراً وإرادة أخلاقية وقوّة اختيار. ويكون الإنسان قادرًا على عمل ما، وهو يوافق غريزته الطبيعية والحيوانية مئة بالمئة، ولا يوجد أيّ رادع أو مانع خارجي فيه، لكنّه يتركه بعد تفكير وموازنة للمصلحة في الأمر. كما أنّه قادر على القيام بأعمال يعلم أنّها مخالفة لطبيعته تماماً، ولا يوجد في البين أيّ عامل خارجيّ يجبره عليها، وذلك لأنّه فكر ورأى المصلحة في ذلك.
وهكذا، فإنّ حصول هذا العمل مشروط بموافقة العقل كسلطة تشريعية عليا والإرادة كقوة تنفيذية... ومن هنا يعلم أنّ الإنسان مؤثّر في مصيره كعامل مختار، بمعنى أنّه بعد أن تتوافر كلّ الشرائط الطبيعية المؤثرة يبقى له اختياره وحريته في الفعل أو الترك.
وليس معنى حرية الانسان أن يكون متحرِّراً من قانون العلّية، إذ لا يرتبط هذا بالاختيار، بالإضافة إلى استحالة الخلاص من قانون العلّية في حدّ ذاته، بل إنّ مثل هذه الحريّة هي عين الجبر، فما الفرق بين أن يكون الإنسان مجبراً من قبل عامل خاصّ يجبره على ما يخالف طبعه وميله، أو أن يكون العمل نفسه متحرّراً من قانون العلّية ومن أيّ ارتباط بعلّة، ومن جملة ذلك ارتباطه بالإنسان نفسه، فيقع وحده ومن دون أيّ تأثير. إنّنا إذا قلنا بحرية الإنسان قصدنا أنّ العمل ناشئ منه وبإرادة ورضاً كاملٍ منه، وبتشخيص من قواه الإدراكية، وأنّ ليس هناك أيّ عامل يجبره على القيام بما لا يرضى به ولا يرغب فيه، لا القضاء والقدر، ولا أيّ عامل آخر.
والخلاصة: إنّ كلّ العلل والأسباب هي مظاهر للقضاء والقدر الإلهي، فكلّما تكثّرت العلل والأسباب المختلفة والوقائع المتباينة الممكن وقوعها بالنسبة إلى حادثة ما، تكثّرت أنواع القضاء والقدر المختلفة بالنسبة إليها أيضًا، فما وقع من الأحوال هو بالقضاء والقدر الإلهيين، وما لم يقع هو بالقضاء والقدر الإلهيين أيضًا.
الطبيعة التي لا تقبل التغيير2
يجب أن نضيف هنا أنّه توجد في الطبيعة أيضاً أمور حتمية، أي يوجد قضاء وقدر محتّمان، لا يقبلان التغيير. فإنّ كلّ موجود في الطبيعة مسبوق بالعدم، ولا بدّ أن يكون معلولاً لموجود آخر، وهذا قضاءٌ حتّمي. ثمّ إنّه لا بدّ لكلّ موجود طبيعي أن يتّخذ سبيله للفناء والزوال ما لم يتبدّل إلى موجود غير مادي، وهذا أيضاً قضاء وقدر حتمي. وإنّ الموجودات الطبيعية تصل إلى مرحلة لا يمكنها فيها أن تغيّر مسارها، فإمّا أن تنعدم أو تطوي المسار نفسه، ومعنى ذلك أنها تحت تقدير حتمي. فمثلاً الحيوان المنوي للرجل عندما يتّصل ببويضة المرأة ويكوّن الخلية الملقحة (الزايكوت) فإنّه يحدد الطينة والخميرة لمستقبل الطفل، ويؤدّي إلى تحقّق صفات موروثة خاصّة في المولود تؤثّر - لا ريب - في مصيره ومستقبله. ومن الواضح أنّ الحيوان المنوي للرجل لو كان قد خصّب بويضة امرأة أخرى لتشكلت طينة وخميرة أخرى، وبعد تشكيل الطينة لا يمكن تبديلها إلى طينة مغايرة. ومعنى ذلك أنّ القضاء والقدر في هذه المرحلة محتّمان، وكذلك فإنّ الكثير من الكيفيات التالية للرحم قطعية وحتميّة. ومن هنا نجد الرحم قد جُعِل في بعض الروايات لوحاً من ألواح القدر.
النظم الثابتة3
كما أنّ القوانين والنظم الحاكمة في هذا العالم أيضاً لا تقبل التغيير والتبديل، فإنّ الموجودات الطبيعية متغيرة متبدّلة، ولكنّ النظم الطبيعية ثابتة لا تتغيّر.
والموجودات الطبيعية متغيّرة متكاملة، وتتّخذ لها مسارات مختلفة، فتارة تصل إلى حدّ الكمال، وأخرى تتوقّف، وتارة تسرع وأخرى تبطئ، حيث تغيّر مصيرها العواملُ المختلفة، ولكنّ النظم الطبيعية ليست متغيّرة ولا متكاملة، بل هي ثابتة على منوال واحد، يقول القرآن الكريم متحدثاً عن النظم الثابتة ومعبّراً عنها بتعبير "سنّة الله": ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلً﴾4.
فمثلاً إن كون العاقبة للمتقين، وإن الأرض لعباد الله الصالحين في النهاية هي سنّة إلهية لا تتغير: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾5، ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾6.
ومن السنن الحتمية أنه ما لم يغير الناس أنفسهم وأوضاعهم وأحوالهم فإنّ الله لن يغير أوضاعهم العامّة ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾7.
إشكال: علم الله بالأشياء قبل وقوعها يستلزم الجبر8
لا بأس في التعرّض هنا إلى أشهر إشكالات الجبريين، ونقوم بتحليله لتتضح الإجابة عليه. إنّ الله عالم من الأزل بما وقع وما يقع، ولا تخفى على الله وعلمه الأزلي خافية. ومن جهة أخرى فإنّ العلم الإلهيّ لا يقبل التغيير ولا يتبدّل ولا المخالفة للواقع، ذلك لأنّ التّغيير منافٍ لتماميّة ذات واجب الوجود وكمالها، ولا يمكن مخالفة ما يعلمه من الأزل لما يقع، لأنّه يلزم أن لا يكون علمه علمًا بل جهلًا، وهذا أيضًا يتنافى مع تمامية الوجود المطلق وكماله وعليه، وبحكم المقدمتين الآتيتين:
أ- إنّ الله عالم بكلّ شيء.
ب- إنّ العلم لا يقبل التغيير ولا الخلاف.
لا بدّ أن نستنتج: إنّ الحوادث والكائنات يجب أن تجري بنحوٍ ينطبق مع علم الله قهرًا وجبرًا. وخصوصًا، إذا أضفنا إلى ذلك أنّ العلم الإلهي علم فعلي إيجابي، أي هو علم يكون المعلوم فيه نابعًا من العلم، وليس علمًا انفعاليًا يتحقّق العلم فيه من وجود المعلوم، نظير علم الإنسان بحوادث العالم.
وعلى هذا، لو كان الأمر في العلم الأزلي أنّ الشخص المعيّن سوف يرتكب المعصية المعينة في الساعة المعينة، فإنّه لا بدّ أن تقع تلك المعصية جبرًا وقهرًا بالكيفيّة نفسها، ولا يمكن للشخص المرتكب أن يغيّر ذلك إلى شكل آخر، بل لا يمكن لأيِّ قدرة في الوجود أن تغيّرها، وإلّا فإنّ علم الله سيتحول إلى جهل!
الجواب:
الردُّ على هذه الشُبهة بعد معرفة مفهوم القضاء والقدر معرفة صحيحة أمرٌ سهل. فإنّ الشبهة إنّما حصلت بعد أن أُعطي لكلّ من العلم الإلهي من جهة، ونظام الأسباب والمسبّبات في العالم من جهة أخرى حسابٌ مستقلّ، بمعنى أنّه فرض أن العلم الإلهي في الأزل تعلّق صدفة بوقوع الحوادث والكائنات، ولأجل أن يكون هذا العلم علمًا، ولئلا يقع خلافه فقد لزم أن يسيطر على النظام العالمي، ويخضع للمراقبة الشديدة ليكون مطابقًا للتصوّر والتخطيط المسبقين له. وبعبارة أخرى: إنّه يفترض أنّ العلم الإلهي، بصرف النظر عن نظام الأسباب والمسبّبات، قد تعلّق بوقوع الحوادث وعدم وقوعها، وأنّ من اللازم أن يجعل هذا العلم مطابقًا للمعلوم الواقع بأيِّ وسيلة، وعليه فلا بدَّ من ضبط نظام الأسباب والمسبّبات في العالم، ففي بعض الموارد يعمل على منع ما من شأنه أن يؤثّر، وإبطال عمل الإرادة والاختيار لمن يعمل بهما، لكي يكون ما سبق في علم الله الأزلي مطابقًا لما يقع ولا يغايره. ومن هنا، فيجب سلب الاختيار والحريّة والقدرة والإرادة من الإنسان لتكون أعماله تحت السيطرة الإلهية، ولئلّا يتحوّل علم الله إلى جهل.
إنّ العلم الأزلي الإلهي ليس منفصلًا عن النظام السببي والمسبّبي في العالم، إنّ العلم الإلهي علم بالنظام وما يقتضيه العلم الإلهي هو هذا العالم مع هذه الأنظمة، فالعلم الإلهي مباشرة ومن دون واسطة لا يتعلّق بوقوع حادثة ولا بعدم وقوعها، وإنّما يتعلّق العلم الإلهي بالحادثة من خلال علّتها وفاعلها الخاصّ وليس تعلّقه بها بشكل مطلق غير مرتبط بأسبابها وعللها. وإنّ العلل والأسباب متفاوتة، فبعضها علّيته وفاعليّته طبيعية، وبعضها علّيته شعورية، وبعضها مجبور، والآخر مختار.
وما يوجبه العلم الإلهي الأزلي هو صدور أثر الفاعل الطبيعي من الفاعل الطبيعي، وأثر الفاعل الشعوري من الفاعل الشعوري، وأثر الفاعل المجبور من الفاعل المجبور، وأثر الفاعل المختار من الفاعل المختار، ولا يقتضي العلم الإلهي أن يصدر أثر الفاعل المختار من ذلك الفاعل قهرًا وجبرًا.
والإنسان في نظام الوجود كما قلنا مسبقًا يملك نوعًا من الحريّة والاختيار، وله إمكانات في فاعليّته، وتلك الإمكانات ليست متوافرة للموجودات الأخرى حتى للحيوانات. ولأنّ النظام العيني يستمدّ وجوده من النظام العلمي، وأنّ منبع العالم الكوني هو العالم الربّاني، فإنّ العلم الأزلي المتعلّق بأفعال الإنسان وأعماله هو بمعنى أنّه يعلم من الأزل من هو الذي سوف يطيع باختياره وحرّيته، ومن هو الذي سوف يعصي بحرّيته واختياره كذلك. والذي يوجبه ذلك العلم ويقتضيه هو أن يطيع ذلك المطيع بإرادته وأن يعصي ذلك العاصي بإرادته، وهذا هو معنى قول أولئك القائلين بأنّ "الإنسان مختار بالإجبار" فلا يمكنه أن لا يكون مختارًا. فليس للعلم الأزلي أيُّ دخل في سلب الحريّة والاختيار ممّن قرّر له في النظام العلمي والنظام العيني أن يكون مختارًا، وليس له أيُّ دخل في سلب الاختيار والحريّة الإنسانية، بأن يجبره على الطاعة أو المعصية.
وعلى هذا فكلتا المقدمتين المذكورتين في الإشكال صحيحتان ولا شكّ فيهما، وكذلك صحيح ما قلناه في تلك النقطة الإضافية من أنّ علم الله فعلي وإيجابي لا انفعالي وتبعي... ولكنّه لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان مجبرًا ومسلوب الاختيار، وأنّه عندما يعصي يكون قد أُجبر على العصيان من طرف قوّة أعلى منه، بل إنّ الموجود الذي خُلِق مختارًا في النظام التكويني هو في النظام العلمي أيضًا حرٌّ مختار، فإذا فعل فعلاً يجبر عليه كان علم الله جهلًا.
فالنتيجة على هذا هي أنّ العلم الأزلي بأفعال الموجودات ذات الإرادة والاختيار ليس جبراً، بل هو نقيض للجبر، فإنّ لازم العلم الأزلي هو أن يكون المختار مختارًا حتمًا.
وهكذا يمكن أن نستنتج ما الآتي:
1- إنّ مشيئة الله ماضية، ولا يمكن لأيّ شيء أن يغلبها.
2- إنّ هذه المشيئة تظهر في عالم القضاء والقدر (نظام العلل).
3- إنّ مشيئة الله قضت أن يكون الإنسان مختارًا.
4- وهذه المشيئة جعلت العالم متّسعًا لخيارات لا متناهية.
5- الإنسان لا يمكنه أن يعرف حقيقة المشيئة.
6- عندما يعرف الإنسان أحد القوانين والسنن الحاكمة يظنّ أنّه عرف المشيئة.
7- لكنّه سرعان ما يكتشف أن هناك قوانين أخرى كان يجهلها عندما شاهد القضاء لا يجري وفق القوانين الأولى.
عندما يحلّ القضاء9
يلوح في الأخبار عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الأطهار عليهم السلام أمرٌ هو: إنّ القضاء والقدر عندما يحلّان تسقط الأسباب والعلل وخصوصاً العقل وقوّة التدبير لدى الإنسان، عن التأثير.
وقد ذكر كتاب (الجامع الصغير) بعض الأحاديث في هذا المعنى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنها: "إنّ الله إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرجال حتى يمضي أمره، فإذا أمضاه ردَّ إليهم عقولهم، ووقعت الندامة"10.
والإشكال الذي يبدو هنا هو أنّ هذه النصوص تؤكّد على كون القضاء والقدر ناقضاً ومبطلاً لقانون العلّية العامّة، وتجعله عاملاً في قبال سائر العوامل في العالم، إلا أنّه أقوى منها، وهذا الأمر ينافي ما مرَّ ذكره وما أيّدته الروايات من أنّ القضاء والقدر لا يوجب شيئاً إلاّ من خلال مجرى العلل والأسباب. فقد جاء في الخبر: "أبى الله أن يجري الأشياء إلّا بأسباب، فجعل لكلّ شيء سبباً، ولكلّ سبب شرحاً، وجعل لكلّ شرح علماً، وجعل لكلّ علم باباً ناطقاً..."11.
والإشكال الآخر في مثل هذه الروايات: إنّ ما جاء فيها يتنافى مع عمومية القضاء والقدر، مع أنّه ليس هناك شيء خارج عن القضاء والقدر ، وذلك ما أكده القرآن بصراحة، فإذا كان كلّ شيء بيد القضاء والقدر الإلهي ولم تكن هناك لحظة ليس فيها قضاء وقدر فما معنى "إذا حل القضاء"؟
أعتقد أنّ هذه الروايات تنظر إلى موضوع صحيح لا ينافي عمومية مبدأ العلّية ولا عمومية القضاء والقدر، فهي تلاحظ النظام الكلّي للعالم، ومجموع العلل والأسباب الأعمّ من المادّيّة والمعنوية، إذ تنظر إلى الموارد التي تتغلّب فيها العلل والأسباب المعنوية على العلل المادّية.
إنّ العلل لا تنحصر في المجال المادي، إذ إنّ النظام الأكمل مكوّن من مجموع العلل والأسباب الظاهرة والخفية. وكما أنّ العلل المادّية المحسوسة يؤثّر بعضها في بعض، ويشلّ بعضها البعض الآخر عن التأثير، فإنّه في بعض الموارد تكفّ العلل المادّية عن العمل بتأثير العوامل المعنوية، وقد جاء هذا المعنى في القرآن ببيان أبلغ وأركز ممّا جاء في الأحاديث، حيث قال تعالى معبّراً عن لحظات معركة بدر: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ﴾12.
وهذا يعني ذكراً لمورد من موراد تقدّم العلل المعنوية على العلل المادّية، فعندما تستحقّ أمّة ما النصر والتأييد الإلهيين، إثر سيرها في طريق الحقّ والعدل، وتستحقّ أمّة أخرى الخذلان والفناء، فإنّ النظام المتقن الكامل للعالم يقف في صف الأمّة الأولى مع قلّة عددها وعُددها المادّية، ويحكم على الأمّة الأخرى مع ما لديها من وسائل وأسباب مادّية بالفناء والزوال.
يكون الاعتقاد بالقضاء والقدر من وجهة النظر الإلهية عاملاً مؤثّراً خارقاً في إيجاد الأمل والنشاط والفاعلية، وضمان النتيجة من السعي والعمل.
وواقع الأمر ـ كما أشرنا إليه من قبل ـ هو أنّ القضاء والقدر والمشيئة الإلهية والعلم الإلهي والعناية الربانية علّة في طول العلل الطبيعية لا في عرضها، فإنّ كلّ النظام اللانهائي للعلل والأسباب مبني على الإرادة والمشيئة والقضاء والقدر الإلهي ومنبعث منها، وأنّ تأثير هذه العلل والأسباب وعلّيتها هو بنفسه بنظر معين عين تأثير القضاء والقدر وعلّيته.
من هنا، فإنّه من الباطل حقاً أن يقال: ما الشيء الذي هو من فعل الله؟ وما الشيء الذي هو ليس من فعله؟ ومن الخطأ أن يقال للشيء إنّه ليس من فعل المخلوق بعد أن نسب إلى الله، أو يقال: إنّ هذا الشيء من فعل المخلوقات، بعد أن نسب إليها، وليس من فعل الله، إنّ تقسيم العمل بين الخالق والمخلوق أمر باطل13، وإنّ كل شيء هو فعل الله في الوقت نفسه الذي هو فعل الفاعل والسبب القريب له.
كلّ أثر ينسب فيه إلى مؤثّره في الوقت نفسه إلى الله ويستند إليه، فإذا نسبناه إلى الفاعل والمؤثّر العادي الطبيعي فقد نسبناه إلى فاعله غير القائم بالذات، وإن نسبناه إلى الله فقد نسبناه إلى الفاعل القائم بالذات.
ــــــــــــ
1- أنسنة الحياة في الإسلام، الإنسان والقضاء والقدر، ص 357- 359.
2- أنسنة الحياة في الإسلام، الإنسان والقضاء والقدر، ص 361- 362.
3- أنسنة الحياة في الإسلام، الإنسان والقضاء والقدر، ص 362.
4- سورة الأحزاب، الآية 62.
5- سورة الأنبياء، الآية 105.
6- سورة الأعراف، الآية 128.
7- سورة الرعد، الآية 11.
8- أنسنة الحياة في الإسلام، الإنسان والقضاء والقدر، ص 392- 397.
9- أنسنة الحياة في الإسلام، ص 369 – 379.
10- السيوطي، جلال الدين، الجامع الصغير، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1981م، ج1، ص253.
11- الكافي، ج1، ص183.
12- سورة الأنفال، الآية 44.
13- من المستحسن مراجعة مقال "القرآن ومسألة الحياة" للمؤلّف في النشرة الفصلية، "مكتب تشيع" الصادرة في قم، إيران.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
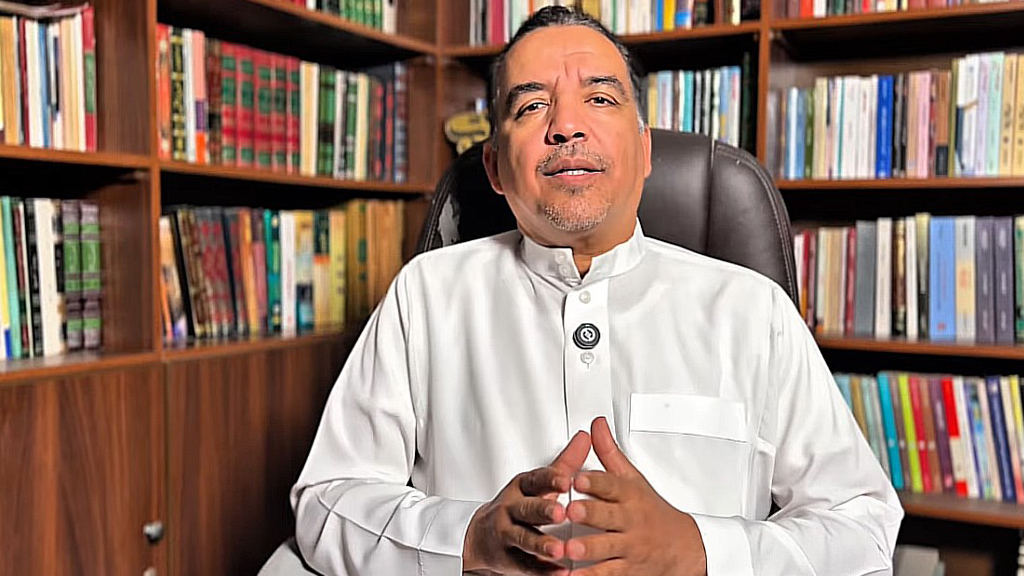
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟









