علمٌ وفكر
الزمن

إن المعرفة الواعية بوجود الزمن لا يملكها إلا الحياة الحيوانية، والإنسان وحده هو الذي يقيسه. والعناصر التي تتكون منها جمع الأشياء المادية يندر أن تتغير على مر الدهور. وقد تتركب العناصر أو قد تفترق، ولكن الزمن إن يكن ضروريًّا لإتمام أي تغيير كيميائي، فهو لا أهمية له بالنسبة للذرات. إن أصبعاً من الديناميت تتحول من مادة صلبة إلى غاز في جزء من خمسة وعشرين ألفًا من الثانية، ولكن الذرات نفسها لا تتغير.
وقد يرتفع جبل ثم يتفتت، ولكن ذرة محبوسة في وسطه تنتظر في قلق ذلك الوقت الذي تتحلل فيه كي تتحرر، وإن تكن إلكتروناتها تعزل فلكها باستمرار.
والكاميرا تلتقط الصورة في جزء من مائة جزء من الثانية فيتدخل اهتزاز قدرة ألف وثمانمئة ميل ليحدث التغيير الكيميائي. وهكذا تسجل الأفلام بالألوان كل جمال المنظر. إذن، إن الذرات تهتز ويعاد تنظيمها ولكنها لا تتغير.
والكائنات الحية تبدو كأنها تقيس الزمن، ولكن الأشياء العاطلة من الحياة تسجله فحسب.
والمياه المنحدرة من الأنهار الجليدية في عصر الثلج قد خلقت طبقات من الصلصال تدل على كل سنة على حدة، وتنبئ بطريقة فجة عن مراتب درجات الحرارة التي كانت سائدة. كذلك الرواسب الكلسية المتدلية من سقوف الكهوف والأخرى التي تعلو أرضها بأشكال مخروطية تؤدي المهمة نفسها من مائة ألف سنة أو تزيد، ولكنها لا تدري ماذا تفعل.
والراديوم والرصاص يغيران نسبهما في الصخور الصلبة، ويدلان على بليون سنة من استقرار الأرض، ناهيك بما قبل ذلك. والزمن بالنسبة لكل الكائنات الحية، هو شيء لا يدرك كنهه، لأن الحياة لها مدادها، والفرد ينتهي وجوده، وأي شيء حي في حالة طبيعية، لا يقيس الزمن في وعي منه، ولكن الزمن يقيس الكائنات الحية، ويسود أوجه نشاطها من ميلادها إلى نهايتها.
وقد اتضح أن هناك شيئًا يسمي الزمن البيولوجي (أي المختص بعلم الأحياء). ويبدو أن الزمن يسير في بطء بالنسبة للأطفال، على حين يسير بسرعة فائقة بالنسبة لكبار السن. وهذه الظاهرة المعروفة قد وجد أنها قائمة على دورة الحياة التي للخلايا، وقد يمكن التعبير عن ذلك بأبسط طريقة بالقول إن خلايا كل مخلوق حي تتطور تطورًا سريعًا عند بدء الحياة، ثم تبطئ عند اقتراب نهايتها. وإذا تكلمنا عن ذلك من الوجهة البيولوجية، قلنا إن كثرة حوادث الخلايا التي تحدث في الطفولة تشعر الطفل يطول الزمن، في حين أن بطء نشاط الخلايا في الكبر، تشعر الإنسان بأن الزمن يمر سريعًا، ويبدو أن دورات الحياة لا علاقة لها بالزمن المطلق الذي نقيسه بحركات الأجرام السماوية.
إن الجرثومة (الميكروب) قد تتوالد في ساعة، والإنسان في عدة سنين، وذبابة (مايو) لا تستطيع قياس الزمن تحت الماء، ولكن كل جيل منها يعيش ساعة حياته السعيدة تحت الشمس. فهل يمكن أن يكون العلماء على صواب، وأننا إذا وصلنا إلى الخلود، سنقيس الزمن بالحوادث، لا بالفلك؟
والأسماك في البحر لها وقتها لوضع بيضاتها، ولكنها إنما تطيع قانوناً للطبيعة ولا تدري لماذا. والبذر والحصاد لهما أوقاتهما، وقد تنضج مساحات من القمح في يوم واحد تقريبًا. والأشجار تنقضي عليها سنوات حتى تحمل الثمر وحلقاتها السنوية تسجل أعمارها.
وقد وجد أن أنواعًا معينة من الصراصير تصدر صريرًا كذا مرة في الدقيقة الواحدة طبقا لدرجة الحرارة، وقد أحصى عدد مرات صريرها فوجد أنها تسجل درجة الحرارة بالضبط مع فارق درجتين. وقد نظم وقت صرصور لمدة ثمانية عشر يومًا فوجد أنه يبدأ أغنية حبه أو فرحه قبل خمس دقائق من الساعة المحددة أصلًا.
وهناك أنواع معينة من البط في قناة بأوربا كانت تاتي كل يوم بانتظام إلى قنطرة في ساعة معينة وتدق جرسًا أعد لها.
وللطيور وقتها المحدد للطيران نحو الجنوب، وكل فرد منها يقرر الانضمام إلى سربه، ثم تهاجر في يوم يكاد يكون معينًا كل سنة. وذباب (مايو) يخرج من البحيرات ليطير طيران العرس، وتسقط ملايين منه في الشوارع في اليوم نفسه.
والجراد البالغ من العمر سبع عشرة سنة في ولاية نيو انجلاند يغادر شقوقه تحت الأرض، حيث عاش في ظلام مع تغيير طفيف في درجة الحرارة، ويظهر بالملايين في شهر مايو في سنته السابعة عشرة. وقد يختلف بعض المتعثر عن رفاقه بالطبع، ولكن الكثرة الساحقة تنضج بعد سنوات الظلام تلك، وتضبط موعد ظهورها باليوم تقريبًا، دون سابقة ترشدها.
و(دودة البوص) تدب بانتظام شديد من كل مكان إلى آخر، ولو استطاعت العد لأمكنها أن تقيس الوقت والمسافة بعدد قفزاتها، ولكنها ليست بحاجة إلى الحساب. فلا تضحكن من قفزتها، لأننا نحن البشر نقيس المسافات بالقدم.
إن كل كائن حي بوجه عام يراعي الزمن ويسجله بالعمل ولكنه لا يبدي دليلًا على توقيت واع منه.
ويبدو أن الفصول، ودرجة الحرارة، والنهار والليل، والمد والجزر، كلها تسطير على تتابع الحياة. وقد أوجد التطور عادات من قياس الوقت بغير وعي، ويبدو أنها تعمل بطريقة ذاتية (أوتوماتيكية) مثل نبض القلب أو الهضم. وكثير من الناس الذين أعتادوا أن يستيقظوا في ساعة معينة، يمكنهم ذلك بدون (منبه)، وبصرف النظر عن الموعد الذي ينامون فيه. ولقد أضاف الإنسان الزمن إلى المادة التي لا زمن لها. والزمن لا يمكن وزنه ولا تحليله.
وبالنسبة إلينا يتعلق الزمن بهذه الكرة الأرضية وحدها، ومقاييسنا للزمن قد لا تكون لها أية علاقة بالكون في مجموعه، ولكن الزمن يملي علينا بواعث غير واعية، بلغت من القوة أنها تتحكم في كل شيء حي.
والإنسان، كحيوان، ليس له شعور خالص بالزمن، ولكنه يستطيع أن يضبط إلى حد ما أثر الزمن في بواعثه. والإنسان الفطري لا يعرف عمره إلا بالمقارنة مع الحوادث، والاعداد بالنسبة لها إنما تعني قليلا أو كثيرًا. والإنسان العصري ينسى أيام ذكرياته السنوية، ولكن زوجته لا تنساها، فهل المرأة أكثر ارتقاء من الرجل؟ أم تراها ترقب التقاويم خفية؟ لا هي ولا هو يستطيعان أن يختارا يوم الرابع والعشرين من مايو بعد سبع عشرة سنة في الظلام، كما يفعل الجراد؟
لقد كان الإنسان الفطري يحب الزمن كإيقاع،كما في القرن الرتيب على طبل. وفد رفعه التوقيت في رقصة، فوق مستوى الغريزة.
والانسجام التام في الأنغام الموسيقية قد قادنا إلى الاستمتاع الرائع بالقطع الموسيقية الفائقة المتحدة الأنغام (هارمون)، وايقاع الاوركسترا، على أن الاهتزازات التي تعتري وحدة النغم في فترات من الوقت، لا تعد موسيقى إلا عند الإنسان وحده، كما يبدو.
وقد ألزمت المدنية الإنسان زيادة الضبط والدقة في قياس الزمن وتسجيله. وأدت الفصول المتعاقبة، والتي يحددها وقت بلوغ الشمس أقصى مداها شمالًا، وأقصاه جنوبي خط الاستواء، وأدت إلى تكوين دوائر درويد وتشييد الأهرام، وغير ذلك من علائم الوقت في نواحي العالم. وكان ظهور الشمس أو ظلها فوق هذه الأشياء عند علامة معينة – كانت في العادة علامة خفية – ينبئ الكاهن كم يومًا يعد حتى يحين وقت الزرع أو يجيء وقت فيضان النيل. أما الآن فإن التقاويم غير البالغة الكمال، تعلق في كل بيت، وبها نميز الأيام.
وفضلاً عن ذلك أصبحنا نسجل الساعات والدقائق والثواني، والجزء من الألف من الثانية. وكلما اقتربنا من ضبط الوقت تماماً، زادت حاجتنا إلى الاستزادة من معرفتنا بالكيمياء، والطبيعة، والمعادن، ودرجة الحرارة، والفلك والرياضة. ونحن نحسب جدول زمن الكواكب والأقمار والمذنبات، ونعتمد على معرفتنا بالوقت في تنبؤنا بحركاتها، وتحديد الساعة والدقيقة لكسوف الشمس وخسوف القمر، في الماضي والحاضر. ونحن نعرف سرعة الضوء بالثانية، ونسجل طبائع الأجرام السماوية، التي تصحح نفسها بالتتابع لدرجة الدقة الأبدية كما يبدو.
إن التطور قد وصل بالكائنات الحية إلى ما يقرب من المواءمة مع البيئة الموجودة، ولكنه من الناحية النظرية على الأقل لا يمكنه أن يمضي أبعد من ذلك، وأن تقدم الإنسان فيما وراء ضروريات الحياة إلى إدراك الوقت ليخرج به عن الحدود التي يبدو أن التطور الطبيعي قد أقامها على حدة.
والإنسان إذ يقترب من الإدراك الكامل للزمن، يقترب في الوقت نفسه من إدراك بعض قوانين الكون الأبدية، ومن معرفة الخالق سبحانه وتعالى.
وما لم توجد حياة عقلية أخرى في بعض نواحي الكون، فإن الإنسان ينفرد وحده بمعرفة الزمن، وسيطرته على الزمن تقترب به من شيء أعظم من المادة.
فمن أين تأتي هذه القفزة العظيمة التي يقفزها الإنسان بعيدا عن الفوضى، وعن جميع تركيبات المادة وعن كل الكائنات الحية الأخرى؟ إنها لابد أن تأتي من شيء أسمى من المصادفة.
*-كريسي موريسون -العلم يدعو للإيمان
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
محمود حيدر
-
 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (لات) في القرآن الكريم
معنى (لات) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أنواع الطوارئ
أنواع الطوارئ
الشيخ مرتضى الباشا
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
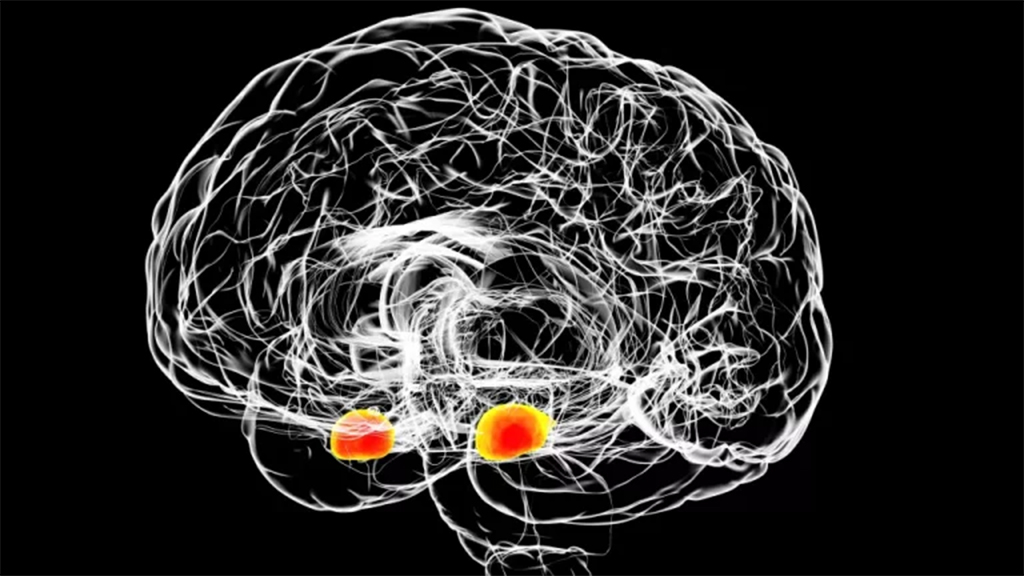
النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
-

خطر الاعتياد على المعصية
-
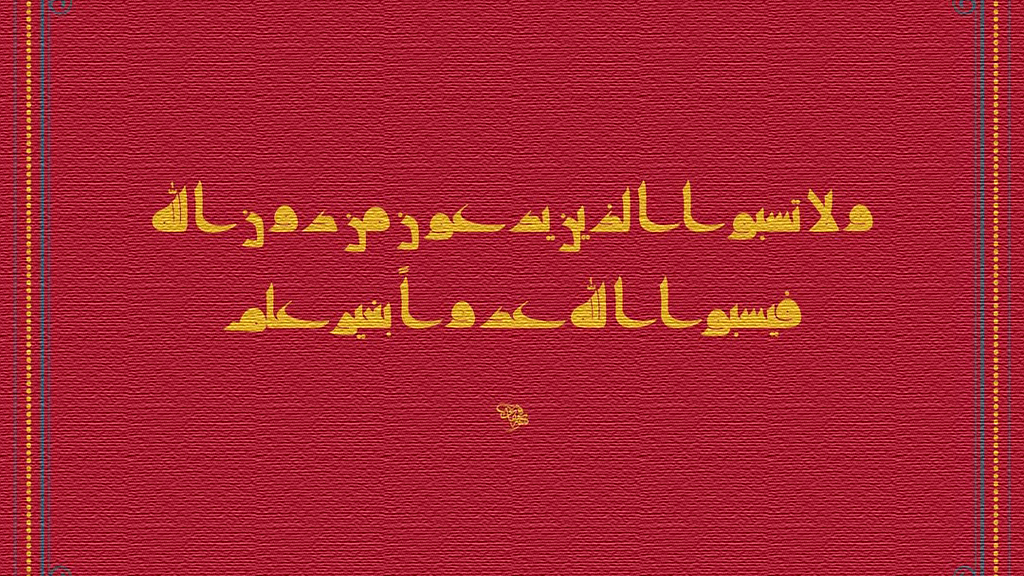
السّبّ المذموم وعواقبه
-

معنى (لات) في القرآن الكريم
-
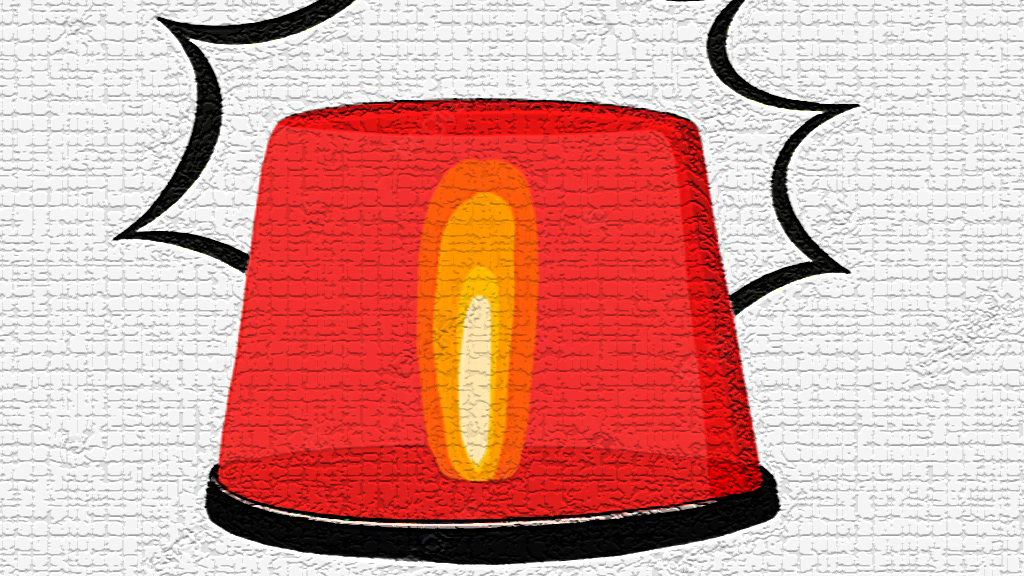
أنواع الطوارئ
-
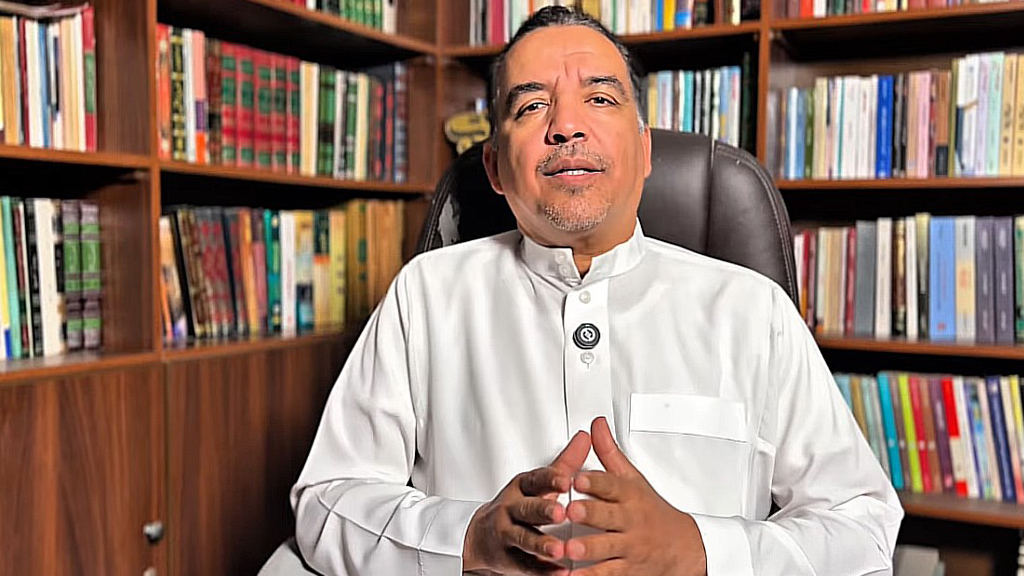
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)









