علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد مهدي شمس الدينعن الكاتب :
الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي. عاد عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.المغيَّبات

الشيخ محمد مهدي شمس الدين
في ناسِ هذا العصر مَن إذا وَقعَت أبصارُهم على هذا العنوان طافَ على ثُغورِهم شبحُ ابتسامة، ولاحَ في أعيُنِهم بريقُ الهُزْء، واتَّسَمت معالمُ وجوهِهم بأمارات الاستنكار. ولِمَ كلّ هذا؟ لأنّنا في هذا العصر الآليّ لا نستطيع -إذا أردنا أنْ نَحترمَ أنفسَنا وعقولَنا- أنْ نؤمنَ بوجودِ إنسانٍ يَعلم الغَيْب، إنسانٍ تَنقَشِعُ من أمام عينَيه حُجُب القرون وتَنطوي المسافات، فيَقرأ المستقبلَ البعيد أو الخاطر المَحجوب كما يَقرأ في كتابٍ مفتوح، ويَعي حوادثَه كأنّها بنتُ السّاعة الّتي هو فيها.
وكلُّ إنسانٍ يقول هذا، فلا بدَّ أن يكون واحداً من اثنين: إمّا مجنوناً، وإمّا جاهلاً بما قُدِّر للعقل الإنسانيّ أنْ يَعيَهُ من نظام الكون. وقد لا يقولون هذا بألسنتِهم، ولكنَّهم يقولونه بوجوههم وأيديهم.
في ناسِ هذا العصر مَن يقولُ هذا.
الإنسان الآلة
وطبيعة الثّقافة المُنحرفة الّتي يلقاها إنسانُ هذا العصر في كلِّ مكان هي الّتي تدفع بهؤلاء إلى أن يَقفوا هذا الموقف، ويتَّجهوا هذا المُتَّجه، في إنكار كلّ دعوى تذهب إلى أنَّ في الإنسان شيئاً آخر وراءَ غُددِه وخلاياه.
الثّقافة الحديثة هي الّتي تفرض على الإنسان مثل هذا الموقف؛ فهذه الثّقافة تَعتبرُ الإنسانَ «آلة»، آلةً دقيقةَ الصُّنع فقط، وهي تَخضع في عمليّاتها لقانونِ الآلة وحده، فلا شيء وراء الغُدد والأعصاب يمكن أن يُعتبَر موجِّهاً للنّشاط الإنسانيّ وباعثاً له.
هذه النّظريّة، نظريّة الإنسان الآلة، وَجَدَت أوَّل تعبيرٍ لها على لسان ديكارت Descartes في فلسفتِه حينما اعتَبَر الإنسانَ آلة، وأنشأ ثنائيّةَ النّفس والجسد، ثمّ وَجَدَت تعبيراً أشدّ صراحة على لسانِ توماس هوبس Thomas Hobbes في فلسفته الميكانيكيّة، والّذي جرَّد الكائنَ الإنسانيَّ من كلِّ قوّةٍ غير مُدركة. وبينما كان ديكارت يعترف بنشاطٍ داخليٍّ سمّاه «الأفكار الباطنيّة»، نرى هوبس قد تنَكَّر لهذا وأرجع مضمون الفكرة إلى الخبرة الحِسِّيّة وحدها.
وبين القرنَين -الثّامن عشر والتّاسع عشر- ساهمت علومٌ أُخَرَ غير الفلسفة في تأكيد هذه النّظريّة. ومهما تكن حظوظُ هذه العلوم من قوَّة التّأثير وضعفها في صياغة هذه النّظرية وإقرارها، فلا مراءَ في أنَّ علمَ النّفس المُعاصِر من أعظم العلوم أثراً في تأكيدها.
فقد بدأ علمُ النّفس عهدَه التّجريبيّ في أواخر القرن التّاسع عشر (1879م) على يد فيلهلم فونت Wilhelm Wund الّذي أسَّس «سيكولوجيا الاستبطان»، والذي حاوَلَت مدرستُه إحلال كلمة «شعور» المُرادِفة للحسّ في العمليّات النّفسيّة محلّ كلمة «روح»، الّتي هي إرثٌ دينيٌّ وغيرُ مُدرَك. وبعدها تتابَعَت المدارسُ النّفسيّة: السّلوكيّة، التّحليل النّفسيّ، علم النّفس التّحليليّ، علم النّفس الفرديّ، الجشطلت Gestalt، ... وكلُّها تَتنكَّر للرُّوح، ولأيِّ قوّةٍ غيبيّةٍ أخرى، وتردُّ السّلوكَ الإنسانيَّ إلى إفرازاتِ الغدد، وعمليّات الجهازَين الحشويّ والعصبيّ، واللّاوعي، والغرائز.
وقد بَلغَ التَّعصُّبُ لهذه العلوم ذروتَه في القرن التّاسع عشر، ففيه استَحوَذ الغرورُ على العلماء المُحدَثين، وظنُّوا أنّهم قد تمكّنوا من اكتشاف جميع القوانين الميكانيكيّة الّتي تُسيِّر الكون، وذهبوا إلى أنّ كلّ دعوى يُراد منها إثبات أنّ ثمّة قوى غير مُدرَكة تُهيمن علينا، وتتحكَّم فينا، هي دعوى خرافة ذَهب زَمَنُها، خرافة صنَعَها الإنسانُ يوم كان أفُقُ تفكيره غائماً وضبابيّاً إلى حدٍّ يُثير الإشفاق. ولعلَّ من الخير لنا أن نتبيَّن الأساس الّذي يقومُ عليه إنكارُ الرُّوح في الثّقافة الحديثة.
هَوَس التّجريب
الميزةُ الكبرى للحضارة الحديثة الّتي هي مُعطًى للثّقافة الحديثة أنّها حضارة التّجريب، فكلُّ شيءٍ يجب أن يخضع للتّجربة المعمليّة ليَصحّ أن يؤمن به، فإذا لم يَخضع للتّجربة لم يَصحّ أن يؤمن به، كما لو خضع لها وكَشَفَت زَيْفَه. وقد عاد هذا الاتِّجاه التّجريبيّ على الحضارة بما لا يُتصوَّر مدى خصْبه من النّتائج، ولكنّ الخطأ وَقع حين داخَلت العلمَ العزّةُ بنفسِه، فادَّعى أنَّ بوسعه أن يُدخِلَ الإنسانَ إلى المعمل ويجعلَه موضوعاً للتّجريب. وليس الإنسان موضوع التّجريب هنا هو هذه الكتلة من اللّحم والعظم المشدودة إلى بعضها بجهازٍ من العصب، وإنّما هو النّفس الإنسانيّة. فقد ادَّعى العلمُ الحديث أنَّ بإمكانه أن يفحص صحّة الدّعوى الكبرى القائلة بوجود الرُّوح والنّفس، لِيُثبتَ صحَّتها أو بطلانها، عن طريق التّجربة المعمليّة. وقد اضطلع بهذه المهمّة عِلْمان تجريبيّان، هما الفيزيولوجيا والسّيكولوجيا، هذان العِلْمان أدخلا الإنسانَ إلى المعمل لِيريا أحقٌّ ما يقال من أنّ وراء هذه التّشكيلة الدّقيقة من الغدد والخلايا والأجهزة العصبيّة والحشويّة، شيئاً يُسمّى نفساً وروحاً، أو أنّ هذه خرافة من جملة الخرافات؟
ولقد كانت النّتيجة بطبيعة الحال -وهذا شيءٌ كان من الممكن أن نجزم به سلفاً- هي أنّ لا روحَ ولا نَفْسَ ولا شيءَ وراء جسم الإنسان.
وأُذيعت هذه النّتائج على أنّها «حقائق» أثبتَها العلمُ التّجريبيّ وآمنَ بها النّاس، لأنّ العلمَ التّجريبيّ والتّطبيقيّ، الّذي أَخضعَ الأمراضَ لِسلطانِه، وكَشَفَ عِلَلَها ووَضَع أدويتَها، والّذي لا يزال يُفاجئنا كلّ يوم بجديدٍ، لا يمكن أن يستعصي عليه هذا الموضوع.
وعلى هذا النّحو المسرحيّ حُلَّت المشكلة -أعقَد وأعضَل مشكلة واجَهَت العقل الإنسانيّ منذ القِدَم- واعتُبِرَ أمرُ الرّوح الإنسانيّة قد انقضى.
ونقولُ كلمتَنا في المسألة
نحن نؤمنُ بالعلم قوّةً في يد الإنسان، وسبيلاً إلى إنماء الحياة الإنسانيّة وإغنائها. ونحن نؤمن بالتّجربة منهجاً للبحث أفضل من جميع المناهج الأُخَرَ. ولكنّنا نؤمن بالعلم إلى حدٍّ محدودٍ، ونؤمن بالتّجربة منهجاً للبحث في ما هو قابل للتّجربة. إنَّ الميدان الأصيل للعلم التّجريبيّ هو الموضوع القابل لأن يقع تحت أدوات التّجريب: يد الإنسان وعينه وحاسّة الشّمّ فيه وموازين الحرارة والضّغط والمشارط وأنابيب الاختبار وما إليها. فكلّ موضوع خارجيّ يصلح أن يقع تحت أداة التّجريب يصلح أن يكون ميداناً للعلم الّذي يَستخدم هذه الأداة، ويمكن أن يُتَوصَّل فيه بواسطتها إلى نتائج معتمدة نسبيّاً.
ونتساءل: هل الرُّوح من هذا القبيل؟ وهل يمكن أن تقع موضوعاً صالحاً لأداة التّجربة المعمليّة؟ اللّهمّ لا! فالباحثون عنها لا يجرأون على القول بأنّها شيءٌ ذو كيان يمكن أن يَصِل إليه الحسّ أو ما يصطنعه الإنسان من أدوات.
ونتساءل كرّةً أخرى: إذا كانت الرُّوح شيئاً لا يمكن أن يقع موضوعاً لأداة التّجربة، فكيف يصحّ أن تُتَّخذ هذه الأداة سبيلاً إلى البتِّ في أمرها؟
نعم، إنّ «أساطين» السّيكولوجيا -وخاصّة السُّلوكيُّون- والفيزيولوجيا يقولون لنا إنّ باستطاعتهم أن «يختبروا» وجود الرُّوح عن طريق مراقبة الانفعالات الّتي تطرأ على مختلف أجهزة الإنسان، بفعل السّوائل الكيماويّة المختلفة.
ونتساءل ثالثة: هل عواطف الإنسان ومطامِحُه وأفكاره تتجمَّع كلّها في بضعةٍ من عَصَب، تنفعلُ بالسّوائل الكيمائيّة الّتي تُراق عليها لِنحكم بأنّ لا روحَ ولا شيء سوى هذه البضعة الخاضعة للفعل الكيماويّ؟ وهل يُمكن أن يُعتَمد على نتيجةٍ هذه مقدّماتها في تقرير موقفِنا من الحياة والكون، وفي تحديد مصيرنا الّذي نُريد؟ إنّ العلم التّجريبيّ نفسَه يأبَى علينا الأخذ بنتيجةٍ هذه مقدّماتها، فنتيجة كهذه لا يمكن أن تُسمّى نتيجةً علميّةً بِحال.
إذاً، فلا دليل يمكن أن ينهض على أنّ الرّوح الإنسانيّة لا واقع لها، وأكثر من دليل يدلُّ على أنّ الرّوح الإنسانيّة، أعظمُ واقعيّةً من بعض الأشياء الّتي نحسبها واقعيّة.
ما هو الواقعيّ؟ أَهُوَ الشّيء الّذي تُدركهُ حواسُّنا؟ لا، لقد أصبحَ هذا التّفسير السّاذج «للواقعيّ» شيئاً بعيداً عن المفهوم العلميّ الحديث، ولو شئنا أن نفسِّر الواقعيّ بهذا التّفسير لَوَجَب علينا أن نَكفُر بأَشْيَع الحقائق في حياتنا الحاضرة، وأعني بها الكهرباء. فالكهرباء -كما يقول يعقوب فام في كتابه البراجماتزم [أي الذّرائعيّة]: «لا صورة ذهنيّة لها عندنا، ولا شكل نستطيع أن نراه بِعَين العقل أو نتخيّله، ومع ذلك فمدلوله له وجودٌ ذاتيّ مستقلّ في هذا النّظام الموضوعيّ للكون. وبعبارة أخرى: الكهرباء موجودٌ حقيقيٌّ، وإنْ كان الذّهن لا يَستطيع أن يتخيّلها، لأنّنا نشاهد آثارها وعملها في الحياة اليوميّة».
إذاً، فليس الواقع هو ما نحسّه، وإنّما الواقع هو ما يعمل على صياغة حياتنا بآثاره وإنْ لم يَبلغ علمُنا مدى كُنْهه. وإذا كان هذا هو الواقع فما الّذي يمنع أن تكون الرُّوح حقيقةً من الحقائق الجمّة الّتي تصنَعُ حياتَنا بآثارها؟ إنّ جهلنا بحقيقتها لا يبرِّر نكران وجودها. وقد عرفتَ أنَّ الّذين يُنكرونها يبنون نكرانَهم على ما لا يَصلح أن يكون أساساً للموقف العقليّ الّذي التَزَموه تجاه الرُّوح، فالأداة التي اصطَنَعوها لمعرفة الرُّوح قاصرة عن أن تُنيلَهُم ما أرادوا.
لقد حَدَسَ القدماء فلم يَهدِهم حَدْسُهم إلى شيءٍ، ولقد جرَّب المُحدثون فلم تَهْدِهِم تجربتُهم إلى شيءٍ، ويَقف الإنسانُ مكتوف اليدَين أمام غياهِب الأسرار، ويُردِّد حُكمَ القرآن في اعترافٍ بالعجز: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء:85.
خُلاصةُ القول
ونَخلص من هذا كلّه إلى القول بأنَّ مُنكِري «المُغيَّبات» ليسوا سوى طائفة من النّاس تنظر إلى الإنسانِ من أحدِ جوانبه، وتَبني أحكامَها على ما ترى غير حاسبة أنّ ثمّة غير هذا الجانب، وأنّ حكمَها على الإنسان قبل الإحاطة به من أقطاره -في الحدود الّتي تَبلغها المعرفة- ضَرْبٌ من الخَبْطِ العشوائيّ الّذي لا يليق بمَن يدَّعي العلمَ ويَستهديه في ما يفعل أو يقول، وهؤلاء أشبه بمَن يَحكم بأنَّ لون الهرم أحمر لمجرَّد أنّه رأى ضلعاً واحداً من أضلاعه بهذا اللّون، قبل أن يرى بقيَّة الأضلاع.
وحيث قد عرَفنا أنَّ في الإنسان قوًى وراء جهازه العصبيّ والحشويّ، ووراء غدده وخلاياه، لا نُدركها بما لدينا من وسائل المعرفة، فلا مبرِّر لإنكار «إمكان» أن يكون لدى إنسانٍ من النّاس، بسببِ ما يَتمتَّع به من سُموٍّ روحيٍّ ونقاءٍ داخليٍّ -وهذه صفات قابلة للتَّفاوت- قدرة على معرفة ما يخبِّئُه الغد وتضطمّ عليه أحشاءُ المستقبل.
وإذا كان «يُمكن» أن يوجد إنسانٌ كهذا، فلنقُم بنقلةٍ تُثبتُ أنّ إنساناً كهذا «موجودٌ بالفعل»...
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
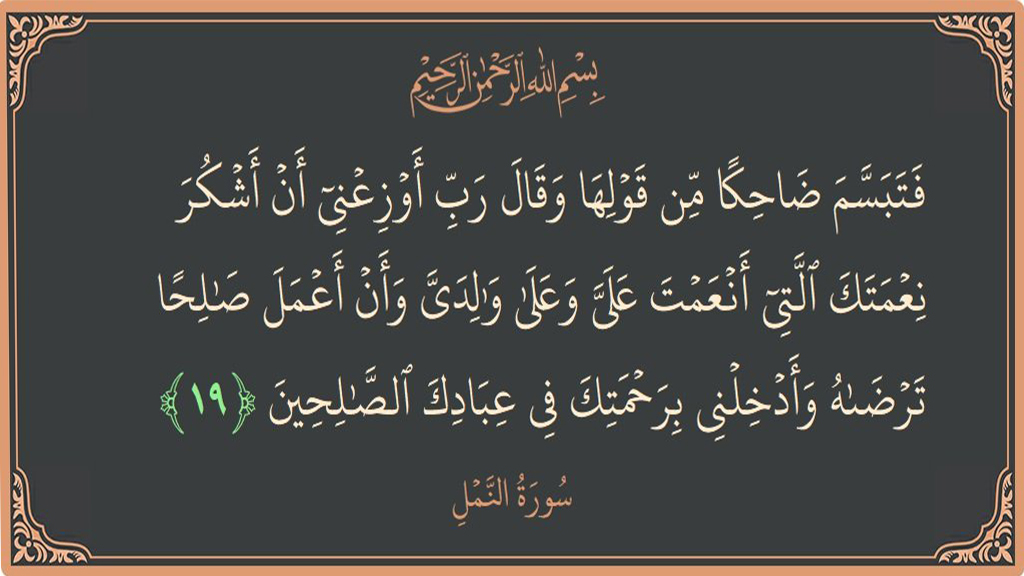
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-

معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
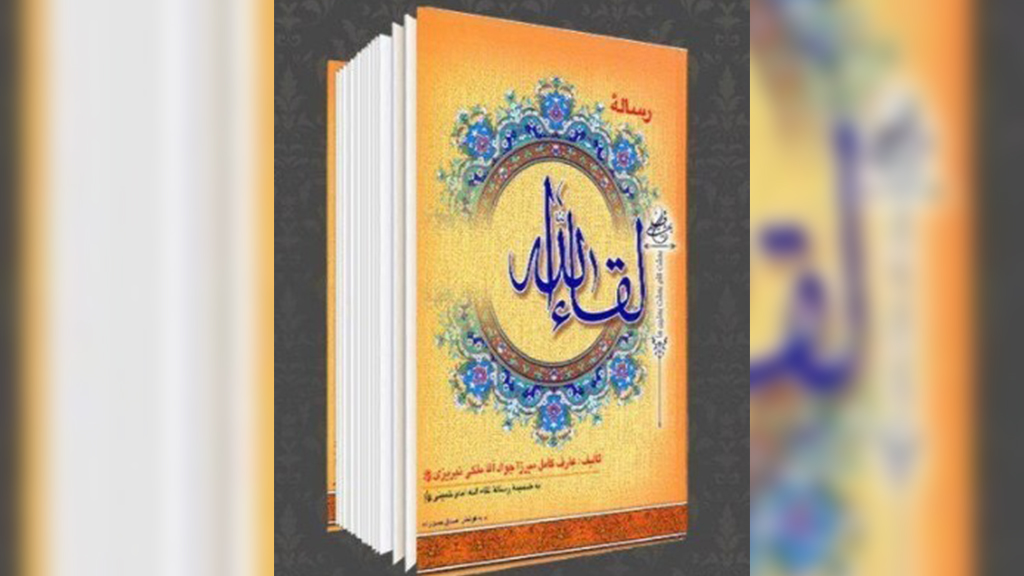
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
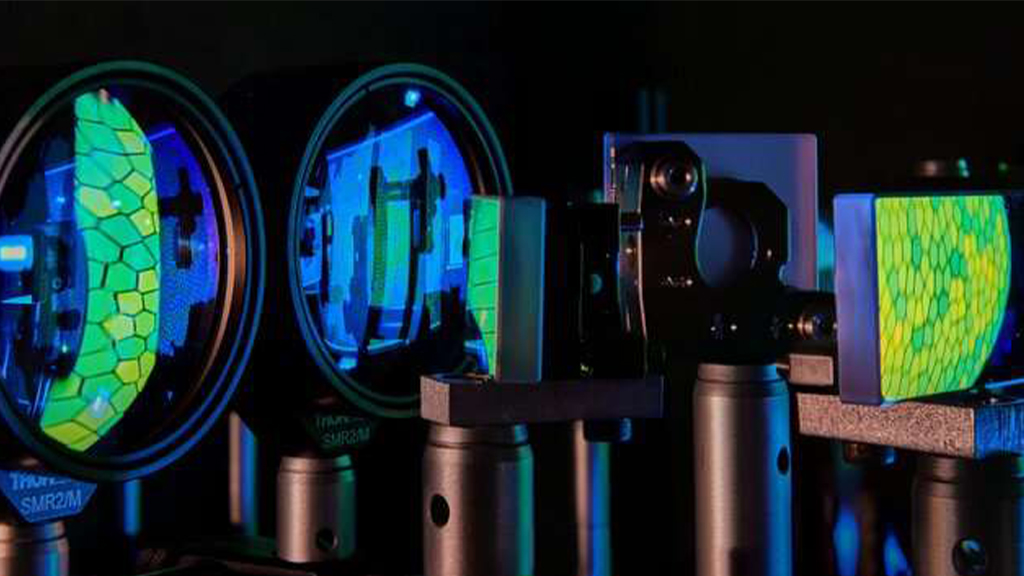
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










