علمٌ وفكر
الأصالة أو ذاتيّة الإسلام (2)

السيّد موسى الصّدر
الملائكة:
وهي فكرة قديمة قِدَم الأديان، لكنها بصورة عامّة، في الإسلام وفي الأديان كلّها، تختلف عمّا ورد في آراء الفلاسفة باسم أرباب الأنواع، وباسم المثل الأفلاطونية أو الأنوار الأسفهبدية.
نوقش موضوع الملائكة في الإسلام في كتب الباحثين من الشرق والغرب مناقشات مفصّلة، وساعدهم على هذه المناقشات كلمات علماء الكلام والسّير من الأساطير والتخرّصات حول الملائكة وحول المقرّبين منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل بالذات؛ ورأى بعض المستشرقين الكبار خلال مقارناتهم، أن هذه الفكرة في الإسلام دخيلة، واعتمدوا لذلك صيغ هذه الأسماء وغير ذلك.
ونحن حينما نحاول البحث في ذاتية الفكرة الإسلامية عن الملائكة، نعيد إلى ذاكرة المستمعين ما ورد في أول المحاضرة حول تصديق الإسلام بالأديان السماوية السابقة وبما جاء فيها، ثم نقول:
إنّ ما ورد في كلمات علماء المسلمين في الكلام والسّيرة والفقه أيضًا، كلّه يحمّل قائليها المسؤوليّات. أما مصادر الشريعة الإسلاميّة، فخالية من هذه التفاصيل، ولا تهتمّ إلّا بالإيمان بالملائكة وبالجانب التربوي منه الّذي سوف نبحث فيه؛ أمّا حقيقة الملائكة وتفاصيلها وتجرّدها وماديتها، فلا تجدها في المصادر الأصليّة. ولهذا، فالاعتقاد بهذه التفاصيل وبغيرها، لا يعدّ من الإيمان الإسلامي الذي يدين به المسلم، بل كلّ ما يجب أن يؤمن به المسلم، هو وجود ملائكة الله فقط، كما يجب أن يؤمن بالله وبكتبه وبرسله، وأنّ الله جعل من الملائكة رسلًا، وأنهم يسبّحون بحمد ربهم ويقدّسونه في الليل والنهار ﴿لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾[التّحريم: 6]. يؤمن المسلم بهذا كلّه، لأنّ القرآن نصّ عليه وأخبر عنه. أمّا الجانب العلمي في فكرة الملائكة، فلا أعرف أيّ مبدأ أو دين غير الإسلام تعرض له، ماعدا الذي ورد في إنجيل متّى في الإصحاح الأوّل، وفي أعمال الرسل بصورة موجزة.
هذا الجانب تشير إليه بعض الآيات القرآنية التي تعبِّر عن الملائكة بـ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً﴾[النازعات: 5]، والتي تسند كثيرًا من الأحداث الكبار في الدنيا والآخرة إلى الملائكة، ومن هذه الآيات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾[فصّلت: 30-31]
تتلخّص الفكرة في أنّ الملائكة هم الذين يدبّرون القوى الكونية الظاهرة والخفية بأمر من الله، وأنهم يطيعون الله ولا يتخلفون عن أمره. فمن يسلك سبيل الحقّ، تواكبه الملائكة قائلين له ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾. فالسالك ليس منفردًا في طريق الحقّ، بل القوى الكونيّة التي هي طوع يد الملائكة، تسانده وتقوّيه وترفع وحشته.
إنّ المؤمن السالك في سبيل الحقّ والعدل، لا يشعر بالوحدة والوحشة، بل يشعر بمواكبة الكون وتأييده لقواه، فيطمئنّ بأنّه المنتصر، حيث ﴿فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾[التحريم: 4].
وهذا الشعور هو ضروري بالنّسبة إلى حملة الرسالات وأصحاب المبادئ الذين يحاولون التأسيس وإعادة بناء الإنسان ومجتمعه.
الشيطان:
والحديث عن الشيطان، مَلَك الشّرور، يرتبط بالحديث عن الملائكة، حيث إنّه كان مخلوقًا معهم، حسب وصف القرآن، قبل خلق آدم، مطيعًا ساجدًا مسبّحًا لله، ثم عصاه حينما أمره بالسجود لآدم، فرفض استكبارًا واعتزازًا بعنصره، ثم أُمْهِلَ إلى يوم الدّين، وهو يقود حملة الإغواء وتضليل البشر بالتعاون مع جنوده قوى الشرّ.
ويختلف هذا التفسير اختلافًا كليًّا عن معنى أهريمان عند الفرس القدامى، حيث إنه خالق الشرور، وهو في صراع دائم على رأيهم، مع آهورمزدا إله الخير.
يختلف تفسير الشيطان المخلوق عن أهريمان الخلق تمامًا مبدأً وأثرًا؛ حيث إنّ مشكلة الصراع النفسي التي يعانيها الإنسان المؤمن بإلهي الخير والشرّ هي مشكلة كبيرة، حيث إنه يرى الكون كلّه والمجتمع والإنسان كلّ منهما يتبعض. وهذا الإنسان الذي يشعر بالازدواجية في وجوده وفي مجتمعه وفي مبدئه ومصيره، ويعيش في صراع أبديّ ذاتًا وسلوكًا وزمانًا، لهو إنسان محطَّم ضعيف حقًّا.
ويختلف معنى الشيطان في الإسلام عن معنى ملاك جهنّم ورئيس هذا العالم وإله الدنيا في سائر التفسيرات. وأخيرًا، يتفاوت مفهومنا عن الشيطان عن رأي البعض من أنّه الموحّد الأكبر الذي امتنع عن السجود لغير الله ،وصار عندهم رأس القدّيسين وقائد الموحّدين.
أما أصالة الفكر الديني حول الشّيطان، فإنها تبلغ القمة في القرآن من الناحية التربويّة، فإن الشيطان اسمه الأصلي إبليس الذي كان من المقربين عند الله، فطُرِدَ من مقام القرب لأجل معصية صدرت عنه استكبارًا فسُمّي الشيطان. فانحرافه وطرده وشقاؤه لعصيانه أوامر ربّه، لا لذاتية الشقاء فيه، ولا لعفوية الطرد وإبعاده عن مقام القرب.
ومن جهة ثانية، فإن الشيطان كذات يمثّل وحدة قوى الشرّ وتكتّلها أمام قوى الخير، في صراع أزليّ أبديّ بين الحقّ والباطل، مهما كان نوعهما أو وصفهما أو قدرهما.
وأهمّ النواحي التربوية في إعطاء فكرة الشيطان واستلامه مهمّة الإغواء والتضليل مع جنوده التي منها النفس الأمّارة بالسوء، أهمّ هذه النواحي، هي تكريس اختيار الإنسان، والتأكيد أنه مخيَّر بين الخير والشرّ، لا مسيَّر لا يهتدي إلّا إلى دوره الكوني المقرَّر له.
وقد أوضح القرآن الكريم هذه الناحية في لوحة تاريخيّة رائعة، أوضح فيها كيفية الخلق في سورة البقرة الآيات 30 إلى 38، وبموجب هذه الآيات، أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة، لا آلة مسيَّرة ولا شبه آلة، بل أراد خلق موجود يتصرّف حسب إرادته، ويمارس حريته، حيث إنّ حرية التصرّف لا تتم إلّا مع وجود نزعتي الخير والشرّ في الإنسان، وإلّا مع وجود طريقي الخير والشرّ في الأرض.
خلق الله الإنسان بهذه الخصائص، ثمّ علّمه الأسماء، وجعله مستعدًا لمعرفة حقائق الكون والقوى الكونية، متمكّنًا من الإحاطة بها عن طريق معرفتها، ثمّ أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فخضعوا وسجدوا له بأمر الله، وخضوعهم للإنسان يستلزم مطاوعة القوى الكونيّة التي هي بيد الملائكة له، فأصبح آدم سيّد الكون، خليفة الله في الأرض، وامتنع إبليس من السجود لآدم، وطُرِدَ من مقام المقرَّبين، وأُمْهِلَ حسب طلبه إلى يوم القيامة، وبدأ هو وجنوده بإغواء البشر، وأصبحوا من الدعاة إلى طريق الشرّ، يساندون النزعة الشرّيرة في الإنسان.
فالكون ميدان للسّير في الخطّ المستقيم وللانحراف والضّلال. والإنسان أمام مفترق الطريقين، يسمع صوت الله بلسان عقله وبلسان ضميره وبلسان أنبياء الله وبالطّرق الأخرى للهداية، وصوت الشيطان بلسان نفسه الأمّارة بالسوء، وبلسان عناصر السوء والفساد من البشر وغيرهم. يستمع الإنسان في حياته إلى النّداءَين، فيجيب بملء إرادته لنداء الخير أو لنداء الشرّ. وهكذا نرى أنّ الشيطان في مفهومه الإسلاميّ، يقوم بدور بارز في تعميق التخير الإنساني ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾[الأنفال: 42].
النبي:
والنبي عبد من عباد الله، له ما لهم من الحالات والرغبات، ويشعر بما يشعرون من الصراع النفسي بين الخير والشرّ، لكنّه يتبع في القول والفعل ومعاشرة الناس ما يُوحى إليه، وإن لم يكن مطابقًا لمراضيهم، لا ينحرف ولا ينطق عن الهوى، ولا يساير ولا يجامل رغبات النّاس، ولا يزن الأمور بالموازين الشايعة.
إنّ النبيّ عبد من عباد الله، لا ملاك ولا نصف إله، يعيش ويهرم ويموت ويحشر ويحاسب يوم القيامة، وبذلك يصبح قدوةً صالحة للناس، إمامًا لهم، سندًا حيًّا لواقعية رسالته، مثبتًا إمكانيّة تطبيق تعاليمه الدينيّة.
وقد ورد في القرآن الكريم في سيرة الأنبياء عامّة، وفي سيرة النبيّ محمّد خاصّة، دلائل كثيرة على ذلك، حيث وجّه إليهم النقد والتّشجيع والتأييد والتهديد والنصيحة والعتاب على بعض التصرّفات. والنبي مع ذلك، يتمتع بعناية الله ووحيه وتسديده، وبذلك يصبح قوله وعمله ورضاه عن عمل الآخرين هي سيرة وأسوة حسنة للأمّة.
فالصفة المميزة للنبيّ في رأي الإسلام، كونه عبدًا ورسولًا في الوقت نفسه، وبذلك تبدو بوضوح أصالة الفكرة، وعدم انفعالها بالعاطفة الطبقيّة، كما يقول "برتراند راسل"، حيث يتّهم الإسلام بذلك، نظرًا إلى موقفه من السيد المسيح، وتأكيده أنّه ما قُتِل وما صُلِب. إنّ الإسلام المنكر لصلب المسيح يؤكّد أنّ كثيرًا من الأنبياء قُتِلوا في سبيل رسالتهم ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾[البقرة: 87].
فلا ينكر صلب المسيح لعاطفة الزّمالة، ولا للتأثر بآراء النوستيسيزم، بدليل موقفه أيضًا من المسيح بالذات، بل للرّسالة مقام إنساني كبير، لا ينزع صفات البشر عن حاملها، وهو مع ذلك مقام الاتصال بالله، ونقل تعاليمه بكلّ أمانة ودون خطأ وتحريف.
المعاد:
إنّ المعاد من المبادئ العامة لجميع الأديان، ولأكثر المدارس الفلسفية، ولكنه عند الإسلام، يتميّز بخصائص مهمة تجعله فكرة ذات أصالة.
هذه الميزات هي أولًا أن الجزاء في يوم المعاد بالأفعال نفسها الصادرة عن الإنسان: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً﴾[آل عمران: 30]. ويختلف هذا التفسير عن المجازاة في الحقوق الجزائيّة، وعن تفاسير المعاد في غير الإسلام، حيث إن الجزاء نوع من ردّ الفعل الحسن أو القبيح للانتقام أو للتأديب أو الإصلاح. فالعمل يختلف عن الجزاء عادة، ولكن الجزاء في المعاد الإسلامي هو الأعمال نفسها التي تتمثل بالصورة المتناسبة لعالم الخلود. والمعاد، من جهة ثانية، يوم بروز النتائج ووقت اكتشاف حقيقة الأعمال، وإلّا فالجزاء حسب تحديد القرآن، هو مقترن بالعمل وقت صدوره، ولكنّه خفيّ عن الأبصار، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾[ق: 20]. ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾[ق: 22].
ومن جهة ثالثة، فالمعاد عند الإسلام هو تمثّل الإنسان بجسمه وروحه للحساب، وليتلقى حصاد عمره. أما النقاش المعروف بين فلاسفة الإسلام الملتزمين، إنما هو حول تحديد معنى الجسم الذي يحشر، لا في أصل المعاد الجسماني.
والباحث يعرف بعد هذه الملاحظات مدى الفرق الواضح بين المعاد الإسلامي وبين معنى السّماء، أو معنى عودة الروح عند المصريّين القدامى، أو الوثنيّين في الجزيرة، أو انتصار النّور على الظلمة عند المجوس.
وأخيرًا، تبلغ الذاتيّة في الإسلام قمّتها في قسم الأمثال وقسم التّاريخ، حيث إنّنا نعرف اليوم مدى ثقافة الإنسان في أقطار العالم، ومقدار معرفته في العلوم والتّاريخ حال ظهور النبي محمد وحال نزول القرآن. إنّنا نعرف ذلك، ولكنّنا نجد أنّ القرآن لم يتأثر أصلًا بالآراء العلميّة السائدة في عصره، وبالمعلومات التاريخية المعروفة عند البشر في ذلك الوقت.
فالآيات الواردة في الاستشهاد بحركات الشّمس والقمر والنجوم والأرض وغيرها، لم تتأثر إطلاقًا بالهيئة البطليموسيّة وآرائها.
والآيات التي تشير إلى مبدأ الخلق، وتكوين الأرض، واتّساع الكون وغيرها، تكاد أن تنطبق على أحدث النظريات العلمية من دون تأثر بثقافة عصر نزول القرآن.
والآيات التي تنقل تاريخ الفراعنة، وخصوصاً فيما يعود إلى فرعون يوسف وتسميته بالعزيز، وفيما يعود إلى غرق فرعون المعاصر للنبيّ موسى ونجاته ببدنه، هذه الآيات لم تتأثّر أصلًا بالروايات الشائعة في عصر ظهور النبيّ محمّد، بل إن بعض هذه المعلومات كانت خفيّة عن معرفة البشر إلى زمن اكتشاف تاريخ الفراعنة بواسطة شامبليون.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-
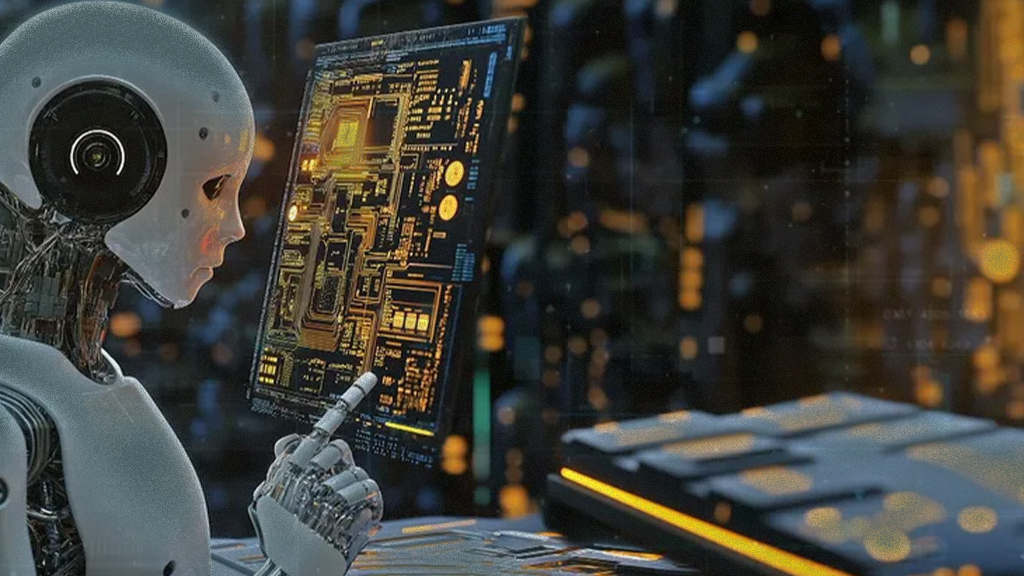
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
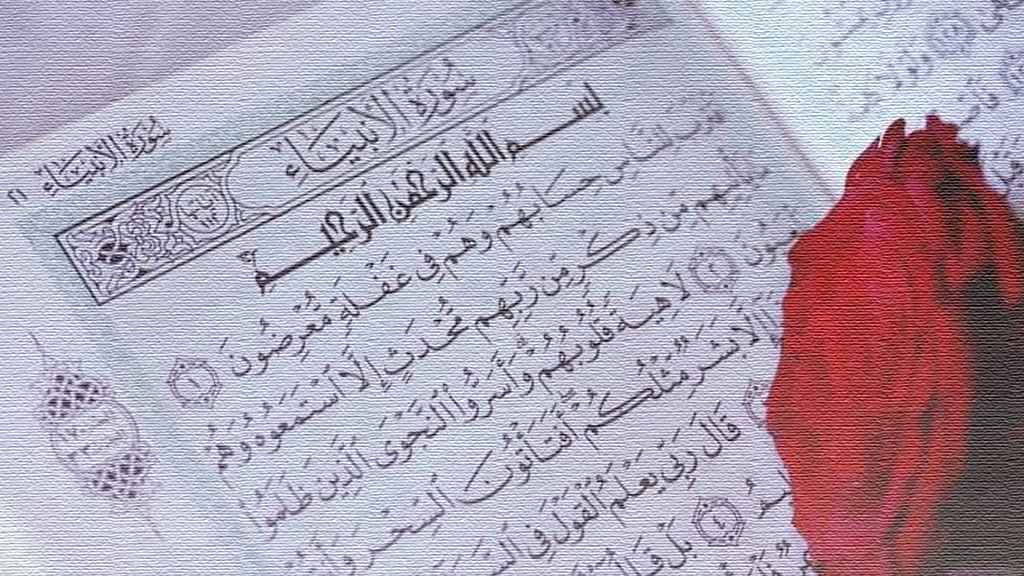
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
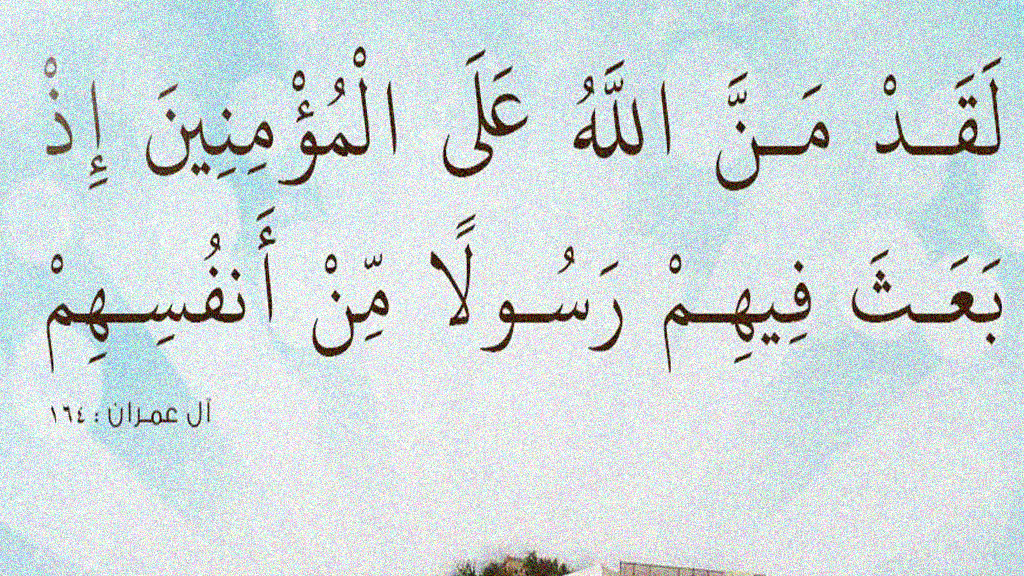
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين









