علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النّظريّات الأخلاقيّة (4)

نظرية الوجدان (2)
الوجدان والسعادة
من المسائل الّتي طُرِحَت هنا، مسألة العلاقة بين الكمال والسعادة، وأنّه هل الكمال غير السعادة أو هو عينُها وذاتها؟ لهذا السؤال جوابان:
الأوّل: ما ذكره «كانط» من أنَّ الكمال غير السعادة، وأنّ الوجدان إنّما يدعو الإنسان للكمال، لا للسعادة، وهو يدَّعي أنّ الشيء الجميل الوحيد في هذا العالَم هو «إرادة الخير»، وهي الإرادة الّتي تنقاد انقياداً مطلقاً للوجدان، وهذا هو الكمال المطلوب، سواء قدَّم لنا هذا الكمال سعادةً أم ألَماً؛ لأنّ المهمّ ليس السعادة، بل الواجب. فالواجدان إذاً، لا يسعى خلف السعادة ولا يعنيه أمرها، فالأخلاق عنده فوق السعادة؛ لأنّ السعادة تعني اللذَّة. إن كان ليس كلّ لذّة هي سعادة، فاللذّة المعقّبة بالألم ليست سعادةً، بل السعادة الخالصة تلك الّتي لا يشوبها شيءٌ من الآلام الروحيّة والجسميّة والدنيويّة والأخرويّة، ويقابلها «الشقاء».
من هنا، ينبغي ملاحظة مجموع اللذائذ ومجموع الآلام؛ فما كان منها أشدّ تحقيقاً للّذّة وخلوصاً من شوائب الآلام والشقاء، فهو السعادة؛ لأنّ «السعادة» تعني اللذّة الخالصة. ولكن -يقول «كانط»- «الوجدان» لا يبحث عن هذه السعادة، بل هو يبحث عن «الكمال»، وإن جرَّ ألَماً وشقاءً؛ لأنّه لا يمكن عبور دائرة الحيوانيّة والوصول إلى أُفُق الملَكوت، إلَّا بذلك، فهو يفكّك بينهما، وهذا الرأي هو السائد بين مفكِّري الغرب إلى الآن.
الثاني: ما ذكره الفلاسفة والحكماء المسلمون في أبحاثهم الأخلاقيّة، منهم «ابن سينا» في كتابه «الإشارات»، و«الفارابيّ» في كتابه «تحصيل السعادة» وغيرهما، وحاصل ما ذكروه هو:
أنّ «السعادة» هي غاية كلّ إنسان، والسّاعي إليها يسعى إلى كمالٍ ما؛ لأنَّ كلّ سعادة هي كمال وخير، والكمال سعادة، خلافاً لِما يعتقده «كانط» من تغايُرهما وانفصالهما، وإنِ اعترف بإشكاليّة ذلك من حيث صعوبة تلك الأخلاق الّتي تضع «الواجب» فوق «الجمال»، و«الكمال» فوق «السعادة».
أمّا الفلاسفة المسلمون، فيرون مفهوم «السعادة» ركناً أخلاقيّاً لا يمكن إغفاله، ورقماً مهمّاً لا يمكن إسقاطه من المعادلة، كما صرَّح بذلك المعلّم الثاني «الفارابيّ» (في كتابه تحصيل السعادة)، وكذلك صاحب كتاب «جامع السعادات» وصاحب كتاب «معراج السعادة» .
ونحن هنا، نسأل «كانط»: هل الإنسان الواصل إلى الملَكوت بعد اجتيازه مرتبة الحيوانيّة، سعيدٌ أم شقيٌّ؟ والجواب جزماً، هو أنّه سعيدٌ. وهذا يدلّ على عدم انفكاك «الكمال» عن «السعادة». والسعادة المنفكّة عنه الّتي ذكرها «كانط»، إنّما هي السعادة واللذّة المادّيّة الدنيويّة، وإلّا فالسعادة الحقيقيّة المطلقة لا يمكن فصلها عن الكمال، وحتّى «كانط» نفسه لم يستطع فصلها عنه. ونحن مهما فسَّرنا كلامه بشكل ما، فلا مناصّ من القول بأنّ مراده من «السعادة» هو ما يُطلِق عليه قدماء فلاسفتنا «السعادة الحسيّة» في قِبال «السعادة الروحيّة غير الحسيّة». لكن حيث إنّ «كانط» لا يقيم وزناً للعقل النظريّ، ولم يعتمد على ما نطلق عليه اسم «الفلسفة الإلهيّة»، فقد اتّخذ من «الوجدان الأخلاقيّ» محوراً ومنطلقاً لفلسفته، وهو يعتقد بأنّ مفاتيح المسائل المغلقة كلّها بِيَد هذا «الوجدان الأخلاقيّ»، من قبيل مسألة الدين والحرّيّة والاختيار وخلود النفس والمعاد وإثبات وجود الله تعالى.
الوجدان واختيار الإنسان
لقد آمن «كانط» بأنّ «العقل النظريّ» -أو ما نُسمِّيه «الفلسفة»- لا يمكنه إثبات حريّة الإنسان، بل هو -أي العقل- يصل إلى نتيجة معاكسة تماماً، وهي أنّ الإنسان مسلوب الاختيار والإرادة. ولكنّنا نستطيع عن طريق «الحسّ الأخلاقيّ» الفطريّ المرتكز في باطننا، والمعلوم لدينا بالعلم الحضوريّ والإدراك المباشر، أن نكتشف أنّ الإنسان حرّ ومختار؛ فالإنسان إذا وضع إرادته تحت سلطان «الوجدان» واستشعر «الواجب»، فسوف يشعر بالحرّيّة شعوراً مباشراً، إذا ما وقف موقف الاختيار بين سلوكَين.
ما ذكره «كانط» هنا، سبقه إليه آخرون؛ إذ صرّحوا بأنّ الاختيار دليلُه الحسّ الباطنيّ، دون العقل النظريّ. يقول «مولوي»:
إنّ قولك: افعل هذا أو ذاك، هو دليل اختيارك لو كنت تعقل.
الوجدان وخلود النفس
من جملة التساؤلات الملحّة الّتي تواجهها البشريّة في طلبها الحثيث للحقيقة، سؤال وثيق الصلة بذات الإنسان، بل إنّ جوابه يمثّل حقيقة هذا الإنسان، والسؤال هو:
هل النفس الإنسانيّة تفنى بموت الإنسان؟ أو هي تنعم بالخلود في عالَمٍ آخر، تسعد فيه أو تشقى؟
هذا السؤال تسبّب في انقسام فلاسفة الغرب الكبار إلى فئتَين، اختارَت إحداهما الشقّ الأوّل منه، وآمنت الأخرى بالثاني، وإليها ينتمي «كانط»، وهو وإن أصرَّ على أنّ البراهين الفلسفيّة ومنطق العقل النظريّ لا قدرة لها على إثبات خلود النفس، إلّا أنّه يثبت ذلك عن طريق الوجدان الباطنيّ للإنسان.
بيان ذلك: إنّ وجداننا الأخلاقيّ يدعونا دوماً للفضيلة وترك الرذيلة، يدعونا لأداء «الواجب الأخلاقيّ»، كالصدق والأمانة والعدل من جهة. ومن جهة أخرى، نحن نعلم بأنّ هذه الأمور لا ثواب ولا عوض عنها في هذه الحياة الدنيا؛ فالمحسن لا يُكافَأ فيها على إحسانه، بل هذه الأمور قيود تمنع الإنسان من التمتّع بالمنافع واللذائذ الدنيويّة، ولولاها لنالت يداه ما لذَّ وطاب. ولكن، على الرغم من علمنا بهذا كلّه، فإنّنا ما نزال نشعر وجداناً بأفضليّة التقوى وصنع المعروف، وإن اصطدم ذلك بمنافعنا. وهذا الشعور ما كان ليبقى ويصمد لولا الإيمان القلبيّ العميق بأنّ هذه الحياة ليست سوى وجه ظاهريّ لحياة أخرى مستورة، يُكافَأ فيها المحسن، ويُعاقَب المسيء، وتلك الحياة حياة خالدة؛ إذ لولا خلودها لَما كان للجزاء معنى. وإذا وصلنا إلى هنا -يقول «كانط»- فقد وصلنا إلى «الله»؛ لأنَّ الإيمان بالخلود يتضمّن الإيمان بوجود إله بِيَدِه الجزاء والحساب.
وخلاصة القول: إنّه من المحال ألّا يعلم الإنسان بالعاقبة الحميدة لأفعاله الخيّرة، وإنّ كلّ إنسان يؤمن في أعماقه بوجود حياة أخرى للجزاء، وإن جحدها باللسان، وهذا معلوم لديه بالعلم الحضوريّ كما عرفت؛ ولذا تراه لا يترك الصدق والعدل، وإن جُوزِيَ عنها بالإساءة والظلم.
من هذا العرض المختصر، تبيَّن لنا أنّ «كانط» لا يثق بالفلسفة والعقل النظريّ في ما يرتبط بما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)، وأنّه عوَّل في إثبات «الماورائيّات» على «الوجدان» و«العقل العمليّ»، فهو واقع تحت سلطان الوجدان ومتأثّر به إلى حدٍّ كبير ويعلّق عليه آمالاً عريضة، وهذا الانفعال يعكسه قوله المأثور عنه: بأنّ في هذا العالَم شيئَين يثيران عجب الإنسان، وهما: قبّة السماء ذات النجوم المتلألئة، والوجدان الإنسانيّ. وهو مغرم جدّاً بجملة «جان جاك روسو» (Jean Jacques Rousseau) الّتي يقول فيها: إنّ شعور القلب فوق منطق العقل؛ بمعنى أنّه قد يدرك الإنسان بوجدانه ما لا يدركه بعقله؛ وذلك لأنّ للقلب أسباباً خاصّة به لا يفهمها العقل، كما يقول «باسكال» (Pascal Blaise) العالِم الرياضيّ المشهور. إذاً، ثمّة طريق آخر غير «العقل النظريّ» يوصل إلى الله تعالى، وهو طريق القلب والوجدان، ويُشار هنا إلى استعمال كلمة «القلب» مكان «العقل» في لسان عرفائنا، ومرادهم منه هو «الوجدان» المطروح هنا.
هذا الوجدان نفسه، هو المراد في حديث الإمام الصادق (عليه السلام) مع ذلك الرجل الّذي قال له: يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى اللَّهِ مَا هُوَ؟ فَقَدْ أَكْثَرَ عَلَيَّ الْمُجَادِلُونَ وَحَيَّرُونِي. فَقَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَلْ رَكِبْتَ سَفِينَةً قَطُّ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ كُسِرَ بِكَ حَيْثُ لَا سَفِينَةَ تُنْجِيكَ، وَلَا سِبَاحَةَ تُغْنِيكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ هُنَالِكَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ وَرْطَتِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ [الإمام] الصَّادِقُ (عليه السلام): «فَذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِيَ، وَعَلَى الْإِغَاثَةِ حَيْثُ لَا مُغِيثَ» .
نقد نظريّة «كانط»
لا شكّ في وجود نقاط مضيئة ومعانٍ عالية في هذه النظريّة، ولكن فيها أيضاً نقاط قابلة للنقد، نذكر منها موارد ثلاثة:
1. تحقير الفلسفة
إزراؤه بـ«العقل النظريّ» أو ما يسمّيه هو بـ«العقل الخالص»، والتقليل من شأنه ودوره في استكشاف ما وراء الطبيعة (الميافيزيقا)، فهو يؤكّد بأنّنا لا نستطيع إثبات شيء من هذه المسائل عن طريق العقل النظريّ، وهذا اشتباه منه. فنحن -ودون تجاهُل لدور الوجدان والعقل العمليّ أو إنكاره - يمكننا إثبات اختيار الإنسان وبقاء النفس، ووجود الباري تعالى بواسطة العقل النظريّ أيضاً، كما أنّ الأخلاق الّتي يستلهمها من الوجدان، بإمكان العقل النظريّ إدراكها، ولو من باب التأييد للوجدان.
2. فصل الكمال عن السعادة
ما أشرنا إليه سابقاً، من فصله الكمال عن السعادة، وهذا خطأ فادح، لِمَا عرفتَ عن عدم الانفكاك بينهما، وأنّ كلّ كمال هو في ذاته نوع سعادة، وأنّ السعادة والبهجة غير منحصرة في اللذّة الحسّيّة. ولو صرفنا النظر عن هذه النقطة، فإنّ سؤالاً يطرح نفسه هنا، وهو: كيف يشعر الإنسان بالمرارة والندم حينما يتمرَّد على وجدانه ويخرج عن طاعته، ولا يشعر بالطمأنينة واللذّة حينما ينصاع ويدخل في طاعته؟
بناءً على رأي السيّد «كانط»، فالإحساس بالمرارة يلازم الإنسان حتّى لو كان مطيعاً للوجدان؛ لأنّه نفسه الّذي قال بفصله عن السعادة، وهذه النتيجة يُشْكَل قبولها ويعسر هضمها؛ إذ كيف يداخلنا الإحساس بالندم وتأنيب الضمير، سواء أطعنا الوجدان أم تمرّدنا عليه؟! إنّ هذا لمحال؛ لأنّ الإنسان إذ يشعر بالندم والحسرة إثر مخالفته لأوامر الوجدان، في قبال ذلك يشعر بالمسرّة والبهجة إثر إطاعته له وامتثال أوامره وتلبية ندائه. ومثال ذلك، الشخص الّذي يُؤثِر غيرَه على نفسه؛ إذ تعتريه حالة من النشوة الروحيّة، ويفيض قلبُه غبطةً وحبوراً، كالحديقة المملوءة زهوراً؛ لأنّه يعدّ ما أصابه من كدح ومشقّة في سبيل إسعاد الآخرين وهنائهم نوعاً من اللذّة والمسرّة الّتي لا يشعر بها في اللذّات الحسّيّة. وحسناً فعل «أبو علي سينا» في خاتمة «الإشارات»؛ إذ عقد فصلاً خاصّاً تحت عنوان «خطأ حصر اللذّة في اللذّة الحسّيّة»، ثمّ ذكر نماذج عدّة من اللذائذ المعنويّة، بل إنّ علم النفس الحديث يثبت -أيضاً- عدم انحصار لذّة الإنسان في اللذّة الحسّيّة.
اللذّة الحسّيَّة لذَّة عضويّة مرتبطة بالمحرّك الخارجيّ، كلذّة الطعام والغذاء الحاصلة من المأكول أو المشروب، وكاللذائذ الأخرى الحاصلة من الحاسّة الشامّة أو اللامسة أو السامعة. وثمّة لذائذ غير مرتبطة بالجسم، كاللذّة الحاصلة من فضيلة الشجاعة للرجل الشجاع؛ فالرجل الحائز على هذه الفضيلة والمتلبّس بها، يشعر باللذّة حينما يرى يده وقدرته فوق الآخرين، كما أنّ المحبوب من الناس يُسَرُّ بذلك، والعالِم يداخله إحساس بالانتصار والنشوة إثر كشفه عن حقيقة علميّة ما، فهذه المسرّات لا يد للعوامل الحسّيّة فيها.
من هذا الباب، ما يُحكى عن الخواجة «نصير الدين الطوسيّ» من أنّه إذا استعصَت عليه مسألة ما، ثمّ وُفِّق لحلّها وكشفِ إبهامها، اعترته حالة من السرور والبهجة، وقال: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذّة؟ كما يُنقَل عن السيّد «محمّد باقر»، المعروف بحجّة الإسلام، أنّه ارتأى ليلة زفافه أن يشتغل بالمطالعة حتّى يحين وقت الزفاف، إلّا أنّ استغراقه في البحث أنساه ذلك، ولم ينتبه لِما هو فيه حتّى سمع أذان الفجر، وأمّا عروسه المسكينة، فقد ظنَّت أنّه راغبٌ عنها، زاهدٌ فيها؛ ممّا اضطرّه لأنْ يُقسِم لها بأنّه لم يتعمَّد ذلك، وأنّ الاستغراق في المطالعة هو المسؤول عن تأخُّره.
والحاصل أنّه لا يمكن التفكيك بين مسألة اللذّة وبين المسائل الوجدانيّة؛ وإذ يلتذّ أحدٌ ما، فلأنّه نال ما يتمنّاه. وإذ يـتألّم؛ فلأنّه لم يبلغ الكمال الواجب بلوغه. فما هو الرائج اليوم في الفلسفة الغربيّة من التفكيك بينهما، أمرٌ مبايِنٌ للصواب وغير صحيح إطلاقاً؛ لأنّ كلّ كمال يجلب -قهراً- نوعاً من اللذّة للإنسان، ولو أنّه عند طلبه للكمال غافلٌ عنها.
عَدُّ أحكام الوجدان كلّها مطلقة
من هنا لم يرتضِ ثلّة من فلاسفة العرب ومفكّريهم هذه النظريّة، وقالوا: إنّ «الوجدان» ليست له أحكام مطلقة بالقدر المذكور في هذه النظريّة، بل توجد أحكام مطلقة وأخرى مقيّدة، فمِن الأُولى: العدل والظلم؛ فإنّ العاقل يحكم بحُسن الأوّل وقبح الثاني بنحوٍ مطلق. ومن الثانية: الصدق، حيث إنّ الحكم بحُسنه لا يتمتّع بالإطلاق، بل هو مقيَّد بالمبدأ الّذي تعتمد عليه فلسفة الصدق. وقد يحدث أن يُفَرَّغ الصدق من هذا المبدأ، فينقلب من حَسَنٍ إلى قبيح، ومن ممدوح إلى مذموم.
فما ذكره «كانط» من أنّ الوجدان يأمر بالصدق مطلقاً، بلا رعاية للمصلحة، رأيٌ تعوزه الدقّة، والوجدان نفسه يشهد بذلك. فلو أنّ ظالِماً يلاحق رجلاً ما كي يقتله ظلماً وعدواناً، سأل أحداً عنه وعن مكانه، فبماذا يجيبه؟ إن قال: لا أعلم عنه شيئاً، فهو كذبٌ لا يرتضيه الوجدان -وجدان «كانط»-، وإن أخبره بمكان ذلك المسكين، فسوف يقتله بغير وجه حقّ. فهل ترون هنا، أنّ الوجدان يأمر بالصدق مطلقاً، أيّاً كانت النتيجة؟! لا ريب في أنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ الوجدان لا يرضى أبداً بالظلم وإهدار حقّ الآخرين، وهذا حُكمٌ مطلق غير مقيّد بعدم الكذب؛ ولذلك أجاز الفقه الإسلاميّ مثل هذا الكذب الحكيم؛ لحكم العقل العمليّ به، وهذا هو رأي أهل المعرفة والحكمة. وهذه المسألة قريبة الصلة بمسألة الحُسن والقبح العقليَّين المطروحة من قِبَل المتكلّمين والأصوليّين. يقول «سعدي»: الكذب ذو المصلحة خيرٌ من صدقِ ذي فتنةٍ.
ثمّة حكاية تقول: أُدخِل أحدُ المتّهَمين على الملِك، فأمر بقتله، وإذ آيس الرجل من الحياة، شرع في سَبِّ الملِك وشتمه، ولكنّ الملِك لم يسمع جيّداً، فسأل: ماذا يقول هذا الرجل؟ فقال الوزير: إنّه يقول: ﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ﴾. وهنا تدخّل أحد الأشخاص ممَّن كانوا يتحيّنون الفرصة للنيل من الوزير كي يتقلَّد الوزارة بدلاً منه، فقال: لا ينبغي الكذب في حضرة الملوك، ثمّ التفت إلى الوزير، وقال: إنَّ هذا الرجل حقَّر الملِك وأهانه، وأنت تقول إنّه قرأ آية من القرآن؟ وظنَّ أنّه أصاب الوزير في مقتل. لكنّ الملِك قال له: إنّ كذِبَه أحسنُ من صدقِك. وإنّما نسج «سعدي» هذه الحكاية للتنبيه على هذه الحقيقة.
لا بدَّ هنا من التفريق بين الكذب ذي المصلحة، والكذب الّذي يجرّ نفعاً لقائله بغير استحقاق، أو يدرأ عنه ضرراً هو مستحقٌّ له؛ إذ إنّ كثيراً من الناس إمّا أنّهم يتعمّدون الخلط بينهما، وإمّا أن يلتبس عليهم الأمر حقّاً. والفرق بينهما هو: أنّ الكذب ذا المصلحة فاقدٌ لروح الكذب وحقيقته، وحالَّةٌ فيه روح الصدق؛ وبعبارة أخرى: هو الكذب الّذي تُنقَذ به الحقيقة، ويُدفَع به الظلم. أمّا الكذب ذو النفع المذموم، فهو ما يُراد به النفع الشخصيّ، ولو على حساب الحقيقة. وثمّة فرق بين «المصلحة» و«المنفعة»، فـ«المصلحة» تدور مدار الحقيقة وترعاها، أمّا «المنفعة» فتدور مدار الذات، فهي المنظورة حال الكذب، كما هو دَيْدَن ممارسي الكذب؛ إذ يكذبون سعياً وراء المنافع الذاتيّة، وهم يدّعون أنّه كذب حكيم جائز، والحال أنّه كذب مذموم كسائر الأكاذيب. إلى هنا، اتّضح أنّ القبيح ليس هو مطلق الكذب، كما أنّ الحَسَن ليس هو مطلق الصدق.
وقد أخطأ جماعة من الزرادشتيّة؛ إذ عابوا على «سعدي» قوله السالف الذكر، واعتبروه معلِّماً لمساوئ الأخلاق، وبهذا العذر منع المستعمرون الإنجليز قراءة كتب «سعدي» وتداوُلها في المدارس الهنديّة الّتي أسموها تحت إشرافهم، كما ذكر ذلك أحد فضلائنا. وكأنّ قلوب الإنجليز تقطر دماً على الشعب الهنديّ وتعليمه، حيث لا يريدون أن يكذبوا وإن كان في ذلك مصلحة. لكنّ أهل النظر سرعان ما أدركوا سرّ هذا المنع، وهو أنّ «سعدي» كتب في مقدّمة «كُلستان» بيتَين من الشعر لا يعجبان الإنكليز، قال: أيّها الربّ الكريم، أنت ترزق من
خزانة الغيب اليهود والنصارى
فكيف تحرم محبّيك من فيضك
وأنت تشفق حتّى على أعدائك؟
وهما يتضمّنان أنّ المجوس والنصارى أعداء الله تعالى، وهذا لا يُعجب الإنكليز بطبيعة الحال.
والخلاصة أنّ الحكيم المجرِّب يدرك أنّ الصدق قد يفقد الحُسن في بعض الموارد، ويُفرَغ من المصلحة، وأنّ الكذب قد يكتسب سمة الحُسن في بعض الحالات، وتنعدم مفسدته، وأمّا الحكم بشيء من دون تجربة مسبقة -كما يفعله بعضهم- فلا يؤدّي إلى مطابقة الواقع، فمَن لم يجرّب الصدق في حياته، وجُبِل على الكذب، لو سألناه: هل تكذب إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ لأجاب دون تردّد: كلّا، لا يجوز الكذب مطلقاً. فهو لأنّه لم يجرّب الصدق أصلاً، لا يخطر بباله أنّه قد يكون ذا مفسدة، بخلاف الممارس للصدق، فهو يدرك روح الصدق، وأنّه إنّما يصدق للمصلحة، فإذا اقتضت المصلحة أن لا يصدق، أخذ بها. ولذلك، أجاز الفقه الإسلاميّ الغيبة والكذب في موارد معيّنة، رعايةً للمصلحة، في حين أكّد حرمة الكذب في بقية الموارد، ولا سيّما ما أُريد منه إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. ولهذا، حرص الدين الإسلاميّ على إبعاد المسلم عن الكذب وممارسته، بل حتّى عن مجرّد التفكير فيه، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُه».
فاستقامة اللسان أمر ضروريّ لاستقامة القلب الّذي هو محلّ الإيمان، وإن أحرجتك بعض المواقف، فبالإمكان استعمال ما يُسَمّى بـ«التورية» في الاصطلاح الفقهيّ، وهي أن يكون كلامك مطابقاً لِما تصوّرته أنت، لا لِما افترضه الطرف الآخر. مثلاً، لو سُئلت: هل رأيت فلاناً؟ وكنت قد رأيته فعلاً، فبالإمكان أن تقول في الجواب: لا، ولكن يكون قصدك شيئاً آخر غير (فلان) المسؤول عنه. وينبغي عدم ممارسة الكذب المذموم المحرَّم باسم التورية، كما يصنع بعض الأفراد، فإنّ ذلك استفادة غير مشروعة ويجب الاحتراز عنها.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
محمود حيدر
-
 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (لات) في القرآن الكريم
معنى (لات) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أنواع الطوارئ
أنواع الطوارئ
الشيخ مرتضى الباشا
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
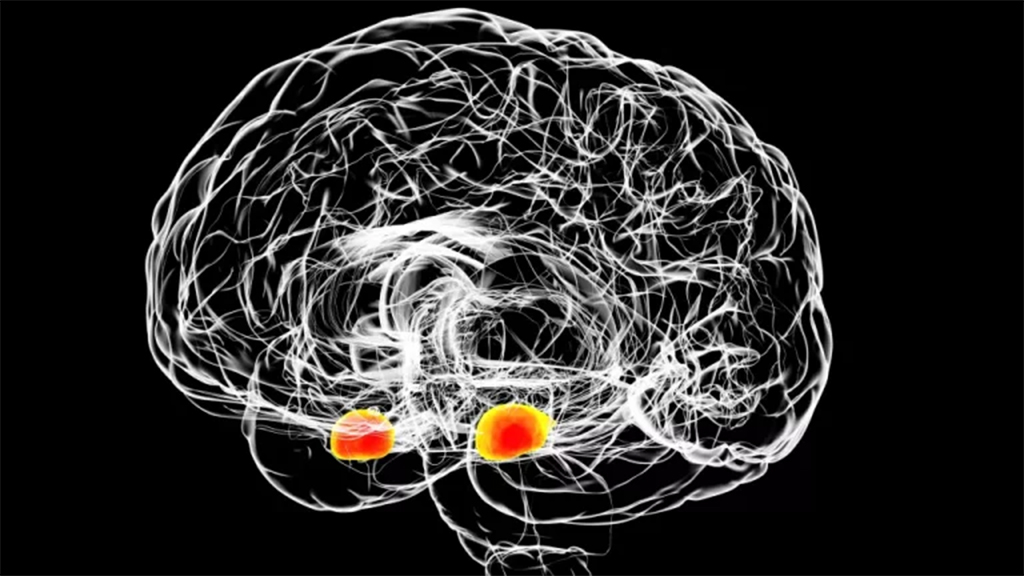
النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
-

خطر الاعتياد على المعصية
-
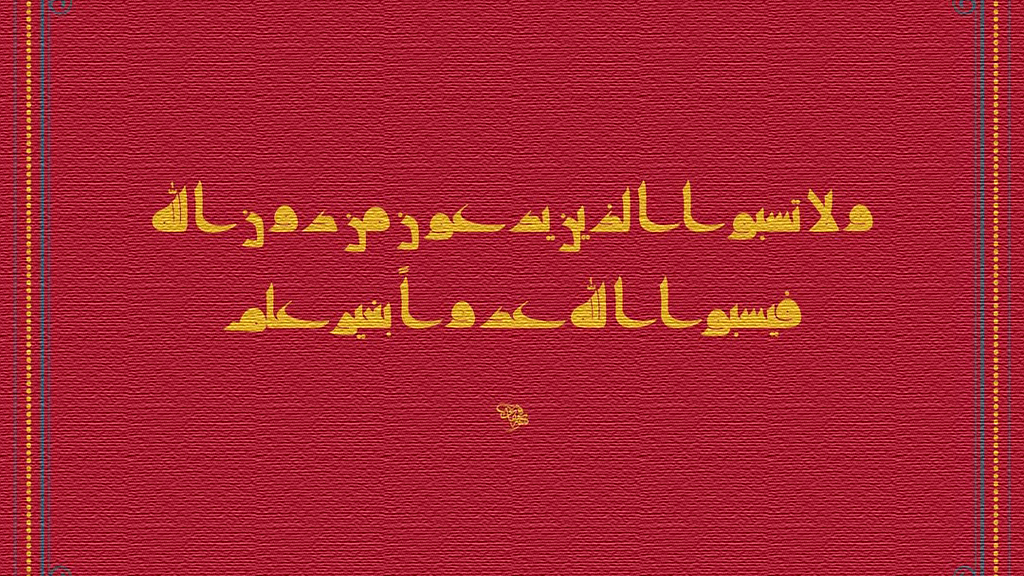
السّبّ المذموم وعواقبه
-

معنى (لات) في القرآن الكريم
-
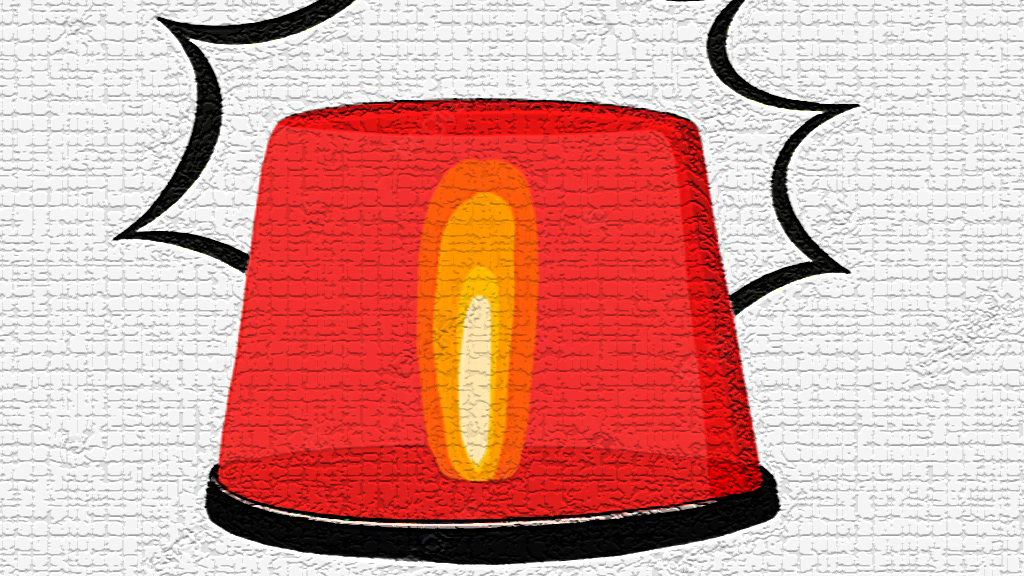
أنواع الطوارئ
-
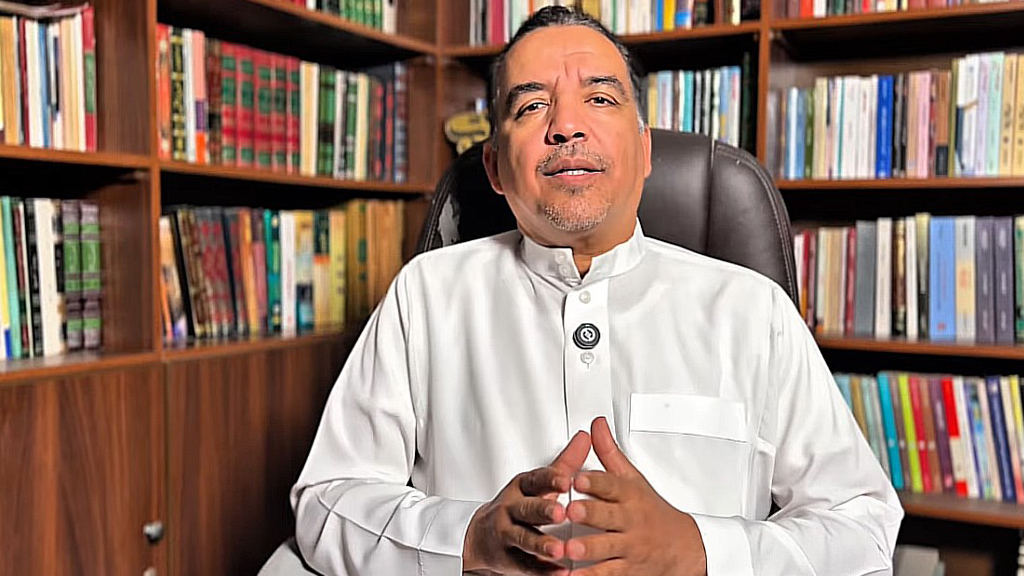
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)










