علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النّظريّات الأخلاقيّة (7)

نظريّة العبادة (1)
من النظريّات المطروحة هنا كمرجع للأفعال الجميلة والأخلاق الحميدة -مضافاً إلى ما تقدّم-، «نظريّة العبادة»؛ بمعنى أنّ هذه السلوكات تُعَدّ من مقولة «العبادة»، والمتحلّي بتلك الأخلاق، عابدٌ حقيقةً، وإن لم يشعر، بل وإن لم يعترف بالألوهيّة في مرتبة «الظاهر».
وقد تسألون: هل يمكن أن يكون هناك عابدٌ لله من دون أن يشعر؟ والجواب: نعم، بل يوجد بيننا مَن يؤمن بالله دون أن يشعر بذلك. كلُّ البشر يعرفونه تعالى في عمق فطرتهم، ويؤمنون به في «لاشعورهم»، ولكن يتفاوتون في معرفته سبحانه في رتبة «الشعور الواعي الظاهريّ». وإذا كانت هذه الفكرة غير قابلة للفهم في القرون السالفة، فهي سهلة الفهم هذه الأيام؛ إذ ثبت أنَّ للإنسان نوعَين من الشعور:
1. شعور ظاهريّ؛ وهو ما يكون للإنسان اطّلاع مباشر عليه.
2. شعور باطنيّ، وهو نوع من العلم أيضاً، إلّا أنّه خارج عن سلطة الشعور الظاهريّ، ولا اطّلاع له عليه.
وعلماء النفس اليوم، يعتقدون بأنّ القسم الأكبر من الشعور الإنسانيّ مغفول عنه، وما هو منظورٌ للإنسان هو القسم الأصغر منه. ونحن لو رجعنا إلى بواطننا وفتّشنا ضمائرنا، لعثرنا على سلسلة من الأفكار والإحساسات والمعلومات والميول والبُغض والحبّ وما شابهها، وقد نتصوّر أن لا شيء وراء ذلك. على الرغم من أنّ الكثير الكثير من المعلومات والمدركات والإحساسات والميول راسخة في أعماق أرواحنا، ونحن عنها غافلون، وقِسم منها خافٍ ومستتر عن ظاهر شعورنا. ويوضحون هذه الفكرة بقولهم: لو وضعنا بطّيخة في حوضٍ من الماء، فسوف يغطس منها 9/10، وسيبقى مقدار قليل منها طافح على وجه الماء، وكذلك الحال لو ألقينا قطعة من الثلج، وتُقَدَّر نسبة الشعور الباطنيّ إلى الشعور الظاهريّ، كنسبة الجزء الغاطس إلى الجزء الطافح عيناً.
والعالَم أيضاً على هذا المنوال، فنحن لا ندرك سوى عالَم الطبيعة، وهو المسمَّى في القرآن بـ«عالَم الشهادة»، والحال أنّ ثمّة وجوداً لعالَم آخر هو المسمّى بـ«عالَم الغيب». ونسبة هذَين العالَمين إلى بعضهما كنسبة جزئَي تلك البطّيخة إلى بعضهما؛ فالجزء الغاطس منها يماثل عالَم الغيب. إنّ عالَم الطبيعة، بمجرّاته ونجومه، وبذلك الفضاء الّذي لا يعلم البشرُ إلى أين ينتهي، ليس إلّا كحلقةٍ ملقاةٍ في صحراء مترامية الأطراف.
والحاصل أنّ ما نذكره هو عبادةٌ لاشعوريّة، وقد يدعو هذا للعجب، ولكن بما ذكرناه من وجود شعور باطنيّ، لا يبقى للعجب مجال.
وقد يعترض معترضٌ بأنّ الإنسان ما دام حيّاً، فهو ليس بحاجة إلى وكيل ووصيّ، فإذا كان هو نفسه يعلم ويدرك بأنّه لا يَعبد، فلماذا نُلبِس فعله الأخلاقيّ ثوب «العبادة اللاشعوريّة»، ومن ثمّ ننسب ذلك إليه؟
وجواب ذلك: أجل، الإنسان كثيراً ما ينجز أعمالاً هو نفسه لا يشعر بها، والأهمّ من هذا، هو أنّه لا يعرف نفسه. ولتوضيح ذلك، نقول:
أوّل سؤال يواجهنا هو: ما هي العبادة؟ ما هو تعريف العبادة؟ ما هو جنسها وفصلها وأجزاؤها تحليلاً؟
إذا كان المقصود منها جملة الأفعال والطقوس الّتي يقوم بها الإنسان بعنوان «العبادة والتعبّد»، كالصلاة والصوم والحجّ والدعاء وصلة الأرحام وما شابه ذلك، فإيضاح هذه الأمور سهل يسير، فيُقال: الصلاة عبارة عن سلسلة الأذكار والنيّة والركوع والسجود، والعبادة صومٌ وإمساكٌ وهكذا.
وأمّا إن كان المقصود من «العبادة» حقيقةً ما، وما تلك الأفعال والشعائر الّتي حمَّلَنا إيّاها الله تعالى إلّا انعكاسٌ وقالبٌ لتلك الحقيقة المتجلّية في فطرتنا، سواء التفتنا إلى ذلك أم لا، ففي عمق فطرتنا تكمن حقيقةٌ ما؛ فإذا كان المراد من العبادة هذا المعنى -كما هو الحقّ- فلن يكون تعريفها ميسوراً، والفلاسفة عجزوا عن تعريفها كما عجزوا عن تعريف «العدالة» و«الجمال» -مع كونه غريزةً بشريّة كما قالوا- وكذا تعريف «العلم» أيضاً؛ فلو تصفّحنا كتب الفلاسفة، فسوف نرى تعاريف مختلفة له، فواحدٌ يقول: هو من مقولة «الكيف»، وآخر يقول: هو من مقولة «الإضافة»، وثالث يقول: هو لا ينتمي لأيّ مقولة أصلاً، وهكذا...
ولكن ما يجدر ذكره ولفت النظر إليه، هو أنّنا إذا أردنا إدراك حقيقة ما، فلا ضرورة تدعو لأن نَعلَمَها ونعرفها، بل إذا استطعنا تعريفها عرَّفناها، وإن لم نستطع ذلك لم نعرّفها، كما هو الحال في عنصر «الجمال»؛ فعلى الرغم من أنّنا لا نستطيع تعريفه، إلّا أنّنا نشخّص أموراً ذات مساس وعلاقةٍ به، وحتى في ما يرتبط بعنصر «العبادة»، يوجد لدينا تشخيص على نحو معيَّن؛ لأنّنا في «العبادة» نقدِّس حقيقةً ما، أمّا ما هي تلك الحقيقة؟ إنَّها تلك الّتي إذا أردنا إبرازها في صورة خاصّة وقولبتها، ننطق بـ«سبحان ربّي العظيم وبحمده»، وبـ«سبحان ربّي الأعلى وبحمده»، و«الله أكبر»؛ وبهذا نكون قد صغناها في قالبٍ لفظيّ أو عمليّ محدّد. ولك أن تقول: إنّ «العبادة» هي تقديس الكمالات والإشادة بها والترنّم بذكرها، كالبلبل حين يقف قبال زهرة جميلة، ثمّ تأخذه حالة من التغزّل بها والمديح لها، فكذلك الإنسان أيضاً، يمجّد حقيقة المعبود بواسطة عبادته.
«العبادة» تعني الخروج من دائرة الذات المحدودة والضيّقة، الخروج من محدوديّة الآمال والتمنيّات، والانطلاق والعروج إلى الكمال المطلق؛ لأنَّ في العبادة التجاءً وانقطاعاً واستغاثةً واستقواءً واستنجاداً بالمعبود، وتحرُّراً من «الأنا» وعبادة الذات والآمال، وهذا هو معنى «التقرُّب» إلى المعبود تعالى. ونحن إذ نقول: نصلِّي «قربةً إلى الله»، فليس ذلك لمجرّد المجاملة والملاطفة، بل الإنسان المصلِّي هو واقعاً في حالة عروج إلى الحقّ المتعال. فهذه المعاني كلّها حاصلة في العبادة، ولا ضرورة لأن نكلّف أنفسنا تعريف «العبادة»؛ أي تعريف ذلك «التجلّي الروحيّ الخاصّ للبشر»، الّذي هو أعلى وأشرف وأبهى وأعظم حالات الإنسان على الإطلاق.
وما ذكرناه في «نظريّة الجمال» جارٍ هنا أيضاً، فقد قلنا إنّ «الجمال» ليس مقصوراً على الغريزة الجنسيّة الحيوانيّة، بل هو ذو مجال واسع ورقعة فسيحة جدّاً تشمل الطبيعة كلّها، بل تشمل ما هو أكثر؛ أعني المعاني، كالفصاحة والبلاغة، بل وندَّعي شمول سلطة الجمال للمعقولات أيضاً، الّتي هي أرفع وأسمى من الحسّ والخيال، ونحن نقرأ في دعاء «السحر»: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ، وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ».
فالجمال الحقيقيّ هو جمال الحقّ تعالى، جمال ما وراء المادّة، وما الجمال الموجود هنا والمنظور لنا إلّا ظلالٌ وانعكاسٌ لذلك الجمال. ولذلك، نلاحظ أنَّ «العرفاء» يُطلِقون على الصفات «الثبوتيّة» عنوان الصفات «الجماليّة»، وعلى الصفات «السلبيّة» عنوان الصفات «الجلاليّة»، وهذا خلاف ما اصطلح عليه «المتكلّمون»، فإنّهم يسمّونها «الثبوتيّة» و«السلبيّة».
العبادة لله أيضاً غير منحصرة في الإنسان، بل هي حقيقة ثابتة مستبطَنة في جميع موجودات هذا العالم، ولا يوجد في هذا العالَم والكون كائنٌ ما لا يعبد الله تعالى، كما لا يوجد إنسان غير عابدٍ له سبحانه، ولو بنحو «لاشعوريّ» كما عرَّفت، فالأشياء والكائنات كلّها تحمد تعالى وتثني عليه، يقول تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾. ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾. ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ﴾. ﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾.
إذاً، «العبادة» في منطق القرآن ليست مقصورة على «العبادة الشعوريّة الواعية» للإنسان، بل قد يكون كثير من الناس الأقلّ عبادة، أقلّ ما يفعلونه هو الوقوف تُجاه القبلة لصلاة ركعتَين، وإن كانت الروح تحلّق بعيداً في مكان آخر.
كان «الفارابيّ» الّذي عاش قبل ألف ومئة عام، يقول: «صلَّت السماء بدورانها، والأرض برجحانها، والماء بسيلانه، والمطر بهطلانه». ويُدلي أهلُ الباطن والقلب بِدَلوِهم أيضاً، فيقولون: لو حاز الإنسان من المراتب الكماليّة والمعنويّة ما تنفتح معها أُذُنُ قلبه، لسمع تسبيح الموجودات وتحميدها:
كلّ ذرّات العالَم في الخفاء
تقول لك في الصباح والمساء
نحن نسمع ونرى، نحن أذكياء
لكن معكم أنتم الغرباء، نحن صامتون
لأنّكم وراء الجماد تذهبون
متى أصدقاء روح الجمادات تصبحون؟
يعني: أنتم معشر البشر، لماذا أنتم منكوسون؟ متى تعرفون سرَّ الجمادات؟ نعم، إنّ «الوعي» و«الشعور» ليس من مختصّات الإنسان والحيوان، بل يوجد في النبات أيضاً، وحتّى الجمادات لها مرتبة معيّنة منه، والعلم في يومنا هذا يؤكّد ذلك، والخبراء يقولون: «كلّ ذرّ من ذرّات العالم -في حدّها الخاصّ بها- تستفيد من درجة معيّنة من الشعور».
الحسّ الأخلاقيّ موصول بالحسّ الباطنيّ بـ«الإله»
إنّ قلب الإنسان يعرف ربّه، ويدرك وجوده بحسب الفطرة والغريزة، وهذا معنى قولهم: إنَّ الأخلاق من مقولة «العبادة»، ولكنّها «عبادة لاشعوريّة»، والإنسان في ذلك كالطفل. يقول الشاعر:
مثل ميل الأطفال نحو الأمّهات
ولكن لا يعرفون سرَّ ميل الشفاه
إنّ الطفل حديث الولادة، يبدأ منذ الأيّام الأولى من حياته، وقبل أن يتمكّن من فتح عينَيه أو يدرك إدراكاً شعوريّاً وجود أمّه، وتكون في ذهنه صورة لها، يبدأ بإحناء رأسه، ثمّ يحرّك شفتَيه، وفجأة ترى شفتَيه تبحثان عن ثدي الأُمّ. ولو سأل أحدٌ هذا الوليد: عن أيّ شيء تبحث؟ لَمَا استطاع الإجابة والإيضاح، بل هو فاقد للذهن المفكّر، وصفحة ذهنه خلاءٌ، لم تُزَيَّن بالصور والنقوش بعدُ، كما أنّه لا يستطيع النطق كي يفصح عن هذا الأمر، لكنّنا نراه يسعى بطريقة «لاشعوريّة» خلف شيء ما موجود؛ يعني يطلب بنحو «لاشعوريّ» ثدي الأمّ، وهذه الغريزة أقوى بكثير في الحيوانات، خصوصاً الحشرات منها.
إذاً، معنى كون الأخلاق من مقولة «العبادة»، هو أنّ المرء يُقدّس سلسلة من السلوكات الأخلاقيّة، ويمارسها في حياته، وإن خالفَت هوى نفسه ومنافعه الشخصيّة، بل و«العقل العمليّ» الّذي يدعو لمراعاة النفع الشخصيّ، وذلك كالإيثار والإنصاف ونحوهما. فعلى الرغم من أنّ المنطق الطبيعيّ لا يرتضي ذلك، إلّا أنّ المرء يفعل ذلك بشوق ورغبة، ويعدّه نوعاً من الشرف والعظمة، ويرى أنّه بذلك قد ارتقى بذاته ذرى المجد، وما ذلك إلّا لتطابُق هذه الصفات مع صفات المعبود الباطنيّ، وملاءمتها لأخلاقه.
حين يواجه «الإنسان» نفسه، فإنّ مسألة «الإنصاف» تبدو له مسألة صعبة. فعلى سبيل المثال، لو كان يوجد طبيبان يُشرِفان على علاج مريض، وكان أحدُهما أكثر خبرة وشهرة، وكان الآخر شابّاً حديث التخرُّج ما زال في أوّل الطريق، ثمّ اختلف نظرُهما بشأن علاج ذلك المريض، فالآخرون لن يأخذوا -من دون شكّ- بنظر الطبيب الشابّ ويُعرِضوا عن قول الطبيب الأوّل المعروف صاحب الخبرة والتجربة، وهذا الأمر يقرّ به كِلا الطبيبَين. ولكن قد يتّفق أن يكون نظر الطبيب الشابّ هو الأصوب والأصحّ، ويدرك الطبيب الأوّل ذلك، فيكون -حينئذٍ- على مفترق طريقَين: فإمّا أن يدوس على شخصيّته وشهرته ويسحقها، فيقول: إنَّ هذا الطبيب الشابّ أَصوَب منّي نظراً، وأحسن فهماً، وإنّ التشخيص الّذي أعطيتُه للحالة لم يكن دقيقاً، وإنّ العلاج الصحيح هو الّذي وصفه ذلك الطبيب، فإنْ خطا هذه الخطوة وتصرّف على هذا النحو، فعملُه هذا يُعَبَّر عنه بـ«الإنصاف»؛ وإمّا أن لا يفعل ذلك، فيتجاوز الإنصاف، ويقول للطبيب الشابّ: أنت لا تعرف شيئاً، ولا خبرة كافية لديك، والأفضل أن تذهب لشأنك؛ وقد يستبدل العلاج الّذي وصفه بآخر كي لا يموت المريض، ولكنّه ليس مستعدّاً لأنْ يعترف بخطئه، بل يحاول تبرير عمله وتوجيهه.
إنّ الإنسان لَتَعتمِل فيه هاتان الحالتان، وكثيراً ما يوجد أُناسٌ في هذه الدنيا يميلون للإنصاف ويمارسونه بالفطرة وبنحوٍ فطريّ، وهذا نوع إسلامٍ واستسلامٍ لله؛ أي للقانون الإلهيّ؛ لأنّ لله تعالى نوعَين من القانون: نوع منها ثبّتَه في فطرة الإنسان، ونوع آخر لم يُجعَل كذلك، وإنّما يُعرَف فقط عن طريق أنبياء الله ورسله، وهي متشعّبة من الفطرة أيضاً.
من المفروغ منه أنّ الأنبياء يدعمون القوانين الفطريّة ويؤيّدونها، وإن كانوا قد أتوا، مضافاً إلى ذلك، بقوانين وتعاليم أخرى. وكما يدرك الإنسان بروحه وفطرته، وعن طريق حاسّة «باطنيّة لاشعوريّة»، وجودَ الله سبحانه، كذلك هو يدرك قانون الله ويعرف ما فيه رضاه، فهو بالفطرة يخطو نحو رضاه تعالى، وإن كان لا يعلم بأنّه يسير في هذا الاتّجاه. وقد يتّفق هذا لعابد الوَثَن، مثل ما كان يفعله «حاتم الطائيّ» وأشباهه، ولدينا أحاديث كثيرة عن نبيّ الإسلام والأئمّة (عليهم السلام) تدور حول المشركين والكافرين الّذين قاموا بمثل هذه الأفعال، فقد كانوا (عليهم السلام) يُسأَلون: أليس لهذه الأعمال أجرٌ عند الله؟ فيجيبون (عليهم السلام): إنّها ليست دون أجر.
صحيحٌ أنّ المعتمَد في الإثابة على الأعمال هو «النيَّة»، ولكن حينما يستجيب الإنسان لحسّه الأخلاقيّ، فإنّ هذا الحسّ غير منفصل عن معرفة الله سبحانه، خلافاً لِما يظنّه بعضُهم؛ فـ«الحسّ الأخلاقيّ» هو حسّ معرفة الله وإدراك وجوده.
الإنسان يدرك بفطرته أنّ العفو موجِبٌ لرضى المعبود، يدرك بالفطرة أنّ خدمة خلق الله والتضحية من أجلهم موردُ رضى المعبود.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ..﴾
معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ..﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (16)
معرفة الإنسان في القرآن (16)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

ما هي ليلة القدر
-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
-

معنى سلام ليلة القدر
-

ليلة القدر وسيلة الرحمة
-

معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ..﴾
-
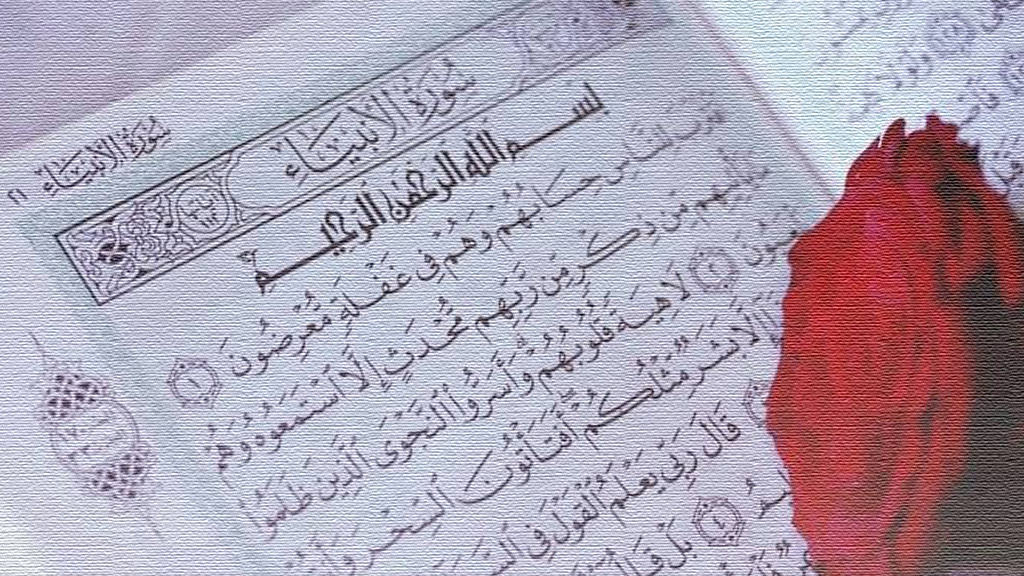
معرفة الإنسان في القرآن (16)
-

ليلة الجهني
-
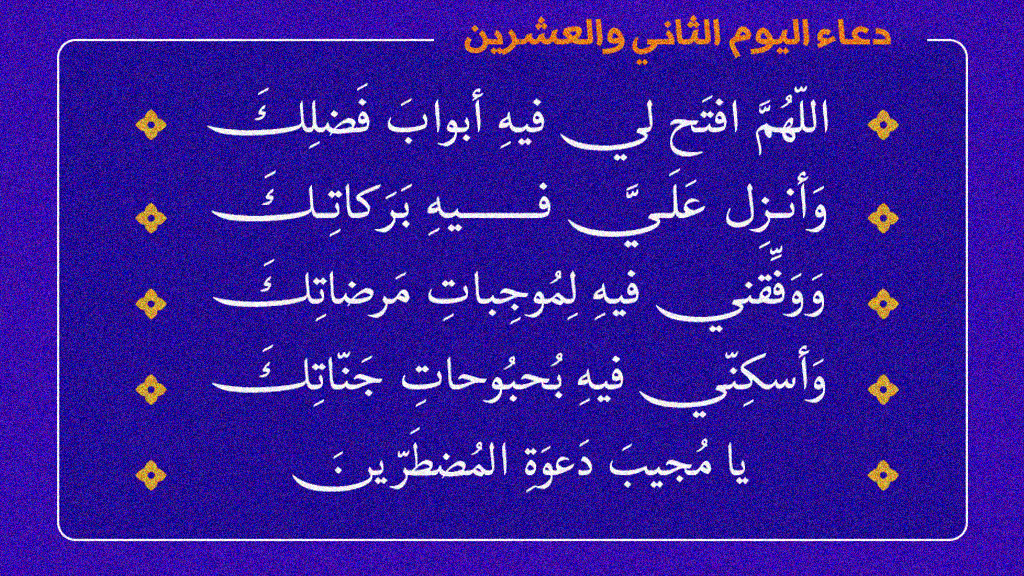
شرح دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان
-

(عيسى) الإصدار الروائي الأول للكاتب علي آل قريش
-

معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾










