علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النفس الإنسانية (7)

عماد الأخلاق
كيف نقنع الفرد بضرورة الفضائل وضرر الرذائل؟ ومن أيّ باب ندخل إليه كي يؤثر الصدق والحقّ ونحوها على منفعته الشخصيّة ونزواته الحيوانيّة؟ وبعبارة ثانية، يُراد من الأخلاق أن تكون حرباً شعواء ضدّ «الأنا» و«الذات»، وهذا لا يكون إلّا باعتمادها على منطق سديد يقنع المرء أن يجاهد «نفسه»، ومن دون ذلك، ستكون الأخلاق مجرّد كلمات رنّانة لا تملأ فراغاً من القلب، ولا تجيب سؤالاً من العقل.
إنّها كلمات فارغة لا نفع وراءها، ولا فائدة تُرجى منها إلّا دفن «الذات» تحت رمادها، كما يقول ذلك «ألكسيس كارِل» (Alexis Carrel)؛ فالأخلاق في نظره كالبندقة الفارغة من اللبّ، وهذا هو سرّ زهد البشر في الأخلاق.
والملاحَظ أنّه كلّما تقدَّم العالَم في ميادين الثقافة والعلم، قلَّ تمسُّكه بالأخلاق الفاضلة، وازداد قناعةً بعدم جدواها؛ لأنّه إذ يفكّر مليّاً في ما يُعرَض عليه منها، يرى أنّه لا عماد قويّاً لها يصمد أمام منطق «الأنا»، الداعي إلى عدّها فوق كلّ شيء. فلماذا يتعب ويكدح لأجل إسعاد الآخرين؟ وما هو عوض ذلك؟ وإذ لا يجد جواباً مقنعاً من ملقِّني هذه الكلمات، يُعرِض عنها ويصرف نظره؛ لماذا؟ لأنّه لُقِّن ذلك في منزل العائلة ومدرسة المجتمع، لكنّه ما إن يتقدّم في العلم والفكر، سوف يدرك أنّه لا واقع لهذه الأخلاقيّات؛ لأنّه لم يُقدَّم له تفسير منطقيّ لها.
لَعمري، إنّه لَخَطرٌ عظيمٌ يُهدّد البشريّة! لأنّ الضدّ هنا هو «العلم» لا «الجهل»، و«الوعي» لا «السذاجة»، وحتّى أولئك المحرومون من الرشد الفكريّ والوعي، والّذين قد يؤمنون بما يُلَقَّنونه من مفاهيم، سرعان ما يشكّكون بها لمجرّد همسة أُذُن مِن مشكِّك؛ فالجنديّ قد يتولَّد لديه، بالتلقين المستمرّ، إحساسٌ كاذب بحبّ وطن وتراب ما، وقد يُضحّي بسبب هذا الإحساس بالكثير، ولكنّ هذا الإحساس مبنيٌّ على رمال متحرّكة، ينهار لأقلّ نسمة تهبّ عليه؛ لأنّه إحساسٌ ليس له ركيزة راسخة في أرض الحقيقة، وهذه هي نوعيّة الأخلاق الّتي يروّج لها المادّيّون، لكن لا يجدون لها سوقاً.
معرفة الله عماد الأخلاق
كما أنّ «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» تعالى، كذلك هي حجر الزاوية في «إنسانيّة» الإنسان و«أخلاقه»، فلا معنى لها من دون معرفته تعالى، وكلّ المعنويّات لا قيمة لها إلّا في ظلّه تعالى. فـ«الإنسانيّة» و«المحبّة» إذا لم ترجعا إليه تعالى، فهما هباء، ولا يمكن أن تكونا مظلَّة للأخلاق. وأنا لم أرَ أحمق من منطق «برتراند راسِل» ذي الاتّجاه المادّيّ؛ فإنّه يدعو للأخلاق الفاضلة باسم «الإنسانيّة»، من دون ربطها بالله تعالى والروح. إنّه هراء؛ لأنّه ما لم يؤمن الفرد بالله تعالى وما يتبع ذلك، فسينظر لبقيّة الأفراد كما ينظر للشجر أو الخراف.
وقد يقول أحدكم بأنّنا نرى الانضباط الأخلاقيّ في مجتمعات متمدّنة بعيدة عن الله تعالى، فهم لا يكذبون ولا يخونون ولا يتجاوزون الحدود والقانون الموضوع لهم، على الرغم من عدم لجوئهم للدين والأمور المعنويّة، وهذا مُشاهَد في الشعوب الأوروبّيّة والأميركيّة. وحيث إنّ الوقوع أدلّ دليل على الإمكان، نستنتج إمكان بناء الأخلاق حيث تعلو على «الأنا»، بلا حاجة إلى الإيمان بالله ومعرفته. والحقّ أنّي أنا أيضاً كنتُ لفترةٍ أعتقد بإمكانيّة ذلك، حتّى انكشف لي شيء آخر، وهو أنّ «الأنا» المعبودة لها أنواع ومظاهر مختلفة، منها:
1. الأنا الشخصيّة
وهي أضيق أنواع «الأنا» و«النفس» ومراتبها؛ بمعنى أنّ صاحبها لا يرى في مرآة الحياة سوى ذاته، فهو يعيش وحده، ويسعى لسعادته هو فقط؛ فـ«ذاته» هو محور اهتماماته وغاية خطواته.
2. الأنا العائليّة
هي أوسع دائرة من سابقتها؛ بمعنى أنّ ذلك الفرد صاحب «الأنا» الضيّقة يوسّع دائرتها، لتشمل أفراد عائلته، من زوجة وأولاد. لذلك، ترونه عادلاً وأميناً وصادقاً وعطوفاً في منزله، بل هو يبذل نفسَه كي يُسعِدهم. وبعبارة أخرى: هو نموذج رائع للإنسان، لكن في حدود العائلة والمنزل. أمّا إذا غادره إلى المجتمع، فهو شيء آخر؛ ترونه يريد كلّ شيء لعائلته، ويتوسّل لذلك بالحرام قبل الحلال، وبالرذائل قبل الفضائل؛ ولأنّ «ذاته» كبُرَت بالعائلة وثقُل العبء، فإنّ حِرصَه وسَعيَه سيشتدّان بلا ريب؛ وهذا يتطلّب مزيداً من الاحتيال والغشّ والنفاق ونحوها؛ لتأمين لوازم «الأنا» الكبيرة. وهذا كلّه لا يخرج عن مفهوم «عبادة الذات» والانغماس فيها، ولا يمكن عدُّ ذلك من الأخلاق، ولا ُيمدَح صاحبُها؛ لأنّ الأخلاق -كمَلَكة- لا تُجَزَّأ، وإلّا فحتّى قطّاع الطرق واللصوص لا يسرقون أموال بعضهم، ولا يخونون، بل يتعاونون، وقد يُؤثِر أحدُهم صاحبَه على نفسه، فهل نحترمهم لذلك ونتّخذهم قدوةً لنا؟
3. الأنا الوطنيّة
والكلام هنا هو الكلام هناك، بلا فرق في البَيْن، اللهمَّ إلّا في السعة، فإنّ من ينذر نفسَه لوطنه وبلاده، تكون «الأنا» لديه أكبر، ودائرتها أعظم قطراً، فهو يعدُّ وطنَه جزءاً من «ذاته»، فهو لا يخونه، ولا يفرّط في مصالحه، ولا يسفك دماء بني وطنه؛ لأنّ ذلك كلّه مرتبط في رأيه بـ«ذاته» هو. لكنّه لا يتردّد أبداً في اقتراف السيّئات وارتكاب الجرائم، في سبيل هذه «الأنا الوطنيّة»، من دون أن يرفّ له جفن، وهذا هو حال رجال السياسة في أوروبّا، فكم من جرائم عظام ارتكبوها بحقّ الدول والشعوب المستعمرة؟ والأنكى من ذلك أنّهم يفخرون بذلك، ويعدّونه إنجازاً ونصراً وطنيّاً؛ هذا، في حين تجدهم أنفسهم في أوطانهم مثال العدل والأمانة والأخلاق، فهذه المصطلحات لا معنى محصّل لها إلّا في داخل بلدانهم. كما يقول مؤلّف كتاب «الحرب العالَميّة»: «إنّ الحديث عن الأخلاق إنّما ينطبق على الأفراد، لا الشعوب»؛ أي أفراد الدول القويّة الاستعماريّة. وشاهدُ ذلك هو المآسي الّتي تحمَّلَها الشعب الجزائريّ جرّاء اعتداء الفرنسيّين عليه.
ألم يكن الفرنسيّون أوّل من أصدر وثيقة حقوق الإنسان على مستوى العالَم؟ فأين كانت هذه الوثيقة أيّام الحرب الأولى والثانية؟ أليس الشعب الجزائريّ بشراً له حقوق؟ فهل رحموا منه امرأةً، أو رقُّوا لأطفاله؟ هل احترموا تراثه الثقافيّ ومكتباته العلميّة ومساجده؟ كلّا، لم يفعلوا شيئاً من ذلك؛ لأنّهم كما يقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾، فهو يعجبك بجميل كلامه، ويستميلك ببريق معانيه، وهو يؤكّد كلامه بإشهاد الله على ما في قلبه، وأنّه صادق كلّ الصدق، وعامل بما يقول، لكنّه ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾.
كلام «غوستاف لوبون» (Gustave Le Bon)
كتب المذكور، مؤخّراً، كتاباً بعنوان «مدنيّة الإسلام والعرب»، وعقد فيه فصلاً بحث فيه أسباب عزوف الشعوب الشرقيّة عن المدنيّة المعاصرة، ذكر منها:
1. عدم توافُق الوضع الحياتيّ للأُمم الشرقيّة مع حياة الأُمم الغربيّة؛ فإنّ الثانية تحيا حياةً بسيطة وعاديّة، أمّا نحن الشرقيّين، فنأخذ في حياتنا بما توصّلنا إليه من اكتشافات واختراعات؛ أي إنّنا نصبغ حياتنا بما وصلت إليه مدنيّتنا، ونكيّف وضعنا على ذلك، لا على الوضع الغربيّ.
2. المظالم الّتي يمارسها الغرب دوماً تجاه الشعوب والبلاد الشرقيّة، والأضرار الّتي يُلحقها بها في الأنفس والأموال.
ثمّ يذكر ما فعلته أيديهم في أمريكا والصين والهند، خصوصاً قضيّة ترويج بريطانيا لمادّة الأفيون في أوساط الشعب الصينيّ؛ لإحكام القبضة عليهم، ومقاومة ساسة الصين لذلك، واندلاع الحرب بين الطرفَين، وكيف أنّ الإنكليز صبّوا نيران مدافعهم وحمم قنابلهم على رؤوس الشعب الصينيّ، حتّى أجبروهم على قبول الأفيون وتصديره إليهم؛ وحصيلة ذلك، هلاك ستّمئة ألف صينيّ سنويّاً، في حين لا تُغرّم بريطانيا سوى خمسة عشر مليون جنيهاً سنويّاً، تُدفَع كفائدة للحكومة الصينيّة. وفي خضمّ هذه الأحداث، يرسل الإنكليز مبشّريهم إلى الشعب الصينيّ، فيتساءل الصينيّون بدهشة وحيرة: واعجباً! تروّجون الأفيون وتفسدون الشباب وتهلكونهم، ثمّ ترسلون مَن يدعونا للأخلاق والإيمان!
طريقان لجهاد النفس
لا يمكن أن تتجذّر الأخلاق إلّا بفناء «النفس» وذوبان «الأنا»، لكن لا بالمعنى المعروف عند مرتاضي الهند ومتصوّفة الإسلام، وهو سحق النفس وإعدامها وكأنّها لم تكن؛ فإنّ الإسلام كمنهج للحياة وروح للإحياء، يرفض هذا الجهاد، بل هذه إبادة واستئصال، لا جهاد. هذا طريق.
والطريق الآخر عبارة عن توسعة هذه النفس وانفتاحها على الآخرين، وإعطائها أبعاداً لا حدود لها من الحبّ والشفقة والعدل ونحوها، حيث ينطوي فيها العالَم الأكبر. شعر:
أنا مبتهج جدّاً بهذا العالَم؛ لأنّه من ذلك المحبوب
عاشقٌ أنا للعالَم كلّه؛ لأنّه كلّه فيضٌ منه
بعبارة أخرى، الجهاد الأمثل هو الجهاد الإيجابيّ، الّذي يهذّب «النفس» ويسلك بها المحجّة البيضاء، وهذا يكون عبر توسعة دائرتها؛ لتكون ذات شعاع لا نهاية له، يغمر الموجودات. لذلك، نلاحظ أنّ الإسلام كما يحثّ على جهاد النفس، كذلك في الوقت نفسه، يُوجِب حفظ حقوقها والدفاع عنها، لكنّ المراد هو «النفس الفاضلة» الّتي لا تصدر عنها رذائل، فلا ضير في الدفاع عن هذه النفس بالحقّ. قال تعالى: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾.
وتوسعة النفس بهذا المعنى، تعني أنّ الأخلاق، في نظر الإسلام، لا يحدّها حدٌّ من أرض وعرق ودين، فهي سواء للمسلمين وغيرهم، فكما لا يجوز الاعتداء على المسلمين، كذلك لا يجوز على غيرهم. وأمّا المجازاة -وهي غير التجاوز- فتُطَبَّق على جميع الناس، دون استثناء، كلّ بحسبه، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا﴾. فالحقّ يعلو على النفس والأُمّ والأب وغيرهم، ولا يعلوه شيء.
حين دخل المسلمون مكّة المكرّمة، مكّة الّتي كسر أهلُها رباعيّة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وأدموه، مكّة الّتي طرد أهلُها الرسول وأصحابه بعد أن أذاقوهم سوء العذاب، لكن يأتي الوحي بهذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾؛ يعني لا تخرجكم عداوة القوم لكم عن حدود العدل؛ بحجّة الانتقام وأنّهم مشركون وأعداء، فإنّ لكلّ شيء أدباً وأخلاقاً، فإن تكن عداوة، فللعداوة أخلاقها وأدبها.
الإمام الحسين (عليه السلام) والأخلاق
وإن حدَت بك الرغبة لأنْ تعيش هذا الجوّ، فعليك بسيرة الإمام الحسين بن عليّ (عليهما السلام). الجميع يعرف الظروف الصعبة الّتي قام فيها الحسين (عليه السلام) بحركته الإصلاحيّة، كان زمانه (عليه السلام) مملوءاً بالظلم، محفوفاً بالتجاوزات السافرة وهدر الحقوق. في ظلّ هذه الأجواء الحالكة السواد، نهض الإمام (عليه السلام). ولكن، هل أثَّر ذلك كلّه في أخلاقه الفاضلة وسجاياه الكريمة؟ هل دعته قسوة العدوّ إلى تبنّي ما يتبنّاه من غدر ونفاق وتلوّن؟ كلّا، وألف كلّا، بل إنّ حصيلة تربيته يأبى ذلك، فكيف به (عليه السلام). فهذا مسلم بن عقيل سفيره إلى أهل الكوفة، رفض رفضاً قاطعاً أن يفتك بابن زياد غدراً، على الرغم من سنوح الفرصة لذلك؛ لأنّ ذلك جُبْنٌ لا شجاعة، ودناءةٌ لا مروءة. ولَمَّا قيل له في ذلك، قال: إنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) قال: «الإِيمَانُ قَيَّدَ الفَتْكَ».
وهذا أبو عبد الله (عليه السلام) يلتقي مع عدوّه في طريقه، وكان جيش العدوّ يعاني العطش وقلّة الماء، فما كان منه (عليه السلام) إلّا أن سقاهم واحداً واحداً، ورشّف الخيل ترشيفاً. ولَمَّا اقتَرح عليه أصحابُه أن يغتنموا الفرصة ويبادروهم القتال، أبى (عليه السلام) ذلك ما لم يبدؤوا هم بالقتال. أجل، هذه هي الأخلاق القائمة على معرفة الله تعالى، أخلاق شامخة لا تنال منها عوادي الدهر ونوائبه، ولا يحدُّ منها حبّ الذات والأهل والجاه.
في يوم عاشوراء، يوم الدم والشهادة، أراد أحدُهم الإغارة على مخيّم أبي عبد الله (عليه السلام) من الخلف، لكنّه فُوجِئَ في عتمة الليل بالخندق المحفور، فثارت ثائرتُه وأخذه الغيظ، فأساء الكلام وتلفَّظ بقبيحه، فقال مسلم بن عوسجة: ائذن لي يابن رسول الله، أن أرميه بسهم، فمنعه الإمام الحسين (عليه السلام)، وقال له: «لَا تَرْمِهِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَهُمْ».
وخلاصة القول: إنَّ مسألة «الأنا» و«النفس» ليس لها حلّ جذريّ إلّا في ظلّ الدين والإيمان بالله تعالى، وإلّا فالحلول أجمع ستذهب أدراج الرياح، ولن تُجدي الأخلاق الشيوعيّة ولا أخلاق «نيتشه» ولا «ميكافيلّي»، لأنّها محدودة وضيّقة الأبعاد، بل هي لا تُعَدُّ نظريّات أخلاقيّة، بل هي ردود أفعال وانعكاسات إفراطيّة لحالات نفسيّة ضمن ظروف خاصّة. ولا يخطرَنَّ ببالكم أبداً إمكانَ تطبيق هذه المفاهيم الّتي ينادون بها -من عدل وإنسانيّة واستقامة وغيرها- كما ينبغي، من دون الاعتماد فيها على معرفة الله تعالى؛ لأنّهما متلازمان، بل إنَّ أحد الأدلّة على ديمومة الحاجة إلى الله تعالى، والإيمان به هو حاجة البشريّة للأخلاق،؛ فما دامت موجودة فهي بحاجة إليها، بحاجة إلى قوامها، وهو الله تعالى؛ لأنّه هو مبدأ كلّ شيء، وإليه ينتهي كلّ شيء، وكلّ شيء لا يتّصل به فهو منقطع الأوّل والآخر، يقول تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.
فالقول الحقّ والكلمة الطيّبة متجذّران في فطرة الإنسان ووجدانه، كتجذُّر الشجرة الباسقة في الأرض الصلبة، تؤتي ثمارها كلّ فصل، فكلّ فصولها ربيع. أمّا زخرف القول وباطل الكلام، فهو مهما ظهر بمظهر الحقّ والعلم، ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ﴾، فكما أنّ الشجرة الّتي لا أصل لها متزلزلة، كذلك باطل الكلام، كسراب بِقِيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (12)
معرفة الإنسان في القرآن (12)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
حسين حسن آل جامع
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

ليلة الجرح
-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)
-

شهر الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
-
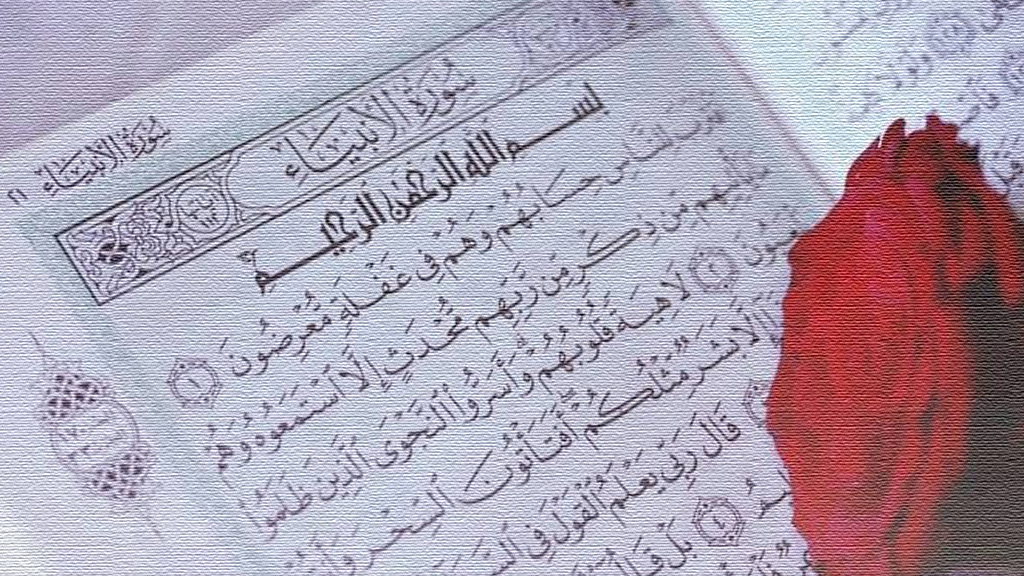
معرفة الإنسان في القرآن (12)
-

شرح دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة
-

دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
-

إصداران تربويّان لصلة العطاء لترسيخ ثقافة النّعمة وحفظها










