علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الآخَريّة النّاقصة؛ حين الغربُ لا يرى إلا نفسه
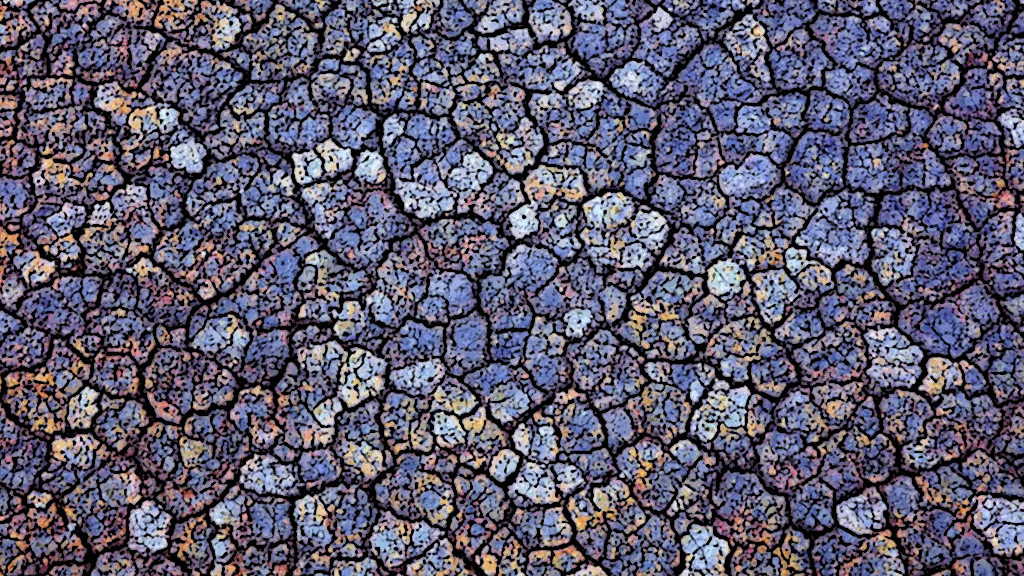
لم تأخذ الذاتيَّة والآخَريَّة كل هذا الجدل، لو لم تتحوَّل في التفكير الغربي إلى عقدة “نفس ـ حضاريَّة” بات شفاؤها أدنى إلى مستحيل. ما يجعل الحال على هذه الدرجة من الاستعصاء أنَّ العقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه، كان يعمل في الغالب الأعم على خطّ موازٍ مع السلطة الكولونياليَّة، ليعيدا معاً إنتاج أيديولوجيا كونيَّة تنفي الآخر وتستعلي عليه.
إنَّها معضلة الهويَّة التي تسلَّلت إلى روح الحداثة، فأمسكت بها ولـمَّا تفارقها قط. يظهر لنا ذلك في اضطرابها المزمن أمام عالم متعدِّد الأديان والثقافات والأعراق. فلقد تشكّلت رؤية الغرب للغير على النظر إلى كل تنوّع حضاري باعتباره اختلافاً جوهرياً مع ذاته الحضاريَّة. ولم تكن التجربة الاستعماريَّة المديدة سوى حاصل رؤية فلسفيَّة تمجّد الذات وتُدني من قيمة الآخر. من أجل ذلك سنرى كيف سينشئ فلاسفة الحداثة وعلماؤها أساساً علمياً وفلسفياً لشرعنة الهيمنة على الغير بذريعة “تحضيره” وإدخاله قسراً تحت سطوتها.
ولكي نقترب من مقصدنا، سنمضي إلى معاينة إجماليَّة لما ظهر من تنظيرات الحداثة الغربيَّة وهي تُفرِطُ في تقديس ذاتها: مبتدأ المشكلة ظهرت مع الكوجيتو الديكارتي الذي أسَّس للحداثة بنيانها الفلسفي وهندستها المعرفيَّة. ثم كان لها أن تمتدّ إلى الكانطيَّة بقديمها وجديدها، ولم تنتهِ إلى يومنا هذا. الحداثات التي قامت أصلاً على الفرديَّة والنسبيَّة والشكّ المعرفي ظلت أسيرة أنانيتها الفظّة. ربما لهذا السبب وغيره، سيفقد الكوجيتو براءته، ثم لينتج بعدئذٍ عن طريق وَرَثَته من مفكري ما بعد الحداثة ثقافة الإقصاء والاستلاب والاستعلاء على الآخر. وأمَّا الذين نقدوا تهافت الكوجيتو فقد بيَّنوا ذلك بالحجَّة الدامغة: قالوا إنّ الـ “أنا” موجود (ergo sum) التي تلي “الأنا أفكر” (Co gito) تعبّر عن شخص “أو كيان” يريد أن يظهر نفسه بالتفكير والكينونة بمعزل عن الخالق. ولكونه عجز عن فعل هذا الفعل، فقد حُرِمَ معرفة نفسه مثلما حُرِمَ تجلّي الخالق في نفسه. وكانت النتيجة: استبدادٌ واستعداءٌ لكل مغاير أو مختلف، وخصومة لجميع ما لا يدخل تحت وصاية الأنا وسلطانها. هكذا يشكِّل الكوجيتو الديكارتي انعطافة انطولوجيَّة ومعرفيَّة نحو الأنا لنصبح بإزاء أنانيتين نشأتا كتوأم لا انفصام له: أنانيَّة ضدّ الخالق وأنانيَّة ضدّ المخلوق. وأما الأثر المترتِّب عليهما معاً، فهو ظهور ليبراليَّة حادَّة ذات نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في غاية الأنانيَّة.
المآل الذي انتهت إليه “ذاتيات” الحداثة كانت فقدان العقل دوره في تحكيم البديهيات الأخلاقيَّة، وعدم قبول أي شيء معياري خارج التحكيم الشخصي. هذا ما يصِفُه الفيلسوف الكندي المعاصر تشارلز تايلور بـ “إيديولوجيَّة انشراح الذات” (epannouissement de soi)، حيث بلغ اكتفاء “الأنا” بذاتها درجات الذروة.
تلقاء هذا لا يعود مستغرباً ذاك المشهد الذي تُختزل فيه الحضارة الغربيَّة بالعناصر الدنيويَّة المحض. الأمر الذي كشفت عنه فردانيَّة صمّاء شكَّلت السبب الحاسم للانحطاط الراهن للغرب، وباتت ـ بحسب الفرنسي رينيه غينون ـ المحرّك الحصري للإمكانيات السفلى للإنسانيَّة، والتي لا يمكنها أن تنتشر بصورة كاملة إلا بتغييب البعد المتسامي للإنسان. وما ذلك كله إلا لأن مثل هذا الصنف من الفردانيَّة يقع على الطرف النقيض لأي غيريَّة روحانيَّة وأي عقلانيَّة حقيقيَّة.
لقد عُدَّتِ الحضارةُ الغربيَّة في المخطَّط الأساسي للتاريخ وفي الإيديولوجيّات الحديثة، وحتى في معظم فلسفاتِ التاريخ بوصف كونها الحضارة الأخيرة والمطلقة. أي تلك التي يجب أن تعمّ العالم كلّه، وأنْ يدخلَ فيها البشر جميعاً. في فلسفة القرن التاسع عشر يوجد من الشواهد ما يعرب عن الكثير من الشكّ بحقّانيَّة الحداثة ومشروعيتها الحضاريَّة. لكنّ هذه الشواهد ظلَّت غير مرئيَّة بسبب من حجبها أو احتجابها في أقل تقدير. ولذلك فهي لم تترك أثراً في عجلة التاريخ الأوروبي. فلقد بدا من صريح الصورة أنَّ التساؤلات النقديَّة التي أُنجزت في النصف الأول من القرن العشرين، وعلى الرغم من أنّها شكّكت في مطلقيَّة الحضارة الغربيَّة وديمومتها، إلا أنَّها خلت على الإجمال من أيّ إشارة إلى الحضارات الأخرى المنافسة للحضارة الغربيَّة. حتى أن تويبني وشبينغلر حين أعلنا عن اقتراب أجلِ التاريخ الغربيّ وموته، لم يتكلّما عن حضارةٍ أو حضاراتٍ في مواجهة الحضارة الغربيَّة، ولم يكن بإمكانهما بحث موضوع الموجود الحضاري الآخر. ففي نظرهما لا وجود إلا لحضارة واحد حيَّة ناشطة هي حضارة الغرب، وأمَّا الحضارات الأخرى فهي ميّتةٌ وخامدةٌ وساكنة.
حين توصَّل جان بول سارتر إلى قوله المشهور “الآخر هو الجحيم”، لم يكن قوله هذا مجرَّد حكم يصدِرهُ على آخر أراد أن يسلبه حريّته أو علَّةَ وجوده، وإنّما استظهر ما هو مخبوء في أعماق الذات الغربيَّة. إذ لا موضع ـ حسب سارتر ـ للحديث عن محبَّة أو مشاركة أو تآزر بين الذوات، لأن حضور الذات أمام الغير هو بمثابة سقوط أصلي، ولأن الخطيئة الأولى ـ حسب ظنّه ـ ليست سوى ظهوري في عالم وُجِدَ فيه الآخرون..”
ولأن غيريَّة الغرب هي غيريَّة مشحونةٌ بالخوف على الذات من الآخر إلى هذا الحد، فلن تكون في مثل هذه الحال سوى إعراب بيِّن عن ظاهرة هيستيريَّة لا تقوم قيامتها إلا بمحو الآخر أو إفنائه. سواء كان محواً رمزياً، أو عبر حروب إبادة للغير لا هوادة فيها.
لقد كان التفكير العنصري جزءاً لا يتجزّأ من العلم وفلسفة التنوير. ولم تكن عادة تصنيف الآخرين إلى فئات “طبيعيَّة”، وبالطريقة نفسها التي صنّفت فيها الطبيعة، سوى مظهر من مظاهر “التراث التنويري”. جمعٌ من فلاسفة وعلماء الطبيعة في القرن الثامن عشر من كارل فون لينيه kARL VON LINNE إلى هيغل، سوف يسهمون في وضع تصنيف هَرَمي للجماعات البشريَّة. الشيء الذي كان له عظيم الأثر في تحويل نظريَّة النشوء والارتقاء الداروينيَّة على سبيل المثال إلى فلسفة عنصريَّة في مطالع القرن الحادي والعشرين. أمّا أحد أكثر تصنيفات المجتمعات الإنسانيَّة ديمومة، والتي تمتدّ جذورها إلى اليوم، فهي ما تمثّله ملحمة الاستشراق التي ولدت كترجمة صارخة لغيريَّة لم تشأ أن ترى إلى الغير سوى موجودات مشوبة بالنقص، أو كحقل خصيب لاختباراتها وقسوة أحكامها.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (12)
معرفة الإنسان في القرآن (12)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
حسين حسن آل جامع
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

ليلة الجرح
-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)
-

شهر الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
-
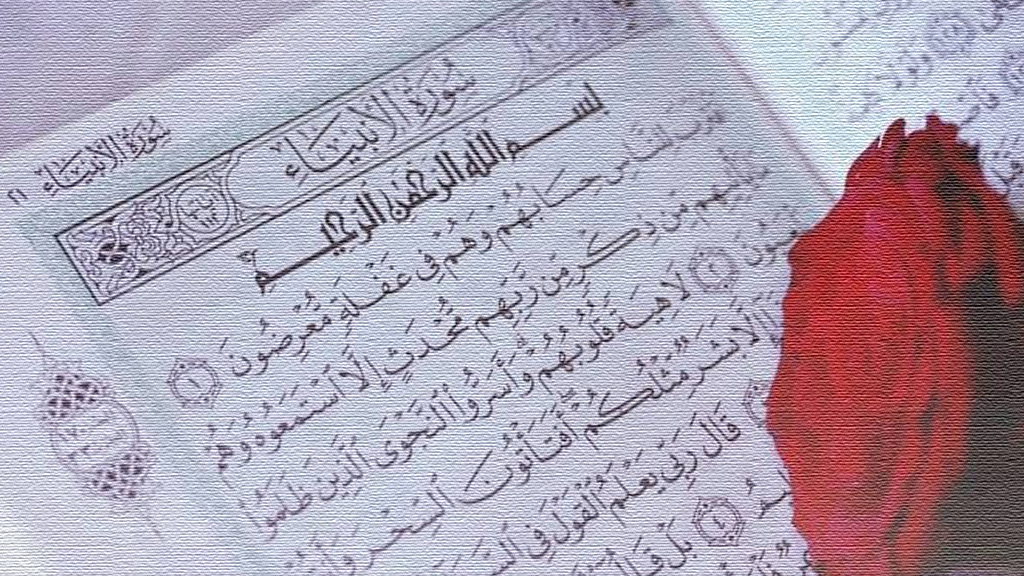
معرفة الإنسان في القرآن (12)
-

شرح دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة
-

دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
-

إصداران تربويّان لصلة العطاء لترسيخ ثقافة النّعمة وحفظها










