علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقلانيّة بما هي ذريعة للاستبداد

غالباً ما يجري تناول العقلانية في التفكير السياسي العربي اليوم، على نحو شديد العمومية والتجريد، ما رتّب أطروحاتٍ ومواقف ومسالك، تنزع في الكثير من الأحيان إلى تسويغ ما يخالف مقاصدها وحقيقتها الواقعية. ولعل في محاكاة الثقافة السياسية العربية الراهنة حيال التحولات الحاصلة، ما يبيّن عمق الاضطراب في التعامل مع المصطلح، لنقرأ بشيء من التأنّي في حقيقة الإشكال.
لقد مضى زمن مديد، بدا فيه أن اللحظة لم تَحِنْ لكي يختلي العقل الغربي بنفسه ويتأمَّل. ثمة مَن يزعم، وفي زعمه اقتراب من حقيقة المشهد في الغرب، أنَّ الحداثة وهي تنجز آخر تقنياتها، لا تنفك تستغرق في غفلتها التي أدَّت بها إليها عقلانيتها ذات البعد الواحد. لم تعد العقلانية ـ كما حملت في نصوص التنوير الغربي ـ صالحة على ما يظهر، للإحاطة بما صار يعرف اليوم بـ"ما بعد الحداثة".
كذلك فإنَّ العقلانية التي نذرت نفسها لاستنقاذ التاريخ من بدائيته، وأوهامه، وفوضاه، دخلت في ما ينافي قيمتها الأصلية. حتى السؤال الذي أنتجته ليعثر لها عن طريقة فضلى لسيادة العقل، ما فتئ أن انقلب عليها. صار سؤالاً استجوابياً في ما يقدمه المشهد العالمي من تغييب لأحكام العقل وقوانينه. كأنَّما انقلبت هي أيضاً، على نفسها، فاستحالت «طوطماً» للخداع والإيهام، بعدما كانت أنجزت فلسفتها «العظمى» في «تأليه» الإنسان.
جرى التنظير الفلسفي لعقلانية الامتداد، مجرى اليقين في غريزة الغرب السياسي. أسس «روحياً» لحملات القوة، وسوَّغ لمقولة استعمار الشرق، فجعلها تاريخاً ممتدّاً لم تنته أحقابه بعد. لقد اعتبرت عقلانية التنوير أنها هي نفسها التاريخ، وهي نفسها البديل للزمان اللاّعقلاني الذي استولد جهالة القرون الوسطى تحت تأثير المؤسسة المسيحية. ومعها أصبح زمن الإنسان أدنى إلى صحراء تيه، لجهة كونه مجرد ما يدوِّنه الإنسان عن تفوّقه وقسوته وفعاليته وجبروته. أي كل ما يكتبه، أو يروي تقدمه.
ولذلك فليس من قبيل التجريد أن يستنتج أيديولوجيو العقلانية الغربية، الأميركية تعييناً، أنَّ فن تكوين الحقائق أهم من امتلاك الحقائق. لقد انبرى هؤلاء لاستدعاء هذه المقولة ورفعها إلى مستوى متعالٍ، فكان من نتيجة ذلك أن آلت بهم إلى ذروة اللاّعقلانية.
بينما هم يدخلون الألف الثالثة على حصان التهديد النووي واحتكار السيطرة المطلقة على العالم. إنَّ الخط الذي انتهت إليه العقلانية الحديثة، من خلال مطابقة العقل الكوني الإنساني بين الواقع والمعقول؛ أي إضفاء العقلانية على المعقول بدلاً من عقلنته، قد دفعت به إلى أن يقبل كشيء معقول عدداً من مظاهر الاستلاب الإنساني. لم يعد العقل مجسداً في الأفعال والأنظمة والعلاقات البشرية.
أو أن يسعى إلى البحث عمّا يحرِّر من الاستلاب، بل أصبح يبرِّر أنواع الاستلاب الموجود. وبدا بوضوح أنَّ ضغط الواقع القائم في المجتمع الإنساني المعاصر، قد دفع إلى أن يتراجع خطوات إلى الوراء عمّا كان قد أعلنه كغاية له في لحظة انبثاقه، وفي مراحل تطوره الأساسية.
لم تعد غاية العقل هي الكشف عن جوانب اللاّمعقول في الواقع، بل غدت هي البحث عن الصيغة التي يمكن بفضلها اعتبار ذلك الواقع مطابقاً للمعقول. لم تعد الغاية هي التجاوز والتنوير والتغيير، بل أصبحت هي التبرير بعينه. وبدل أن يكون العقل الإنساني موجِّهاً للواقع المعاصر له، أصبح خاضعاً لهذا الواقع...
تعبِّر اللاّعقلانية عن نفسها، دائماً، بوسائل عقلانية، ذلك أنَّ عقلنة ما هو غير معقول، أي منح المشروعية لسطوة رأس المال والشركات وامتداداتها، يستلزم تأليف لغة ذرائعية قصدها إضفاء رداء المعقولية على الذي يحدث. لقد اتخذت العقلانية هنا صفة جديدة كل الجدَّة؛ أصبحت بمثابة أيديولوجية تسوِّغ الربط بين الإجراءات والوسائل المتوافرة، وبين ما هو مرسوم من أهداف واستراتيجيات. لعلَّ دولة ما بعد الحداثة (تحتل أميركا نموذجها الصارخ اليوم)، هي أكثر النماذج اهتداءً إلى هذا التحويل الأيديولوجي للعقلانية. عند انتهاء الحرب الباردة، أخذت الليبرالية قسطها الوفير من الراحة لكي تؤدلج انتصارها.
زعم منظِّروها أنها نهاية التاريخ وخاتمته السعيدة. ولقد تسنَّى لهم بوساطة شبكة هائلة من الاتصالات البصرية والسمعية، أن ينتجوا المقدمات الأولى لمعارف ما بعد الحداثة. استطاعت «العقلانية الأميركية» أن «تفلسف» اللاّمعقول الدولي، و«تمفهم» لا توازنيته، وتؤدلج الاستهلاك فتمنحه صفة النظام المقتدر، الآيل إلى إنتاج حقائق معرفية تؤسِّس للديمقراطية الجديدة وحقوق الإنسان.
كان على «عقلانية» ما بعد الحرب الباردة، أن تقطع صلتها بالموروث المفاهيمي لحداثة التنوير. لقد حسمت مقالتها المدعاة بتقريرها أن تداعيات المشهد العالمي «لا تعكس فقط نهاية الحرب الباردة، أو نهاية حقيقة خاصة بعد الحرب، بل نهاية للتاريخ بالذات»، أي نهاية التطور الأيديولوجي للبشرية كلها، وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية كشكل نهائي للسلطة على البشرية جمعاء.
وفي ما يوحي إظهار عقلانيتها، اعترفت الليبرالية بأنَّ انتصارها جرى في مجال الأفكار وهو لـمّا يزل بمعظمه هناك، فلم يكتمل في العالم الواقعي. كأنَّما تريد بهذا أن تؤسِّس لـ «الما بعد» ولـ «ما ينبغي» أن تكون برامجها الميدانية في العالم، لكي تسود الليبرالية سيادة كاملة، مطلقة، تملك خلالها الزمان والكينونة معاً وبلا منازع.
هل تشعر الليبرالية، في زمن «الما بعد العالمي»، أنها بلغت حدود «الجنون» حين جانبت نظام القيم وجعلت العالم كينونة منزوعة الأخلاق؟ ثم هل تجد نفسها واقعة في ما يشبه الخواء المفتوح على اللاّمتناهي؟!
لقد تنبَّهت الوجودية إلى هذا بصورة مبكرة، فأجابت بما يشبه الفانتازيا الفلسفية، حين وجدت أنَّ اللاّعقلانية غالباً ما ترتدي رداء العقل لكي تعيد اكتشاف ذاتها، ثم لتظهر حسنها عارية أمام الملأ. ربما هي تدرك أنَّها مضطرة إلى الهروب من العقل، تحت وطأة المصلحة والدوام وغريزة البقاء.
لكن سيبدو أنَّ لعبة الهرب من العقل إلى الجنون، كأنها عودة إلى العقل بمخيلة أخرى. إنَّ هذه السيرورة التي ستؤول حتماً إلى مآل كهذا، لا بد أن تنتج معرفة على صورتها. معرفة تسعى إلى ملء الخواء، ولو بأيديولوجيات كاذبة بحيث تكون المحصّلة شيوع قناعات واعتقادات كلية، غايتها عقلنة السائد السياسي ونمط حياة المتفوق، وغايتها تأسيس المزيد من القدرة على اكتساح العالم، عبر تحويل التبرير الأيديولوجي إلى مقدس يدخل في ثنايا الوجدان العام للبشرية. بهذا يصير كل ما ومن يسهم في تشكيل وترسيخ هذه الغايات معترفاً به، وعضواً في المشروع العقلاني، وكل ما ومن يعرقله يصير لا عقلانياً أو كائناً لا تاريخياً.
كان مؤلماً للفيلسوف الفرنسي جان فرنسوا ليوتار، أن يقف أمام صورة العالم فيجده على هذا النحو من الخواء والوحشية، فإذا هو يقول: "قد منَحَنا القرنان التاسع عشر والعشرون من الإرهاب قدر ما نتحمل. لقد دفعنا ثمناً باهظاً للحنين للكل وللواحد، للمصالحة بين المفهوم والمحسوس، بين الخبرة الشفّافة والخبرة القابلة للتوصيل.
وتحت المطلب العام للنضوب وللتهدئة، يمكننا أن نسمع دمدمة الرغبة في العودة إلى الإرهاب، في تحقيق الوهم للإمساك بالواقع. والإجابة هي: لنشن حرباً على الكلية Totality، لنكن شهوداً على ما يستعصي على التقديم، لننشط الاختلافات وننقذ شرف الاسم".
كذلك سوف يأتي من الفلاسفة الفرنسيين المابعد حداثيين، من يعيد التأكيد على أنَّ العقلانية وانتقاد العقلانية كلاهما ممارستان تحتاجان إلى العقل كمستند من ناحية، وكخطاب مُضمر أو صريح لكل العلاقات الأخرى، سواء منها المعترفة بسلطان العقل والداعية له، أو المنتقدة لبعض إنتاجه باسم إنتاجات أخرى أتت أو لم تأتِ بعد.
والطريق الذي يقترحه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا والمدعو بـ«التفكيك»، إنَّما هو استراتيجية ممارسة مختلفة تأتي في الوقت الذي تهافتت فيه كل الخطط حسب رأيه، وقيل كل ما يقال، وفُعِلَ ما يمكن أن يُفعَل. فالخطاب المطلق قد أنجز وانتهى سلطانه، وفي هذه اللحظة بالذات يراد لنا أن نقول شيئاً مختلفاً، وأن نعمل العمل المختلف.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (12)
معرفة الإنسان في القرآن (12)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
حسين حسن آل جامع
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

ليلة الجرح
-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)
-

شهر الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
-
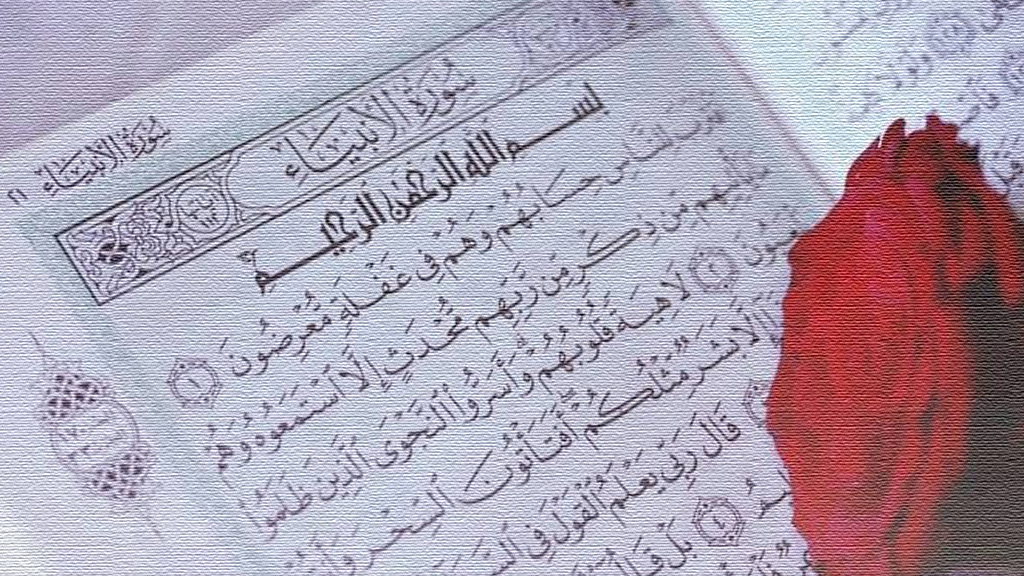
معرفة الإنسان في القرآن (12)
-

شرح دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة
-

دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
-

إصداران تربويّان لصلة العطاء لترسيخ ثقافة النّعمة وحفظها










