علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الحقّ والحقيقة (3)

ولمّا لم تكن وظيفتنا هنا البحث في اللغة الفلسفيّة، أو تعريف الفلسفة عند العلّامة إلّا بمقدار كشفها عن “الحقيقة الفلسفيّة”، فإنّا سنُعرض عن الدخول في الموضوع، لنورد ما أورده (قده) في مجال تبيان خصائص البحث الفلسفيّ، وبالتالي كيفيّة تقييم الحقيقة الفلسفيّة ومعرفتها، وذلك من خلال عرض الخطوات التالية:
أوّلًا: إبراز وتأكيد أنّ “الفلسفة أعم العلوم جميعًا؛ لأنّ موضوعها أعمّ الموضوعات، وهو الموجود الشامل لكلّ شيء”.
ثانيًا: إنّ محمولات الموضوع الفلسفيّ إمّا نفسه، وإمّا أخص منه، لكنها ليست غيره. إذ لا يصح أن ينسب لهذا الموضوع ما ليس منه، بل لا غيره على نحو الحقيقة.
ثالثًا: إنّ مسائله مسوقةٌ على نحو معكوس الحمل، بمعنى أنّنا بدل أن نقول: الوجود إمّا واجب أو ممكن، أو إمّا علّة أو معلول.. وإمّا واجب الوجود أو ممكن الوجود، فنظن أنّ الوجود هو المحمول بسبب هذه الهيئة اللفظية، لكن واقع الأمر أنّ الموضوع حقيقة هو الوجود أو الموجود، وما المحمول إلّا ذاك المعبِّر عن موضوعه الذي ليس إلّا الوجود.
رابعًا: إنّ غاية الفلسفة ذاتيّة مقصودة بنفسها، لأن معرفة الوجود؛ أي حقيقة الحق وواقع الأمر، إنّما هو غاية بذاته وعنها تصدر كلّ غاية.
خامسًا: إنّ معرفة هذه الحقيقة إنّما يتم بالبرهان الذي يوجب موضوع الفلسفة أن يكون من باب انتقال من لازم للازم.
إنّ هذه الخطوات الخمس التي ثبّتها العلّامة (قده) إنّما تؤكّد على كون “الحق” هو “الوجود”، وأنّ “الحقيقة الفلسفيّة” تارة نقصد بها نفس هذا الحق الذي هو الوجود، والذي يطيب للعلّامة أن يسمّيه ببعض الأحيان “بالواقع”. وقد نقصد بالحقيقة الفلسفيّة تارة أخرى نفس معرفة هذا الحق. والمعرفة هنا إنّما هي غاية بذاتها، لأنّها ترتبط بما ترتبط به كلّ ذات وهو الحق. وعليه، وإن لم يذكر العلّامة هذه الغاية المتوخّاة في كتابه نهاية الحكمة، إلّا أنّه في كتابه الآخر بداية الحكمة أعلن أنّ هذا الفن “غايته تمييز للموجودات الحقيقيّة من غيرها، ومعرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلّة الأولى التي تنتهي إليها سلسلة الموجودات، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا”.
إذن، إنّ الغاية هي معرفة أصل الوجود الذي هو الحق ومعرفة لسلسلة معاليل الموجودات، وبالتالي سنن ارتباطها ونشوئها. كما أنّه، وبحسب تعبير العلّامة، معرفة لما تنتهي إليه هذه السلسلة من العلل، وما هي أسماؤه وصفاته العليا؟ وهو التعبير الذي إنّما يُستخدم بغية الحديث حول الله سبحانه وتعالى. وبالتالي، فنحن أمام تجلّيَيْن في لغة الاستخدام الفلسفيّة التي يمارسها العلّامة الطباطبائي، أّولهما: إبراز التواصل والتماهي بين أصل كلّ حقيقة ذاتيّة تتحدّث عنها وفيها الأديان والفلسفات، وهو الحق بما هو الله سبحانه. والتجلّي الآخر هو الفلسفة والحقيقة الفلسفيّة في ممارستها الاكتشافيّة للوجود، أو كما يطيب للعلّامة أن يسمّيه “بالواقع”.
وقبل أن أقفل هذا الجزء من الموضوع، من المفيد استثمار المناسبة بالإشارة إلى كون شرّاح الطباطبائي أكّدوا، وبشكل دائم، إلى بناء تعبيرات فلسفته في موضوع الوجود على مفردة أو اصطلاح “الواقع”. وفي ظنّي، أنّ الواقع بما يعنيه من “الوجود الحق”، إنّما هو تعبير يتماشى مع الجدل الفلسفيّ الذي دخلته المدارس الفلسفيّة الحديثة، من مادّيّة ومثاليّة، وما قالته بعض هذه المدارس من أنّ الواقع هو ما يتم التوافق عليه، أو هو ما ننتجه في مقولاتنا وطروحاتنا عبر مفاهيم ذهنيّة، أو أحكام تمثّل واقع الموضوع، أو الموضوع بعينه.
وهنا تأتي كلمة الواقع والواقعيّة عند العلّامة (قده) لتشير إلى إيمانه بالوجود المادّيّ الخارجيّ، وأنّه مصدر لعالم الخيال الذهنيّ، وحليف الأحكام والمقولات العقليّة، إلّا أنّ هذا الوجود المادّيّ ليس وحده هو الواقع، أو الحق، بل كلّ ما له ذات فعليّة مادّيّة أو مجرّدة هو واقع. عليه، فإنّ متن الواقع أوسع دائرة وانتشارًا من الوجود المادّيّ، لذا، فالحقيقة الفلسفيّة وإن لم يكن بإمكانها التخلّي عن عالم الحس والمادّة، لكنها تتجاوزه نحو متن واقع أوسع وأكثر بساطة وتجرّدًا. ومهمّة الفلسفة في معرفة الحقيقة الفلسفيّة هي (درك هذا الحق)، أو الواقع، أو بحسب تعبير مدرسة الحكمة المتعالية، “الأصيل”.
ومن المعلوم أنّ الأصيل يأتي في قبال الاعتباريّ، ويُحمل السؤال التالي على مهمّة الفلسفة: لمن الأصالة للوجود أو الماهية؟ إذ بعد أن تقرّر الفلسفة أنّ الحق أو العين الخارجيّة واحدة، وأن العقل يدركها بثنائيّة مركّبة من اثنين هما: الوجود والماهيّة، فإنّ البحث – حسب الحكمة المتعالية – يجري حول أيّهما الأصيل، وأيّهما الاعتباريّ؟ ولما تقرّر في فلسفة الحكمة المتعالية أنّ الوجود هو الأصيل، بمعنى أنّ المتقرِّر خارجًا، أو المجعول من العلّة الأولى الذي يوفّر الفعل أو التفاعل والتأثّر والتأثير هو الوجود. فإنّ الحق بمعنى الذات الإمكانيّة هو رديف مصطلح الوجود، وهو كصنوه يصدق على الوجود الواجب أنّه عين الوجود وأنّه الحق سبحانه. ومنه يصدق الوجود والحق على كلّ مجعول وموجود. أمّا الماهيّة فهي ما يقابل الوجود، وهي الاعتبار الذي يقابل الحق.
والحقيقة الفلسفيّة إنّما هي انعكاس للكشف عن هذا الحق (الواقع).
وعليه، فكلّ مباحث الوجود، في فلسفة العلّامة الطباطبائي، أو الواقع، إنّما هي مباحث حول الحق وخصائص الحقيقة الفلسفيّة. أمّا هذه الحصة الخارجيّة الواحدة التي اعتبرها الملّا صدرا أّنها حاصلة للوجود “بنفس حقيقته الواجبيّة، وبسبب مراتبها المختلفة ضعفًا وشدّة، وأضاف إليها قسمًا آخر وهو ما يحصل بسبب الإضافة إلى الماهيات”.
[أمّا عند الطباطبائي]، وتبعه على ذلك الأستاذ، وصرّح بأن التخصّص بسبب الماهيات أمر ينسب إلى الوجود بعرض المهية. وجدير بالذكر أنّ الأستاذ لم يصف حقيقة الوجود بصفة الوجود بخلاف صدر المتألهين، بل الظاهر من كلامه أنّ المراد بها الواقعيّة المطلقة الشاملة للواجب والممكنات[1].
وليس هذا الحق إلّا الحقيقة الواحدة القابلة لأن ننتزع منها مراتب وحصص متكثّرة في عين أنّها واحدة. وعن هذه الوحدة الكثيرة المنتزعات، قامت في الفلسفة الباحثة عن الحقيقة الفلسفيّة مسائل من مثل الاشتراك المعنويّ، والوجود التشكيكيّ أو الشخصيّ، ومراتب الوجود، والعلّة والمعلول… وغير ذلك من الأمور العامّة التي أثّرت وتماهت مع مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، والمرتبط بأمور المبدإ أو الواحد الحق، أو الواقع المطلق والوجود المطلق…
والمتابع لطبيعة المعالجة المتعلّقة بهذه المباحث، سيجد نفسه أمام تبيان لطبيعة الحقيقة الفلسفيّة وخصائصها، وقبل أن نذكر أمورًا من هذه الطبيعة والخصائص، علينا التأكيد أنّ مبحث الأصالة ولأي شيء تعود، للوجود أو الماهية؟ إنّما تشق طريقها نحو إدراك الفائدة والثمرة من خلاف معرفة الارتباط بين أهمّية الحقيقة الفلسفيّة وعلاقتها الأكيدة بمبحث الأصالة؛ إذ من دون هذا الربط سيبقى الأمر في غاية الإشكاليّة، حول أنّ أيّهما الأصيل: الوجود أو الماهية، نزاع لفظيّ. أو ما هي الثمرة والعبرة من هذه المباحث المطولة؟ إنّ ربط المبحث: الوجود، والماهية بمساره المتعلّق بالحق أو الحقيقة الفلسفيّة هو الكفيل ببيان أهمّية هذه المباحث فلسفيًّا، إذ سنتعرّف من خلالها إلى جملة أمور، منها:
أ. أنّ الحق واحد يتمظهر بمظاهر متعدّدة، هي أشبه بآيات وعلامات تشير إلى وحدته عبر أصالة الوجود بما هو واحد مفهومًا، وإن تعدّدت مصاديقه عينًا. وهذا ما تشير إليه مباحث “أحكام الوجود الكلّيّة” في كتاب نهاية الحكمة، الذي تعرّض فيه إلى كون مفهوم الوجود مشترك معنويّ، بمعنى أنّه واحدٌ في معناه برغم ما يحمل عليه من أمور وماهيات متنوّعة. عليه، فإنّه؛ أي هذا الوجود الواحد؛ إنّما “يراد به نفس الحقيقة العينيّة والذي يُحكى عنها بهذا المفهوم العام”[2].
ب. أنّ هذا الربط بين المباحث الكلّيّة للوجود والحقيقة، سيسمح لنا ببيان الفوارق المقصودة من التشابه اللفظيّ حين استعمال كلمة الحقيقة في الفلسفة؛ لأنّ لفظ الحقيقة قد تُستعمل مرادفة للمهية ومقابلة للوجود. قال الشيخ في إلهيات الشفاء (إنّه من البيّن أنّ لكلّ شيء حقيقة خاصة هي مهيته، ومعلوم أن حقيقة كلّ شيء الخاصّة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات)، وقال تلميذه في التحصيل: (الإنسانيّة في نفسها حقيقة ما، والوجود خارج تلك الحقيقة)، وقد تستعمل مرادفة للوجود العينيّ، وهذا هو المراد بقولهم: (حقيقة الوجود أصيلة دون مفهومه). وقد تستعمل في ألسنة العرفاء في مورد الواجب تبارك وتعالى في مقابل الوجود المجازي الذي ينسبونه إلى الممكنات. كما أنّ القائلين بوحدة الوجود في عين كثرته، قد يستعملون حقيقة الوجود في الوجود الساري في جميع الموجودات سريانًا عينيًّا مشابهًا لسريان مفهوم الجنس في أنواعه سريانًا ذهنيًّا، أو لسريان الكلّيّ الطبيعيّ في أفراده، كما أنّهم قد يخصّون حقيقة الوجود بأعلى مراتبه؛ أعني مرتبة وجود الواجب تبارك وتعالى. وقد يستعمل الحقيقة مرادفة الكُنْه، كما يقال حقيقة الوجود مجهولة؛ أي لا يُدرك الذهن كنهه[3].
هذا المقطع من كلام مصباح اليزدي، يوفّر علينا رفع كثير من إشكالات استخدام مصطلح الحقيقة في كلام أهل (العقليات الإسلاميّة) من أصحاب المدارس الفلسفيّة، أو التوجه العرفانيّ، ولا ضير هنا أن نشير أنّ الاستناد إلى قوله في تحليل موضوعنا يكتسي أهمّيته من كونه فيلسوفًا معاصرًا، وهو رغم تمثيله لمدرسة الصدرائيّة الجديدة، ورغم اعتباره أحد أبرز تلامذة العلّامة الطباطبائي، فإنّ له آراء خاصة في الفلسفة تقرّبه من الاتجاه المشائي في الفلسفة.
وهو في هذا المقطع وجّه النظر إلى الفارق بين البحث في المفهوم، والبحث في العين، فالحقيقة عندما تطلق لدى بعض المدارس الفلسفيّة إنّما يراد بها الماهية، وهم يميّزونها عن الوجود – أي عن الواحديّة في المعنى – حتى إذا ما أرادوا الإلفات إلى العين الخارجيّة قصدوا بذلك الوجود، وهؤلاء على اختلاف في تفسير هذه الحيثيّة، فمنهم من يعيدها إلى الذات الإلهيّة حصرًا، ومنهم من يعيدها إلى الوجود بما هو سارٍ في الموجودات، واحدٌ على تنوّعه، ومنهم من ينسبها؛ أي الحقيقة، إلى الكُنْه، ويعتبر أنّ هناك ترادفًا بينهما، ممّا يعني أنّ الحقيقة وإن انطوت على سريان في عالم الكثرة، إلّا أنّ ذلك لا يخرجها عن واحديتها المكتملة بالواحد الأحد تبارك وتعالى.
لكن ما لا ينبغي إهماله هنا، هو كون هذه الحقيقة أمرٌ لا يُدرك كُنْهه. وهذا ما سيأخذنا إلى العلاقة بين الحقيقة الفلسفيّة والمعرفة، بعد أن كان البحث في البعد الأنطولوجيّ للحقيقة الفلسفيّة.
وقبل أن نقفل هذا الجانب، فإنّ مدارات هذه المباحث ستسمح لنا فهم ارتباط المفهوم بالذهن حينما يقابل الخارج فيكون مُحدِّدًا لذاك الخارج، وهو هنا نصطلح عليه بالماهّية، أو بالماهيات (بالجمع). لنعتبر أنّ الخارج هو مستوطن الحقيقة الذي نسمّيه الحق… بل إّننا لو نظرنا للوجود الذهنيّ خارج مقابلته للعين الخارجيّة، وتعاطينا معه كخارج، صار هو أيضًا حق؛ بمعنى وجود، وهذا ما يسمح لمداركنا التمييز بين الحق بما هو هو، وبينه بما هو أمرٌ أصيل تعبِّر عنه الحقيقة الفلسفيّة – حسب مدرسة الصدارئيّة –
ج. إنّ سياقات هذه المباحث تسمح بالقول: إنّ خاصّيّة هذه الحقيقة هي البساطة؛ بمعنى عدم التركّب، وما مبحث التركّب إلّا بهدف يعود لطبيعة تفاعل الإدراك الذهنيّ مع القضايا والحقائق لفهمها. لكن هذا العقل أو الذهن هو نفسه أيضًا قادر وبمستوى أرفع على تجريد هذا التركّب لمعرفة خاصّيّة الوحدة والبساطة.
د. إنّ هذه الجدلية بين ما هو ذهنيّ وخارجيّ، وبين الحق والحقيقة، وبين تنوّع العلاقة بين الوجود والماهيّة، وبين السعي لنيل البساطة من التركّب هي التي تهيء لنا أرضيّة الحديث عن التناسب المؤثّر للحقيقة في نفس الأمر؛ أي عند الحق بما هو تطابق وتماهٍ لا انفكاك فيه بين الواقع، والتعبير عنه بشكل سليم يمنع كلّ وجوه السفسطة.
هـ. إنّ الوجود الحق، أو حقيقة الوجود قائمة بذاتها ولا شيء أو سبب وراءها، بل كلّ ما عداها إمّا مرتبط بها يعود إليها، أو هو وهم وفراغ.
و. إنّ فلسفة العلّامة الطباطبائي إنّما تتبنّى في وحدة الوجود، الوحدة التشكيكيّة لا الشخصيّة، بمعنى أنّ الحقيقة الفلسفيّة إنّما تتبدّى وتكشف عن نفسها واحدة في عين الكثرة. ومن هنا، أقرّت فلسفته (قده) بالواقع بمراتبه المادّيّة وما وفوقها. ممّا سمح له أن يسمّي فلسفته بالواقعيّة. وقد أطلق بهذا الصدد اسمًا لكتاب شرحه المطهري (قده) في تبيان موقع الفلسفة الإسلاميّة من المادّيّة الجدليّة، وبعض المدارس الفلسفيّة المعرفيّة، أسماه أسس الفلسفة والمنهج الواقعيّ. وإذا أردنا تحديد الفائدة المرجوّة من مضمون “الوحدة التشكيكيّة”، فهي في الإجابة عن سبب تشخّص العين في الحقيقة الفلسفيّة، التي تجاوزت القول بأنّ التشخّص الماهويّ يكون بالعوارض، وهذا بما أنّه مدعاةٌ للاستهجان؛ إذ العوارض في أنفسها ماهيات كلّيّة، فكيف يتشخّص كلّيٌّ بكلّيٌّ آخر؟ الأمر الذي دفع مدرسة (أصالة الوجود) للقول: إنّ التشخّص للكلّيّ الطبيعيّ إنّما يكون بالوجود، فصار الحديث حول الوجود بذاته، والوجود بمراتبه، والوجود بما هو مشخِّص للماهيات. ممّا يعطي للوجود حقيقة واحدة تتنوع بتنوعات شتى.. وهذا ما عبَّر عنه العلّامة بالقول: إنّ للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصّصًا بحقيقته العينيّة البسيطة، وتخصّصًا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، وتخصّصًا بالماهيات المنبعثة عنه المحدِّدة له. ومن المعلوم أّن التخصّص بأحد الوجهين الأوّلين مما يلحقه بالذات، وبالوجه الثالث أمرٌ يعرضه بعرض الماهيات[4].
والملفت، قبل أن نطوي مبحث الحقيقة الفلسفيّة عند فلاسفة ومفكّري “الحكمة المتعالية”، بمن فيهم العلّامة الطباطبائي، أمور ثلاث:
الأمر الأوّل: إنّ هذه الفلسفة لا يقع فيها أي مكان للعدميّة، وبالتالي للعبثيّة. فالعدم لا شيئيّة له، وبالتالي فلا أحكام خاصّة ترتبط بالعدم؛ إذ مقتضى وجود أحكام أنّ يكون هناك ذات ما للموضوع، وطالما أنّه لا ذات للعدم، فلا أحكام خاصّة به، بل إنّ العدم أو العدميّة إذا ما طرحنا في حقّها أي حكم فهو بسبب المقابلة بينها وبين الوجود، أو من باب إضافتها للوجود، لذا ورد: “الملكة وعدمها”، أو أنّ “عدم العلّة علّة لعدم المعلول”، فهي أمور نربطها بالوجود حتّى يكون لها نحو من التصريح بالكلام.
لكن هنا، من المفيد الإلفات أنّ مفهوم أو فكرة العدم بما هي أمرٌ مفهوم ذهنيّ، فهو وإن كان يتمّ عبر تصور وجود مفهوميّ للعدم، إلّا أنّه يسمح لنا بإبجاد ولحاظ الحيثيات والفوارق والتمايزات، التي يصعب على الذهن تقريرها دون العدم، أو مفهوم العدم.
الأمر الثاني: إنّ الحقيقة الفلسفيّة بهذا البعد الأنطولوجيّ – الميتافيزيقيّ، تشكّل قاعدة لصلاحية أي مبحث فلسفيّ، بل ومنطقيّ؛ لأن أيّ فلسفة أو منطق لا يقوم على أصالة الحقيقة، لا يمكن تصور منظومة أو أطروحة فلسفيّة ممكنة بحقه.
عليه، فلو توسّعنا في طبيعة المبحث الفلسفيّ للحقيقة الفلسفيّة بما يلحظ تطورات الفكر والفلسفة، بل والعلم، فإنّ بإمكان التوفّر على إنشاء قاعدة أو أرضيّة مشتركة لعموم مباحث المدارس الفلسفيّة، والفلسفة اليوم هي بأمس الحاجة لتعيش مناخًا من التقارب، بعيدًا عن هذا الاغتراب الذهنيّ والثقافيّ الذي تعيشه المدارس والاتجاهات الفلسفيّة عن بعضها، ونفس كلام العلّامة الطباطبائي وطلّابه من فلاسفة (الصدرائيّة الجديدة)، لطالما أشاروا إلى أنّ محوريّة أصالة الوجود تعفينا من الاعتناء الفلسفيّ بمستويات عديدة من مسائل ومقولات مباحث الماهيّة. وكما هو معلوم، فإنّ إجراء أي تخلخل في هيكليّة نظام ما، فإنّه يفتح الطريق لمثل هذه الممارسة حسب ما يلزم وما يقتضي إعادة ترميم أو ترتيب النظام؛ وبمعنًى آخر، فإنّ الأرضيّة لإجراء فعل نقديّ في أنساق وهيكليّة النظام الفلسفيّ الإسلاميّ القائم هو أمرٌ ممكن، إذا ما انطلقنا من محوريّة الحقيقة الفلسفيّة باعتبارها غاية لموضوع هو: عين الحق. وما ينبغي علينا التأكيد عليه أنّ كثيرًا من المسائل الفلسفيّة التي ضمّتها المتون الفلسفيّة، لم تعد تستجيب للأسئلة الفلسفيّة الكبرى بلغة الزمن الراهن والاحتياجات المعاصرة. من هنا، فإنّ التركيز حول محوريّة الحق والحقيقة الفلسفيّة كأصل، وأنّ ما سواها أمور اعتباريّة، قد يشجعنا على التجديد والاجتهاد الفلسفيّ في معالجة خارطة البحث الفلسفيّ، إن من حيث الشكل، أو من حيث المضمون.
الأمر الثالث: إلى هنا، كنا نقوم بدراسة الحقيقة الفلسفيّة في بيئتها الأنطولوجيّة؛ وهي بيئة تفسح لنا الدخول إلى ميادين مختلفة من المستويات والأصناف. من ذلك: المستوى المعرفيّ لمبحث الحق والحقيقة، أو المستوى المرتبط بالتأويليّة وعلاقتها بالفهم واللغة، أو المستوى الذي يدخلنا لدائرة دراسة العلوم الإنسانيّة أو العلوم الدينيّة. ولإبراز هذه الفسحة الأنطولوجيّة من مبحث الحق والحقيقة الفلسفيّة، سوف نفرد استكمالات ما عالجه العلّامة الطباطبائي وبعض طلابه في هذا الشأن. لما يحقّق لنا ذلك اتساعًا في دائرة الانشعاب الفلسفيّ في درس الإشكاليات والأفكار، وهو ما سنحيلة لمناسبات أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العلامة محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، علق عليه: الأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، المجلد الأوّل، الصفحة 50.
[2] المصدر نفسه، الصفحة 22.
[3] المصباح اليزدي، شرح نهاية الحكمة، مصدر سابق، الصفحة 23.
[4] محمد حسين الطباطبائي، أسس الفلسفة والمنهج الواقعيّ، ترجمة: عمار أبو رغيف، قم، دار أم القرى، الصفحة 58.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
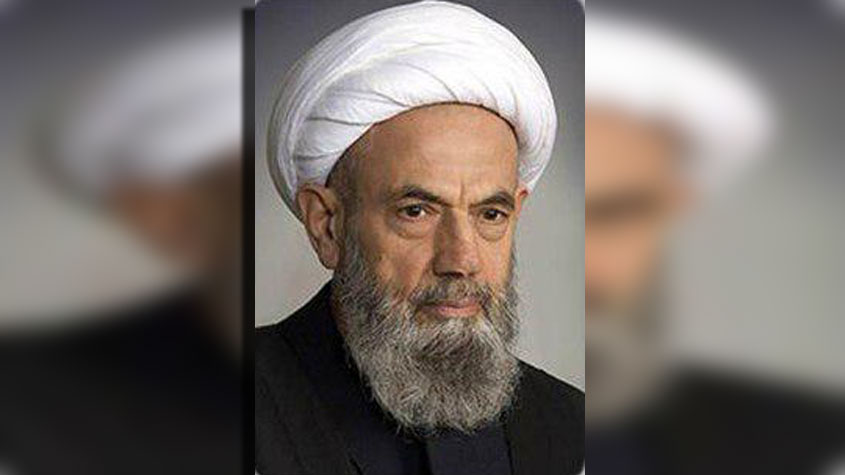 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
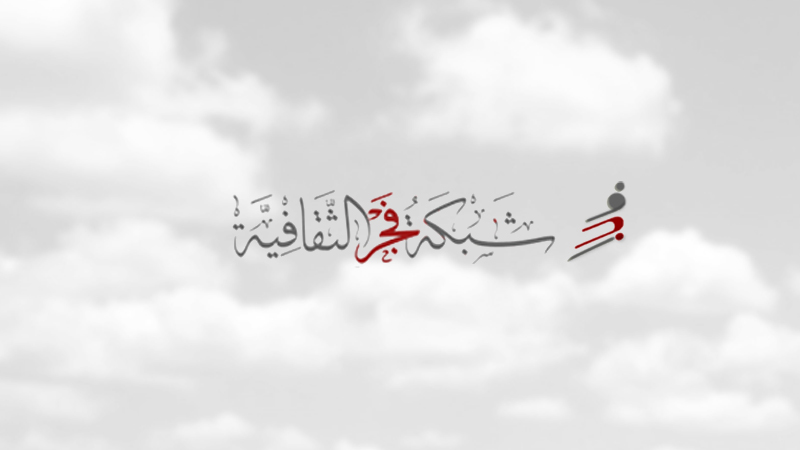 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-
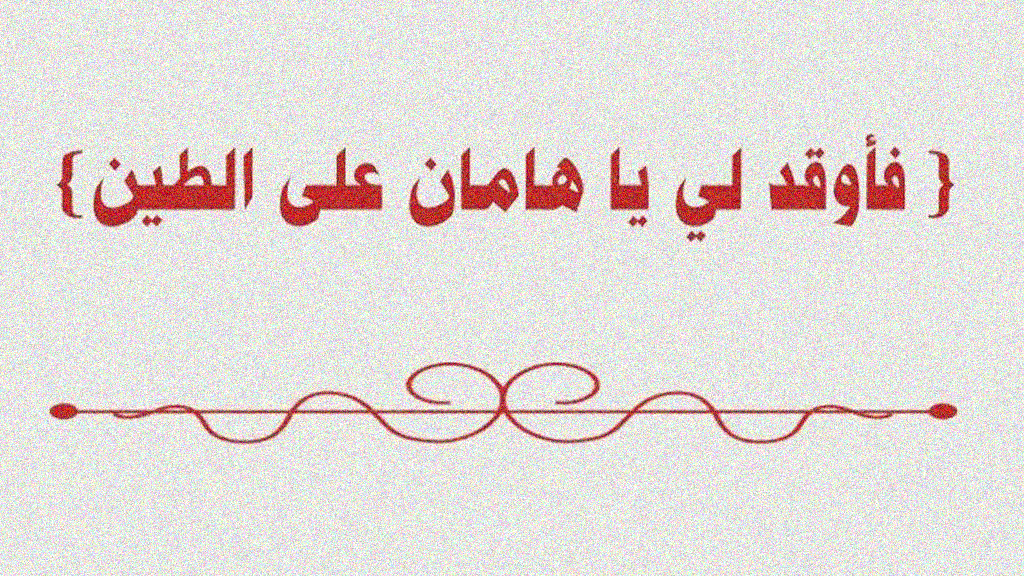
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
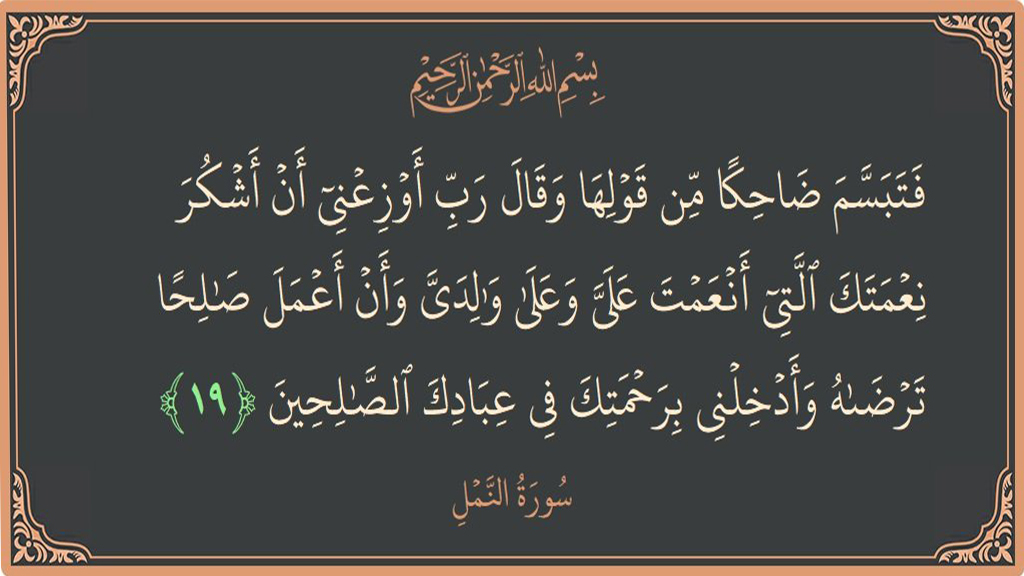
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)










