قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد هادي معرفةعن الكاتب :
ولد عام 1348هـ بمدينة كربلاء المقدّسة، بعد إتمامه دراسته للمرحلة الابتدائية دخل الحوزة العلمية بمدينة كربلاء، فدرس فيها المقدّمات والسطوح. وعلم الأدب والمنطق والعلوم الفلكية والرياضية على بعض أساتذة الحوزة العلمية، عام 1380هـ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف لإتمام دراسته الحوزوية فحضر عند بعض كبار علمائها كالسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة والتحق بالحوزة العلمية هناك وحضر درس الميرزا هاشم الآملي. من مؤلفاته: التمهيد في علوم القرآن، التفسير والمفسِّرون، صيانة القرآن من التحريف، حقوق المرأة في الإسلام.. توفّي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من عام 1427هـ بمدينة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلامالاستدلالُ في القُرآن (1)

الشيخ محمد هادي معرفة ..
مزيج إسلوبين: الخطابة والبرهان وإمتاع العقل والنفس معاً
امتاز القرآن في استدلالاته بالجمع بين أسلوبين متنافيين في شرائطهما، هما: أسلوب الخطابة وأسلوب البرهان. ذاك إقناع للعامة بما يتسالمون به من مقبولات مظنونات وهذا إفهام للخاصّة بما يتصادقون عليه من أوّليات يقينيات..
ومن الممتنع عادةً أن يقوم المتكلّم بإجابة ملتمس كلا الفريقين، ليجمع بين الظن واليقين في خطاب واحد.. الأمر الذي حققه القرآن فعلاً بعجيب بيانه وغريب أسلوبه.
والبرهان: ما تركب من مقدمات يقينية، سواء أكانت ضرورية (بديهية أو فطرية) أم كانت نظرية (منتهية إلى الضروريات). والقضايا الضرورية ستة أنواع:
1ـ الأوليات: وهي قضايا قياساتها معها. يكفي في الجزم بالحكم مجرّد تصور الطرفين، كقولنا: (الكلّ أعظم من الجزء). أو مع تصوّر الواسطة وحضورها في الذهن، كقولنا: (الأربعة زوج) لأنه ينقسم إلى متساويين.
2ـ مشاهدات: هي قضايا محسوسة بالحواسّ الظاهرة كإضاءة الشمس.
3ـ وجدانيات: منشؤها الحسّ الباطني كالإحساس بالخوف والغضب.
4ـ متواترات: أخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب والاختلاق.
5ـ مجربات: يحصل الجزم بالنتيجة على أثر تكرّر المحسوس.
6ـ حدسيات: هي سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. ويقابلها الفكر، الذي هو حركة الذهن نحو المبادئ ثم رجوعه إلى المطالب، فلا بُدّ فيه من حركتين، على خلاف الحدس، إذ لا حركة فيه. لأن الحركة تدريجية، والانتقال آني.
أمّا الخطابة فهي ما تركّب من مقدّمات كانت مقبولة معتقداً بها لأمر سماوي أو لمزيد عقل ودين.
ونظيرها الجدل: المتركّب من قضايا مشهورات تقبّلتها العامة وخضعت لها أعرافهم ونسجت عليها طبائعهم، فألفوها وأذعنوا بها إذعاناً.
أو قضايا مسلمات تسلّم بها المخاطبون كأصول مفروضة مسلم بها.
والقرآن الكريم قد استفاد في دلائله من كل هذه الأساليب، وفي الأكثر جمع بينها في خطاب مع العامة يشترك معهم الخواّص.
هذا غاية في القدرة على الاستدلال وإقامة البرهان..
ولنضرب لذلك أمثلة:
1ـ قال تعالى ـ بصدد نفي آلهة غير الله ـ: (لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا) (الأنبياء: 22).
هذه الآية ـ بهذا النمط من الاستدلال ـ في ظاهرها البدائي احتجاج على أساس الخطابة والإقناع، قياساً على العرف المعهود، أن التعدد في مراكز القرار سوف يؤدي إلى فساد الإدارة.. ونظيرها آية أخرى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون) (المؤمنون: 91).
يقول العلامة الطباطبائي: وتقرير الحجّة في الآية، أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد، لكانوا مختلفين ذاتًا، متباينين حقيقة. وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فتتفاسد التدابير، وتفسد السماء والأرض.. (1).
وهذا النمط من الاستدلال، طريقة عقلانية يتسلمها العرف العام قياساً على ما ألفوه في أعرافهم.
ولكن إلى جنب هذا، فهو استدلال برهاني دقيق، قوامه الضرورة واليقين، وليس مجرّد قياس إقناعي صرف.
ذلك أنّ الآية دلّت العقول على أن تعدّد الآلهة، المستجمعة لصفات الألوهية الكاملة، يستدعي إما عدم وجود شيء على الإطلاق، وذلك هو فساد الأشياء حال الإيجاد.. أو أنها إذا وجدت وجدت متفاوتة الطابع متنافرة الجنسيات، الأمر الذي يقضي بفسادها، إثر وجودها وعدم إمكان البقاء.
وذلك لأنه لو توجهت إرادتان مستقلتان من إلهين مستقلين ـ في الخلق والتكوين ـ إلى شيء واحد، يريد أنّ خلقه وتكوينه .. فهذا مما يجعله ممتنع الوجود، لامتناع صدور الواحد إلاّ من الواحد، إذ الأثر الواحد لا يصدر إلاّ مما كان واحداً. ولا تتوارد العلتان على معلول واحد أبداً.
وفرض وجوده عن إرادة أحدهما، مع استوائهما في القدرة والإرادة، فرض ممتنع. لأنه ترجيح من غير مرجح، بل ترجح من غير مرجح، وهو مستحيل.
ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث شيء وأراد الآخر عدم إحداثه! فلو تحققت الإرادتان، كان جمعاً بين النقيضين.. أو غلبت إحداهما الأُخرى، فهذا ينافي الكمال المطلق المفروض في الإلهين.. وإلا فهو ترجيح من غير مرجح.
ولو توجهت إرادة أحدهما إلى إحداث نظام ومخلوق، والأخر إلى نظام ومخلوق غيره.. إذن لذهب كل إله بما خلق .. ولكان هناك نظامان وعالمان مختلفان في الخلق والنظام، وهذا الاختلاف في البنية والنظام يستدعي عدم التآلف والوئام والانسجام، وسوف يؤدّي ذلك إلى تصادم وأن يطغى أحدهما على الآخر ولعلا بعضهم فوق بعض. الأمر الذي يقضي بالتماحق والتفاسد جميعاً..
وكل أولئك باطل بالمشاهدة، إذ نرى العالم قد وجد غير فاسد، وبقي غير فاسد. ونراه بجميع أجزائه، وعلى اختلاف عناصره، وتفاوت أوضاعه، من علوّ وسفل وخير وشّر، يؤدي وظيفة جسم واحد، تتعاون أعضاؤه مع بعضها البعض، وكل عضو يؤدّي وظيفته بانتظام، يؤدي إلى غرض واحد وهدف واحد.. وهذه الوحدة المتماسكة ـ غير المتنافرة ـ في نظام الأفعال، دليل قاطع على الفاعل الواحد المنظم لها بتدبيره الحكيم، وهو الله ربِّ العالمين.
وهذا هو البرهان القائم على قضايا يقينية في بديهة العقل.
وقال تعالى ـ بصدد نفي المثل ـ: (ليس كمثله شيء) (الشورى: 11).
جاءت الدّعوى مشفوعة ببرهان الامتناع، على طريقة الرّمز إلى كبرى القياس.
ذلك أن (المثل) المضاف إليه تعالى، رمز إلى الكمال المطلق، أي الذي بلغ النهاية في الكمال في جميع أوصافه ونعوته. الذي هو مقتضي الألوهية والرّبوبية المطلقة. لأنك إذا حققت معنى الألوهية فقد حققت معنى التقدم على كل شيء والمسيطر على كل شيء (فاطر السماوات والأرض)(2). (له مقاليد السماوات والأرض) (3).
إذن فلو ذهبت تفترض الاثنينية في هذا المجال، وفرضت اثنين يشتركان في هذه الصفات التي هي غايات لجميع الأوصاف والنعوت، فقد نقضت وتناقضت في افتراضك.. ذلك أنك فرضت من كل منهما تقدماً وتأخراً في نفس الوقت، وإن كلاً منهما مُنشئاً ومنُشأً. ومستعلى ومستعلى عليه.. إذ النقطة النهائية من الكمال، لا تحتمل اثنين، لأن النقطة الواحدة لا تنحلّ إلى نقطتين.. وإلا فقد أحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد في الطرفين.. إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً.. فأنى يكون كل منهما إلهاً.. وللإله المثل الأعلى..؟!.
ويرجع تقرير الاستدلال إلى البيان التالي:
إن الإله هو ما استجمع فيه صفات الكمال وبلغ النهاية في الكمال..
ومثل هذا الوصف (مجمع الكمال) لا يقبل تعدّداً لا خارجاً ولا وهماً.
إذن فلا تعدّد في الآله، وليس له فردان متماثلان.
وهذا من أروع الاستدلال على نفي المثيل.
وكلمة (المثل) هذه، تكون إشارة إلى ما حواه المثيل من صفات وسمّات خاصّة تجعله أهلاً لهذا النعت (إيجاباً أو سلباً) في القضية المحكوم بها.
مثلاً لو قيل ـ خطاباً لشخصية بارزة ـ: (أنت لا تبخل) كان ذلك دعوى بلا برهان. أما لو قيل له: (مثلك لا يبخل) فقد قرنت الدعوى بحجتها.. إذ تلك خصائصه ومميّزاته هي التي لا تدعه أن يبخل، فكأنك قلت: (إنك لا تبخل، لأنّك حامل في طيّك صفات ونعوتاً تمنعك من البُخل).
وهكذا جاءت الآية الكريمة:
إن من كان على أوصاف الألوهية الكاملة، فإن هذا الكمال والاستجماع لصفات الكمال، هو الذي يجعل وجود المثيل له ممتنعاً.. (بالبيان المتقدّم).
وعليه، فليست الكاف زائدة، كما زعم البعض. لأن المثل ـ على مفروض البيان ـ إشارة إلى تلك الصفات والسمات التي تحملها الذات المقدسة.. ولم يكن المراد من المثل التشبيه، فهو بمنزلة (هو) محضاً.
فكان المعنى: ليس يُشبه مثله تعالى شيء، أي ليس يشبهه في كمال أوصافه ونعوته شيء.
قال الأستاذ درّاز: الآية لا ترمي نفي الشبيه له تعالى فحسب، إذ كان يكفي لذلك أن يقول: (ليس كالله شيء) أو(ليس مثله شيء). بل ترمي وراء ذلك دعم النفي بما يصلح دليلاً على الدّعوى والإنعات إلى وجه حجّة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي. ألا ترى أنّك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن إنسان، فقلت: (فلان لا يكذب) أو (لا يبخل) كان كلامك هذا مجرّد دعوى لا دليل عليها. أما إذا زدت كلمة المثل وقلت: (مثل فلان لا يكذب) أو (لا يبخل) فكأنك دعمت كلامك بحجة وبرهان، إذ من كان على صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك. لأن وجود هذه الصفات والنعوت ممّا تمنع الاستفسال إلى رذائل الأخلاق. وهذا منهج حكيم وضع عليه أسلوب كلامه تعالى. وأن مثله تعالى ذا الكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكون له شبيه أو أن الوجود لا يتسع لاثنين من جنسه.. (4).
ــــــــــــــ
1) الميزان: ج17، ص267ط/ بيروت.
(2) الأنعام: 14.
(3) الزمر: 63.
(4) راجع: النبأ العظيم: ص128.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 معرفة الإنسان في القرآن (8)
معرفة الإنسان في القرآن (8)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر
-

معنى (ستر) في القرآن الكريم
-

أداء الأمانة والنقد الذاتي في شهر رمضان
-

حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
-
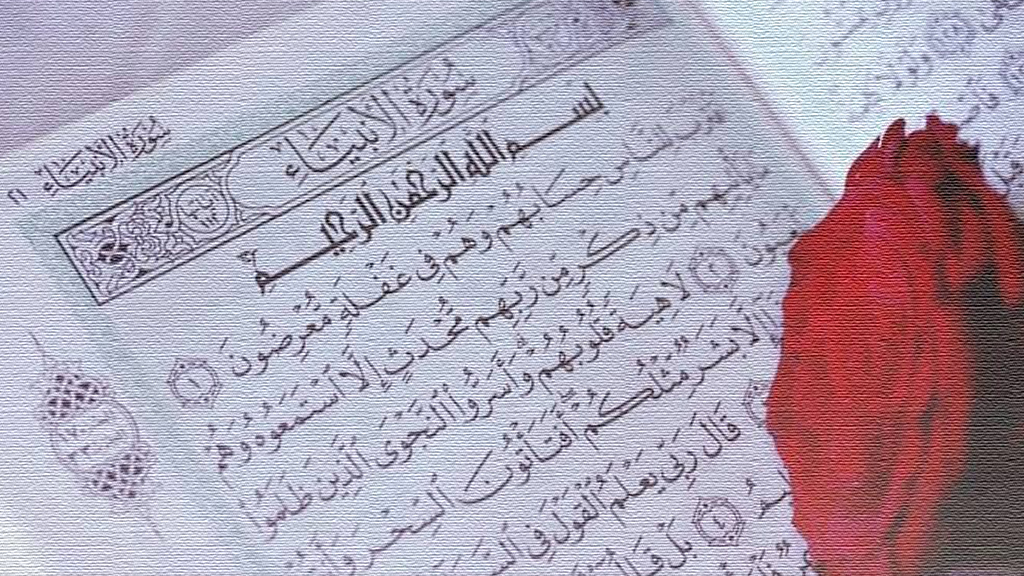
معرفة الإنسان في القرآن (8)
-

شرح دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان
-

خصائص الصيام (2)
-

الإرادة والتوكل في شهر رمضان
-
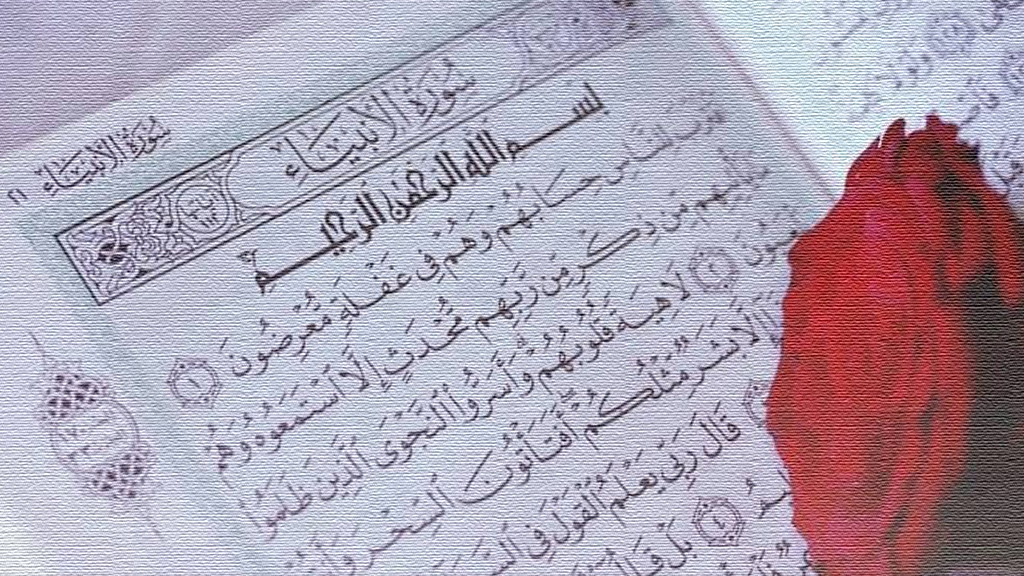
معرفة الإنسان في القرآن (7)
-

شرح دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان










