قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد صنقورعن الكاتب :
عالم دين بحراني ورئيس مركز الهدى للدراسات الإسلاميةعصمة النَّبيّ (ص) فيما يتّخذه من قرار

الشيخ محمد صنقور
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
وقال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾.
أليس هذا دليلٌ على أنَّ الرَّسول ليس معصومًا في القرارات؟ وبالتَّالي ليس معصومًا بمفهوم العصمة المطلقة؟
الثَّابت بمقتضى الدَّليل العقلي القطعي وكذلك النّصوص القطعيَّة الصّدور هو عصمة النَّبيّ (ص) المطلقة وأنَّه معصوم في كلّ ما يصدر عنه، ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ الأنعام/50، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى / إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ النّجم/3-4، ولسنا في المقام بصدد التّفصيل في ذلك.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ التَّوبة/43 فلا يُنافي ما ذكرناه من عصمة النَّبيّ (ص) المُطلقة.
فقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ﴾ التَّوبة/43 سِيق لغرض التّلطّف في الخطاب، وهذا الأسلوب متعارف عند أهل المحاورة، ولا يعبِّر عن ارتكاب المخاطَب لخطأٍ يستوجب الدّعاء له بالعفو عن ذلك الخطأ بل هو دعاء ابتدائي يُساق لغرض التّكريم والتّوطئة الطيبة لبيان المطلوب للمخاطب.
فمساق الآية مساق قولنا لأحدٍ: "حفظك الله ما هو قولك في كذا؟"، أو قولنا: "غفر الله لك متى ستزورنا؟".
وأمَّا قوله تعالى: ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ التَّوبة/43، فهو ليس استفهامًا لغرض العتاب والتَّوبيخ كما توهّم ذلك بعض المفسّرين، وإنَّما الغرض منه بيان واقع المأذون لهم، فهو فضح لحقيقة المأذون لهم وكشف عن نفاقهم وعدم صدقهم. وهذا هو معنى قول الإمام الرّضا (ع) حينما سئل عن معنى الآية الشَّريفة: أنّ الآية سِيقت على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة.
فالخطاب موجّه للرّسول (ص) إلاّ أنّ الغرض منه بيان واقع المأذون لهم للأمَّة وأنّهم غير صادقين في أعذارهم التي اعتذروا بها لطلب الإذن في عدم الخروج إلى الحرب.
فالآية لا تعبّر عن عدم مناسبة الإذن للمصلحة بل إنَّ الإذن لهم كان هو المناسب للمصلحة التَّامّة كما يظهر ذلك من الآيتين السَّابعة والأربعين والثَّامنة والأربعين من نفس السّورة.
﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ / لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾.
التوبة/47-48، فخروجهم كان فيه مفسدة عظيمة على المسلمين، فلو أنّهم خرجوا كما أفادت الآيتان لزادوا المسلمين خبالاً ولأوقَعوا الفتنة في صفوف المسلمين، ولأنَّ في المسلمين من يتأثَّر بما يرجفون به من تضليل وفتنة لذلك كانت المصلحة في عدم خروجهم كما تقرِّر الآية السَّابعة والأربعون.
والآية التي تليها تعبّر عن معرفة النّبي (ص) بواقعهم وأنَّه كانت له معهم تجربة سابقة حين أوقعوا الفتنة بين المسلمين وقلّبوا له الأمور فلم يكن النّبيّ (ص) غافلاً عن واقعهم وسوء أثرهم وما يترتّب على مشاركتهم للمسلمين في الخروج.
إذن فالآيتان تقرِّران صوابية القرار الذي اتّخذه رسول الله (ص) معهم حين أذن لهم بعدم الخروج، وهو ما يؤكد أنَّ الآية التي هي محلّ البحث لم يكن المقصود منها التعبير عن عدم مناسبة الإذن لهم بعدم الخروج. إذ أنَّ قرار الإذن كان هو الأنسب للمصلحة كما أفادت الآيتان الكريمتان.
ثمَّ أنَّ هنا قرينة أخرى تعبّر عن أنّ عدم خروجهم كان هو الأنسب للمصلحة وأنَّ إذنه لهم بعدم الخروج مطابق للإرادة الإلهيَّة، وهذه القرينة هي قوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين: ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ التوبة/46، فانبعاثهم وخروجهم كان مكروهًا لله عزّ وجلّ لذلك خذلهم وثبَّطهم.
وبذلك يتبيَّن أنّ الإذن لهم بعدم الخروج كان مُطابقًا لمقتضى الإرادة الإلهيَّة، وبذلك يتأكّد أنّ الاستفهام لم يكن لغرض العتاب للرّسول على مُخالفة الأولى وإنَّما هو لغرض التّوبيخ والتَّعرية لواقع المنافقين.
فالقرآن الكريم أراد من هذه الآية أن يقول للمسلمين أنَّ الإذن الذي صدر عن الرَّسول (ص) لا يعني إعفاء المستأذنين من المسؤولية وأنَّ العذر الذي قدّموه لم يكن واقعيًّا بل كان كاذبًا، فاستئذانهم لا يُسقط التَّكليف عنهم، وبذلك يكون القرآن الكريم قد كشف زيفهم للمسلمين، إذ أنَّهم قد يُبَرِّرون عدم خروجهم بأنَّ التَّكليف بالخروج ساقط عنهم لإذن النَّبيّ (ص) لهم بعدم الخروج.
والمتحصل مما ذكرناه أن الإذن لهم من قبل النّبيّ (ص) بعدم الخروج كان مناسبًا للمصلحة التَّامَّة، ومطابقًا للإرادة الإلهية كما تبيّن ذلك من الآيات الثَّلاث: الخامسة والأربعين، والسَّابعة والأربعين، والثَّامنة والأربعين، إلاّ أنَّ المسلمين كانوا بحاجة إلى أن يتعرّفوا على واقع المنافقين وإنَّ اعتذارهم واستئذانهم لم يكن صادقًا ولا مُسقطًا للتَّكليف بالخروج لذلك جاءت الآية المباركة محلّ البحث لتبيِّن ذلك.
وخلاصة القول هو أنَّه لا ينبغي فهم الآية المباركة منفصلة عن سياقها.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾التّحريم/1، فليس فيه ما يُعبِّر عن عدم صوابيَّة ما اتّخذه النّبيّ من قرار التّحريم على نفسه، والمراد من التّحريم في المقام ليس هو التّحريم الشّرعيّ وإنّما هو إلزام نفسه بترك شيء بواسطة الحلف، وذلك بقرينة الآية التي تلت الآية المذكورة: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ التّحريم/2، أي التّحلل من اليمين والحلف بواسطة التّكفير.
فالمستظهر من الآية المُباركة أنَّ النَّبيّ (ص) كان قد حلف على ترك شيء مباح إرضاءً لزوجاته، إذ أنَّ ذلك الشَّيء الذي فعله رسول الله (ص) كان مكروهًا عند بعض أزواجه. ولا محذور في أن يحلف الإنسان على ترك شيء مباح خصوصًا إذا كان لغرض عقلائيّ كإرضاء الزَّوجة.
والخطاب وإن كان مُشعرًا بعتاب النّبي (ص) على تحريمه ذلك المباح على نفسه إلا أنَّه واقعًا توبيخٌ لزوجته التي اضطرَّتْهُ لذلك حرصًا منه على تأليفها وحتَّى لا تُفشي ذلك لأنَّ إفشاءه يبعث الحياء في نفس رسول الله (ص) وكان الرّسول (ص) شديد الحياء والذي هو من الإيمان كما هو ثابتٌ قطعًا.
فقد أفادت الرّوايات أنَّ الذي حرَّمه رسول الله على نفسه بالحلف هو معاشرة جاريته التي اطلعت إحدى زوجاته على مُعاشرته لها في منزلها أو أنَّه العسل الذي تناوله فادّعت إحدى زوجاته أنَّ ذلك سبَّبَ انبعاث رائحة غير طيّبة من فمه المُبارك وكان يكره ذلك فحلف أن لا يتناول العسل إرضاءً لها.
فالرَّسول (ص) أراد من حلفه إرضاء زوجته وهو غرض عقلائيّ راجح، فالآية لم يكن غرضها عتاب الرّسول (ص) وإنَّما كان غرضها توبيخ زوجته التي آذته واضطرّته للحلف ثُمّ أفشت سرّه الذي حلف على ترك ذلك الشّيء من أجل أن تكتمه.
والقرينة على ذلك هو ملاحظة الآية الرَّابعة من سورة التَّحريم والآية التي تلتها: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ / عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾التحريم/4-5.
فالقرآن الكريم في هاتين الآيتين ينتصر للرسول (ص) ويُنبّأ زوجتَيه وهما حفصة وعائشة أنَّ الله هو ناصره عليهما إن تظاهرا وتواطئا على إيذائه وكذلك ناصره جبرئيل وصالح المؤمنين وعموم الملائكة.
ثُمَّ أنَّه وبّخهما صريحًا وأفاد بأنَّ الرَّسول (ص) لو أوقع الطَّلاق بهما فإنَّ الله سيبدله بزوجات خيرًا منهما.
وكلّ ذلك يعبّر عن أنَّ التَّوبيخ في الآية الأولى لم يكن موجّهًا للرّسول (ص) وإنَّما كان موجّهًا لزوجتَيه ، فكأنَّ القرآن أراد أن يُسلِّيه ويُطيِّب نفسه ويقول إنَّ مَن حلفتَ لاسترضائها لم تكن تستحقّ منك هذا الاسترضاء.
فمساق الآية هو مساق قولنا لمن أحسن للمسيء: "لمَ أحسنت له؟"، فالاستفهام في هذا المثال ليس عتابًا، إذ أنَّ الإحسان للمسيء أمرٌ راجح، فالغرض من هذا الاستفهام هو بيان أنَّ هذا الإنسان لا يستحقّ الإحسان، فهو توبيخ لمن أحسن إليه وليس إلى المُحسن، فلذلك يفهم المُحسن من الخطاب والاستفهام أنّه تعاطف وليس توبيخًا.
وبما ذكرناه يتّضح أنّ ما فعله رسول الله (ص) كان صائبًا ومُطابقًا للمصلحة التَّامة والإرادة الإلهيَّة وأنَّ الغرض من الاستفهام في الآية المُباركة هو التَّسلية للرّسول (ص) والتَّعبير عن الاستياء من موقف تلك الزّوجة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (12)
معرفة الإنسان في القرآن (12)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
حسين حسن آل جامع
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)
-

شهر الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
-
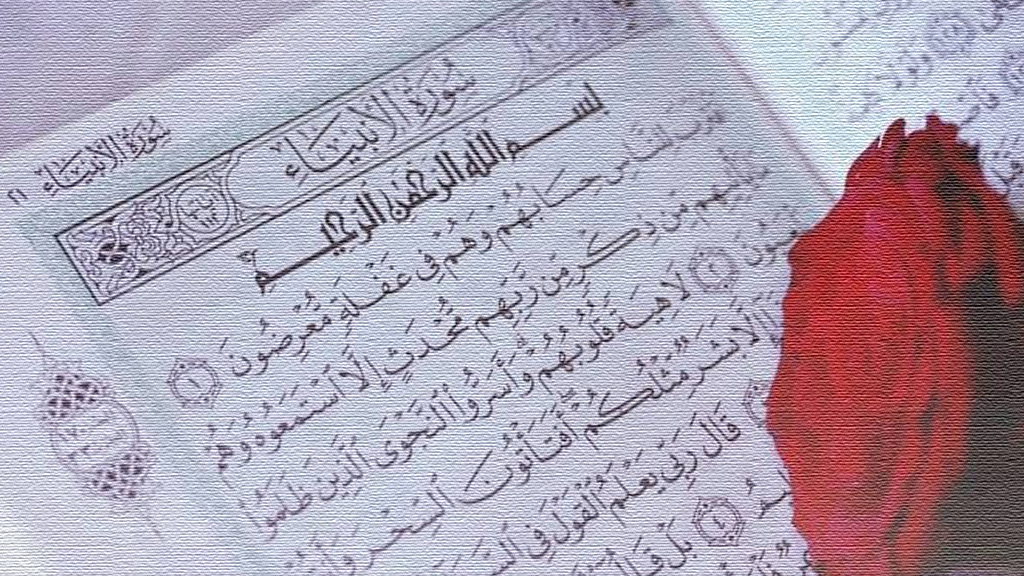
معرفة الإنسان في القرآن (12)
-

شرح دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة
-

دحض جميع الصور النمطية السلبية الشائعة عن المصابين بالتوحد
-

إصداران تربويّان لصلة العطاء لترسيخ ثقافة النّعمة وحفظها
-

الصوم، موعد مع الصبر









