قرآنيات
آيات النجوى في سورة المجادلة

الإمام الخامنئي "دام ظلّه"
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. (الآيات 8 – 10 من سورة المجادلة).
يقول تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أيّ إنّ النجوى التي بينهم والتهامس ليس كلامًا بسيطًا عاديًا يتداولونه فيما بينهم، بل ما يقولونه هو إمّا إثمٌ وذنب، أيّ ما يُعدُّ ذنبًا ضمن علاقة الإنسان مع الله، أو أنّ ما يتناجون به هو عداوة، أيّ يتضمّن عداوةً للمؤمنين أو معصيةً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أيّ إعراضًا عن أمره، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لنمضِ إلى الجهاد! يتناجون فيما بينهم: ألّا تمضوا للجهاد، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنفقوا في سبيل الله! تناجوا كذلك: ألّا تُنفقوا! فمُناجاتهم لها أحد هذه المعاني الثلاثة.
﴿وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ جاء في روايةٍ أنّ اليهود والمنافقين كانوا يدخلون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون عوضًا عن "السلام عليك": "السّام عليك" ، وذكر البعض أنّ "السام" بمعنى الموت، أيّ "الموت لك"، لكنّ "السام" كما حقّقنا ليس بمعنى الموت، بل هو بمعنى الإعراض والنأي، وكانوا يُريدون بذلك القول للمسلمين: أعرضوا بأسرع وجهٍ عمّا أنتم عليه، وعن العقيدة التي تؤمنون بها والنهج الذي تنتهجونه. طبعًا إذا اعتبرنا "السّام" بمعنى الموت فينبغي أن يكون بمعنى الإعراض عن الحياة، لا مُطلق الإعراض.
ويمكن أيضًا أن يكون مرادهم حقيقةً الإعراض عن الحياة، لأنّ اليهود كانوا قومًا خُبثاء ويُلحِقون الأذى. كانوا يدخلون مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون بحدّة: "السّام عليك"، من دون أن يلفظوا لام "السلام". وكم كانوا سعداء بفعلتهم تلك، وكم كانوا يتضاحكون في الخفاء لأنّهم وجّهوا هذه الشتيمة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخدعوا المسلمين بأنّهم يلقون عليهم السلام، وهكذا كان المنافقون أيضًا.
القرآن يفضح هذه الأفعال ويقول ﴿وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ وقد كانوا يقولون هذا بسخريةٍ وتحدٍّ أنْ: لنرَ! فليعذبنا الله! بما أنّ المسلمين يقولون إنّ الله يعلم كلّ شيء، وإنّ الرسول مطّلعٌ على كلّ الأمور، فها نحن نشتمه ونُسيء له في القول فـ ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾.
يقول تعالى في الردّ عليهم ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ فإن كانوا يظنون أنّ العذاب الذي قدّره الله لهم - وهو جهنّم - قليلٌ عليهم، إذ يقولون ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ فإنّ جهنّم التي أعدّها الله لهم هي حسبهم من العذاب. وجهنّم هي مجموعةُ كافّة أنواع العذاب الإلهيّ الجسديّ والروحيّ، وهي على درجاتٍ وأنواعٍ شتّى. ﴿يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أيّ إنّ ما يقومون به مصيره وعاقبته جهنّم. و"المصير" من الصيرورة، و"بِئْسَ المصير" يعني أنّ حركتهم هذه والعمل الذي يقومون به مصيره في النهاية إلى جهنّم، وجهنّم هي أمرٌ طبيعيٌّ وجَبْريٌّ لهذا الصنف من النفسيّات، وهذا النوع من الأشخاص وهذا النّوع من القلوب، فبئس القرار وبئس المصير.
بعد أن يذمّ تعالى عداوة هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود بهذه الأعمال، يتوجّه في خطابه إلى المؤمنين قائلًا: "إذا أردتم الـمُناجاة فيما بينكم فانتبهوا إلى ما تتناجون به، فيجب ألّا يكون إثمًا ومعصيةً ومعاداةً لهذا وذاك، ولا معصيةً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإعراضًا عن أوامره، إذا أردتم النجوى فليكن بأمورٍ شخصيّةٍ عاديّةٍ لا تريدون مثلًا أن يسمعها أحدٌ فتذكرونها خفيةً فيما بينكم، لكن لا تغتابوا هذا وذاك، ولا تُعادوا هذا وذاك، أو تتّهموا هذا وذاك، أو تبثُّوا شائعةً ضد هذا وذاك، أو لا يكوننّ (ما تتناجون به) معصية لأمر الرسول.
خلاصة آيات النجوى
باختصار، هذه الآيات تتحدّث عن البعد الأخلاقي والبعد السياسي للنجوى. فقد كان هذا عملًا سيّئًا من الناحية الأخلاقية، وخطيرًا وغير صائبٍ من الناحية السياسيّة. سيّئ من الناحية الأخلاقية لأنّه عندما يتناجى شخصان فإنّ الآخر الذي يجالسهما يشعر بالغربة، فالأمر يبدو وكأن هذين الشخصين ينتمي أحدهما إلى الآخر بينما الآخرون غرباء، ويبدو الأمر وكأنّ هناك خبرًا سيّئًا أو مزعجًا حول المؤمنين يعلمانه هذان ويتهامسان حوله، وهذا ما يجعل المؤمنين يشعرون بالقلق حول إمكانية وجود خبر سيّئ أو حدوث أمر خطير، لذا تصدّى القرآن للمنافقين من خلال هذه الآية.
وأمّا البُعد السياسيّ فهو أنّ المنافقين كانوا يقومون بها بنحوٍ مدروس، فقد كان في الأمر مؤامرةٌ أحيانًا وكانوا يتناجون بها. وبما أنّ المسلمين كانوا مكلّفين بعدم إساءة الظنّ بأحد، فكان من اليسير جدًّا أن تتغلغل بينهم العناصر الدّخيلة، وأن تتسرّب في محافلهم ومجالسهم القضايا السرّيّة على نحو النجوى. فقد كان المنافقون يتناقلون فيما بينهم قضاياهم الحزبيّة - كما يُصطلح اليوم - فيقولون مثلًا: "تعال اليوم يا سيّد إلى مسجد ضرار، نريد أن نقوم بالعمل الفلاني، كلّ أصحابنا مجتمعون هناك"، كانوا يقولون هذا لبعضهم البعض ويتهامسون حوله.
وهكذا، فالنجوى كانت تُسهّل تواصل أعداء الإسلام حتّى في محافل المسلمين. كان المنافقون يجلسون مُتجاورين في المسجد وفي مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتناجون فيما بينهم. وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرّاتٍ عديدةً عن القيام بذلك، إلّا أنّهم لم يكونوا يُنصتون لنهيه، ولم يكونوا يحملون الأمر على محمل الجدّ إلى أن نزلت هذه الآية، لذا فإنّه تعالى يقول من الآية الأولى في هذه الآيات التي قرأناها: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ ولم يُذكر هذا النهي في القرآن إلّا في هذه الآيات، فمن الواضح أنّ النهي عن النجوى قد حصل خارج القرآن، أيّ من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه قد نهاهم أن "لا تقوموا بهذا العمل! لماذا تتهامسون؟". بلسان النصيحة، وبلسانٍ لطيف، ويمكن أنّه كان ينهاهم بلسانٍ حادّ، لكنّ آذانهم لم تكن صاغية، وكانوا يكرّرون مرةً أخرى عملهم ذاك.
لذا نزلت هذه الآية القرآنية بهذا اللحن الحاد، وأفضت إلى إيجاد نحوٍ من الأمان للناس من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية كذلك. لكن على الرغم من أن هذا العمل كان عمل المنافقين والغرباء عن المسلمين، إلّا أنّه لم يكن محبّذًا بين المسلمين أنفسهم أيضًا، فقد كان يجعلهم هم أيضًا غرباء وأجانب فيما بينهم، فالامتناع عن النجوى أدبٌ اجتماعيّ. ولذا فقد جاء في الروايات أنْ إذا جلستم في محفلٍ وكنتم تتحادثون، فلا يتناجى اثنان منكم، فهذا يجعل الآخرين يسيئون الظنّ بهذه الأفعال وبما يحصل ويرتابون لها، ويشعرون بأنّهم غرباء.
طبعًا ليس في الأمر حرمة، فقد يكون ثمّة أمرٌ فوريٌّ أحيانًا، ويكون الكلامُ ضروريًّا، ويريد الإنسان مثلًا إخبار شخصٍ بأمرٍ عاجلٍ إذا اطّلع عليه الآخرون فسيُسبب الأمر مشكلة، ولا ينبغي للجميع أن يطّلعوا عليه أو لا يلزم ذلك. طبعًا لا ضرر في الأمر إن كان بقدر الحاجة وعند الضرورة، لكنّ الإسلام طبعًا يُعارض هذا النحو من السلوك والنهج الذي يفصل الناس عن بعضهم البعض، ويُجزّئهم ويجعلهم مَثْنى وثُلاثَ ويُوهِن اتّحادهم.
لذا فإنّ هذا الجانب (للنجوى) موجود من الناحية الأخلاقية، ونظائره موجودة كذلك ويجب الانتباه إليها. ثم يدخل في أدب اجتماعي آخر في الآيات اللاحقة، ويبيّن ضربًا آخر من النجوى وهي نجوى الرسول، وهي مسألة تخصّ الانتهازيين الذين كانوا يذهبون لمناجاة الرسول ليُوحوا بأنهم قريبون جدًّا منه فيهمسون في أذنه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-
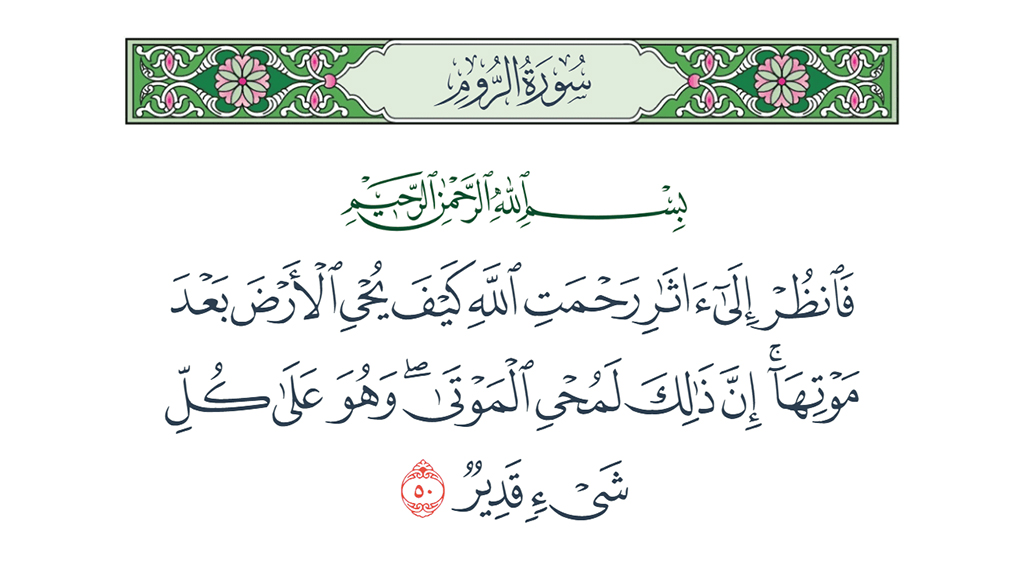
البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
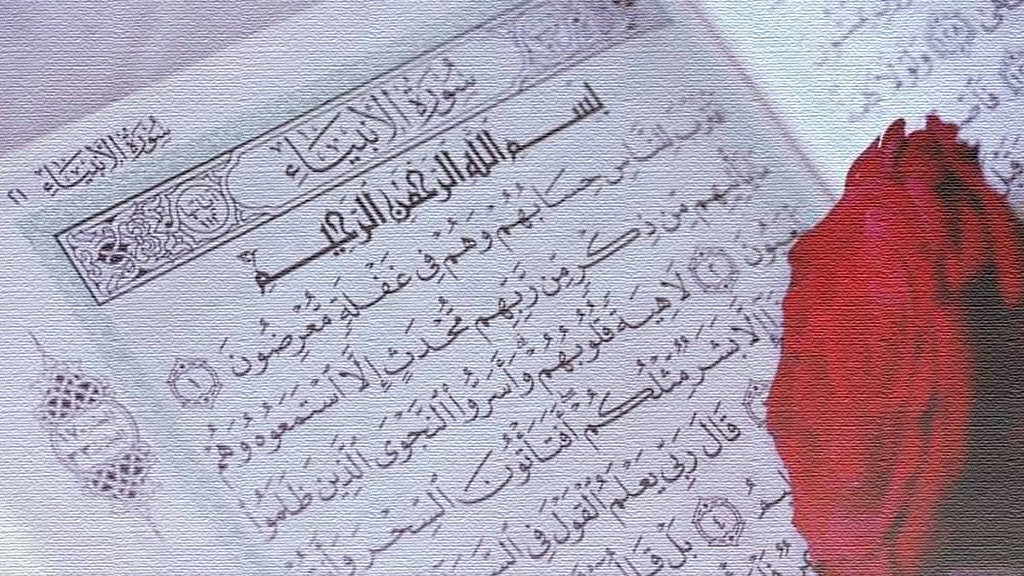
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم









