من التاريخ
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :
من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهارسول اللّه وقدرته الروحيّة

لقد كانت آثار الشجاعة، والقوّة باديةً في جبين عزيز قريش منذ طفولته وصباه، ففي الخامسة عشرة من عمره الشريف شارك في حرب هاجت بين قريش من جهة، وقبيلة هوازن من جهة أخرى، وتدعى «حرب الفجار»، وقد كان في هذه الحرب يناول أعمامه النَبل. فها هو «ابن هشام» ينقل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُنْتُ أنبّلُ عَلى أعْمامِيْ» (2).
إن مشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في العمليات الحربية في مثل هذه السن تكشف عن شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم وقدرته الروحية الكبرى وتساعدنا على أن ندرك مغزى ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حق النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنّا إذا أحمر الْبأَسُ اتّقيْنا برَسُول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنّا أقرَبَ إلى العَدوِّ مِنْهُ» (3).
كانت العرب تقضي عامها كله بالقتال والإغارة، وقد تسبب هذا الوضع في اختلال حياتهم، واضطراب أمورهم، ولأجل هذا كانوا يحرّمون القتال ويتوقفون عنه في أربعة أشهر من كل عام (هي شهر رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم) ليتسنى لهم ـ في هذه المدة ـ أن يقيموا أسواقهم، ويستغلّوها بالكسب والتجارة والبيع والشراء (4).
ولهذا كانت أسواق «عكاظ» و «مجنَّة» و «ذو المجاز» تشهد طوال هذه الأشهر الحرام اجتماعات كبرى وتجمعات حافلة وحاشدة، كان يلتقي فيها العدوّ والصديق جنباً إلى جنب، يتبايعون، ويتفاخرون.
فقد كان شعراء العرب المشهورون يلقون قصائدهم في هذه الاجتماعات الكبرى، كما يلقي كبارُ خطباء العرب وفصحاؤهم خطباً قوية، وأحاديث في غاية الفصاحة والبلاغة، وكان اليهودُ والنصارى والوثنيون يعرضون معتقداتهم في هذه المناسبات من دون خوف أو وجل.
ولكن هذه الحرمة قد هُتكت أربعَ مرات في تاريخ العرب، وتقاتلت القبائلُ العربية فيما بينها في هذه الأشهر الحرم، ولهذا سُمِّيت تلك الحروب بحروب «الفجار»، وفي ما يلي نشير إليها على نحو الإجمال:
ووقعت الحربُ فيها بينَ قبيلتي «كنانة» و «هوازن» وجاء في سبب نشوب هذه الحرب أن رجلاً يدعى «بدر بن معشر» كان قد أعدَّ لنفسه مكاناً في سوق «عكاظ» يحضر فيه، ويذكر للناس مفاخره فوقف ذات مرة شاهراً سيفه يقول: أنا واللّه أعزُّ العرب فمن زعم أنه أعزّ منّي فليضربها بالسيف.
فقام رجلٌ من قبيلة أخرى فضرب بالسيف ساقه فقطعها، فاختصم الناس وتنازعت القبيلتان، ولكنهما اصطلحتا من دون أن يُقتل أحدٌ (5).
وكان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى أمرأة من «بني عامر» وهي جميلة، عليها برقع، فقالوا لها: إسْفري لننظر إلى وجهِك، فلم تفعلْ، فقام غلامٌ منهم، فجمع ذيل ثوبها إلى ما فوقه بشوكة فلما قامت انكشف جسمُها، فضحكوا، فصاحت المرأة قومها، فأتاها الناسُ، واشتجروا حتّى كاد أن يكون قتالٌ، ثم اصطلحوا، وانفضُّوا بسلام.
وسببه أن رجلاً من «كنانة» كان عليه دَيْنٌ لرجل من «بني عامر»، وكان الكناني يماطل، فوقع شجارٌ بين الرجل، واستعدى كل واحد منهما قبيلته، فاجتمع الناسُ، وتحاوروا حتّى كاد يكونُ بينهم القتالُ، ثم اصطلحوا.
وهي الحرب الّتي ـ قيل أنه ـ شارك فيها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد ادّعى البعض أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومذاك في الخامسة عشرة، أو الرابعة عشرة من عمره.
وقال بعضٌ: إنه كان في العشرين من عمره وحيث أن هذه الحرب قد استمرت أربع سنوات. لهذا يمكن أن تكون جميع هذه الأقوال صحيحة (6).
وقيل في سببه: أن «النعمان بن المنذر» ملك الحيرة كان يبعث إلى سوق «عكاظ» في كل عام بضاعة في جوار رجل شريف من أشراف العرب، يُجيرها له حتّى تباع هناك ويشتري بثمنها من أقمشة «الطائف» الجميلة المزركَشة ممّا يحتاج إليه، فأجارها «عروة الرجال الهَوازني» في تلك السنة، ولكن «البراض بن قيس الكناني» انزعج لمبادرة «عروة» إلى ذلك، فشكاه عند «النعمان بن المنذر» ولم يجد اعتراضه وشكواه، فحسد على «عروة» حسداً شديداً، فتَربَّص به حتّى غدر به في أثناء الطريق، وبذلك لطّخ يده بدم هوازني.
وكانت قريش يومذاك حليف كنانه، وقد اتفق وقوعُ هذا الأمر يوم كانت العرب مشغولة بالكسب والتجارة في سوق عكاظ، فأخبر رجل قريشاً بمقتل الهوازنيّ على يد الكنانيّ، ولهذا عرفت قريش وحليفتها بنو كنانة بالأمر قبل هوازن، وأسرعوا في الخروج من «عكاظ» وتوجهوا نحو الحرم (والحرم هو أربعة فراسخ من كل جانب من مكة، وكانت العرب تحرّم القتال في هذه المنطقة) ولكن هوازن علمت بذلك فلاحقت قريشاً وحليفتها فوراً، وأدركتهم قبل الدخول في الحرم فوقع بينهم قتال، ولما جنّ الليل كفّوا عن الحرب فاغتنمت «قريش» وحليفتُها فرصة الليل، وواصلت حركتها باتجاه الحرم المكي وبذلك نجت من خطر العدو.
ومنذ ذلك اليوم كانت تخرج قريش وحليفتها من الحرم بين الفينة والأخرى وتقاتل هوازن، وقد شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأيام مع أعمامه على النحو الّذي مرّ بيانه.
وقد استمر الأمر على هذه الحال مدة أربع سنوات، حتّى أن وُضعَت نهاية لهذه الحرب الطويلة بدفع قريش لهوازن دية القتلى الذين كانوا يزيدون على قتلى قريش على يد هوازن (7).
وإن تحريم القتال في الأشهر الحرم كانت له جذورٌ دينية، وحيث أن حرب «الفجار» استمرت أربع سنوات فيمكن أن يكون لمشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وجهاً وجيهاً وهو الدفاع، خاصة أنه لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن مشهده يومئذ فقال: «ما سَرّني أنّي أَشْهدهُ، إنَّهُمْ تَعَدَّوْا عَلى قَومي عرضوا (أي قريش) عَلَيْهم (أي على هوازن) أنْ يَدْفعُوا إلَيْهِم البرّاض صاحِبَهُمْ (أي الّذي قتل عروة) فأَبُوا» (8).
ويحتمل أن تكون مشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في غير الأشهر الحرم بناء على استمرار هذه الحروب مدة أربعة أعوام، وإنما سميت مع ذلك بالفجار لأن بدايتها وافقت الأشهر الحرم لا أنّها وقعت بتمامها في الأشهر الحُرم.
وبذلك لا يبقى مجال لأن تُسْتَبْعَد مشاركة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيام تلك الحرب.
لقد كان في ما مضى ميثاقٌ وحلفٌ بين الجرهميين يدعى بحلف «الفُضُول»، وكان هذا الحِلفْ يهدف إلى الدفاع عن حقوق المظلومين، وكان المؤسسون لهذا الحلف هم جماعة كانت أسماؤهم برمتها مشتقة من لفظة الفضل، وأسماؤهم ـ كما نقلها المؤرخ المعروف «عماد الدين ابن كثير» ـ هي عبارة عن: «فضل بن فضالة»، و «فضل بن الحارث»، و «فضل بن وداعة» (9)، وحيث أن الحلف الّذي عقدته جماعة من قريش فيما بينها كان متحداً في الهدف (وهو الدفاع عن حقوق المظلومين) مع حلف «الفضول» لذلك سمّي هذا الاتفاق وهذا الحلف بحلف «الفُضول» أيضاً.
فقبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين عاماً دخل رجلٌ من «زبيد في مكة في شهر ذي القعدة، وعرض بضاعة له للبيع فاشتراها منه «العاص بن وائل»، وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيديّ قريشاً، وطلب منهم أن ينصروه على العاص، وقريش آنذاك في انديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته:
| يا آل فِهر لمظلوم بضاعتُه |
|
|
| ومُحرمٌ أشعثُ لم يَقض عُمْرتَه يا للرِّجال وبَيْن الحجر والحَجَر |
|
|
| إن الحرامَ لِمَن تمَّت كرامتُه |
|
|
فأثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر رجال من قريش، وهيّجت غيرتهم، فقام «الزُبير بن عبد المطّلب» وعزم على نصرته، وأيّده في ذلك آخرون، فاجتمعوا في دار «عبد اللّه بن جَدْعان» وتحالفوا وتعاهدوا باللّه ليكونَنّ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتّى يؤدّى إليه حقه ما أمكنهم ذلك ثم مَشوا إلى «العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.
وقد أنشدَ الزبير بن عبد المطلب في ذلك شعراً فقال:
| إنَ الفُضُولَ تَعاقَدُوا وتَحالَفوا |
|
|
| أمرٌ عَليْهِ تَعاقَدُوا وتواثقُوا |
|
|
وقال أيضاً:
| حَلفْت لَنعْقَدن حلفاً عليهمْ |
|
|
| نسمّيه «الفُضُولَ» إذا عَقَدْنا |
|
|
| ويعْلَمُ منْ حَوالي البيتِ أنّا |
|
|
وقد شارك رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا الحلف الّذي ضمن حقوق المظلومين وحياتهم، وقد نُقِلت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عبارات كثيرة يشيد فيها بذلك الحلف ويعتزُّ فيها بمشاركته فيه وها نحن ننقل حديثين منها في هذا المقام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد شَهدْتُ في دار عبد اللّه بن جدعان حلفاً لو دُعيتُ به في الإسلام لأجبتُ».
كما أن ابن هشام نقل في سيرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ما بعد عن هذا الحلف: «ما أحبُّ أنَّ لي به حُمُرَ النِعَم».
ولقد بقي هذا الحلف يحظى بمكانة واحترام قويّين في المجتمع العربي والإسلامي حتّى أن الأجيال القادمة كانت ترى من واجبها الحفاظ عليه والعمل بموجبه، ويدل على هذا قضيةٌ وقعت في عهد إمارة «الوليد بن عتبة» الأموي (11) على المدينة.
فقد وقعت بين الإمام الحسين بن علي عليه السلام وبين أمير المدينة هذا منازعة في مال متعلّق بالحسين عليه السلام، ويبدو أنَ «الوليد» تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له الإمامُ السبط الّذي لم يرضخ لحيف قط، ولم يسكت على ظلم أبداً:
«أَحلِفُ باللّه لتَنْصِفَنّي مِنْ حَقّي، أوْ لآخُذَنَّ سَيْفيْ ثمَّ لأَقُومَنَّ في مَسجد رَسُول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ لأَدْعُونَّ بِحلفِ الفُضُول» (12).
فاستجاب للحسين فريقٌ من الناس منهم «عبد اللّه بن الزبير»، وكرّر هذه العبارة وأضاف قائلاً: وأنا أحْلِفُ باللّه لئن دعا به لآخُذَنَّ سَيْفي ثُمّ لأَقُومَنَّ مَعه حتّى يُنْصَفَ مِنْ حَقّهِ أوْ نَمُوتَ جَميعْاً.
وبلغت كلمة الحسين السبط عليه السلام هذه إلى رجال آخرين ك «المسورة بن مخرمة بن نوفل الزُهري» و «عبد الرحمان بن عثمان فقالا مثل ما قال «ابن الزبير»، فلما بلغ ذلك «الوليد بن عتبة» أنصف الحسين عليه السلام من حقه حتّى رضي (13).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ نهج البلاغة : قسم الرسائل ، الرقم 38.
2 ـ السيرة النبوية : ج 1 ، ص 186 ، وقد قال ابن الأثير في النهاية بعد نقل هذا الحديث وضبط الكلمة « انبل » مشدّدة « اُنبِّل » : « إذا ناولته النبل يرمي » راجع مادّة نبل.
3 ـ نهج البلاغة : فصل في غريب كلامه الرقم 9.
4 ـ يُستفاد من قوله تعالى في الآية 36 من سورة التوبة : « إنَّ عِدَّة الشّهور عِندَ اللّه اثنا عَشَر شَهْراً في كِتابِ اللّه يَوْم خلَقَ السَّماواتِ والأَرْض مِنْها أربعةٌ حُرُم » أن تحريم القتال في هذه الأشهر الأربعة كان ذا جذور دينية ، وكانت العرب الجاهلية تحترم هذه الأشهر اتباعاً لسُنّة « إبراهيم الخليل » عليه السلام.
5 ـ ولقد كان ممّا أزاله الإسلام ومحاه هذا التفاخر الجاهلي المقيت.
6 ـ التاريخ الكامل : ج 1 ، ص 358 و 359 ، السيرة النبوية : ج 1 ، ص 184 الهامش ، تاريخ الخميس : ج 1 ، ص 259.
7 ـ سيرة ابن هشام : ج 1 ، ص 184 ـ 187 ، الأغاني : ج 22 ، ص 56 ـ 75.
8 ـ الأغاني : ج 22 ، ص 73.
9 ـ البداية والنهاية : ج 1 ، ص 290.
10 ـ البداية والنهاية : ج 1 ، ص 290
11 ـ من قبل عمّه معاوية.
12 ـ السيرة الحلبية : ج 1 ، ص 132.
13 ـ البداية والنهاية : ج 2 ، ص 293.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 معنى (خفى) في القرآن الكريم
معنى (خفى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)
الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)
محمود حيدر
-
 كيف تُرفع الحجب؟
كيف تُرفع الحجب؟
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ
-
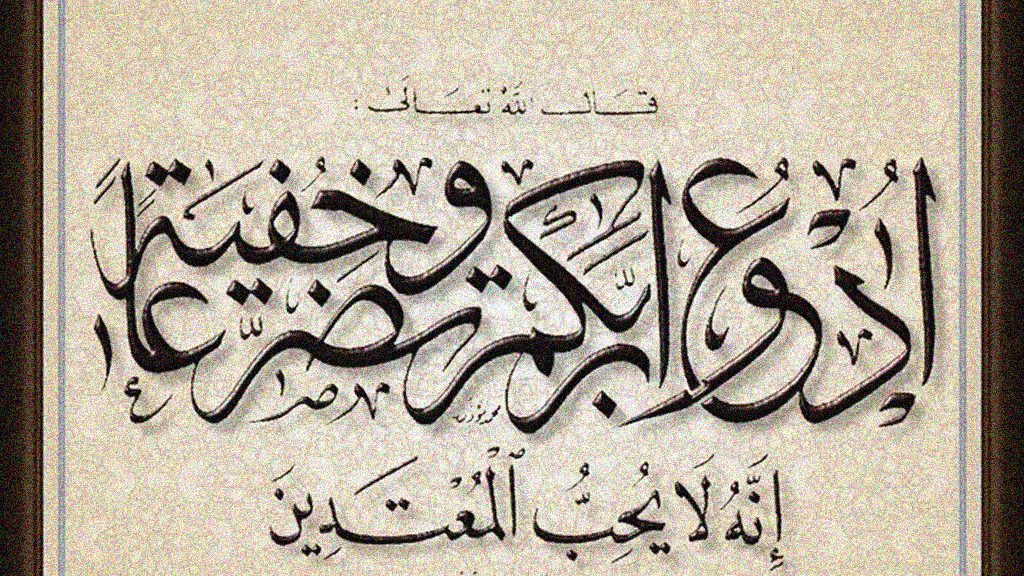
معنى (خفى) في القرآن الكريم
-

التجارة حسب الرؤية القرآنية
-
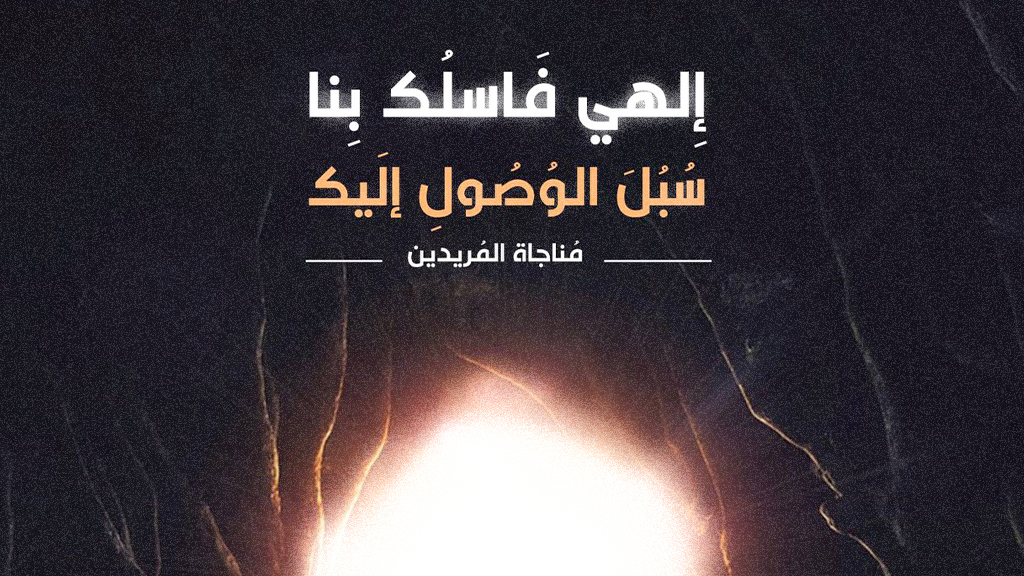
مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)









