من التاريخ
لماذا لمْ يقم بالسيف أحدٌ من الأئمة عليهم السلام بعد الحسين عليه السلام؟

الشيخ عبدالوهاب الكاشي
من الأخطاء التي وقع ويقع فيها بعض الناس هو القياس في سلوك الأنبياء والأوصياء، فإذا أحد منهم قام بعمل بارز وحساس بحيث يعجبهم ويتلائم مع رغباتهم وأفكارهم، فحينئذ يتوقّعون من الآخرين أيضاً أنْ يفعلوا نفس ذلك الفعل، ويقوموا بمثل ما قام به فلان؛ لأنّه أعجبهم ووافق أهواءهم، وعلى هذا الأساس يقولون: لماذا لمْ يقم أحد من الأئمّة بثورة مسلحة بعد الحسين عليه السلام؟ ومِنْ ثمّ رفض بعض المسلمين إمامة أي إمام لمْ يقم بالسيف ضد أعدائه. فالإمامة عندهم مشروطة بشرط الكفاح المسلح؛ ولذا فهم يعترفون بإمامة علي عليه السلام، ثمّ الحسن عليه السلام، ثمّ الحسين عليه السلام، ثمّ زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، وابنه يحيى بن زيد وهكذا، أمّا زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام فليسوا عندهم من الأئمّة؛ لأنّهم لمْ يقوموا بالسيف...
والواقع أنّ هؤلاء وأمثالهم يظنّون أنّ مصلحة الأمّة دائماً تدور مدار استعمال السيف والكفاح المسلّح وجوداً وعدماً، فالإمام الذي لا يقوم بهذا الكفاح لمْ يخدم مصلحة الأمّة، غافلين عن أنّ استعمال السيف هو علاج اضطراري، ومِنْ باب آخر الدواء الكي.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله مثلاً لمْ يستعمل السيف إلاّ بعد مضي ثلاثة عشر سنة أو أكثر مِنْ بدء الدعوة، وبعد أنْ اضطر لاستعماله دفاعاً عن النفس، وفي وجه أناس كان موقفه معهم موقف حياة أو موت. وبعده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أغمد سيفه خمساً وعشرين سنة، وصار يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، وأخيراً اضطر إلى استعمال السيف ضد أناس فشلت معهم جميع الوسائل السلمية.
وبعده الإمام الحسن عليه السلام الذي جرّد السيف في بدء الأمر ضد العدو، ولكن لـمّا ثبت لديه أنّ الكفاح السلمي، والحرب الباردة في ذلك الظرف وفي تلك الأحوال أنجح وأنفع للمصلحة العامّة والإسلام من السيف، ترك الحرب وجنح للسلم والمصالحة. فالغرض: أنّه لا شك في أنّ مصلحة الحقّ والدين ليست منحصرة في الحرب بالسيف وفي الثورة الدمويّة دائماً، بل في بعض الأحيان والأحوال وفي حالات شاذّة نادرة. فالحقّ لا يُفرض بالسيف والعقيدة لا تركّز بالقوّة، ودين الله لا يقوم على الإكراه والإجبار.
وإنّ ظروف الحسين عليه السلام كانت ظروفاً شاذّة، انعدمت فيها كلّ وسائل الدعوة السلمية، ولمْ يجد الحسين عليه السلام معها بدًّا مِنْ أنْ يقوم بحركة غريبة ومدهشة لجلب الرأي العام، وإلفات الأنظار وتحريك الضمير الإنساني. وقد تحقّق كلّ ما أراده بحركته، وبقي استغلال ذلك النتاج وصيانة تلك الثمرة بالبيان والتوجيه، ورعاية تلك المكاسب بالدعم الفكري والعلمي والعملي؛ وهذا هو بالذات كان دور الأئمّة عليهم السلام مِنْ أبنائه بعده، وقد قاموا به على أحسن ما يرام وأتمّ ما يكون.
فالحسين عليه السلام وجّه بثورته الأفكار ولفت الأنظار إلى عدالة قضية أهل البيت عليهم السلام، وأنّهم مع الحقّ والحقّ معهم، وأنّ خصومهم مع الباطل. ولكن يا ترى ما هي تفاصيل تلك القضية؟ - أي قضية أهل البيت عليهم السلام - وما هو مفصل هذا الحقّ الذي لهم ومعهم؟ وما هو وجه الخلاف بينهم وبين غيرهم؟
فهذه التفاصيل والشروح والبيانات للناس قام بها أبناؤه عليهم السلام بعده بشتى الوسائل الممكنة لديهم؛ وبذلك ظهر الحقّ وانتشر على الصعيد الفكري عامّة، وعلى الصعيد العملي إلى حدّ كبير نسبة. أمّا إذا قلت: لماذا قعدوا عن استعادة حقّهم المغتصب، ولمْ يقوموا بثورة لاسترجاع الخلافة والإمرة والحكم؟ قلت: إنّ ذلك لمْ يكن مقدوراً لهم جميعاً، ولمْ تتوفّر لأحدهم الإمكانيات لذلك الغرض، كما لمْ تتوفّر للحسن ولا للحسين عليهما السلام كما قدّمنا سابقاً، وأعني بتلك الإمكانيات اللازمة لاسترجاع الخلافة مِنْ أيدي الغاصبين، الأعوان والأنصار بالقدر اللازم والعدد الكافي، والنصاب الشرعي المعروف، وهو النصف مِنْ عدد العدو، وحسب نصوص الآية الكريمة: (الآنَ خَفّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ)(1).
وكان النصاب الموجب للقتال قبل هذا هو العشر كما في صريح الآية الكريمة التي قبلها: (يَا أَيّهَا النّبِيّ حَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاْئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً من الّذِينَ كَفَرُوا...)(2). فكان النصاب المبرّر للقتال أوّلاً هو العشر، ثمّ نسخ وصار النصف مِنْ قوّة العدو. ولا شك في أنّ النصاب الشرعي بصورتيه الأولى والثانية لمْ يحصل لأحد الأئمّة عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سوى علي بن أبي طالب عليه السلام؛ فإنّه الوحيد مِنْ بينهم الذي حصل على النصاب المذكور، وتمكّن من القيام واستحصال حقّه.
وأمّا الباقون فلمْ يحصلوا على أعوان وأنصار، حتّى بمقدار النصاب الأول وهو العشر فضلاً عن النصف؛ فالحسن عليه السلام مثلاً بقي بعد خيانة الجيش في أهل بيته، وعدد قليل من الأصحاب والأنصار لا يتجاوزون المئة رجل، وفي قباله معاوية ومعه ستّون أو سبعون ألف مقاتل.
فأيّ توازن وأيّ تقارب بين القوّتين؟! لذلك سقط عنه تكليف الجهاد الشرعي، ولمْ يبقَ أمامه إلاّ التضحية والشهادة أو الصلح والمهادنة، فاختار الصلح؛ لأنّه كان أصلح يومئذ وأنفع لمصلحة الإسلام العُليا من التضحية... وكذلك الأمر مع الحسين عليه السلام كما تعلم، حيث بقي في نيف وسبعين رجلاً، في مقابل سبعين ألفاً من الأعداء، ولكنّه عليه السلام آثر الشهادة والقيام بعمله الفدائي الخاص نظراً لظروفه الخاصّة....
وأمّا باقي الأئمّة عليهم السلام فحالهم لمْ تختلف عن حال الحسن والحسين عليهما السلام، بل ربّما كان أشدّ وأحرج. يلتفت ذلك الرجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو يمشي معه في ضواحي المدينة فيقول له: يا سيدي، كيف يجوز لك السكوت والقعود عن حقّك وأنت صاحب هذا الأمر وابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟!
فسكت عنه الإمام الصادق عليه السلام حتّى مرّ بهم راع يسوق قطيعاً من الغنم، فقال له الإمام عليه السلام: «يا فلان، كمْ تعدّ هذا القطيع؟». فقال الرجل: لا أدري. فقال عليه السلام: «والله، لو كان لي أنصار عدد هذا القطيع لنهضت بهم». فعطف الرجل على القطيع فعدّه فإذا هو سبعة عشر رأسًا.
ودخل سهل بن الحسن الخراساني عليه ذات يوم وقال: يا ابن رسول الله، لا يجوز لك القعود عن حقّك ولك في خراسان مئة ألف رجل يُقاتلون بين يديك مِنْ شيعتك. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: «وأنت منهم يا سهل؟». فقال: نعم، جعلت فداك يا سيدي. فقال له: «اجلس». فجلس، ثمّ أمر الإمام عليه السلام الجارية وقال: «يا جارية، أسجري التنور». فسجرته حتّى صار اللّهب يتصاعد مِنْ فم التنور، فالتفت الصادق عليه السلام إلى سهل الخراساني وقال: «يا سهل، أنت مِنْ هؤلاء الذين ذكرت أنّهم يطيعون أمري؟». فقال: نعم سيدي أفديك بروحي. فقال عليه السلام: «قم وادخل في هذا التنور». فقال سهل: أقلني أقالك الله يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: «قد أقلتك».
فبينا هم كذلك إذ دخل أبو هارون المكّي رحمه الله فسلّم، فردّ عليه السلام وقال له: «يا أبا هارون، ادخل في التنور». فقال له: سمعاً وطاعة. ثم ألقى نعله وشمّر عن ثيابه ودخل في التنور، فقال الإمام عليه السلام: «يا جارية، اجعلي عليه غطاءه». فغطّته.
ثمّ التفت الإمام عليه السلام إلى سهل بن الحسن وصار يحدّثه، فقال سهل: إئذن لي يا سيدي أنْ أقوم وأنظر ما جرى على هذا الرجل. فقال عليه السلام: «نعم». ثمّ قام ومعه سهل وكشف الغطاء عن التنور، وإذا أبو هارون جالس على رماد بارد، فقال له الإمام: «اخرج». فخرج صحيحاً سالماً لمْ يصبه أيّ أذى. فقال عليه السلام: «يا سهل، كم تجد مثل هذا في خراسان؟». فقال سهل: ولا واحد يا ابن رسول الله.
وهذه العملية هي كرامة، ولا شك أظهرها الإمام الصادق عليه السلام وعبّر بها عن أنّ أهل البيت إنّما هم بحاجة إلى جيش عقائدي، يطيع الأوامر الصادرة إليه من الإمام عليه السلام مهما كانت، لا يعرف التردّد والهزيمة، ولا يفكّر بغير الشهادة أو الغلبة؛ لثقته التامّة بالإمام عليه السلام، واعتقاده الراسخ المتين بأنّ أوامره مِنْ أمر الله ورسوله، وهو أعرف بالصالح والفاسد، والحقّ والباطل مِنْ جميع الناس.
فهم بحاجة إلى هكذا جيش، متوفّر لديهم قدر النصاب الشرعي على الأقل، وقبل القيام بالحركة أو الثورة؛ لكي لا تتكرر نكسة صفين، أو مأساة كربلاء، أو نكبة الحسن على يد جيشه يوم ساباط.
وخلاصة الكلام هو أنْ نقول: أمّا القيام لأجل أخذ حقّهم في الخلافة، وانتزاع السلطة مِنْ أيدي الظالمين فإنّه كان مستحيلاً عادة بالنسبة لهم؛ لعدم توفّر الشرائط واللوازم الضرورية لمثل هذا القيام لديهم، وأهمّها الأنصار والأعوان المخلصون.
غير أنّهم كانوا يدعمون معنويّاً وماديّاً وفكريّاً قدر استطاعتهم كلّ الثورات الحرّة، والحركات الإصلاحية التي كانت تقوم بين حين وآخر ضد الأمويِّين أو العباسيِّين، مثل: ثورة أهل المدينة على يزيد (لعنه الله)، وثورة زيد بن علي بن الحسين على عبد الملك بن مروان، وثورة المختار الثقفي في الكوفة، وثورة محمد ذو النفس الزكية على المنصور العباسي، وبعدها ثورة أخيه إبراهيم أحمر العينين على المنصور أيضاً وغيرها.
وأمّا القيام لأجل التضحية والشهادة مثل قيام الحسين عليه السلام، فإنّه لمْ يكن ضرورياً في عصرهم؛ لأنّ وسائل الإعلام والدعوة إلى الحقّ، وطرق إتمام الحجّة وتبيلغ الرسالة لمْ تنعدم كليًّا في عصر الأئمّة عليهم السلام، كما انعدمت في عصر الحسين عليه السلام حتّى اضطر إلى القيام بالإبلاغ والإعلام عن طريق التضحية والشهادة.
فالإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام مثلاً قاما بأوسع حركة علميّة مستطاعة في ذلك العصر عن طريق المدرسة والتدريس، ونشر العلم واستقطاب العلماء، وتربية ثلة من الشباب المؤمن بالتربية الإسلاميّة، وبثهم في الأقطار والأمصار يبشرون ويرشدون ويعلّمون. فكان عصرهما عليهما السلام أحسن عصور الإسلام ازدهاراً بالعلم والمعرفة، وتقدّم الثقافة وكثرة المدارس والمجالس العلميّة.
وبقي الحال على هذا الوصف، بل وازداد تقدّماً وازدهاراً إلى عصر الإمام الرضا والجواد عليهما السلام... وهما اللذان كوّنا بجهودهما وبمعونة المأمون العباسي، وتعاون المجتمع معهما، كوّنا من المسلمين أساتذة للعالم الغربي اليوم بكلّ علومه واكتشافاته المدهشة.
قال ابن الوشا: دخلت إلى جامع الكوفة في أيّام الرضا عليه السلام فرأيت تسعمئة شيخ يحدّثون ويدّرسون ويقولون: حدّثنا جعفر بن محمد عليه السلام.
وفي الختام نكرّر القول: بأنّ خدمة المصلحة العامّة ونصرة الحقّ ومكافحة الباطل والظلم ليست في الحرب دائماً، بل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
والحرب الدمويّة هي آخر وسيلة يفكر فيها المصلحون المخلصون لأمّتهم وللصالح العام بعد اليأس من الوسائل السلمية. وإلى هذا يشير الإمام علي عليه السلام في كلماته القصار: «رأي الشيخ أحبّ إليّ مِنْ جلد الغلام».
وإلى هذا يشير المتنبي الشاعر في أبياته المعروفة فيقول:
الرأيُ ثمّ شجاعةُ الشجعانِ
هو أوّل وهي المحلّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لنفسٍ حرّةٍ
بلغتْ من العلياءِ كلَّ مكانِ
ولربّما طعن الفتى أعداءهُ
بالرأي قبل تطاعنِ الأقرانِ
لولا العقولُ لكان أدنى ضيغمٍ
أدنى إلى شرفٍ من الإنسانِ
وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله: «مدادُ العلماء أفضل مِنْ دماء الشهداء».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). سورة الأنفال / 67.
(2). سورة الأنفال / 65.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
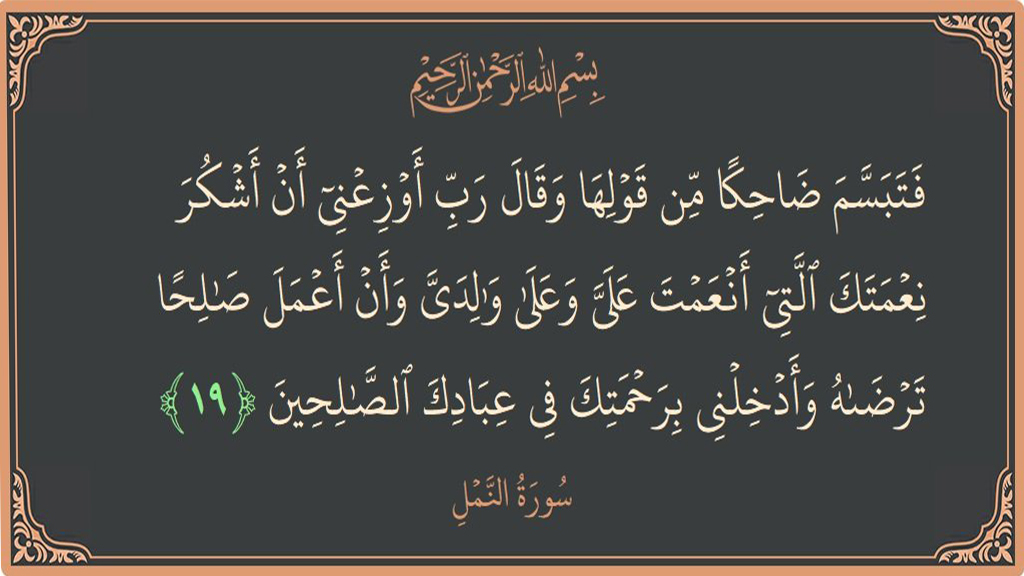
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)









