مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.عاشوراء الحسين (ع) وانبعاث التأويل

{يُضِلُ بِهِ كَثيرًا وَيَهْدي بِهِ كَثيرًا}.[1]
جرت عمليّة تأسيس المجتمع المسلم والأمّة الواحدة على يد القرآن الكريم. منذ اللحظة الأولى التي بدأ النبي الأكرم(ص) يتلو على الناس آياته، انطلق زلزال اجتماعيٌّ كبير أطاح بالنظام الجاهلي إلى غير رجعة، ولم يتوقف هذا الزلزال إلى يومنا هذا.
فكان الرسول يصدع بالقرآن وبه يتقدّم ناشرًا أنوار الهداية والإصلاح. وكان القرآن هو الوسيلة الأولى التي انتشرت به هذه الدعوة الإسلاميّة، وبفضله تغلغلت في النفوس، وصنعت الإيمان، وأنشأت الجيوش، وانتشرت إلى كل المناطق والبقاع.
بالقرآن مضت عملية التغيير والتأسيس والبناء للأمة الإسلامية، وذلك أولًا عبر إسقاط النظام الجاهلي الوثني بمعارف التوحيد، وتغيير وجهة الحياة من الدنيا إلى الآخرة ثانيًا، وتوجيه الجهود والمساعي من القبيلة والعشيرة والأنا إلى البشرية والناس كافة.
كان القرآن يتقدّم الدعوة، فيقتلع من أمامها كل أنواع العقبات العقائدية والأشواك النفسية والعراقيل السلوكية، بإعجاز بيانه وسعة معارفه وعمق علومه وقوة أخباره. وفي المقابل، لم يقف الـمُشركون واليهود وأهل الكتاب وغيرهم من مرضى القلوب والمنافقين موقف الـمُتفرّج، بل سعوا كل جهدهم لإحباط تأثير القرآن، واستخدموا كل وسيلة ممكنة، ولم تكن الحروب آخرها.
بالتأمُّل في الآيات القرآنية التي سجّلت يوميات هذه المواجهة وخباياها، نلاحظ التركيز الفائق من قبل أعداء الرسالة على إبطال القرآن وإطفاء النور الذي أنزل معه، لأنّهم كانوا أكثر مَن أدرك حجم تأثيره. ولـمّا يئسوا من القضاء عليه وحذفه من ساحة الحياة عبر نفي انتسابه إلى الله أو التلاعب به واللغو فيه، بدأوا فصلًا جديدًا من مواجهة القرآن وهو الفصل الذي عُرف بحركة التأويل، الذي كان همّه الأكبر حرف ألفاظ القرآن عن معانيه المقصودة.
فالقرآن الكريم ورَغم وضوح آياته وإعرابها، لكنّه ما كان ليترسّخ في واقع الحياة كدستورٍ إلهيّ ونظامٍ ربّاني شامل لكل أبعادها دون السُنّة النبوية التي قامت مقام البيان كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.[2]
وهكذا تمركزت عمليّة التّأويل عبر شتّى أنواع التّلاعب بالسنّة التي كانت بمثابة تفريع الأصول المحكمة وترجمة المعاني في واقع الحياة والتجسيد العملي للقرآن كلّه والمرجعيّة الأولى في رد متشابهاته إلى مُحكماته.
لم تكن مقولة "حسبنا كتاب الله"، التي أضحت سياسة عامّة لتبرير القرار السلطاني بمنع تدوين الحديث الشريف، المسعى الوحيد لفصل السنّة النبوية عن القرآن المجيد. فقد ظهر هنا الفصل والتفكيك لاحقًا في حركة الخوارج الهدامة، حين جعل هؤلاء كتاب الله مقابل السنّة من أجل إبطال مفاعليها وهدم مبانيها؛ وإنّما أفشل مخططهم الحُجّة الباهرة للقرآن الناطق، علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي استطاع إظهار عظمة السُّنّة وقوّتها، كما فعل بمن سبقهم من الناكثين.
فحين بعث هذا الإمام ابن عمه عبدالله بن عباس لمحاججة الخوارج قبل واقعة النهروان، أوصاه بأن يُحاججهم بالسُّنّة، لأنّ القرآن بدونها حمّالٌ ذو وجوه، يمكن التلاعب به واستخدامه لتبرير أي منطق وتأييد أي مذهب. وكان الخوارج من قبل يرفعون آيات القرآن لإسقاط الحكومة (التحاكم) في صفّين، كالآية الشريفة في قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاه}،[3] وهي الكلمة الحق التي أرادوا بها الباطل.
ثمّ ظهر ذلك في دعوة القاسطين في الشام وادّعائهم السلطنة والخلافة لعثمان بن عفان، مستخدمين قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل}.[4] وحيث إنّ معاوية، وبحسب زعمهم ولي عثمان في الدم والقرابة، فهو السلطان الـمُعيَّن من قبل الله تعالى. وما كان أشد إسرافه في القتل بعد حين!
النقطة الـمُتفَق عليها والتي لا شك فيها هي أنّ الجميع ـ من عرب وأهل كتاب ومسلمين ومنافقين ـ كانوا قد أدركوا قوة القرآن العُظمى وقدرته الباهرة على التأثير في القضايا الكبرى، وأضحى كل فريقٍ يرى في القرآن وسيلته لتحقيق مآربه وأهدافه. ولو أردنا أن نتوقّف عند كل فرقة ومذهب ونُسجّل مواقفهم وسياساتهم في هذا المجال، لملأنا الكثير من الصفحات.
فعصر الرسالة الأولى كان عصر تثبيت القرآن عبر النجاح المبهر في زرع اليأس الـمُطبق في نفوس من أرادوا تحريف ألفاظه وحذف وجوده من ساحة الحياة. وبعد هذا العصر، بدأ صراعٌ من نوعٍ آخر دار حول تفسيره وتبيينه وتأويله. وسوف نرى بعدها كيف أضحى مسار الأمّة الإسلامية ومصيرها مبنيًّا على نتائج هذا الصراع من أيّ جهةٍ جاء.
هذا هو قلب المواجهة الكبرى التي خاضها خلفاء النبي الأكرم من أهل بيته(ص) على مدى عصور الإمامة. ونحن نقرأ في الأحاديث أنّ هذه المواجهة ستعود إلى الواجهة مرّةً أخرى، حين يخرج الثاني عشر من هؤلاء الأئمة الأطهار، وكل فرقة أو شخصية تتأوّل عليه كتاب الله تحتج عليه به.
حين يكون القرآن في الصدارة ويتقدّم عملية التغيير الاجتماعي، فمن الطبيعي أن يُصبح مستهدفًا بالدرجة الأولى. لكن أن يكون في الصدارة فهذا دليل خير وعافية أيضًا؛ لأنّ هذه القدرة العظيمة الأولى يجري استخدامها وتفعيلها وهذا ما سيؤدي حتمًا إلى تحريك المجتمع نحو الأهداف الكبرى.
هكذا وصل الدور إلى الإمام الحسين(ع)، حيث كان تأويل القرآن يدور حول آيات الحكم والإمامة وخصائص الحاكم الإسلامي وصفات خليفة النبي الأكرم(ص). ومثلما برع الناكثون في تأويل القرآن لأجل تثبيت الطبقة الرأسمالية التي أنشأوها واستفحل أمرها في عهد الحاكم الثالث، كان المنطق السائد للمؤولين في عصر الحسين(ع) يسعى لتأمين كل المستلزمات القرآنية لتبديل الخلافة إلى مُلكٍ عضوض ذي شرعية ربانية، يؤمّن انتقالاً هادئًا للسلطة في أعقاب معاوية بن أبي سفيان أو عشيرته الأموية.
ولا نحتاج إلى تعمُّقٍ في الفكر الاجتماعي حتى نُدرك حجم الكارثة التي يُمكن أن يُبتلى بها أي مجتمع إن أصبحت حكومته ملكية وراثية، حيث تكون مثل هذه الحكومات الاستبدادية أبعد شيء عن معايير الكفاءة العلمية والأخلاقية والسلوكية. هنا بالتحديد سيبدأ الانحدار إلى الهاوية بسرعة غير مسبوقة. ولئن كنّا نرى في الحكومات الثلاث التي توالت على حكم الأمّة بعد النبي خطرًا على المجتمع، نظرًا لما فيها من نقائص وعيوب دعت الأول منهم إلى طلب إقالته والثاني إلى اعتبارها فلتة، لكنّ خطر تلك الحكومات ما كان ليصل إلى خطر تحوّل الحُكم والخلافة إلى نظامٍ عشائري ومُلك شخصي. يشهد على كلامنا أنّ تلك الحكومات الثلاث مع ما لنا من ملاحظات عليها، لم تتمكّن من الحؤول دون وصول الإمام علي(ع) إلى الحكم بعد إبعاده عنه لمدة ربع قرن. فإذا تحوّل الحكم إلى ملكية استبدادية، أصبح بإمكان الملوك أن يتلاعبوا بالدين بأسهل ما يكون، فيغيّروا أحكامه ويبدّلوا عقائده، ويجعلوا الناس على دينهم كيفما شاؤوا.
وهكذا، وقف الإمام الشهيد أمام أكبر خطر يتهدّد الإسلام ومعه الـمُسلمين، وهو خطر وصول تيّار النفاق إلى مثل هذه القدرة والسلطة. فإذا كان النفاق الذي هو عبارة عن كفرٍ متستّر، العدوَّ الحقيقيَّ للرسالة {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُم}،[5] فما بالك إذا أصبح ممسكًا بمقاليد الأمّة وزمامها!
إنّ قيام الإمام الحسين(ع)، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إسقاط هذا النظام ولو بعد حين، وهو يعلم أنّ ذلك لن يتحقّق إلا بتقديم نفسه وأهل بيته في مواجهة تُظهر الوجه الحقيقي للنفاق والمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا النظام في عدائه للنبي الأكرم(ص).
وقد بنى الإمام الحسين (ع) على إنجازات من سبقه، وكان آخر هذه الإنجازات قد تحقّق بفضل سياسات أخيه الحسن ونجاحه في ترسيخ الموقعية المعنوية لأهل بيت النبوة داخل الأمّة المسلمة، بعد أن عملت إحدى زوجات النبي الأكرم لمدة مديدة وهي مُطلقة اليد على إقصائهم وتأويل آيات أهل البيت المطهرين. ويبدو أنّ معاوية كان قد تفطّن إلى هذا الإنجاز في أواخر حياته حيث حذّر ولده يزيد إن هو أراد دوام مُلكه أن لا يتعرّض بصورة مباشرة إلى الحسين وأهل بيته.
وحدث ما حدث، وغفل يزيد عن هذه النصيحة وأخذته سكرة الاستكبار وثمالة الغرور، وتجرّأ على المجاهرة بالاعتداء على أهل بيت النبي، الأمر الذي سرّع في تقويض أركان الملكيّة الأُموية والقضاء عليها في نهاية الأمر تحت شعار الثّأر لأهل البيت الأطهار(ع).
لقد توالت الثورات والانتفاضات على الحكومات الأُموية بعد عاشوراء، وكلها ترفع هذا الشعار وتتّخذه وسيلةً لها في حشد التأييد والأنصار، حتى تمكنت إحداها باستئصال هذه الأسرة المشؤومة والشجرة الملعونة في القرآن. وإن كان قد جرى الاستحواذ عليها من قبل بني العباس وتحويلها إلى ملكية أشد شؤمًا ولؤمًا.
إنّ الزلزال الكبير الذي أحدثته عاشوراء في المجتمع المسلم واستمرّت تداعياته لعشرات السنين، بل ما زالت إلى يومنا هذا، هو الذي جعل السلطات الأموية المتعاقبة بعد يزيد في موقع الانفعال، الأمر الذي لم يسمح لها بالمجاهرة برفضها لتعاليم الرسالة وعدائها للنبي الأكرم، وحال دون تخليها عن قناع نفاقها وإعلان حقيقة الردّة والمرود بصراحة، حيث لم يكن المجتمع الـمُسلم ليقف بوجهها أو ينجح في منعها.
وهكذا اضطر تيار النفاق الحاكم للعودة إلى النفاق واستبطان الكفر والمجاهرة بالإسلام ودعم القرآن، ما منح الرسالة ومشروعها التقدمي فرصةً أخرى لكي تستمر وتمضي قُدُمًا. وهذا هو السبب الأول وراء تلك الشعبية الـمُلفتة للنّظام الأموي عند طائفة واسعة من المسلمين وتمجيدهم له واعتباره حُكمًا شرعيًّا نصر الدين وحفظ القرآن.
وفي غمرة هذه المواجهة كان على أئمة أهل البيت(ع) أن يزيلوا النقاب عن هذا النفاق الذي يمكن وفي أي لحظة أن يستريح لوضعه، ويعود إلى موقع الفعل والهجوم. وكان السلاح الأمضى والوسيلة الأولى التي أُتيحت لهم هي عاشوراء نفسها التي لا يصعب الغض والتغاضي عنها كأفظع جريمة ترتكبها أمة بحق حفيد النبي، وهم يفعلون ذلك لتأسيس بنيانهم عليها.
المؤيّدون للنظام الأُموي وإنجازاته الدينية كان عليهم بذل جهود كبيرة لإطفاء النور الذي شع من هذه الواقعة الملحمية الممتزجة بأعظم البطولات والمواقف الخالدة. ولكن كيف لنيرانٍ تأجّجت بفعل قتل سبط النبي وسيد أهل الجنة وريحانة المصطفى الـمُختار أن يخمد أُوراها وهناك من يحمل مشعلها ويحفظ نهجها على مر العصور؟!
وهكذا تحوّلت قضية عاشوراء إلى أهم قضية مركزية في المواجهة والصراع، وكان الانتصار فيها كفيلًا بترجيح كفة الـمُنتصر في قيادة المجتمع وإدارته.
لقد قدّم الإمام الحسين بن علي بهذا الفعل الاستشهادي أقوى وسيلة لإصلاح الأُمّة؛ وبذلك أضحى السنّة النبوية التي لا يمكن التشكيك فيها. فكان على أعداء هذه السُنّة أن يقوموا مرّة أخرى بإخفاء هذه السُّنّة، ولم يكن أمامهم سوى العودة مرة أخرى إلى استخدام القرآن ورفع شعار "حسبنا كتاب الله"، وليقولوا للساخطين إنّ قيام الحسين هو {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُون}.[6]
وهكذا استُعيد القرآن إلى الصدارة، لتعود مواجهات التأويل أقوى ممّا كانت عليه، وذلك لأنّ هذا التأويل الـمُبتغى بعد عاشوراء يُراد له أن يواجه أنصع سُنّة وأشدّها إحكامًا. فمن الذي سيقدر على تبديل هذه الجريمة الكبرى إلى عملٍ مجيد عبر تفسير وتأويل آيات القرآن؟ ومن الذي سيتمكّن من تبرير جريمة الأمويين هذه، وتقديمها كموقفٍ أُريد به حفظ الأمّة والدين؟
إنّ هذا التأويل سيحتاج الآن إلى جُهدٍ فكريّ ومستوًى علميّ ما كان مسبوقًا، ويجب على مؤيدي السلطة الأمويّة أن يُبدعوا فيه؛ وهذا ما سيتطلّب نقل عمليّة التأويل إلى مستويات جديدة وأعماق أبعد. وبذلك، سيتم تثوير القرآن وطرح علومه ومعارفه وقضاياه ومسائله بصورة أدت إلى ما يشبه الطفرة على صعيد الاهتمام بكتاب الله وموقعيته المحورية في الحياة. مرة أخرى ينتصر القرآن وتسطع كلمة الله بطريقة لا تخطر على بال.
ولن يكون مبالغة إن قلنا إنّ معظم النشاط الفكري العلمي للمسلمين الذي تسارع بعد عاشوراء إنّما انطلق من هذه النقطة بالذات. وما كان نشوء المذاهب والتيارات وما نجم عنها من ثمرات علمية مُلفتة إلا نتيجة ذلك النشاط الذي أُريد له أن يواجه السنّة المؤكّدة لعاشوراء الحسين عليه السلام.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1]. سورة البقرة، الآية 26.
[2]. سورة النحل، الآية 44.
[3]. سورة يوسف، الآية 40.
[4]. سورة الإسراء، الآية 33.
[5]. سورة المنافقون، الآية 4.
[6]. سورة البقرة، الآية 134.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
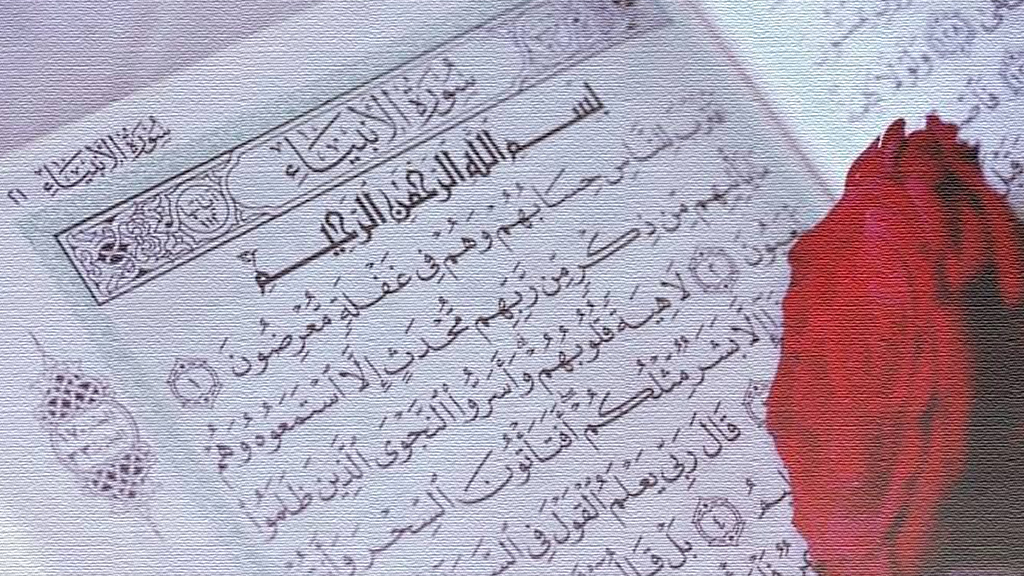
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










