مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.لماذا لا يقبل الله الأعمال إلا بالولاية؟

أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: الصالح والطالح. والصالح منه ما هو مقبول عند الله، ومنه ما دون ذلك. ولا شك بأن قبول الله لأي عمل إنما يكون بحسب انسجامه مع إرادته. وإرادة الله عز وجل واحدة إجمالية، تتكثر وتصبح تفصيلية (كما يحصل حين يأمر الحاكم بالنهوض الاقتصادي فيترجم أمره إلى مشاريع كثيرة في مختلف الوزارات).
لكن كل كثرة وتفصيل في الإرادة الواحدة لا بد أن يرجع إليها ليحققها.. ولما كان وجود الإنسان على الأرض لغاية إصلاحها وعمارتها وتبديلها إلى أرضٍ مشرقة بنور ربّها، وكان هذا الهدف نابعًا من إرادة الله تعالى، فلا بد أن يتحقق. فينبع من ذلك إرادة تكوينية (والله غالب على أمره) وإرادة تشريعية. وفي عالم التشريع يجب أن تكون أعمال العباد تابعة لهذا الهدف متجهة نحوه، إن اقتربت منه وقربت إليه فهي منسجمة مع إرادة الله، وإلا فلا.
هذا ما نفهمه من روايات، صريحة ومشيرة، تناولت مسألة عدم قبول أعمال العاملين "الصالحة" التي هي بالظاهر كذلك. ففي بعض هذه الروايات نجد التأكيد على ضرورة دخول أي عامل وعابد من الباب الذي أمر الله به وإلا فلا قبول ولا رضى، فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: "إِنَّ حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبَدَ اللَّهَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْخِلَالِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ فِي زَمَانِهِ قُلْ لَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجَبَرُوتِي لَوْ أَنَّكَ عَبَدْتَنِي حَتَّى تَذُوبَ كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ فِي الْقِدْرِ مَا قَبِلْتُ مِنْكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَمَرْتُك"؛[1] وفي بعضها تصريح بعدم قبول العمل مهما كان بظاهره موافقًا للشرع، لكونه لا يدخل فيما يريده الله. وأفضل جامع لهذا المعنى هو ما ورد في أحاديث أهل بيت العصمة حول شرطية تولي أولياء الله لقبول الأعمال.
وما نفهمه من هذه الأحاديث هو أنّ ذلك يرجع إلى أن أولياء الله هم محل ظهور إرادته تعالى. ولذلك كانت طاعتهم طاعة لله. وهذا كله غير قضية الإخلاص التي ترتبط بنية القربة، وإن كان الإخلاص دخيلًا في هداية العامل إلى إصابة التكليف.
باختصار، نحن بحاجة إلى تعميق فهمنا لمعنى العمل الصالح الذي يجعل العامل به متصفًا بالصلاح الواقعي؛ وهو مقام طلبه الأنبياء، وجُعل لبعضهم في الآخرة (التي تشير إلى آخر الزمان)، {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحين}.[2]
صحيح أن للفطرة وللعقل دورهما في تعيين الصلاح، وكذلك الشرع، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا العقل نفسه يدلنا أيضًا على أنّ أي عمل صالح إن كان مؤداه فسادًا، فلا يكون صالحًا. كما هو الحال في الأعمال الخيرية التي توطّد سلطة الحكومات الجائرة. فهي بالظاهر تكون خدمة للمحرومين والبائسين، لكن نتاجها ـ ولا شك ـ سيكون عبارة عن كسب تأييد هؤلاء المحرومين ودعمهم لتلك السلطات التي ترعى، بل تحرك تلك الجمعيات الخيرية. ولعل هذا هو الشيء الذي كان يقصده الإمام الصادق عليه السلام حين قال: "أَيُّهَا النَّاسُ دِينَكُمْ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ وَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ تُغْفَرُ وَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ"،[3] مشيرًا إلى المذهب الحق.
ما نحتاجه هنا هو توسعة آفاق العقل في دراسته وتحليله للأعمال الصالحة وعدم حصره في أُطُرٍ ضيقة؛ حيث يُفترض أن يبدأ من تحديد الصلاح العام أو الصلاح الكلي الشامل لكل صلاح ممكن؛ وهو معيار عام وشامل كما كان علي بن أبي طالب معيارًا للحق يدور معه حيثما دار. وحينها لن يطول الأمر حتى ندرك أنه من دون حكومة الصالحين الأبرار والسعي نحوها، سوف تذهب أعمال الخير سدًى؛ كل ذلك انطلاقًا من الاعتقاد المرتبط بالمهمة الكبرى والإرادة الأولى الكلية.
حين لا نرى لوجودنا مثل هذه المهمة على الأرض، فمن الصعب أن نُدرك معنى الإرادة الإلهية الكلية الواحدة؛ وهكذا سنجعل إرادته تعالى أحاديث ونمزقها كلّ ممزق؛ فنتخذ من بعضها وسيلة إليه سبحانه، جاهلين بأنّ إرادة الله لا تتبعض ولا تتجزأ. وهكذا، نتصور أننا بالصلاة نعرج، أو بالصيام نفوز أو بالجهاد نصل، أو بخدمة المحرومين نتقدم. في حين أن كل هذه الأعمال مع عظمتها وأهميتها لا تكون وسيلة إلى الله إلا إذا اندرجت ضمن نظامٍ واحد مترابط يجمعه أمر الله المتمثل في حركة أوليائه؛ كما جاء عن السيدة الزهراء عليها السلام: "وطاعتنا نظامًا للملة، وإمامتنا أمانًا من الفرقة".[4]
لم تكن هذه المعارف خافية على محبي أهل البيت وأتباعهم على مدى العصور، وقد جمع بعض محدثيهم روايات مهمة في هذا المجال وعقدوا لها أبوابًا وكتبًا تؤكد على أن الأعمال لا تُقبل إلا بولايتهم، كما في حديث أبي حمزة الثمالي حيث قال: "قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام: "أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عامًا، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا، لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئًا".[5] وفي رواية أخرى، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: "أَمَا لَوْ أَنَ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ، وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ، فَتَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْه،ِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَان".[6]
ما كنّا نحتاجه في عصر غيبة ولي الله هو اكتشاف طريقه الموصل إلى مشروعه وخطته العامة، لأن الكثير من المحبين قد أضاعوا هذا المعنى رغم اعتقادهم به، حين لم يجدوا له مصداقًا عمليًّا. ولهذا نجدهم يُفسرون أحاديث التولي والولاية ببعدها العقائدي الخاص دون ذكر البعد العملي التطبيقي. فإذا ذكروا فرائض الإسلام وأتوا على ذكر التولي، ذهبوا إلى الاعتقاد بولاية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
لقد فقدنا بغيبة إمامنا ذلك النظام الذي يجمع حبات الأعمال الصالحة، وتسلل إلينا تصور إمكانية الوصول إلى الله بهذه الأعمال دون نظامها الجامع، في حين أن إرادة الله الأولى لم تنعدم ولم تحتجب. وما زالت المهمة الأولى قائمة ما دامت السماوات والأرض.
وكان من آثار هذه الغفلة انحسار القيمة الأولى التي تنبع من هذه العقيدة، وهي قيمة ارتباط الأعمال بذلك المشروع الكبير. وهكذا أضعنا المعيار الذي نتمكن بواسطته من ترتيب الأعمال بحسب القيمة الواقعية عند الله تعالى، وهي قيمة الحسن والقبح.
ولكي يتضح هذا المعنى أذهب في مثالي إلى أقصى ما يمكن أن يحدث؛ وذلك فيما إذا كنا نقارن بين أداء رئيس أمريكا وبين أداء مجاهد كبير ومسؤول كبير في ساحة الإسلام. فلا شك بأن أعمال الطواغيت مخالفة للمشروع الإلهي شاءوا أم أبوا، لأنهم بمجرد أن تسنموا هذه المواقع الحساسة مع جهلهم بمسؤولياتها ومهماتها وطرقها وأهدافها وقيمها، فسوف يظلمون ويفسدون، فكيف إذا كان الإفساد جزءًا من برامجهم وشخصياتهم وأخلاقهم!
ثم نأتي إلى شخص يُفترض أن يعمل في موقع حساس ضمن ما يتوقعه الناس من المجاهدين والعاملين في سبيل الله تعالى، والأهم ما يُتوقع من الموالين وهو أن ينطلقوا في أعمالهم مما يريده ولي الله المنصوب المُعيَّن ـ الذي يُسمّى في عرف الأحاديث بالإمام من الله. فإن بعض المخالفات التي يرتكبها هذا المجاهد قد تكون أضر على المشروع الإلهي من جميع أعمال ذلك الطاغوت، وذلك لأن عمل الطاغوت وإن كان كبيرًا لكن فساده واضح وقبحه أوضح؛ فهو لا يمثل فتنة كبيرة للناس تعميهم عن الحق، إلا من قصد ذلك. في حين أن المخالفة التي صدرت من ذلك المجاهد، بالإضافة إلى كونها مخالفة للمشروع، فقد تعمي عن الحق لأنها تلبس لبوسه ويمكن أن يُسنّ وفقها سنّة المخالفة إلى ما شاء الله؛ وسبب ذلك أنها صدرت عمّن يُتصور أنه من الموالين المؤمنين المسلمين.
فالقبح لا يكمن فقط فيما ظهر وبان، بل إن أقبح القبيح في الأعمال (بحسب هذا التفسير) هو الذي يصد عن الأعمال الصالحة (التي أشرنا في البداية إلى منطلقاتها). وكم من قبيح من الأعمال أدى إلى انبعاث ما لا يُحصى من الأعمال الحسنة. مثل قبيح المستعمرين الذي بعث آلاف المجاهدين ليقوموا بأعمال بطولية وتضحيات فدائية وشهادات ربانية. في حين أن قبيح العاملين المجاهدين الذي خفي على الناس، استمر ودام وصار سُنّة يُعمل بها على مدى العصور!
أتفهم بدايةً سرعة إنكار بعض الإخوان عليّ حين ذكرت لهم الفارق النوعي بين الأعمال وفق معيار الولاية. وأتفهم سرعة حكمهم بالتعصب والتحجر، خصوصًا الذين يستسهلون رمي الأحاديث المعتبرة بعرض الجدار، لا لشيء سوى لأنها تخالف عقائدهم وما نشأوا عليه من نظام فكري.
إن هذا الرفض الذي لقيته منهم يشبه ما كنّا نسمعه في أزمنة سابقة من مجددي الفكر في إنكارهم لموقع محبة أهل البيت ودورها في تحديد مصير المسلم، أو في إنكارهم لقضية الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة. فوفق ميزان العدل، يستبعد هؤلاء المساواة بين العامل الصالح العابد الزاهد والفاجر العاصي المقصر في المصير، ويرون مبدأ الشفاعة الشاملة عاملًا للمساواة. وهنا أيضًا يرى هؤلاء أن محورية الولاية في قبول الأعمال تستخف بالأعمال الكبيرة وتُقلل من شأنها وتجعل من كان قليل العمل مع الولاية أفضل من كثير العمل دونها، رغم أن الله تعالى ربط مصير الإنسان بعمله وسعيه.
إن هؤلاء ربما غفلوا عن أن السعي وحده ليس هو المعيار، وأن الأصل ليس في كثرة الأعمال وأحجامها، بل في صلاحها وإصابتها ورضى الله عنها (الذي هو الموافقة مع إرادته سبحانه). هذا، وإن مبدأ قبول الأعمال على أساس الولاية هو أمر صعب مستصعب؛ لو أعملناه بكل شروطه وجهاته لربما لا يبقى مع غرباله سوى القليل النادر من العاملين.
الاستخفاف بقيمة الأعمال عند الله والاعتباط فيها (وهو غير كونها يسيرة وسمحة) يرجع إلى الغفلة عن شأن الله تعالى. وكلامنا كله في تقييم الأعمال ومصيرها ومآلها، لا في تقييم أصحابها وتحديد مصيرهم حيث الرحمة الواسعة.
إن قبح عمل من يُفترض أن يكون سببًا لإقبال العاملين نحو المشروع الإلهي وانضمامهم إليه وتضافر جهودهم فيه، وهو يفعل العكس، لن يبقى خفيًّا حين نُعيد النظر في كل هذه المنظومة العقائدية القيمية. إعادة النظر مطلوبة، وذلك لأجل نجاتنا والخروج من الحيرة التي تتلجلج في صدورنا جراء قيامنا بالكثير من الأعمال الصالحة ونحن نرى في المقابل ضعف تأثيرها أو انعدامه؛ لأننا بذلك سنحوّل هذه الحيرة على الله ونشك بلطفه وعدله وحكمته من حيث لا نشعر. وفي ذلك هلاك عظيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. المحاسن، ج1، ص97.
[2] . سورة البقرة، الآية 130.
[3]. بحار الأنوار، ج65، ص311.
[4]. بحار الأنوار، ج29، ص223.
[5]. المحاسن، ج1، ص91.
[6]. الكافي، ج2، ص19.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
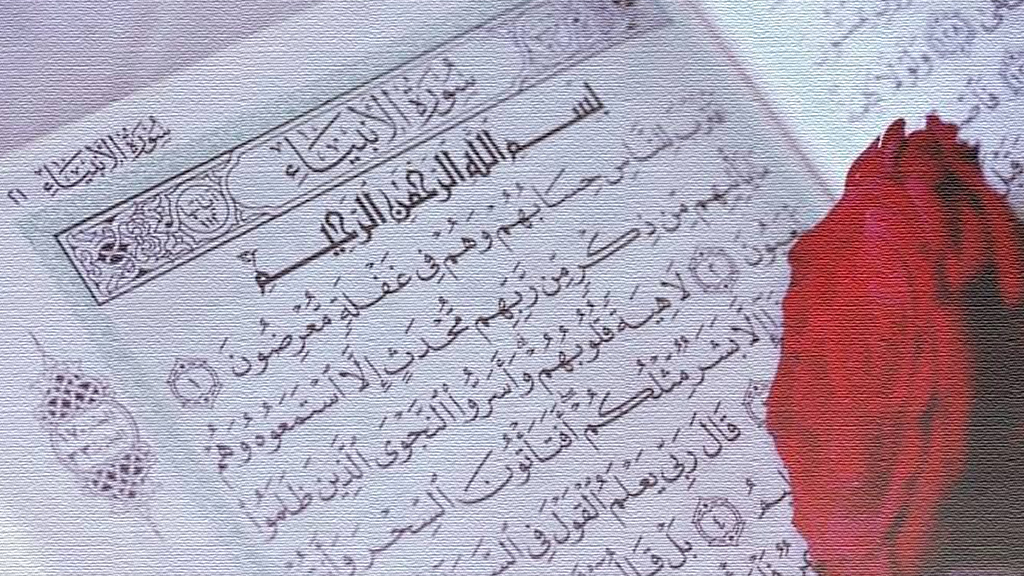
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










