علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

حين يُبسط الكلام على أفلاطون الآن، يتناهى للنّاظر أنّه تلقاء مفارقةٍ غير مألوفةٍ: سوف يبدو له كما لو أنّ استرجاع هذا الحكيم، وجعله قضيّةً راهنةً هو أدنى إلى عودٍ على بَدءٍ لا طائل منه. والحجّة إذ ذاك، أنّ بسطَ القولِ فيه وعليه، هو ضربٌ من تكرارٍ مسبوقٍ بما أنشأه محقّقوه وشارحوه من قبل..
لكن استرجاعنا لأفلاطون اليوم، تسوِّغه فرضيِّتان: الأولى، لأجل ابتعاث تفلسف مستأنف يدور مدار التساؤل عن إمكان قيام ميتافيزيقا تجاوز ما ترسخ من يقينيات منذ الإغريق إلى يومنا الحاضر. والثانية: لأجل التذكير بما غزاه النسيان من الأفلاطونيّة، سواء لجهة نقد مبانيها قديماً وحديثاً، أو لجهة ما يختزنه ميراثها من مفارقات تراكمت عليه الظّنون وسوءات الفهم.
ولمَّا كانت غايتنا المحورية تحرِّي الأثر الأفلاطوني في ما أفضى إليه من معاثر اقترفتها الحداثات المتعاقبة سحابة خمسة قرونٍ خلت، فإنّ من شأن هذه الاستعادة أن تنبِّه إلى الصّدع الكبير الذي ألمَّ بأبنيتها الأنطولوجيّة والمعرفيّة. فعلى الرغم من تحيُّز الحداثة إلى القدماء الذين خالفوا أفلاطون أو انقلبوا عليه، إلا أنها ستتخذ من “ثنائياته” في تفسير العالم ذريعة لإحداث القطيعة بين الطبيعة وأصل وجودها.
ولنا هنا شاهدٌ على تلك الذريعة، لمّا ذهب الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر إلى اختزال معضلة الحداثة بما أسماه “نسيان الكينونة”. أي غفلة الحداثة التي أصابها مسٌّ الأفلاطونية عن حقيقة الوجود، واستغراقها بظواهر العالم الطبيعي وأعراضه. ومع أن هذه المقولة عُدَّت نقطة الجاذبية في فكر هايدغر النّقدي، وأعربت عن المأزق الميتافيزيقي للفلسفة الحديثة، إلا أنها لم تفارق جوهر الثنوية الأفلاطونية. فالكينونة الهايدغرية وبتأثير من أفلاطون كانت أقرب إلى الموجود الأول منها إلى الله الموجد للكون.
ومع أن أفلاطون قد اتَّخذ من الخيريَّة والعدالة والمجتمع الفاضل سياقاً مفارقاً للسابقين واللاَّحقين من حكماء اليونان، إلا أنه لم يقدر على بلوغ التوحيد الخالص كما أظهرته الديانات الإبراهيمية. ولو كان لنا من توصيف لهذه المنزلة لجاز القول إنها إعرابٌ بيِّنٌ عن التوحيد الناقص. ربما لهذا الداعي سيغلب على كتاب المحاورات سمة التساؤل الحائر من دون أن ينفذ صاحبها إلى المحل الذي يفصح عن إجابات يقينية عن الوحدانية الإلهية.
خلاصة ما فعله فيلسوف الجمهورية، ولم يستطع سقراط أن يكمله، تجلَّت في تظهيره لفكرة الخير الكلِّي كمصدرٍ لتحصيل المعرفة. ولقد أراد أن يحلّ هذه المسألة، تأسيسًا على نظريّة المُثُل بما هي الدفاع الأعلى عن الأخلاق الموضوعيّة. غير أن الحريَّ بالاعتناء والنّظر هنا، هو سَرَيان منظومة أفلاطون في الأحقاب التالية مع ما انطوت عليها من إشكاليات وعثرات، سواء في ما يتعلق بعقيدة التوحيد، أو ما يتصل برؤيته الأخلاقية والسياسية والتربوية. وعلى سبيل التذكير ـ نشير إلى تأثيره الكبير على مسيحيّة القرون الوسطى، حيث سيكون لأفكاره نتائج عكسية خصوصاً لجهة استلهامها لاهوته الطبيعي الوارد في كتاب القوانين (Laws)، وأخرج فيه معادلته الشهيرة:
إنّ هناك آلهة، وهي تعتني بشؤون البشر، ومن المستحيل رشوتها أو شراء إرادتها الخيّرة”… كانت النتيجة أن عدداً وازناً من آباء الكنيسة وفلاسفتها وقعوا في تناقض مريب بين إيمانهم الديني وفكرة تعدد الآلهة عند أفلاطون. ومن البيِّن بسببٍ من ذلك، أنّ فلاسفة الحداثة سيأخذون هذه الفكرة عن ظهر قلب لينصرفوا إلى الفصل الحاد بين اللّه والعالم. وهذا لم يكن مجرد حادثٍ عارضٍ في بنية الفلسفة الحديثة، وإنما هو حاصل إرث إغريقي لم تكن الأفلاطونية بمنأى عنه، ثم كان له امتدادُه وسريانُه الجوهري في ثنايا العقل الكلِّي لحضارة الغرب. بهذه الدلالة لم يكن تأرجح أفلاطون بين ضفتّيْ الشرك والتوحيد سوى مؤشِّر على الإضطراب الميتافيزيقي الذي سيورثه إلى العالم الغربي في ما بعد. حتى لقد غدا كلُّ سؤالٍ تُعلنه الحداثة على الملأ مثقلاً بالمعاثر: من الثنوية، إلى النسبيّة والشكوكية، ناهيك بمجمل ما يمكث من آثار وتداعيات ترتَّبت في ما بعد على انحصار التفكير الحداثي في دنيا المقولات الأرسطية العشر.
لا نبتغي من وراء قصدنا، المفاضلة بين أفلاطون وأرسطو. ولا كذلك، الانتصار لأفلاطون بدلاً من شُرعة الحداثة ومبادئها.. وإنما للإضاءة على البَدءِ الذي منه صار أفلاطون فيلسوفًا مؤسِّساً لمملكة العقل الأدنى. قوله بأصالة عالم المُثُل باعتباره الوجود الحقيقي، وجاء في حينه كردٍّ صريح على مادية السوفسطائيّة ولاأَدريَّتِها الصمَّاء، إلا أنه يمتلئ بما لا حصر له من مؤاخذات في هندسته الأنطولوجية.
حين أخرج أفلاطون نظريّة المُثل، أراد إثبات عقيدته المفارقة بأن العالم المادي ليس سوى أشباح للعالم الحقيقي، وأنّ المثال الأعظم الذي يفضي إليه هو الخيريّة التامَّة، وأنّ الخير المطلق هو المقام الأرفع للمعرفة، وهو مبعث الوجود والكمال. مع ذلك بقيت نظرية الخير المطلق ضرباً من التأملات والاختبارات الذاتية، ولم تصل إلى الدرجة التي توصلُ فيه الخيرية بمصدرها الأول. ما يعني أن اقصى ما بلغته المُثُل الأفلاطونية هو التعبير عن ألوهية أرضية، سوف توظَّف في ما بعد بـما سمِيَ “الدين الطبيعي”.
في هذا المسرى يذهب ناقدو نظرية المُثُل الى إبطال قوله أن النفس موجودة قبل البدن، وأن الإدراك العقلي هو عبارة عن إدراك الحقائق المجردة في ذلك العالم الأسمى. يرى هؤلاء أن كلتا القضيتين خاطئتان. فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئاً موجوداً بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة تبدأ النفس بها مادة متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانينها، ثم تصبح بالحركة والتكامل وجوداً مجرداً عن المادة لا يتصف بصفاتها ولا يخضع لقوانينها. وأما المفهوم الأفلاطوني الذي يفترض للنفس وجوداً سابقاً على البدن فهو بحسب هؤلاء أعجز ما يكون عن تفسير هذه العلاقة وتعليل الارتباط القائم بين البدن والنفس، وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من عليائها المثالي إلى واقعها المادي المتهافت”.
في “المحاورات” و”الجمهوريّة” وفي سائر تأمّلاته الميتافيزيقيّة والسياسية، حرص أفلاطون على الوصل الوطيد بين عالم المُثُل ودنيا الإنسان. ولقد حاول ذلك من خلال ثلاثة سبُل: أوّلاً، عن طريق التساؤل كسبيل قويم للمعرفة الحكمية، وثانياً، في ما يسميه بإرسال شرارة الفهم إلى السامعين. “تلك التي تولد فجأةً في الرّوح مثلما يومض الضّوء حين توقد نارٌ وتتغذّى بذاته من ذاتها” كما يورد في رسالته السابعة.. وأما ثالثاً، ففي نظريته السياسيّة القاصدة سعادة الإنسان في كتاب الجمهوريّة. غير انه أخفق في ما ذهب إليه....
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (وفق) في القرآن الكريم
معنى (وفق) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الصدقات وعجائب تُروى
الصدقات وعجائب تُروى
عبدالعزيز آل زايد
-
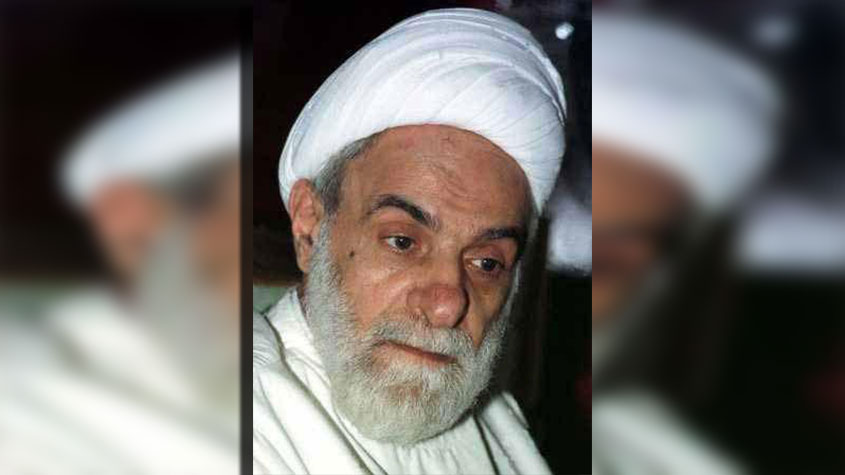 حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)
حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
 صفة الجنة في القرآن الكريم
صفة الجنة في القرآن الكريم
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)
لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)
محمود حيدر
-
 معـاني الحرّيّة (4)
معـاني الحرّيّة (4)
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 (الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى
(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)
النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)
الشيخ شفيق جرادي
-
 (مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني
(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني
عدنان الحاجي
-
 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

معنى (وفق) في القرآن الكريم
-

الصدقات وعجائب تُروى
-

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)
-

صفة الجنة في القرآن الكريم
-

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)
-

معـاني الحرّيّة (4)
-

عبير السّماعيل تدشّن روايتها الجديدة (هيرمينوطيقيّة أيّامي)
-

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى
-
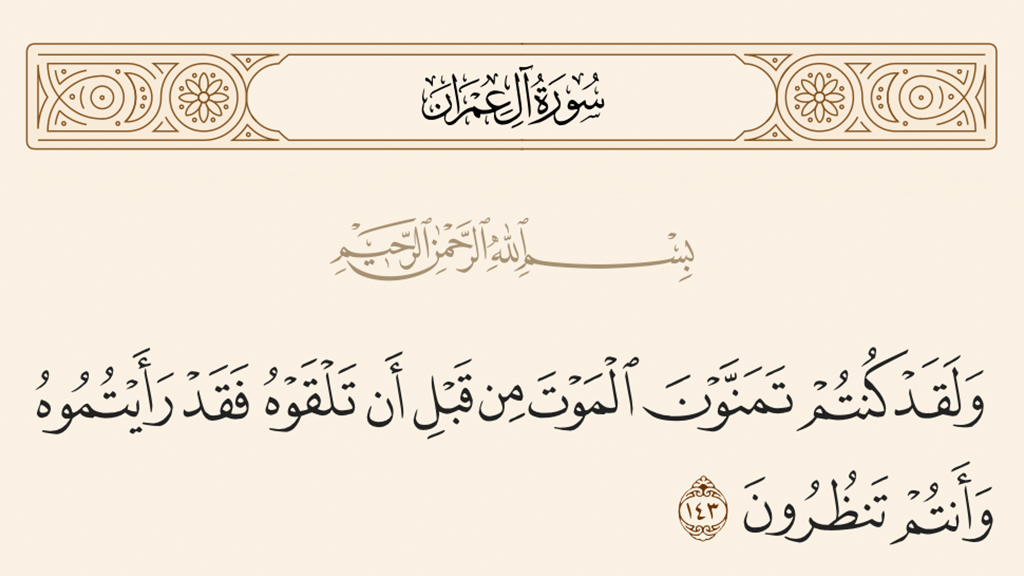
معنى (منى) في القرآن الكريم
-
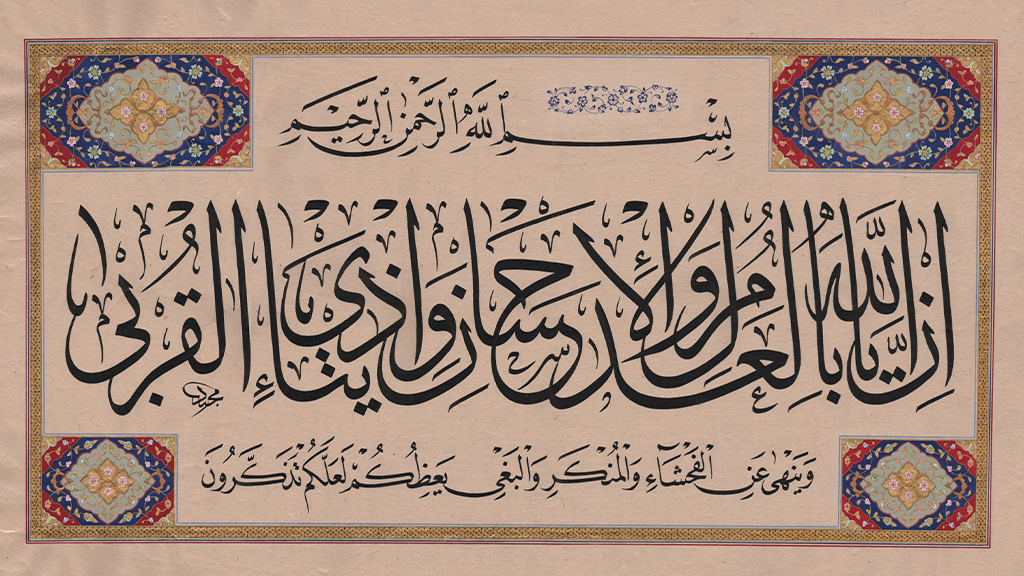
ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة









