مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمكيف يلبي الإسلام احتياجات كلّ عصر

كثيرًا ما تصف البحوث الاجتماعية الإنسان بأنّه مدنيّ واجتماعي بالطبع. ومردّ ذلك إلى أنّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته ويمارس فعالياته بشكل مستقل، بل هو دائب الاحتياج إلى غيره في تأمين بعض مستلزمات حياته، لذلك لا مناص له من اختيار الحياة الاجتماعية والتحرك في نطاق الجماعة.
وكثيرًا ما تواجهنا البحوث القانونية بأنّ المجتمع لا يستطيع أن يلبي الاحتياجات الحياتية لأفراده إلّا في إطار سلسلة من النظم والضوابط التي تسري على الجميع، وتضمن لكل إنسان أن يكتسب حقوقه ويستفيد من مزايا الحياة لتعود عليه ثمار العقد الاجتماعي والقوانين الجماعية التي هو جزء منها بحكم مشاركته بقسط وآخر في نشوئها وإيجادها.
يترتب على هاتين المقدمتين أن تكون الاحتياجات الحياتية هي العامل الذي يكمن وراء ظهور الضوابط والنظم الاجتماعية، وبدون تلبية هذه الاحتياجات لا يستطيع الإنسان أن يستمر بالحياة لحظة. فتلبية هذه الاحتياجات هو الدافع المباشر لنشوء المجتمع وإجراء القوانين والنظم الاجتماعية.
ومن البديهي أننا لا نستطيع أن نطلق وصف المجتمع على كيان جماعي لا يلبّي احتياجات أفراده وليس ثمة صلة بين أعمال ونشاطات أعضائه. وكذلك لا يمكن أن تتسم القوانين والنظم بالواقعية إذا لم يكن لها أثر في سد الاحتياجات الاجتماعية للناس وتأمين حقوقهم وتحقيق سعادتهم.
إنّ وجود القوانين والنظم أمر ضروري لكافة المجتمعات بغضّ النظر عن درجة نضجها وكمالها. فما هو مطلوب أن تؤمن هذه النظم حاجات المجتمع وتنال رضاه على نحو الإجمال. وليس ثمة فرق في تلمّس هذه الضرورة بين مجتمع وآخر، فحتى المجتمعات البدائية الوحشية تعيش حياتها من خلال ضوابط، وغاية ما هنالك أن المجتمعات المتخلفة تعيش هذه النظم من خلال تلبّسها بالعادات والتقاليد المحلية المتمخضة عن مواقف غير منتظمة وجدت بالتدريج، أو إرادة فرد متجبر أو عدة من الأشخاص الذين تحكموا بمقدرات الناس بالقوة.
ولكن الحصيلة تتجسّد دائمًا في أن هناك قواعد واضحة مقبولة نسبيًّا من الجميع أو من الأغلبية تحرّك مسار الحياة الاجتماعية. وما تشهد به وقائع الحياة الآن أنّ هناك في زوايا العالم وأرجائه القاصية مجاميع بشرية ما زالت تعيش حياتها من خلال الآداب والتقاليد المحلية من دون أن يؤدي ذلك إلى تلاشي نسيج حياتهم الاجتماعية.
أما المجتمعات المتقدمة فهي على نحوين، فإما أن تستمدّ نظمها وضوابط حياتها الاجتماعية من شريعة سماوية تنقاد إليها. أو أن تكون مجتمعات غير دينية تخضع لنظم وقوانين ناتجة عن تراضي الأغلبية وتوافق إرادتها على نحو مباشر أو غير مباشر. وبشكل عام، فإننا نفتقد للمجتمع الذي يفتقر إلى ضوابط تحدّد مسؤولية أفراده، بل نستطيع القول إنّ مجتمعًا مثل هذا لا إمكان لوجوده أصلًا.
كيفية تشخيص الاحتياجات
اتضح مما سبق أنّ الاحتياجات الحياتية هي العامل الرئيسي وراء ظهور القوانين والنظم الاجتماعية، والذي نريد أن نتعرف عليه الآن هو كيفية تحديد هذه الاحتياجات التي هي في النهاية احتياجات الإنسانية؟ من الثابت أنّ هذه الاحتياجات يجب أن تكون قابلة للتشخيص من قبل الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ولو على نحو إجمالي وكلّي.
والسؤال الذي يبرز هنا: هل يمكن للإنسان أن يخطئ أحيانًا في تشخيص هذه الاحتياجات الاجتماعي ، أم أنّ كلّ ما يراه محققًا للسعادة يجب الإذعان له والتسليم به دون نقاش، لأنّ ما يراه ويريده هو عين الواقع وبالتالي لا بدّ من القبول به وتطبيقه؟
إنّ أكثر المجتمعات البشرية في عالم اليوم، وبالذات ما يصطلح عليه بالعالم المتقدم يعتبر الإرادة الإنسانية أصلًا في تشخيص الاحتياجات. ولكن لما كانت إرادة أفراد الأمة لا تتفق أصلًا على احتياجات موحّدة أو أنها تتفق على أشياء تعدّ هامشية بالقياس إلى ما تختلف عليه، فقد انتهوا إلى اعتبار إرادة الأكثرية (نصف المجموع + 1) هي الملاك في مقابل إلغاء حرية الأقلية ومصادرة إرادتها.
انّ أحدًا لا يسعه أن ينكر - طبعًا - أنّ لإرادة الانسان صلة مباشرة بوضعه الحياتي. فالإنسان الغني الذي توفرت له وسائل الحياة، تدور في ذهنه آلاف الأفكار والأمنيات التي لا تخطر على ذهن الفقير. والشخص الجائع يطمع بأي طعام سواء كان لذيذًا أو غير لذيذ، أو كان ملكًا للآخرين، أما الغني المترف فلا يمد يده إلّا إلى ألذ الأطعمة يتناولها بدلال وتمنّع.
وهكذا نجد أنّ حالة الرفاه تجعل الإنسان يفكر بما لا يفكّر به وقت الضيق والحاجة وقلة ذات اليد. وبذلك نجد أنّ التقدم المدني في الوقت الذي يسدّ في نموّه التدريجي المطّرد قسمًا من احتياجات الإنسان، يفتح الباب لاحتياجات جديدة تحل مكان القديمة، وهذه العملية تستدعي بدورها الاستغناء عن سلسلة من القوانين وظهور حاجة ماسة إلى مجموعة من القوانين الجديدة، أو أن يصار إلى تغيير القديم عبر تحديثه وتبديله.
ولذلك تجد النظم والقوانين القديمة في الأمم الحية تترك محلّها دائما للنظم والقوانين الجديدة، والسبب الحقيقي في عملية التغيير المستمرة هذه هي إرادة الأكثرية التي تكتسب لدى تلك الأمم صيغة تشريعية تنتج القانون وتسبغ عليه الشرعية والواقعية في نفس الوقت، حتى لو لم تحقق هذه الإرادة الصلاح الواقعي للمجتمع.
على سبيل المثال، نجد أنّ الشخص الفرنسي محترم في المجتمع الفرنسي كونه عضوًا في المجتمع وجزءًا منه، وإرادته محترمة إذا توافقت مع الأكثرية. وما تريد القوانين والنظم الفرنسية تحقيقه هو رعاية الإنسان الفرنسي في القرن العشرين، لا رعاية ذاك (البريطاني) الذي يعيش في بريطانيا، أو الفرد الفرنسي الذي كان يعيش في القرن العاشر مثلًا.
وينبغي الآن أن ننتبه جيدًا لنرى هل أنّ العامل المذكور الذي يتحكم باحتياجات الإنسان يتغيّر أيضًا بتطوّر المدنية وتقدمها؟ ثم هل اختفت العوامل المشتركة بين المجتمعات البشرية على مرّ العصور بحيث لم يعد لها وجود؟ وهل تغيّرت الطبيعة الإنسانية التي ترتبط بها بعض احتياجات الحياة (تمامًا كما تختلف بعض الاحتياجات تبعًا لاختلاف الأماكن وتنوّع مراكز الحياة) على نحو تدريجي كأن يكون الإنسان البدائي فاقدًا للعين والأذن واليد والرجل والعقل والقلب والكلية والرئة والكبد وأعضاء الجهاز الهضمي إلى غير ذلك مما نملكه اليوم من أعضاء، أم أن تكون وظائف هذه الأعضاء قد تغيّرت؟ وهل ثمة معنى للحوادث التي مرّ بها الماضون مثل الحرب والصلح غير سفك الدماء واستئصال الإنسان أو حمايته والحفاظ عليه؟ وهل ثمة آثار لتعاطي الخمور في عهد جمشيد مثلًا (أحد ملوك إيران) مغايرة لما هي عليه الآن؟ وهل كانت آلات الغناء والطرب والموسيقى المختلفة في العصور الماضية تبعث على لذة تختلف عن هذه التي تبعثها آلات اليوم؟
وخلاصة القول: هل اختلفت البنية الوجودية للإنسان الأول عما هي عليه لدى الإنسان المعاصر؟ أم أن أوضاع وأحوال وآثار أعمال الإنسان سابقا وردود فعله الداخلية والخارجية، هي غير أحوال وردود فعل الإنسان المعاصر؟ من الواضح أنّ جواب كل الأسئلة الآنفة هو النفي.
فلا أحد يسعه أن يزعم: أن كنه الإنسانية قد تغيّر تدريجيًّا - أو يمكن أن يحلّ - محله شيئًا آخر، تمامًا كما لا أحد يسعه القول؛ إنّ الطبيعة الإنسانية التي هي حدّ مشترك بين الأسود والأبيض والكهل والشاب، والعالم والجاهل، والقطبي والاستوائي من بني آدم، المعاصر منهم ومن مضى أو سوف يأتي، لا تلتقي على سلسلة من الاحتياجات المشتركة التي تندفع إرادة الإنسان لتأمينها وتحقيقها.
إنّ هذه الاحتياجات الواقعية موجودة بلا ريب، وهي تقتضي وجود سلسلة من النظم والضوابط الثابتة التي لا صلة لها بتلك القوانين والنظم القابلة للتغيير. فلا نجد أمة في أي عصر من العصور لا تجيز الدخول في حرب ضد عدو ثبت لها يقينًا أنه يهدّد حياتها بالدمار ووجودها بالزوال، أو لا تمضي سفك الدم حين يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لدفع شر مثل هذا العدو وقطع دابره.
ولا تستطيع سلطة في المجتمع أن تمنع أفراده من تناول الطعام اللازم لدوام حياتهم، أو أن تقمع الميول الجنسية. إنّ هذه - وأمثالها كثير - هي من نوع الأحكام الثابتة غير القابلة للتغيير، وليس ثمة صلة بينها وبين الجوانب المتغيّرة - في وجود الإنسان وحياته -.
نخلص من مجموع المقدمات التي مرّت إلى النتائج التالية:
1 - تعدّ الاحتياجات الحياتية العامل الأساسي في وجود المجتمع والعقود والنظم الاجتماعية.
2 - للشعوب جميعًا - حتى البدائية الوحشية منها - قوانين ونظم خاصة بها.
3 - تعبّر إرادة أغلبية أفراد المجتمع عن الوسيلة السائدة في عالمنا المعاصر لتشخيص الاحتياجات الحياتية.
4 - إرادة الأكثرية لا تتطابق مع الواقع دائمًا.
5 - ثمة مجموعة من القوانين التي تتغيّر بتقدم العصور وتطوّر المدنية، ومثل هذه القوانين ترتبط بأوضاع وحالات خاصة. وفي المقابل ثمة مجموعة أخرى ترتبط بأصل «الإنسانية» وهي حدّ مشترك بين جميع البشر لا تتغير في جميع أطوار الحضارة وأدوار الحياة وتقلباتها مهما كانت الشروط.
بعد أن اتضحت هذه الموضوعات لنر ما هي رؤية الإسلام؟
ما هي نظرية الإسلام؟
نظرًا لكون الإسلام نظامًا عالميًّا لا يختص بجماعة بعينها ولا بمكان أو زمان معينين فإنّ مخاطبه في نهجه التعليمي - التربوي هو «الإنسان الطبيعي». بمعنى أنّه يتوجه إلى البنية الإنسانية الخاصة التي ينطوي عليها الإنسان العادي والتي يستحق بها اسمه، بغض النظر عما إذا كان عربيًّا أم أعجميًّا، أبيض أو أسود، غنيًّا أو فقيرًا، قويًّا أو ضعيفًا، امرأة أو رجلًا، شيخًا كبيرًا أو شابًّا يافعًا، عالـمًا أو جاهلًا.
و«الإنسان الطبيعي» هو الذي يملك الفطرة الإلهية ولا زالت إرادته نقية لم تلوّث بعد بالأوهام والخرافات، فمثل هذا الإنسان نطلق عليه أيضًا اسم «الإنسان الفطري». ثم ليس ثمة شك أنّ ما يميّز النوع الإنساني عن سائر الحيوانات هو ما جهّز به من عقل وفكر يهديانه سبيل الحياة، في حين تفتقر سائر الحيوانات إلى هذه الهبة الإلهية.
إنّ نشاط أيّ كائن حيّ - عدا الإنسان - هو رهين إرادة تخضع لعواطف ذاك الكائن وغرائزه، فباستثارة هذه الغرائز وهيجانها يهتدي الكائن نحو مقاصده، وعلى أثر الإرادة يمارس فعاليات الحياة فيسعى نحو الطعام والماء وسائر ما تقتضيه حياته. يبقى الإنسان وحده هو الكائن الحي الذي زوّد بجهاز يتحكم بالقوى والعواطف المختلفة التي تطفح على السطح من مشاعر حب وبغض؛ ورجاء وخوف، وودّ وحقد؛ فيجذب هذه ويطرد تلك تبعًا لتشخيصه للمصلحة الواقعية وما يقضي به جهاز السيطرة. فربما استحثت العاطفة الإنسان في أن يقدم على عمل، إلّا أنّ هذا الجهاز يكبح موج العاطفة ويمنع الإنسان من الإقدام، وربما حصل العكس حيث تكره العاطفة الإقدام ويأمر هذا الجهاز به، فكل ذلك يحصل تبعًا للتوازن بين الإرادة والمصلحة الحقيقية، أما إذا توافقت المصلحة مع الإرادة فإنّ الجهاز يأذن بممارسة الفعل.
أساس التربية في المدرسة الإسلامية
لما كان المنهج التربوي المتكامل يقضي أن تستند العملية التربوية مع خصائص ومميزات ذلك النوع الذي تشمله العملية، فإنّ الإسلام أشاد نهجه التعليمي - التربوي على قاعدة «التعقّل» التي يتسم بها الإنسان وليس على العواطف والأحاسيس. على هذا الأساس بالذات يمضي الإنسان الفطري بقوة عقله النقي من الشوائب والأوهام والخرافات صحّة وواقعية ما تنطوي عليه دعوة الإسلام من عقائد وأخلاق فاضلة وقوانين عملية.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 مجاز القرآن: عقلي ولغوي
مجاز القرآن: عقلي ولغوي
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 العلم والعقل والنفس
العلم والعقل والنفس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 رأي العلماء في الثواب والعقاب
رأي العلماء في الثواب والعقاب
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الدين وحده الذي يروض النفس
الدين وحده الذي يروض النفس
الشهيد مرتضى مطهري
-
 وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً
السيد عبد الأعلى السبزواري
-
 المقرّبون (2)
المقرّبون (2)
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 حكم الشيعة لبلاد المسلمين
حكم الشيعة لبلاد المسلمين
الشيخ فوزي آل سيف
-
 معاثر التفكير من اليونان إلى ما بعد الحداثة
معاثر التفكير من اليونان إلى ما بعد الحداثة
محمود حيدر
-
 عن الحقوق وأهمية الثقافة الحقوقية
عن الحقوق وأهمية الثقافة الحقوقية
السيد منير الخباز القطيفي
-
 التفكّر والتّدبّر
التفكّر والتّدبّر
السيد جعفر مرتضى
الشعراء
-
 الإمام الصّادق، الحوراء: من حزن إلى حزن
الإمام الصّادق، الحوراء: من حزن إلى حزن
حسين حسن آل جامع
-
 في رثاء الصّادق عليه السّلام
في رثاء الصّادق عليه السّلام
الشيخ علي الجشي
-
 أملٌ وَشيك
أملٌ وَشيك
ناجي حرابة
-
 كانت الأحلام
كانت الأحلام
جاسم بن محمد بن عساكر
-
 إمضاءة فرَس
إمضاءة فرَس
أحمد الماجد
-
 يا طفل غزّة
يا طفل غزّة
عبد الوهّاب أبو زيد
-
 طريق أقصى
طريق أقصى
فريد عبد الله النمر
-
 في المسجد النّبويّ
في المسجد النّبويّ
عبدالله طاهر المعيبد
-
 طابع بريد السلام
طابع بريد السلام
ياسر آل غريب
-
 حنجرةُ الشوق
حنجرةُ الشوق
زهراء الشوكان
آخر المواضيع
-

مجاز القرآن: عقلي ولغوي
-

العلم والعقل والنفس
-

رأي العلماء في الثواب والعقاب
-
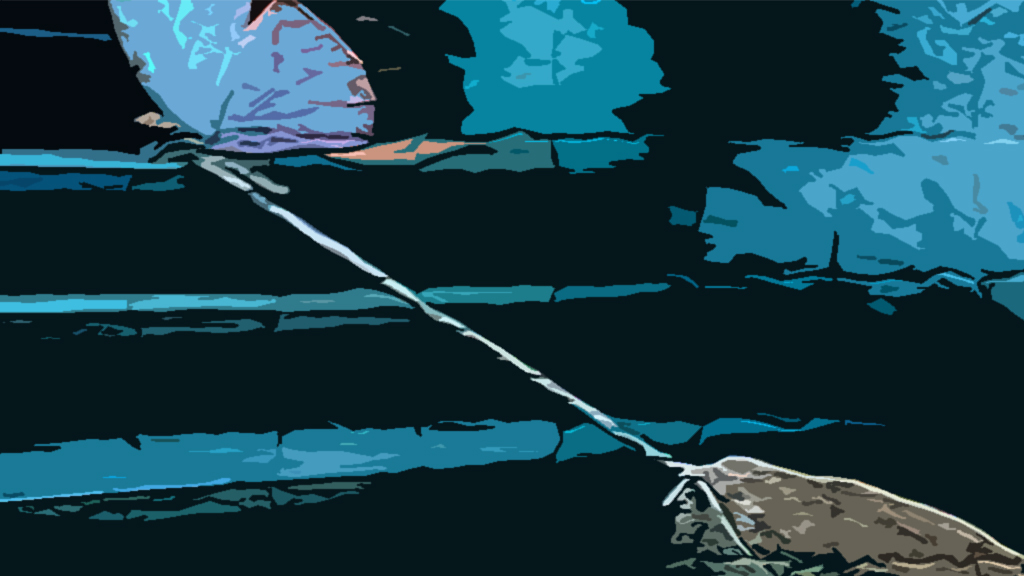
الدين وحده الذي يروض النفس
-

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً
-

المقرّبون (2)
-

(لعبة حياة) معرض فنّيّ لسلمى حيّان، يكشف علاقة الإنسان بالأرض والزّمان والذّات
-
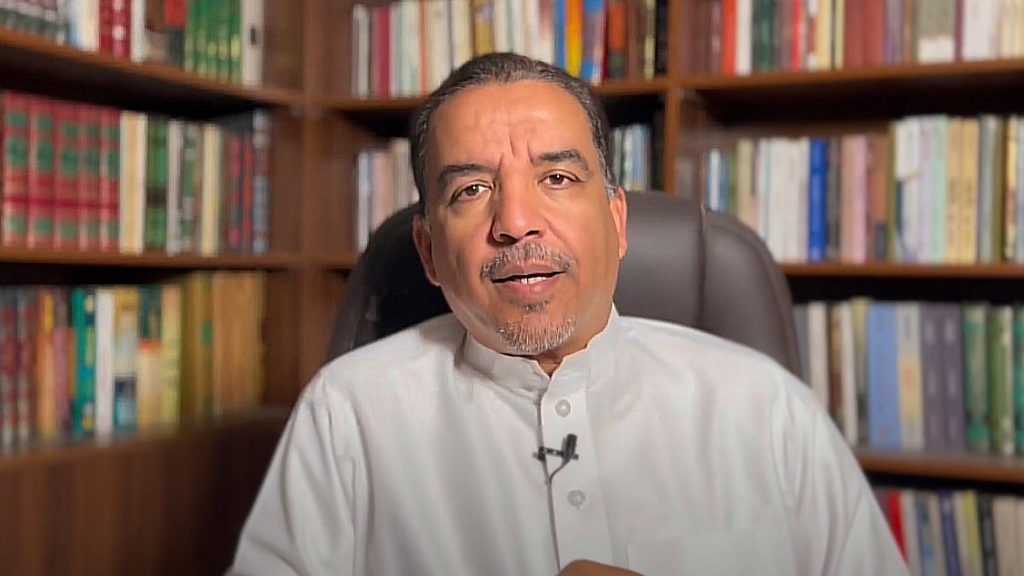
زكي السالم: ديوانك الشّعريّ بين دوافع الإقدام وموانع الإحجام
-

حكم الشيعة لبلاد المسلمين
-

معاثر التفكير من اليونان إلى ما بعد الحداثة










