علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)

المسمَّى الثَّامن: “النومين” أو الشيء في ذاته
حين وقفت المدارس الفينومينولوجيّة الحديثة بانذهال أمام “النومين”، كباعث خفيٍّ لـ “الفينومين”، دأبت على تعريفه بالَّلا مشعور به، أو بالشيء المصموت عنه والمغفول عن سيرته. غير أنَّ هذا “التسقيط المفهوميِّ” لـ”الشيء في ذاته” لم يكن بداعي النّظر إليه كأمرٍ بديهيٍ، وإنَّما لكونه السرَّ الذي اسْتَتَر عن النّظر، وعزَّ فهمُه على طبائع العقول المشغولة بدنيا المظاهر.
منشأ المعضلة في ظاهراتيَّات الحداثة، يعود إلى الفهم الميتافيزيقيِّ لأوّل ظاهرةٍ وجوديَّة. أي إلى ظاهرة نشوء الكون الذي اتَّفقت الفينومينولوجيا اليونانيّة والحديثة معًا على أنّه هو الشَّيء الذي يظهر من تلقاء ذاته. وبالتالي، هو نفسه الشَّيء الممتنع ذاتًا عن المعرفة، والذي ينبغي تعليق الحكم عليه. النتيجة التي ترتَّبت على هذه “المسلَّمة” جاءت على خلاف ما تقتضيه البراءة العلميَّة. والنتيجة، تقييد العقل وتعطيل إمكاناته إلى حدِّ إنكار العلَّة المظهِّرة لهذا الشيء. وما ذاك إلَّا لأنَّ العقل الفينومينولوجيَّ الغربيَّ منذ بداياته التأسيسيَّة قرَّر النَّظر إلى”النومين” كعلَّة تامَّة نشأت من ذاتها بذاتها ولذاتها، ولا حاجة لها إلى علَّةٍ خارجيّةٍ تدفعها إلى الظهور. وبالتالي، سيضطرُّ الناظر إليها لأن يتَّخذ هذه المسلَّمة دربةً له، كقاعدة ضروريَّة لوصف ما هي عليه ظواهر الموجودات في الواقع.
في الميتافيزيقا الحديثة، دارت الأفهام حول النومين مدارات شتَّى من الجدل، إلَّا أنَّها في خواتيمها لم تفارق ما تداوله حكماء اليونان وفلاسفتهم. هو حينًا نفس الأمر المكمون في الشيء، وهو عصيٌّ على الإدراك، ولا يُعرف إلَّا حين يبدو لنا في الواقع العينيِّ.. ذلك ما كان أشار إليه هايدغر لمَّا بيَّن أنَّ الحداثة أخفقت في ابتكار تعريف للكليَّات يوازي أو يجاوز ما وضعه الإغريق. وإنَّ فلاسفة اليونان مذ حدَّدوا المعالم الأساسيَّة لمبادئ فهم الوجود لم تتحقَّق خطوةٌ جديدةٌ من خارج الحقل الذي ولجوه أوَّل مرَّة.
من أجل ذلك، ينبِّه علم النومين (النومينولوجيا) إلى وجوب تصويب خللٍ تكوينيٍّ في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا. فإذا كانت كلمة الما بعد (ميتا) دالَّةً على ما هو تالٍ للطبيعة أو ما فوقها، فذلك معناه أنَّ عالم ما بعد الطبيعة هو امتداد للطبيعة وموصول بها بعروةٍ وثقى. ما يعني أيضًا أنَّ كلَّ ما بعد الطبيعة هو واقعٌ حقيقيٌّ بمرتبةٍ وجوديَّةٍ مفارقة، وإن تعدَّدت ظهوراته كمًّا وكيفًا. مثل هذا الخلل في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا سوف يؤدّي إلى صدعٍ في المبدأ المؤسِّس للعقل، والاستفهام عن حقيقته. وهذا ما سيكشف عن أمرٍ بديهيٍّ سها عنه القول الفلسفيُّ الإغريقيُّ ولواحقُه. فإذا كانت مهمَّة الميتافيزيقا البحث في الوجود بما هو موجود، فإنَّ مبتدأها ومنتهاها تمثَّل بحصر معرفتها بالموجود في ظهوره العيانيِّ، وعدم الاكتراث لما هو عليه في خفائه وكمونِه.
يعتني علم “النومين” بالظاهرة الوجوديَّة بوصف كونها ظهورًا لأصل وجودها، ومتَّصلة به اتِّصال الجزئيِّ بالكلّيِّ، فإذا كانت الفينومينولوجيا تدلُّ على الشيء كما يتبدَّى في العلن، فإنَّ هذا المتبدِّي ما كان له أن يبدو لولا اتِّصاله بمصدره الأوَّل. الذي هو ماهيَّته وحقيقته الواقعيَّة. نعني بذلك الجوهر بذاته الذي ظهر وتوسَّع ليكون ظهور الموجودات امتدادًا لظهوره وتوسُّعاته.
ولكونه علمًا ينشد التعرُّف على الموجود الأوّل وسرِّ ظهوره، والكيفيَّة التي ظهرت منه الكثرة، تُعيد النومينولوجيا الاعتبار لكلام متجدِّد حول فينومينولوجيا الوجود المتعيّن على نحو يجاوز الثنائيَّات المؤسِّسة للمعضلة الميتافيزيقيَّة في ثقافة الغرب. ولذا، فإنَّ المهمَّة التأسيسيَّة لعلم “النومينولوجيا” هي إذًا، استكشاف حقيقة موجودٍ فُطِرَت موجوديَّته على وحدة البساطة والتركيب. وبالتالي، إدراك حقيقة هذا الجوهر الوجوديِّ الذي حظيت ذاته بفرادة جمع الوحدة إلى الكثرة، هو الشيء الوحيد الذي تقوم طبيعته على الثراء والفقر في آن. أي بين الاحتياج إلى موجده وبين كونه مبدأ مؤسِّسًا لعالم الممكنات.
كفَّت الميتافيزيقا التي عهدناها مع قدماء الإغريق عن أن تكون العلم بإلهيَّات ما بعد الطبيعة. جرى هذا من بعد أنسها المتمادي بالمفاهيم، حتى لقد أخلدت إلى دنيا الطبيعة، ودارت مدارها، ولم تكن في مجمل أحوالها ومشاغلها سوى مكوثٍ مديدٍ على ضفاف الكون المرئيّ. لقد انسحرت الفلسفة الأولى بالبادي الأوَّل حتى أشركته مُبديه وبارئه، ثمَّ راحت تخلع عليه ما لا حصر له من ظنون الأسماء: المحرِّك الأوَّل غير المتحرِّك، “النومين أو الشيء في ذاته”، “العلَّة الأولى” و”المادَّة الأولى أو الهيولى”، وأخيرًا وليس آخرًا “القديم والأزليّ”.. وجريًا على هذه الحكاية ستنتهي إلى نعته بالموجود الذي أوجد ذاته بذاته من عدم، ولمَّا أن وُجدَ لم يكن له من حاجة إلى تلقّي الرعاية من سواه. هو بحسب “ميتافيزيقاهم” كائنٌ مكتفٍ بذاته، ناشطٌ من تلقاء ذاته، ومتروكٌ لأمر ذاته.
الفلسفة الحديثة – حتى وهي في ذروة دهشتها بذاتها – لم تَبرح هذه المعضلة الموروثة عن السّلَف الإغريقيّ. مبدأُها المنبسطُ على ثنائيَّة “النومين” و”الفينومين” ظلَّ ملازمًا لها كما هو في نشأته الأولى. وبسبب من هذا التلازم تجدَّدت ألوان المعضلة وتكثَّرت أنواعها، واستدام الاختصام والفرقة بين جناحَيْ الثنائيَّة. ولمَّا لم يكن لهذا المبدأ أن يبلغ مقام الجمع بين الجناحين، أفضت الإثنينيَّة في غُلُوِّها الإنشطاريِّ إلى وثنيَّةٍ صارخةٍ حلَّت ورسخت في قلب الميتافيزيقا، قديمِها ومستحدثِها. من هذا النحو، لم يُفلح النِّظام الفلسفيُّ الكلاسيكيُّ في مُجاوزة معضلته الكبرى المتمثِّلة بالقطيعة الأنطولوجيَّة بين الله والعالم. وهو حين تصدَّى لمقولة الوجود بذاته، أخفق في إدراك حقيقته. ثمَّ أعرض عنها وأخلد إلى الاستدلال المنطقيِّ والتجربة الحسِّيَّة. لهذا ظلَّ الموجود الأوَّل في هندسة العقل المقيَّد بالمقولات العشر لغزًا يدور مدار الظنِّ، ولمَّا يبلغ اليقين.
وبسببٍ من قيديَّته سَرَت ظنونُهُ إلى سائر الموجودات ليصير الشكُّ سيّدَ التفلسُف منذ اليونان إلى ما بعد الحداثة. من أجل ذلك، سنرى كيف سيُخفقُ التاريخُ الغربيُّ رغم احتمائه بهندسات العقل الذكيِّ، في إحداث مسيرة حضاريَّة مظفَّرة نحو النور والسعادة. فلقد تخلَّل ذلك التاريخ انحدارٌ عميقٌ إلى دوَّامة المفاهيم والاستغراق مليًّا في أعراض المرئيَّات الفانية. النتيجة أنَّه كلَّما ازدادت محاولة الإنسان فهم دنياه، وعالمه الواقعيِّ ازداد نسيانه ما هو جوهريّ. والنُّظَّار الذين قالوا بهذا لا يحصرون أحكامهم بتاريخ الحداثة، بل يُرجعِونها إلى مؤثِّرات الإغريق، حيث وُلِدتَ الإرهاصاتُ الأولى لتأوُّلات العقل الأدنى. وهو العقل إيَّاه الذي سترثه الفلسفات الَّلاحقة، لتصبح العقلانيَّة العلميَّة معها حَكَمًا لا ينازِعُه منازعٌ في فهم الوجود وحقائقه المستترة. وكحصيلة لمسارات العقل الأدنى ستأخذ الثورة التقنيَّة صورتها الجليَّة، لِتَفْتتِحَ أفقًا تفكيريًّا سيعمِّق القطيعة مع أصل التكوين وحقيقة الوجود.
المسمَّى التَّاسع:”المونادا” أو الواحد البسيط الذي لا يتمدَّد
كتب لايبنتز “المونادولوجيا” أو علم المونادا (الواحد – البسيط) عام 1714م. وقد بدت كتكثيف لكلِّ نسقه الفلسفيِّ، رغم أنَّها لا تتجاوز الصفحات العشرين. لقد ابتكر هذا المصطلح من كلمة يونانيَّة معناها “الوحدة”، ليؤكِّد أنَّ همَّه الأوَّل هو التوصُّل إلى الواحد البسيط الذي لا يحوي شيئًا آخر. وهذا الواحد هو نفسه الجوهر الفرد الذي لا يتمدَّد لئلَّا يصير قابلًا للقسمة، ولا يحوي شيئًا آخر لئلَّا يصبح مركَّبًا. رأى ليبنتز أنَّ كلَّ مركَّب هو عبارة عن مجموعة وحدات بسيطة، ليس له شكل، وهذا الجوهر هي “المونادا”، التي هي ذرَّات الطبيعة أو عناصر الأشياء. هذه المونادات لا يمكن أن توجد إلَّا بالخلق، ولا يمكن أن تنتهي إلَّا بأمر إلهيٍّ بإفنائها، بمعنى آخر، لا يمكن أن تُنتج أو أن تُدمَّر، وكلُّ مونادا هي فرديَّة وحيدة بمعنى أنَّه ليس هناك مونادا مطابقة لمونادا ثانية، وكلُّ واحدة منها مستقلَّة استقلالًا تامًّا عن نظيرتها.
إنها حسب ليبنتز “بلا نوافذ يستطيع أي شيء أن يدخل أو يخرج منها… غير أنَّ هذه المونادات لا بدَّ لها من أن تحوي بعض الصفات وإلَّا لما أصبحت موجودات: أول هذه الصفات هي أنَّ كلَّ مونادا مختلفة تمامًّا عن الأخرى، تحوي قوَّة للتطوُّر وللتغيُّر من حالة إلى أخرى، وهي خارجيَّة، وغير بيِّنة، ولا تكسب كلَّ وضوحها إلَّا حين تتلاشى في الميل الداخليِّ للقيام بإدراك جديد أكثر تميُّزًا ووضوحًا من الإدراك السابق. ومن ثمَّ فإنَّ القوَّة التي تضعها مع العالم الخارجيِّ لا تأخذ كلَّ معناها إلَّا بعمليَّة الإدراك، حين تنهض المونادا من سُباتها، وذلك حين يصبح لها ذاكرة يمكن أن ندعوها نفسًا. والبشر يخلق عندهم عادة فيفكِّرون بطريقة تجريبيَّة، أي حسب ما صادفهم سابقًا.[جورج زيناتي- الفلسفة في مسارها – دار الكتاب الجديد المتَّحدة – بيروت – 2013 – ص 156.]
قصارى غاية ليبنتز من المونادا هو ما يستظهره كتابه التأسيسيُّ “مقالة في الميتافيزيقا” التي يفارق فيها جلَّ معاصريه من فلاسفة الغرب. عنينا بذلك مسألة الخلق كفعلٍ إلهيّ. بصدد هذه المسألة يقرِّر ما يلي: قبل أن توجد الأشياء في هذا العالم بالفعل، وجدت بما هي ممكنات ضمن عالم من العوالم الَّلامتناهية التي تزخر بها ملكة فهم الله. فالله لا يخلق إلَّا ما كان ممكنًا. يوجد الممكن أوّلًا على شكل أفكار. ولله فكرة عمَّا يمكنه أن يخلق، كما أنَّ له فكرة عمَّا لن يخلقه. هذا التنوُّع في أفكار الله ضروريٌّ، لأنَّ ملكة فهمه تتضمَّن كلَّ الأفكار الممكنة، ولكن ما الذي يحمل الله على تحويل ممكنات من دون أخرى من طور الإمكان إلى طور الوجود الفعليّ؟
يقارن الله بين الأفكار التي في ملكة فهمه، ويتبيَّن قيمة كلِّ واحدة منها، ويقرِّر أن يخلق أو يمنح الوجود لما يرى أنَّه خير بذاته. فالله لا يخلق الخير المترتِّب على وجود الأشياء، بل يخلق الأشياء التي يرى أنَّها خيّرة بذاتها. ولذا، فالممكن، إذًا، بالنسبة إلى ليبنتز ليس شيئًا نظريًّا يتحدَّد من خلال التركيبات الخياليَّة، بل قل إنَّ للممكن عنده شيئًا من الكينونة، غير أنَّه يبقى كائنًا منقوصًا. وبيان ذلك ما يلي:
“لا يحوز الممكن كيانًا كاملًا بل يتضمَّن ميلًا للوجود، وهو يبقى، بحسب تعريف ليبنتز، يطالب بالوجود Exigentia Existers. بسببٍ من ذلك يظلُّ كيان الممكن كائنًا منقوصًا، وهذا، لا يعني أنَّ وجود الممكن، من جهة إمكانه، أن يتحوَّل بالضرورة إلى واقع؛ إذ لو تحوَّل كلُّ ممكن إلى واقع، لكان كلُّ ما في العالم ضروريًّا، ويفقد الخلق بذلك دلالاته، إذ يستحيل وقتها أن نتحدَّث عن إرادة خلق تميّز فعل الله.
[Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, introduction,texte et commentaire par Georges Le Roy (Paris: J. Vrin, 1957, p. 121].
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
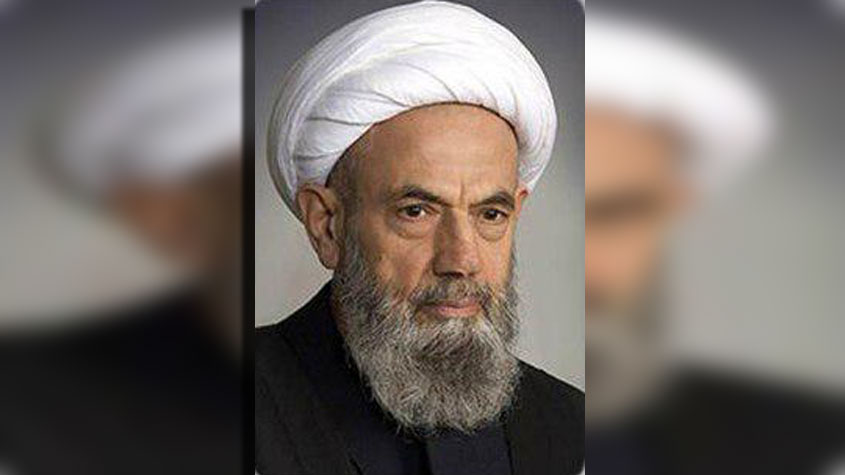 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
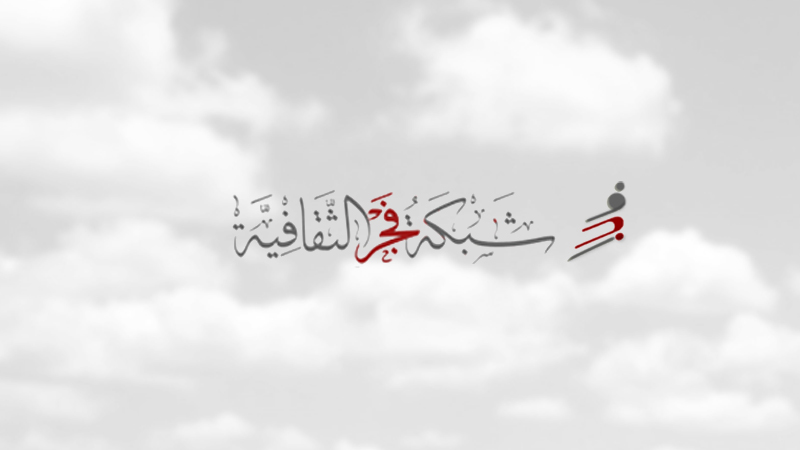 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
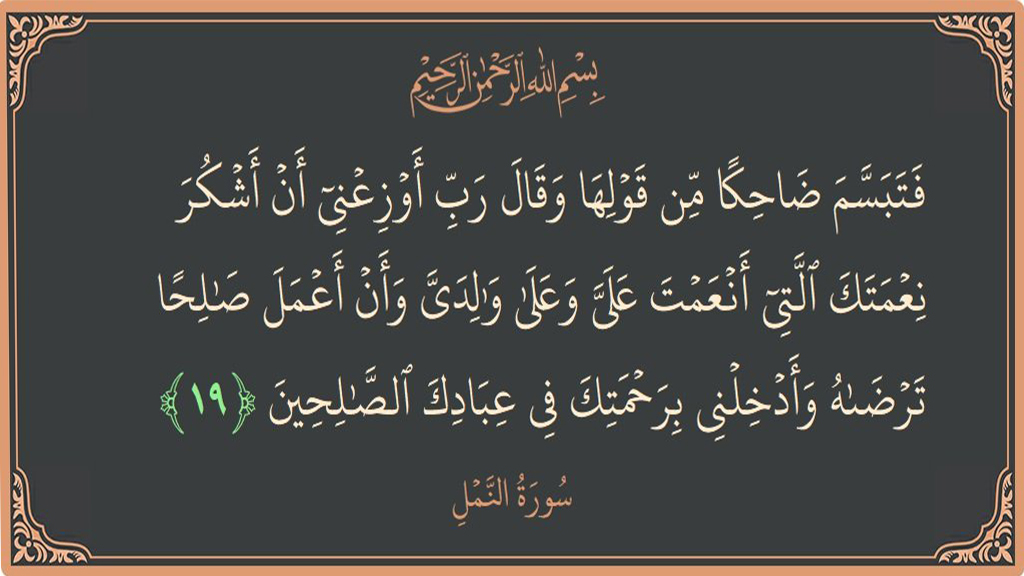
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-
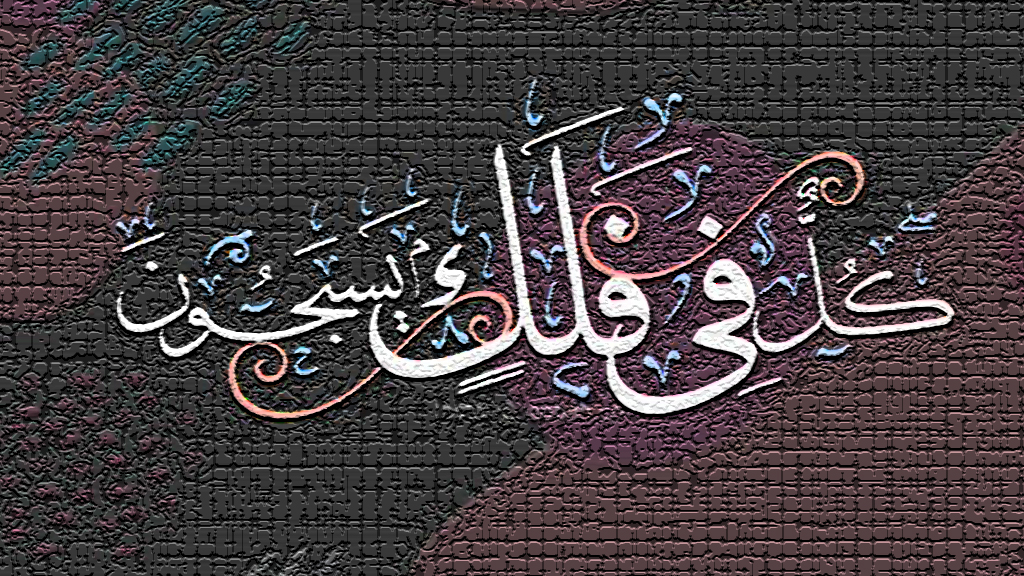
معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
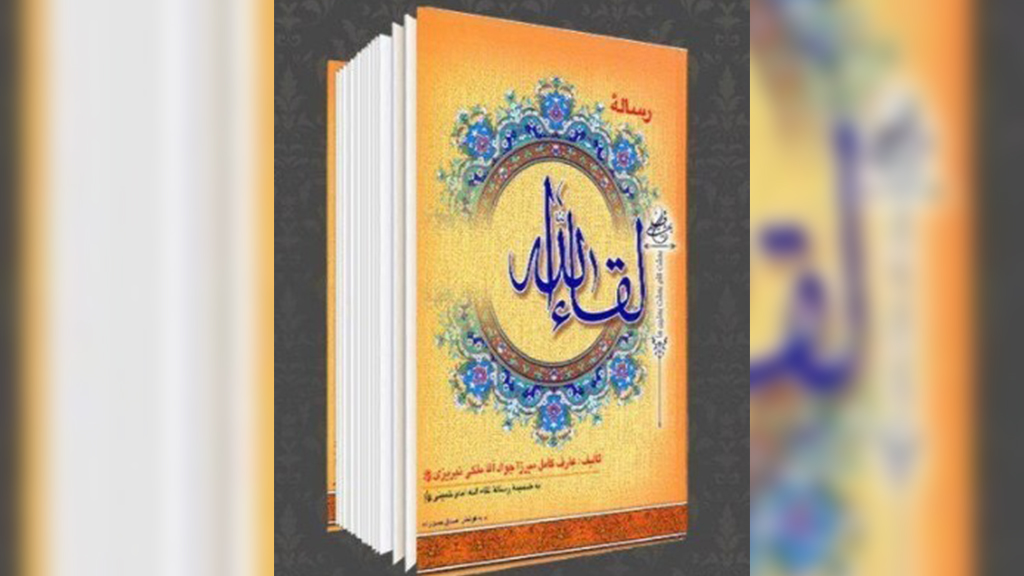
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
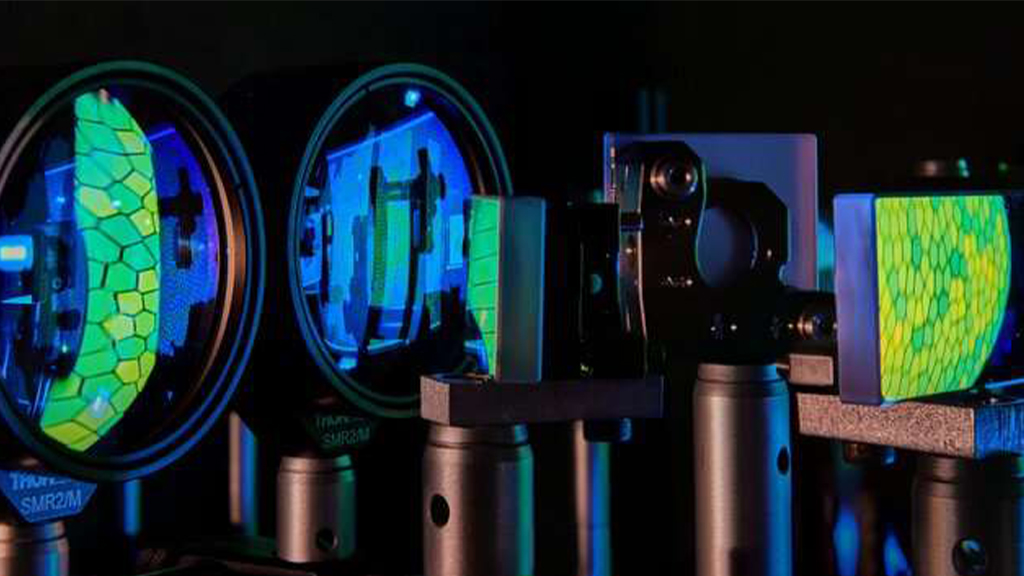
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










