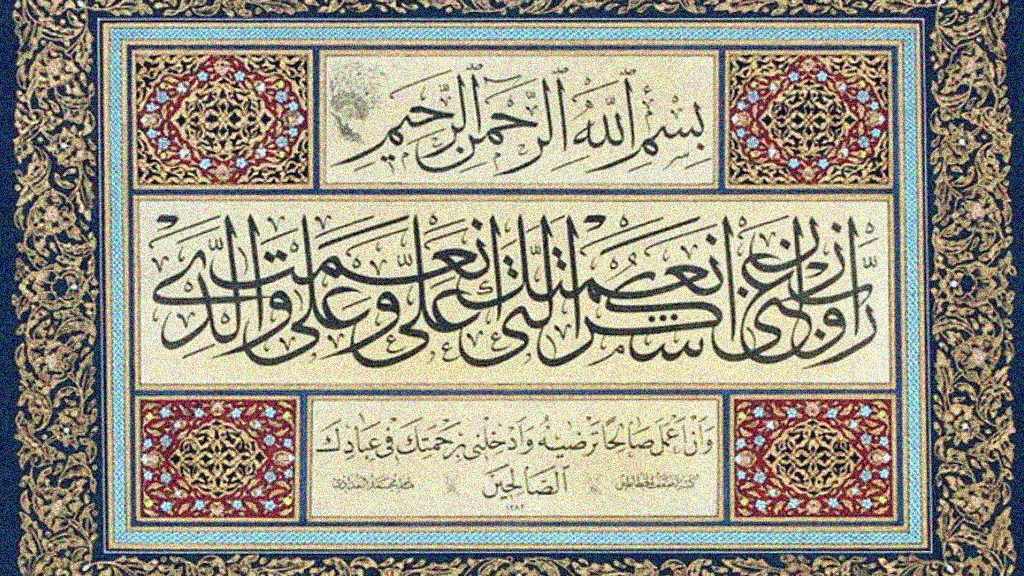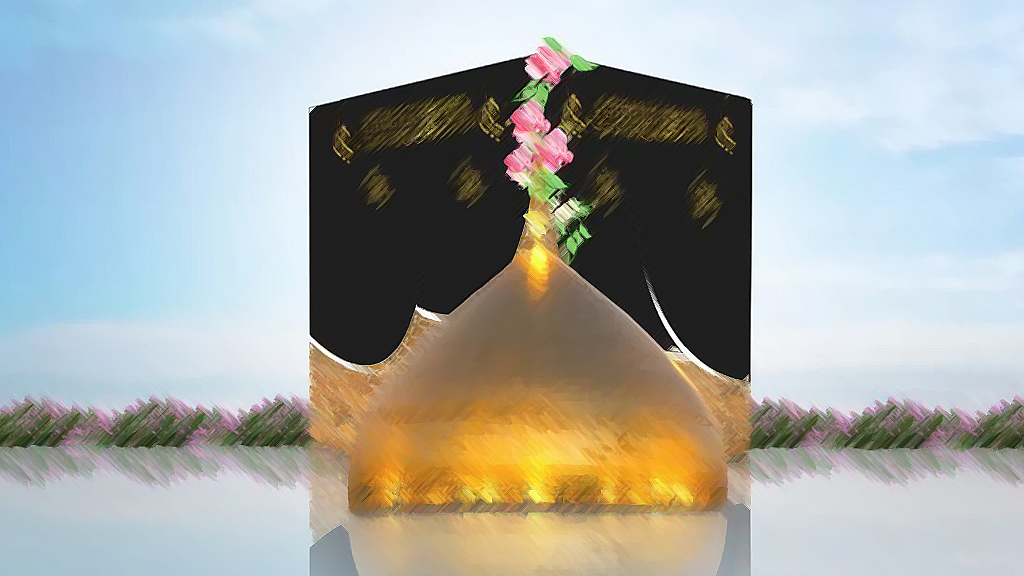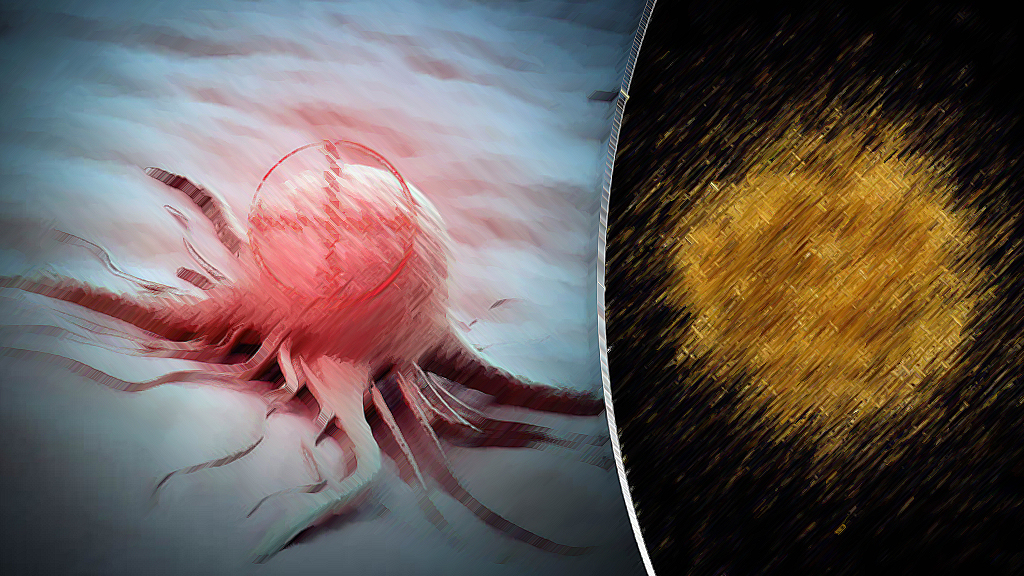علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النّظريّات الأخلاقيّة (6)

نظريّة «الجمال» في الأخلاق (2)
الجمال المعنويّ
لا ريب في أنّ غالبيّة الأفراد يدركون محسوس الجمال وظاهره، ولكن هل يوجد جمال آخر غير محسوس لنا بالحسّ المادّيّ؟ نعم، يوجد «جمال معنويّ» هو أرقى من الحسّيّ، وهذا الجمال تجده ماثلاً في الصور الخياليّة الّتي يرسمها الذهن البشريّ، فإنّ لها جمالاً يدركه متخيِّلها، وتجده أيضاً في الكلام الفصيح البليغ، فإنّ للفصاحة والبلاغة جذباً لا يقاوَم وجمالاً لا يُنكَر؛ فهذا «سعدي» على الرغم من مرور سبعمئة سنة على وفاته، إلّا أنّ أشعاره وحِكَمَه ما زالت حيّة في القلوب والوجدان، تكرّرها الألسن وينجذب لها السامعون.
وسِرّ ذلك ليس هو جمال اللفظ فقط، بل روح تلك الألفاظ ومعانيها العالية الآسرة، وهذا ينطبق أيضاً على شعرَي «حافظ» و«مولوي» اللذَين يطفح شعرُهما بالجمال المعنويّ الخياليّ الرفيع الساحر، حيث إنّه قد يُذهل المرء عن نفسِه نشوةً وانجذاباً، كما حدث للأديب النيسابوريّ -وهو من الأدباء المبرزين، وأنا لم أره، لكنّي رأيت صورته، وهو حوزويّ قديم عليه سيماء العلماء، كان أديباً فذّاً قليل النظير، كما كان شاعراً-، فقد قرأت عنه في أحد الكتب أنّه قال: ثمّة شعر سحرني وأفقدني شعوري مرَّتين في حياتي، وهو شعر غزليّ لحافظ يقول فيه:
إنِّي شاكرٌ لذلك الرفيق المحبوب، وإن كنت عاتباً
وإذا أنت من أهل العشق، فأصغِ لهذه الحكاية
كلّ ما عملته كان بلا أجرٍ ولا مِنَّة منِّي
ولكن أرجو من الربّ العليّ ألّا يبخس المخدوم خادمه
إنّ العارفين بالله العطاشى لا يسقيهم أحد ماءً
لأنّ غير الواصل العارف لا يدرك حاجة العارف
والمرشد العرفانيّ الّذي يملك ماء المعرفة
ليس موجوداً وكأنّه غادر هذا البلد
في هذا الليل، ألا ليل ضاع طريق المقصود
فابرز من مكمنك يا كوكب هدايتي؛ لتدلّني على طريقي الضائع
إنّي في الظلمة كلّما سلكت طريقاً، ازددت وحشة
فيا ويلي من هذه الصحراء، وهذه الطريق الّتي لا نهاية لها
ترى متى أصل النهاية وأرى المحبوب؟
وأنا أرى في البداية مئة ألف عقبة وعقبة
لا يعلقنَّ قلبك المتيَّم بالضفائر؛ فإنّها كالجبال
ألا ترى العاشقين قُطعت رؤوسهم بلا جرم ولا جناية؟
لقد سفكت نظرات عينَيك دمي، وقد رضيتُ بذلك
يا روحي ليس من العدل حماية سافك الدماء
يا شمس الصالحين، إنّ قلبي يحترق شوقاً
فهَب لي ساعة أكون في ظلِّك؛ كي أستمتع ببرد حبّك
أنت وإن أرقت ماء وجهي، إلّا أنّي لن أبرح بابك
لأنّ جور الحبيب لذيذ لِمَن يدّعي العشق والهيام
لقد أضناني حبّك
وإذا كنت مثل «حافظ» أمكنك أن تقرأ القرآن بأربعة عشر طريقاً، أجل، لقد غرق هذا الأديب في هذا الجمال المعنويّ الآسر، وحلّقت روحه عالياً مع تلك المعاني اللطيفة، ولكن لو أراد عارف أن يترنَّم بأشعار حافظ، فهو لن ينتخب هذا الغزل حتماً، بل سينتخب له غزلاً عرفانيّاً كهذا الّذي يقول فيه «حافظ»:
منذ أعوام والقلب يطلب منّا كأس «جمشيد»
ويتمنّى من الغرباء ما هو موجود لديه
إنّه يطلب الجوهرة الّتي لا توجد في صدف عالَم
الكون والمكان، مِن الّذين لا يدلون شاطئ البحر
حملت مشكلتي إلى المرشد العارف
كي يحلّ اللغز بالمدد الإلهيّ
فرأيته جذلان باسماً وبيده قدح الخمرة
وكان ينظر في مرآتها مئات التجلّيات
قال لي: إنّ ذلك الرفيق الّذي عُلّق رأسه
في المشنقة، كان جرمه إذاعة الأسرار
فصاحة القرآن
لماذا نوغل في الطلب وننأى، وهذا القرآن نصب أعيننا وبين أيدينا؟ إنّ من أسرار إعجازه، فصاحته ونغمة آياته، وسلاسة ألفاظه وجمال سبكه. أجل، إنّ القرآن الكريم صاغ معانيه المتفاعلة مع وجدان الإنسان، والنافذة إلى أعماق روحه، في قوالب ذات رنين خاصّ، يتردَّد في عقل المستمع وقلبه، وكأنّه صادر من ضميره ومن أعماقه، وما القرآن إلّا مذكِّر فقط، كما يُعبّر القرآن عن نفسه. إنّ النهج الآسر للقرآن هو الّذي يستمطر الدموع رهبةً وخشوعاً، وهو الّذي يجعل أصحاب القلوب النقيّة ﴿يَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ سجداً﴾، بل ﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعا﴾. إنّ جمال الأسلوب وصدق المعنى القرآنيّ وصفاءه، يجعل المخاطَب الواعي ينقاد للحقّ طوعاً أو كرهاً؛ ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ﴾.
جمال كلام الإمام عليّ (عليه السلام)
إنّ من العوامل الظاهريّة الّتي ساهمت في تخليد اسم الإمام عليّ (عليه السلام)، وإبقاء الأفواه معطّرة بذكره، هو ذلك الجمال الخلّاب لكلامه (عليه السلام). فعلى الرغم من أنّ بني أُميَّة أخذوا عليه أقطار الأرض، وآفاق السماء -على حدِّ تعبير السيّدة زينب(عليها السلام)-، وعلى الرغم من أنّهم لم يدَّخروا وسعاً في النيل من مقامه الشامخ، والحطِّ من شرفه الباذخ، إلَّا أنّه (عليه السلام) ما ازداد إلّا تألُّقاً ورفعةً، وما زال كلامه درَّةً يتيمةً ومنبعاً ثرّا للحكمة والبلاغة والجمال، وكتابه «نهج البلاغة» شاهد عدل على ذلك. وهو حقّاً اسمٌ على مُسمَّى، ولفظٌ وافق المعنى، يعترف بذلك المخالِف قبل المؤالف، وكلُّ بليغٍ جاء بعده (عليه السلام) فمن عذب منهله ارتوى، حتّى أولئك الّذين لا يقيمون علاقات طيّبةً معه (عليه السلام)، حينما يُسألون: كيف أصبحتهم في المكان الرفيع من الفصاحة؟ يقولون: إنَّنا نستظهر مئةً من خطبه (عليه السلام)، وبهذا نكتسب هذه الـمَلَكَة، ومن هؤلاء «عبد الحميد»، وهو أحد الكتّاب الإيرانيّين المعروفين بالحذاقة والمهارة في فنِّ الإنشاء، حتّى قيل: (بدأَت الكتابة بعبد الحميد، وخُتِمَت بابن العميد)، وهو من حاشية آخر خلفاء بني أُميَّة المعروف بمروان الحمار، وهو ممَّن لا يميلون للإمام عليّ (عليه السلام) بحسب الظاهر. والحاصل أنّ عبد الحميد هذا، لَمّا سألوه: كيف تعلَّمت فنّ الكتابة وأمسكت زمامها؟ قال: علَّمني ذلك حفظ كلام الأصلع. أجل، حتّى خصوم الإمام عليّ (عليه السلام) لا يملكون إلّا أن يستظهروا خطبه، ويستعينوا بكلامه؛ لأنّه دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوق.
شبهةٌ وردٌّ
لقد دأب شائنو الإمام عليّ (عليه السلام) على سلب محاسنه وإعارتها مجّاناً لغيره، ولم يَرُق لهم أن يكون «نهج البلاغة» له، فادَّعوا أنّه من آثار «الشريف الرضيّ»، وهذا كلام فارغ لا يسنده دليل؛ لأنّ «المسعوديّ» المؤرّخ المعروف والمعتمد من قِبَل الجميع -وهو غير معلوم التشيّع، وحتّى لو قيل بتشيّعه فليس ذلك بالمعنى المعروف للتشيّع في عصرنا، بل بمعنى الميل والحبّ فقط، أو حتّى بمعنى عدم العداوة- ذكر في كتابه «مروج الذهب» المدوَّن قبل عهد «الشريف الرضيّ» بمئة عام، مقاطع من كلامه وشيئاً من قصار جمله تحت عنوان «ذكر لمع من كلامه وأخباره وزهده». وذكر أيضاً، أنّه توجد في عهده 480 خطبة مستظهَرة تتداولها الألسن، والحال أنّ مجموع الخطب الواردة في النهج هو 239 خطبة فقط، وهذا يعني أنّ السيّد الرضيّ دوَّن أقلّ من النصف.
وعوداً على بدء، نقول: إنّ مثل الشعر والفصاحة والبلاغة والنثر الراقي، ذلك كلّه يتمتّع بجمال معنويّ خاصّ لا تصل إليه أدوات الإحساس الماديّة؛ لأنّه مرتبط بذهن الإنسان، وعلينا أن نخطو خطوةً أكبر لنخرج من مضيق المحسوس إلى أفق أرحب وجمال أرقى.
الجمال المعقول
بعد تجاوُز الجمالَين: الحسّي والمعنويّ، نصل الآن إلى جمال آخر، وهو «الجمال المعقول»، وهو جمالٌ لا يُدركه سوى العقل، دون الحواسّ والقوّة المتخيّلة، ويُسمَّى اصطلاحاً بـ«الحُسن العقليّ» ويقابله «القبح العقليّ». وهذا هو مورد المسألة المعروفة عند متكلّمي الشيعة والمعتزلة وفقهائهم، بمسألة «الحُسن والقبح العقليَّين»، وحاصلها: أنّ أفعال الإنسان قِسمان:
1. أفعال ذاتيّة الحُسن والجمال، تبعث على الإكبار والإعجاب.
2. أفعال طبيعيّة يمارسها الإنسان في أدوار حياته، ولا بريقَ لها.
فمِن الأُولى: الإيثار والتضحية، فمَن الّذي لا يُكبِرُ مَن يتكبَّد المشاقّ في سبيل إسعاد الآخرين وهنائهم؟ إنّه تعالى أكبرَ ذلك في شخص رسوله الكريم، قال جلَّ ذكره: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُول مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوف رَّحِيم﴾؛ فالآية الشريفة هنا في مقام المدح والثناء على هذا الموقف الأبويّ.
وهذا الحُسن الذاتيّ، هو مناط أخلاقيّة الفعل البشريّ وتميُّزه؛ ولذلك -بناءً على نظريّة الجمال المعنويّ- ينبغي أوّلاً، إيجاد الأرضيّة الملائمة؛ كي يدرك الأفراد الجمال المعنويّ للأفعال، جمال التضحية والاستقامة والعدل والعفو والعلم والصبر والجود... لأنّ إدراك هذا النوع من الجمال وتذوُّقه، كفيل بجذب الأفراد نحو السلوك السويّ وتجذير الأخلاق الحميدة، وهذا يعني نفورهم من أضدادها؛ لإدراكهم قبحها وزيفها؛ فالكذب سيُرى شيئاً عفناً، والغيبة ستُرى جيفةً نتنةً، كما هو حال أولئك الثلّة الّذين هذَّبوا نفوسهم وارتقوا بأخلاقهم، حيث تنفُر بطبعها من الرذائل وتعشق الفضائل، وإن كلَّفَهم ذلك غالياً. فعلينا إذاً، أن نُصلِح الذوق العقليّ والفكريّ والمعنويّ؛ فإذا صلح الذوق وارتقى، ارتقى الإنسان بنفسه كذلك.
وقد تقول: ما هو السبيل للارتقاء بالذوق كي يدرك مثل هذا الجمال؟
ونقول لك: ليس ثمّة ما يعيق الإنسان عن هذا الهدف، ومستسهِل الصعب يدرك الـمُنى. وسبيل ذلك هو التربية الموجَّهة والمجاهدة المتبصّرة، ولقد رأينا في حياتنا جماعة تزيَّنت بجميل الخُلُق، وترفّعت عن سفاسف الأمور، وهجرت محسوس اللذائذ طرّاً، وأنِست بذكر الباري تعالى، والتذَّت بعبادته وهداية العباد إليه تعالى، يعبدونه حبّاً وعشقاً لذاته المقدَّسة؛ لأنّهم أدركوا جمال أهليّته للعبادة، ولم يبتغوا من وراء ذلك نفعاً يجلبونه، أو ضرّاً يدفعونه، فحتّى لو آمنهم تعالى من عذابه إذ عصوه، أو حرمهم ثوابه إذ أطاعوه، لَمَا عصوه آمنين، ولَمَا تركوا طاعته متذمّرين. ولا ريب في أنَّ مَن هذا حاله، فهو متخلِّقٌ بأخلاق ذلك «الجمال المطلق»، كالعدل والإحسان، ومتنزّهٌ عن أضدادها، كالظلم والبغي، وصَدَق الله تعالى إذ يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾. وكيف كان، فهذا شيءٌ ممّا ذكره متكلِّمو الإسلام وفقهاؤه في مبحث الحُسن والقبح العقليَّين.
نظريّة أفلاطون
يرى «أفلاطون» -وخلافاً لِما تقدَّم- أنّ الفعل في ذاته لا يتَّصف بالجمال، بل الجميل هو «الروح»، وهو يستمدّ جماله ورونقه منها، كما يستمدّ القمرُ ضوءه من الشمس، وبهذا تكون الأخلاق المرضيّة عبارة عن انعكاسات للروح الراقية، وإن كان الأمر، بدواً، عكس ذلك. وهو يرى أنّ «العدالة» هي أُسّ الأخلاق وعمودها، والعدالة تساوي الجمال.
على الرغم من أنّه ذكر أنّ البشر يدركون حقيقة الأركان الثلاثة (العدالة، والجمال، والحقيقة)، إلّا أنَّ أيّاً منها غير قابل للتعريف. لكنّه مع ذلك، ذكر للعدالة تعريفاً ناقصاً، فقد ذكر أنّها عبارة عن «تناسُب الأجزاء مع الكلّ».
وقد عرَّف «العدالة الاجتماعيّة»، فقال: العدالة الاجتماعيّة هي أن يعمل كلّ فردٍ ويؤدّي وظيفته بقدر طاقته، وبمقدار ما يعمل وينجز يأخذ مقابله. وينبغي أن يكون ذلك حال أفراد المجتمع كافّة، حتّى تحصل المساواة وتتحقّق العدالة في ما بينهم، فلا يبذل فردٌ أكثر من طاقته، وآخر أقلّ من طاقته، أو تُعطى ثمرة العامل للخامل، وإلّا أصبح المجتمع غير عادل، والمجتمع غير العادل مجتمع غير راقٍ وغير سامٍ، ومجتمعٌ هذا حاله غيرُ مؤهّلٍ للبقاء.
ويتابع «أفلاطون» حديثه عن «العدالة»، فيقول: الأخلاق، هي حفظ التوازن بين الميول والرغبات والمعقولات الموجودة عند الإنسان، وكذلك الحفاظ على سلامة الجهاز «الروحيّ»؛ لأنّ الجهاز الروحيّ للإنسان تماماً كالمركبة الّتي يجب مراعاة التناسُب بين أجزائها كي تسير سيراً معتدلاً. وأنت إذا رأيتَ أناساً يستحقّون من الآخرين بليغ الثناء ومنتهى الإطراء، فاعلم أنّهم إنّما استحقّوا ذلك؛ لإيجادهم كامل التوازن والمرونة بين العناصر الروحيّة في شخصيّاتهم، حتّى ارتفعت أرواحهم وصاروا أناساً كاملين. وإذا ارتقى الإنسان بروحه وصارت جميلة ألقة، فلا بدّ من أن تكون ذات جاذبيّة وقدرة على التأثير في الآخرين، ولا بدَّ من أن يرافقها -أيضاً- عشقٌ لها وطلبٌ، وتستجلب الاستحسان والثناء.
ترى هذا متجلّياً في الإمام عليّ (عليه السلام)؛ إذ إنَّ من خصوصيّات وجوده المقدَّس، العدل والتوازن الكامل المتجذّر في روحه الـمَلَكوتيّة؛ ولأجل ذلك عُرِف بأنّه كامل الصفات وجامع الأضداد. يقول فيه «صفيّ الدين الحلّيّ»:
جُمِعَت في صفاتِكَ الأضدادُ
ولهذا عزَّتْ لكَ الأندادُ
ويقول السيّد الرضيّ: كلامُ عليّ متعدّد الأقطار والجوانب، وهو عالٍ في ذلك كلّه.
نعم، لقد طرق في كلامه جميع الأبواب، وضرب الأوتار كلّها ببلاغة وروعة لا تُبارى.
وهذا إنّ دلَّ على شيء، فهو يدلّ على سعة روحه وشموليّتها، وبالتعبير الدارج، يدلّ ذلك على أنّ لروحه أبعاداً عدّة. وفضلاً عن ذلك، فإنّه يدلّ على وجود نوع من التوازن والتلاؤم بين تلك الأبعاد المختلفة ذات العلاقة بروح الإنسان، وكلّ فردٍ يستطيع إدراك هذا من دون أن يستطيع وضعَ تعريفٍ لجمال الإمام عليّ (عليه السلام)، أو مسَّ حقيقتِه.
لقد مضى، حتّى الآن، أربعة عشر قرناً على عصر الإمام عليّ (عليه السلام)، ولكن ما من قرنٍ خلا من مئات الآلاف، بل ملايين المعجبين والمنجذبين نحوه، المتحلّقين حوله.
هل سألتَ نفسك يوماً: لماذا صار حبُّ عليّ إيماناً؟ أليس ذلك لأنَّ حُبَّه يعني عشق الروح المتوازنة المتعادلة، عشق الكمال الإنسانيّ؟ أليس لأنّه عشقٌ لِمَا دعا إليه الله تعالى ورسوله الكريم، وحثَّا عليه؟
ومحبُّ الإمام عليّ (عليه السلام) ليس فقط عاشقاً له ومندكّاً في هواه، بل هو أكثر من ذلك؛ لأنَّ مَن يَعشق عليّاً ويحبّه حقّاً، يعلو بنفسه هو، ويرقى بروحه هو من حيث إنّه أدرك الجمال الخارق لعليّ (عليه السلام)، واستشفَّ الروح الكبيرة الّتي يحملها بين جنبَيه، واستوقفه ذلك التعادل والتوازن الّذي اتَّسمَت به شخصيّة عليّ (عليه السلام)، ومن ثمّ وجد فيه (عليه السلام) المعنى الحقّ للإنسان الكامل.
إنَّ عليّاً (عليه السلام) الّذي عاش مظلوماً مقصيّاً، ملأ الخافقين اسمُه، وعلا في القرون المتمادية ذِكرُه، ونفذ عبر التاريخ عطرُه. أجل، إنّ صدى مجده ينبثق من أعماق أربعة عشر قرناً من الزمن، وتردّده البشر جيلاً بعد جيل، ليس فقط مِن قِبَل مَن يُسمَّون بـ«الشيعة»، بل حتّى مِن قِبَل من يُطلَق عليهم «أهل السُّنَّة»، بل حتّى من المسيحيّين واليهود، فكلّ هؤلاء تلهج ألسنتهم باسم عليّ، وكلُّ من يمتلك ضميراً حيّاً، لا بدَّ من أن يُسمَع من لسانه تمجيدٌ للإمام عليّ (عليه السلام).
لكن، لِمَ ذلك كلّه؟ ذلك كلّه لِمَا لعليّ من جمال، وما لوجوده المقدّس من طهارة وألق، وحسبك دليلاً على ذلك أنَّ «ابن شهر آشوب» قال في كتابه المناقب: وإنّي إذ أكتب هذا الكتاب، أعرف ألِفاً من الكتب المصنَّفة في مناقب عليّ (عليه السلام). ولا يُعلم، هل هذه الكتب الألِف كانت بحوزته، أو أنّه كانت لديه فهارسها فقط؟
وهذا الانطباع والإحساس تُجاه هذا الرجل الفذّ، هو ما تقتضيه فطرة البشر، فكما أنّ الفطرة البشريّة تذعن للجمال الظاهريّ، كذلك تنجذب وتَقِف وقفةَ إجلالٍ مقابل الجمال المعنويّ. والقرآن الكريم يقصّ علينا -وبمنتهى البلاغة والفصاحة- قصّةَ جمال «يوسف» الـمُحيِّر المدهش، يقول القرآن الكريم:
﴿فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَك كَرِيم﴾. والوجه المعنويّ للإنسان الكامل، ينجذب إليه البشر أيضاً من أعماق فطرتهم، ومثال ذلك الوجه المعنويّ للإمام الحسين بن عليّ (عليهما السلام)، الّذي قال الرسول (صلى الله عليه وآله) في حقّه: «إنَّ للحسين محبّة مكنونة في قلوب المؤمني» ، وكلمة «مكنونة» تحمل معنًى كبيراً، والمعنى: أنّ هذه المحبّة مستقرّةٌ وموجودةٌ في قلوب المؤمنين، وقد يحدث أن لا يلتفت المؤمنون في الدنيا لذلك، ولكنّ حبّ الحسين كامنٌ في قلوبهم، متغلغلٌ في ضمائرهم من حيث لا يشعرون.
ولا يقع في نفسك، أنّ الله تعالى أوجَدَ محبَّته (عليه السلام) في القلوب قهراً، وأثبتها جبراً؛ كلا، بل إنّ ذات الفطرة النقيّة للمؤمنين تقتضي تقديس مثل «الحسين» (عليه السلام) وإكباره؛ لأنّها تُقدّس «الـمُثُل والأخلاق» الّتي جسّدها الإمام الحسين (عليه السلام)، وحتّى لو وُجِد رجلٌ آخر قام بما قام به الحسين (عليه السلام)، لقدَّسَته أيضاً القلوبُ الطاهرة، وفاز بحبّهم، ولبَكوه كما تبكي أمٌّ وحيدها.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (برزخ) في القرآن الكريم
معنى (برزخ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (1)
حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (1)
الشيخ محمد صنقور
-
 شكر النّعم
شكر النّعم
الشيخ مرتضى الباشا
-
 هو بحقّ عبد الله
هو بحقّ عبد الله
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 كرّار غير فرّار
كرّار غير فرّار
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
السيد محمد حسين الطهراني
-
 الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الشهيد مرتضى مطهري
-
 المشرك في حقيقته أبكم
المشرك في حقيقته أبكم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الصبر والعوامل المحددة له
الصبر والعوامل المحددة له
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
الشيخ علي الجشي
-
 أمير المؤمنين: الصّراط الواضح
أمير المؤمنين: الصّراط الواضح
حسين حسن آل جامع
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب