علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :
من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهاتطوير علم الكلام ورصد الحركات الإلحادية (1)

أُسس علم الكلام في القرون الإسلامية الأُولى ولم يكن تأسيسه وتدوينه إلا ضرورة دعت إليها حاجة المسلمين إلى صيانة دينهم وعقيدتهم وشريعتهم. وأول مسألة طرحت على بساط البحث بين المسلمين هي حكم مرتكب الكبيرة الّتي اختلف فيها المسلمون إلى أقوال، فمن قائل بأنه كافر، إلى قائل بانه ليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، ويعاقب أقل من عقاب الكافر، إلى ثالث بأنه مؤمن فاسق. وتلت هذه المسألة حدوث كلامه سبحانه أو قدمه فأحدثت بين المسلمين ضجة كُبرى، وصارت مبدءًا لمحنة أو محن. وفي عرض هذه المسألة ارتفع النقاش حول الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة، كاليد، والعين والاستواء على العرش إلى غير ذلك من الصفات.
ثم إنه كلما ازداد الاحتكاك الثقافي بين المسلمين والأجانب، وشاعت ترجمة الكتب الفلسفية والعقيدية للفرس واليونان وغيرهما، زاد النقاش والبحث حولها، للاصطكاك بين تلك الآراء وما جاء به القرآن والسنة، فلم يجد المسلمون في تلك الأجيال إلا التدرع بالبراهين العقلية حتى يصونوا بذلك حوزة الإسلام من السّهام المرشوقة الّتي ما زالت تطلق إلى قلب الإِسلام والمسلمين، ونواميس الدين والشريعة. فشكر الله مساعي الجميع من سنة وشيعة في حفظ الدين وصيانته.
هذا ما قام به القدماء في أداء وظيفتهم الرساليّة، لكن التاريخ يشهد بأن قسماً كبيراً من مسائل علم الكلام، حول المبدأ والمعاد، وحول التوحيد والعدل، متخذة من خطَب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه هو البطل المقدام في دعم هذه الأصول وإحكامها. ولو اعترفت المعتزلة بأن منهجهم الكلامي يرجع إلى عليٍّ عليه السلام فقد صدقوا في انتمائهم وانتسابهم إلى ذاك المنهل العذب الفياض. وليس عليٌّ وحده من بين أئمة أهل البيت، أقام دعائم هذا العلم وأشاد بنيانه، بل تلاه الأئمة الآخرون منهم، كعليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام (ت 38- م 94 هـ)، فقد صقل العقول والأذهان الصافية بأدعيته المعروفة الّتي هي لباب التوحيد وصفوة المعارف الإِلهية، وفيها من العرفان الصافي ما لا يوجد في غيرها. كما أن صادق الأمة وإمامها جعفر بن محمد عليه السلام (ت 83 - م 148 هـ) رفع صرح المدرسة الكلامية الموروثة من آبائه وأجداده، يقف عليه من سبر أحاديثه وكلماته وأماليه، حتى جاء عصر الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (ت 148- م 203 هـ) فأضفى على المسائل الكلامية ثوباً جديداً، وأبان عن المعارف في مناظراته مع أهل الكتاب والزنادقة، وأسكت خصماءه، ودحض شبهاتهم، وردَّ أيديهم إلى أفواههم.
ولو لم يكن لأئمة أهل البيت ميراثٌ كلاميٌ سوى كتاب توحيد الصدوق (ت 306- م 381 هـ)، واحتجاج الطبرسي (المتوفى حوالي 550 هـ) لكفى فخراً في الدفاع عن حياض الإسلام ومعارفه وعقائده.
وقد استخدم أئمة أهل البيت في بحوثهم ومناظراتهم، الوسائل الّتي كان الخصم يستخدمها ويعتمد عليها. كما أن لفيفاً من علماء الكلام قد دقوا هذا الباب ووردوا هذه الشريعة، فتدرعوا بأحسن ما كان خصماؤهم متدرعين به، كما أنهم لم يزالوا بالمرصاد للحركات الإلحادية القادمة من جانب الروم واليونان ومستسلمة أهل الكتاب، فأوجب هذا الرّصد والتدرّع بسلاح اليوم، أن يكون علمُ الكلام علماً يباري الخصماء، ويصرعهم في ميادين البحث، والمناظرة، فجاء يماشي حاجات العصر جنباً إلى جنب، وكتفاً إلى كتف. ولم يكن علماً جامداً محصوراً في إطار خاص، بل كان مادةً حيوية تتحرك وتتكامل حسب تكامل العقول، والأفهام، وحسب توارد الشبهات والأسئلة الّتي بها ينمو كلُّ علم، وبها يتكامل.
فإذا كانت هذه هي وظيفتهم الرسالية أمام الأمة الإسلامية والمسلمين في سبيل صيانة دينهم وشريعتهم، فهذه الرسالة بعدُ باقية في أجيالنا وأعصارنا، فيجب على علماء العقائد والأخصائيين في علم الكلام، اقتفاء أثرهم، ورصد الحركات الإلحادية الهدامة المتوجهة إلى الإسلام من معسكرات الغرب والشرق بصورها الخداعة، وباسم العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، بل باسم التاريخ وتحليل الأديان الكبرى ففيها من السموم القتّالة ما يهدم عقيدة المسلمين، ويزعزع كيانهم، وهم جعلوها في متناول عقولهم وأفكارهم بشتى الطرق والوسائل، فطفقوا يديفون السم بالعسل، حتى يذوقه غير الواعين من المسلمين، ويلتهموه باشتهاء.
إن الحركات الإلحادية الهدامة ابتدأت دورها منذ ظهرت طلائع الحضارة المادية في الغرب، وتَدَيَّن مفكروها بالمادية في غطاء المسيحية وواجهة اليهودية، ووقفوا على أنَّ التغلب على الشرق يتوقف على تضعيف عقائد الشرقيين وإبعادهم عن ديانتهم، فصار ذلك مبدءًا لتأسيس علم باسم الاستشراق، له واجهة الاستطلاع والتحقيق والتنقيب، وواقعيةٌ هي الإِضلال والتحريف، وإضعاف عقائد الشبان. وليس هذا شيئاً مكتوماً على مَنْ سَبَر كتب هؤلاء حتى من اشتهر بالوعي والموضوعية.
هذا، ولو أردنا أن نسلك خُطى من تقدم من علمائنا الكلاميين في الدفاع عن الدين والشريعة، فلا مناص لنا إلا رصد الحركات الإلحادية الّتي تظهر في كل زمن وجيل باسم وصورة وواجهة، وهذا يقتضي تطويرَ علم الكلام الموروث وإكماله حتى يفي بحاجات العصر، ويقف موقف المعلم الرؤوف بالنسبة إلى المتعلم الواعي فيجيب عن الشبهات المستحدثة في كل عصر وجيل باسم العلم والتاريخ. ولأجل ذلك لا مناص في تطوير علم الكلام من البحث في أُمور يقتضي الزمان ضرورة طرحها وتحليلها:
الأول: فصل الدين عن العلم
إن فصل الدين عن السياسة من الخطط الإلحادية الّتي لم تزل تروّج في الغرب منذ كُسِرت شوكة الكنائس، فاتخذوها سنداً وثيقاً لإبعاد الدين عن السياسة، فطفق السياسيون يلعبون بكل شيء سواء أوافق الدين أم لا، قائلين بأن للدين مجالاً، وللسياسة مجالاً آخر، ولكلّ رجاله: (وللحرب والقصعة والثريد رجالها).
وقد لعب السياسيون بهذا الحبل أدواراً، فخصوا الدين بالكنائس والبيع، وخارجهما بالسياسة الّتي لا تفارق الخدعة والدغل.
وجاء بعد هذه الفكرة أو معها فصل الدين عن العلم، وصار هذا أصلاً رصيناً في العلوم الجامعية، تُدَرَّس العلوم الطبيعية والإنسانية على هذا الأصل، فإذا شاهدوا في مورد تناقضاً وتضاداً، فأقصى ما عندهم أنَّ للدين مجالاً وللعلم مجالاً آخر، ولا يصح لواحد منهما التدخل في حدود الآخر. وهذا من الحبائل الإلحادية الّتي يصطاد بها كثير من الشبان بلا مشقة وشدة، وهي تدعوهم إلى الاعتقاد بأمرين متضادين: أحدهما يدعو إلى شيء والآخر إلى ما يضاده، وبما أن الطالب يمارس العلم كل يوم بالأدوات الحسية، فلا يزال يتباعد عن الدين إلى أن يرفضه ويتركه ويصير ملحداً محضاً، وأقصى حاله، أن يكون مسيحياً أو مسلماً بالهوية لا بالحقيقة.
إن الدين المعتمد على الوحي النازل من خالق الكون وصانع نواميسه لا يمكن أن يفترق عن العلم قيد شعرة. فإذا كانت العلوم البشرية كاشفة عن حقائق الكون مع أنها غير مصونة عن الخطأ، فالوحي الّذي لا يأتيه الباطل أولى بأن يكون كاشفاً عن الكون وسننه ونواميسه. ولأجل ذلك يجب في تطوير علم الكلام البحث عن الدين وتبيين مفاده وتعيين حدوده وتشريح موقفه من العلم، وأنهما هل يمشيان في طريقين مختلفين أو في طريق واحد، وهل الدين أمر فردي أو اجتماعي. وهل هو يتلخص في الأوراد والأذكار، أو يعم جميع الشؤون، وأنه هل يُحكِم ويُبرم بلا سند قاطع، أو يعتمد على أوثق المصادر وأقوى المدارك الّتي لا تقبل الخطأ.
الثاني: النسبية أو نفي الحقائق المطلقة
كان الشك والترديد في وجود الكون وما فيه، والعلوم الّتي يتبناها الإنسان، منهجاً رائجاً في الفلسفة الإغريقية حتى قضى عليها أرسطو وأستاذه أفلاطون وغيرهما. إلى أن ظهرت طلائع الحضارة الإسلامية، فقام فلاسفة الإسلام بدحض شبهاتهم ومحوها عن بساط البحث، فلا تجد بين المسلمين من ينتمي إلى السفسطة ويكون له شأن ومقام بينهم. وفي النهضة الصناعية الأخيرة، عادت السفسطة إلى الأوساط العلمية بصورة أخرى، خادعة هدّامة. وهؤلاء، مع أنهم يدّعون أنهم من أصحاب الجزم اليقين، ويكافحون الشك والترديد، يعتقدون بأن ما يدركه الإنسان من القضايا بالأدوات المعروفة صادقٌ صدقاً نسبياً لا صدقاً مطلقاً، صدقاً مؤقتاً لا صدقاً دائماً، وذلك لأن للظروف الزمانية والمكانية والأجهزة الدماغية تأثير في الإدراكات الإنسانية، فليس في وسع الإنسان أن ينال الواقع على ما هو عليه، وأن ترد على ذهنه صورة مطابقة له، مطابَقَةَ الفرعِ للأصل، بل كل ما يحكيه الإنسان بتصوراته وتصديقاته عن واقع الكون ونفس الأمر، فإنّما يحكيه بمفاهيم ذهنية تأثرت بأمور شتى خارجية وداخلية، فالإنسان في مبصراته ومسموعاته أشبه بمن نظر إلى الأشياء بمنظار ملّون، فكما أنّه يرى ألوان الأشياء على غير ما هي عليه، فهذه الظروف الزمانية والمكانية، وما في داخل المدرك وخارجه من الخصوصيات كهذا المنظار، تُري الأشياء على غير ما هي عليه، ولكن لا تباينها، بل تطابقها مطابقة نسبية فالإنسان عند هؤلاء أشبه بمن ابتلي بمرض اليرقان، فكما أنّه يرى الأبيض والأسود صفراوين، لأجل خصوصية في جهازه الإبصاري، فهكذا الإنسان في كل ما يدرك ويقضي، فإنّما يتوصل إلى الواقع بأجهزته الّتي يتأثر العلم الوارد إليها من الخارج بها، ومع ذلك كله فليس ما يدركه خطأً محضاً، ولا صدقاً محضاً، بل هو صحيح في ظروف خاصة.
هذا إجمال ما يذهب إليه النسبيون من الفلاسفة، غير أنه أصبح أساساً للمناهج الفلسفية الغربية منذ عصر ديكارت إلى زماننا هذا، والإنسان المتتبع في كلماتهم ونظرياتهم يقف على أنهم لا يعتقدون بالقضايا الصادقة المطلقة الدائمة الكلية، خصوصاً في فلسفة "جان لاك" (ت 1632 - م 1704) وفسلفة "كانت" (ت 1724 - م 1804) فهؤلاء بإضفاء النسبية على القضايا، وتأثر الإدراكات الإنسانية في جميع الموارد بالخصوصيات الداخلية والخارجية - أعادوا حديث السفسطة ولكن بثوب جديد، وغطاء علمي خادع. ومن سبر دلائل السوفسطائيين في الفلسفة الإغريقية، يقف على أن ما ذكره الغربيون وجهاً لنسبية العلوم، وهو نفس ما ذكر رئيس الشكاكين اليونانيين "بيرهون" في إثبات السفسطة وأن ما يدركه الإنسان من الخارج لا ينطبق عليه لأنّ الأجهزة الإداركية تتأثر بالظروف الزمانية والمكانية والحالات النفسانية، وبذلك لا يمكن أن نعتبر العلوم علماً حقيقياً كاشفاً عن الواقع.
ولو صدق حديث النسبية وأن الأجهزة الإدراكية لم تزل خاضعة لشرائط خاصة، فعلى العلم وكشفه السلام، وعلى ذلك يصبح الدين ومعارفه وشرائعه علوماً صادقة نسبياً، ولو تغيرت الظروف لتغيرت مفاهيم الدين ومعارفه وتشريعاته، إلى غيرها، فاي قيمة لدين هذا أساسه، وأي وزن لمعارف إلهية لا تزال متزلزلة متغيرة بتغير الظروف.
إن نظرية النسبية من أخطر الحبائل الّتي طرحت أمام المتدينين والواقعيين ونحن لا نأتي عليها هنا بكلمة غير أنا نسأل أصحاب هذه الفكرة ويا للأسف تحملها فلاسفة الغرب وأصحاب المناهج منهم، لا سيما الحسيين هل أن القول بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، واجتماع الضدين، ومسألة العلية والمعلولية، وانقسام المفاهيم إلى الممكن والواجب والممتنع، من العلوم النسبية؟ أفهل يحتمل هؤلاء أن للظروف الزمانية والمكانية، والخصوصيات العالقة بذهن الإنسان، تأثيراً في هذه القضايا بحيث لو خرج الإنسان عن هذه القيود لتصوّر هذه القضايا بشكل آخر، فيجوِّز اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، أو يجوز وجود المعلول بلا علّة؟.
والعجب أن هؤلاء عندما يضفون على عامة الإدراكات لون النسبية وينكرون كل قضية صادقة على وجه الكلية والإطلاق والدوام - إن هؤلاء أنفسهم بذلك يثبتون قضية كلية دائمة الصدق غير متلونة بلون ولا محدودة بخصوصية خارجية أو ذهنية حيث يقولون ليس لنا قضية صادقة مطلقة كلية، فإن هذا القول منهم قضية مطلقة لا نسبية، ولو كان هذا النفي، نفياً نسبياً لأصبحت سائر القضايا مطلقة لا نسبية.
إن التركيز على أن للإنسان علوماً مطلقة، مضافاً إلى أن له علوماً نسبية يقتضي التركيز على نظرية المعرفة قبل كل شيء في علم الكلام، فإن لتلك النظرية تأثيراً هاماً في جميع الأبحاث الكلامية، وقد كان القدماء من المتكلمين يبحثون عنها في مقدمات كتبهم فهذا هو الإمام الأشعري، كتب بحثاً مطولاً عن السوفسطائيين في مقدمة مقالات الإسلاميين، وتبعه البغدادي في كتاب أصول الدين، وغيرهما من المتكلمين، حتى أن الإمام البزدوي رئيس الماتريدية في عصره، خصّ فصلاً خاصاً من كتابه في هذه النظرية.
إن علماء الغرب قد بلغوا القمة في البحث عن هذه النظرية، فبحثوا عن أدوات المعرفة، حسيّها وعقليّها، كما بحثوا عن قيمة العلوم الإنسانية مضافاً إلى تحديد مجاري العلم والمعرفة، فإن لهذه المباحث أثراً خاصاً في الأبحاث الكلامية ورصد الحركات الإلحايدة، ولم يزل الإلحاد يدب بين السذج من الشباب من هذه الطرق، فمن قائل باختصاص أدوات المعرفة بالحس، إلى قائل بلزوم الإيمان بما تثبته التجربة ورفض غيرها، إلى ثالث يحدّد معرفة العلوم الإنسانية بشؤون المادة وأعراضها، ويركز على أن ما وراء المادة خارج عن مجال الإدراك الإنساني وأنّه ليس للإنسان فيها القضاء والإبرام نفياً وإثباتاً.
وهذه الأفكار الفلسفية، أخطر على حياة الدين من الحملات العسكرية على كيان المسلمين.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (هون) في القرآن الكريم
معنى (هون) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فرصة سهلة، لكنها حرام
فرصة سهلة، لكنها حرام
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كرّار غير فرّار
كرّار غير فرّار
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
السيد محمد حسين الطهراني
-
 الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الشهيد مرتضى مطهري
-
 اختر، وارض بما اختاره الله لك
اختر، وارض بما اختاره الله لك
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 المشرك في حقيقته أبكم
المشرك في حقيقته أبكم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الصبر والعوامل المحددة له
الصبر والعوامل المحددة له
عدنان الحاجي
-
 كيف يكون المعصوم قدوة؟
كيف يكون المعصوم قدوة؟
السيد عباس نور الدين
-
 (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
الفيض الكاشاني
الشعراء
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 الجواد: تراتيل على بساط النّدى
الجواد: تراتيل على بساط النّدى
حسين حسن آل جامع
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
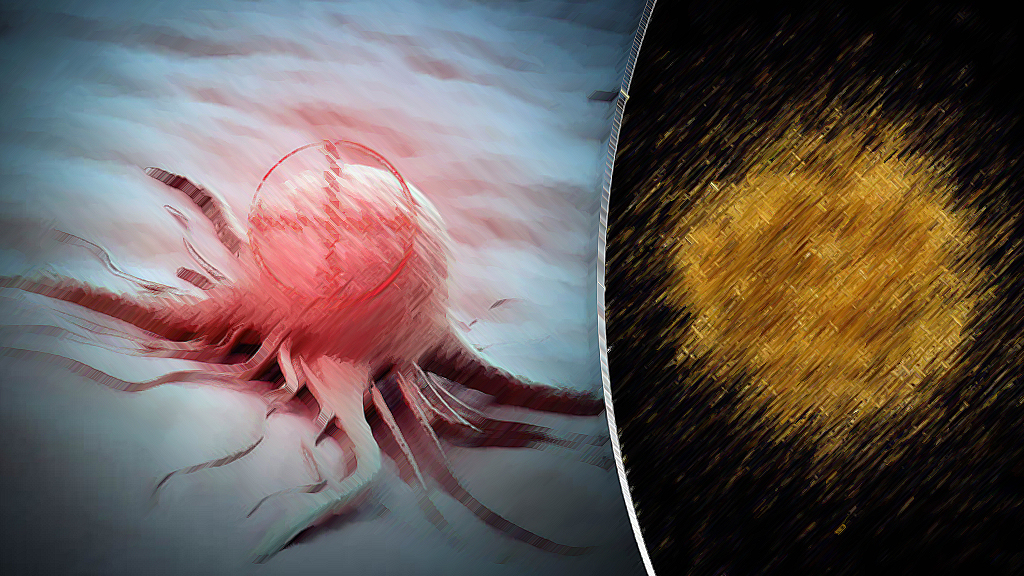
توليف جسيمات نانوية من الذهب الأخضر لعلاج السرطان باستخدام جزيئات حيوية
-

معنى (هون) في القرآن الكريم
-
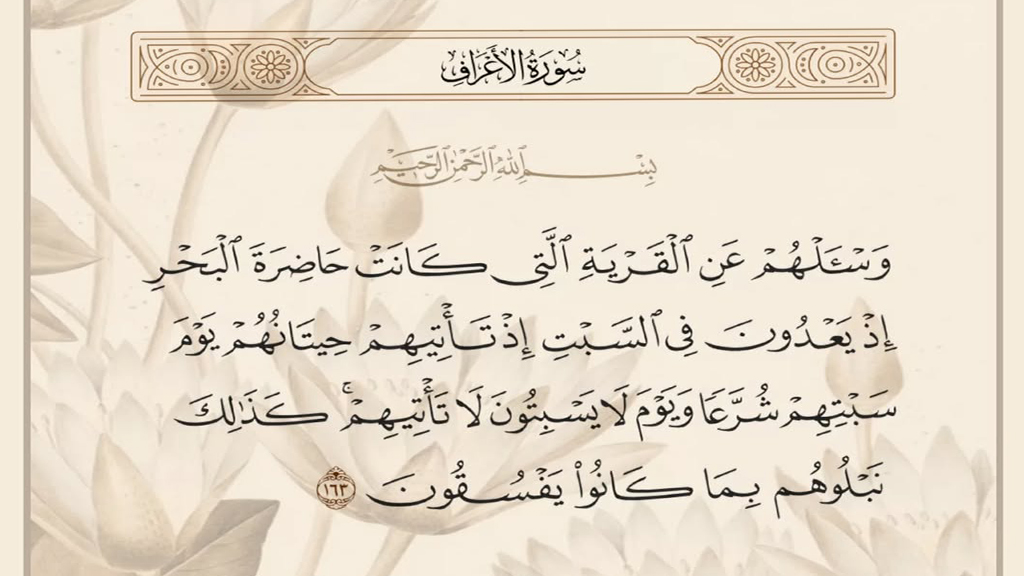
فرصة سهلة، لكنها حرام
-

الإمام علي (ع) وروح المبادرة
-

كرّار غير فرّار
-

أحمد آل سعيد: الطّفل صورة عن الأسرة ومرآة لتصرّفاتها
-

خيمة المتنبّي تسعيد ذكرى شاعرَين راحلَين بإصدارَينِ شعريّينِ
-

لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
-

معنى (دهر) في القرآن الكريم
-

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام










