علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".بصدد التنظير لقول عربي مستحدث في نقد الاستغراب (1)
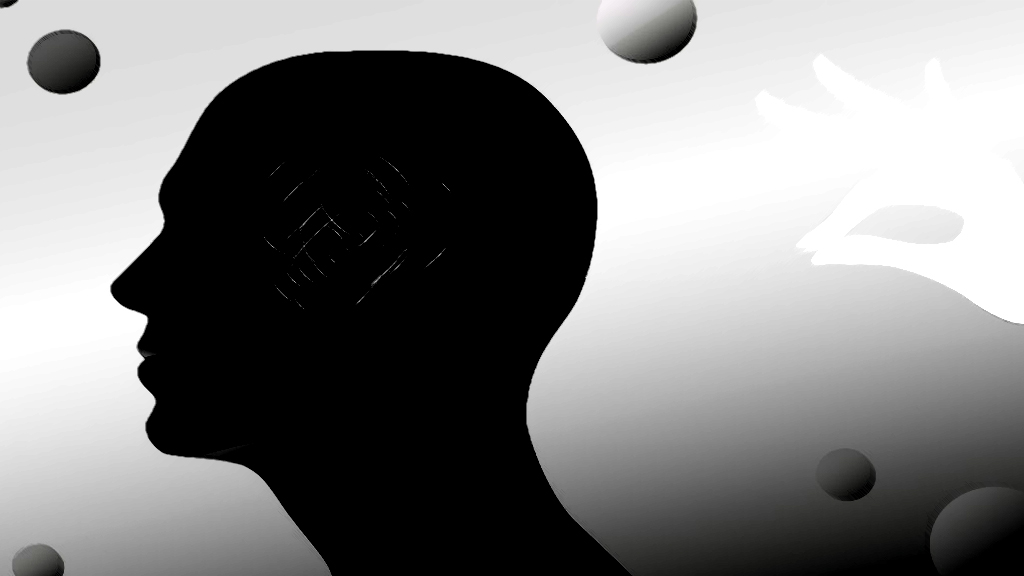
مهمة هذه الأملية التنظير لمنفسحات تفكير تعاين معاثر الاحتدام الحضاري بين العرب والغرب، كما تسعى إلى تسييل أسئلة لم تُسأل بعد، وكذلك الأسئلة التي سُئِلت من قبل وظلت جواباتها طيِّ الاحتجاب…
لقد ابتنينا هذه المهمة على فَرَضية ترى إلى التنظير كمقترح معرفي ينتمي إلى سلالة التفلسف العملي ولا يفارقها أبداً. ولذا سنتاخمه هنا، باعتباره ممارسة تفكيرية تتوخى تحرِّي عِللِ الانسداد الحضاري بغية التعرُّف إليها، وفهمها، وإدراك ماهيتها، واستيلاد الأسئلة المتعلقة بشأنها.
والتنظير – بحسب فرضيتنا- غير موقوف على توصيف ظاهر الحدث وترصّده. فإنه قبل أي شيء، مجهود متبصِّر يروم معاينة المبدأ المؤسس للظواهر والأحداث والأفكار. به تنسلك مهمة المنِّظر في المسرى الأنطولوجي؛ حيث يمضي إلى ما يؤسِّس وما يؤسَّسُ عليه من أفهام . وتلك مرتبة ترقى إلى التعرُّف على الأصل، وتنظر إلى ما يتعدى الاستكشافات العرضية للأحداث والمفاهيم. لكأنها توعز للمِنظُّر من بعد أن فرغ من اختباراته المريرة في سياسيات اللحظة وعالم اأايديولوجيا، وأن يعبر إلى الضفة الأخرى. أي إلى ما لا يتناهى التفكُّر فيه كأن يحرز المنظِّر معها مَلَكَة المبادرة باتجاه فتحٍ معرفي يسبر الأغوار، ويعيّن التخوم، ويقدم التصورات والأفكار.
يكمن المغزى العميق للفعل التنظيري بوصفه فلسفة عمل وفعل. وحين يتوفر الفاعل على إرادة التفكير صار التنظير بالنسبة إليه – لا ضرورة معرفية فحسب – بل واجباً أخلاقياً أيضاً. في هذه اللحظة يشق المنظِّر سبيله نحو نظرية معرفة تقوم على النظر والإيجاد في آن. هكذا، تتأسس فلسفة التنظير على الثقة، بأن الذات قادرة على الفعل والإيجاد متى غادرت أنانيتها وتكاملت بحضورها في فضاء الحضارة الإنسانية الشاملة. حالذاك لا تعود الذاتُ حبيسة القلق والتشظي وانعدام اليقين. ولا يعود السؤال بالنسبة إليها مطروحاً لمجرد الاستفهام العارض، وإنما ذلك السؤال الذي يصدر عن ذات مسؤولة معتنية بضرورات الإجابة وواجبيتها.
التفكير المشرقي والإسلامي اليوم مدعوّ إلى التحرر من غواية المفاهيم التي استورثها في غفلة من زمن، ثم استيقنها حتى ركزت في أعماق نظامه المعرفي. كانت ثنائيات مفاهيمية كمثل الإيمان والإلحاد، والغيب والواقع والدين الدنيا، والحدث والفكر، أشبه بحُجُب تشيّأ تفكير المستغربِ العربي بسببها، وترسّخ كسله، وحالت بينه وبين استقلاله الفكري مفاهيم ومصطلحات وفدت واستوطنت، حتى أرقدته في كهف الغربة.
لقد احتلت أفهام الحداثة المساحة العظمى في مجتمعاتنا لتنتج ضرباً من الهلع الفكري سحابة اللقاء غير المتكافئ مع الخطبة الفلسفية الغربية. ولقد تحولت تلك الخطبة لدى النخب العربية والإسلامية إلى مرجعية مهيمنة ظهرت في غالب الأمر على هيئة نظام معرفي لا شِيَة فيه. كما لو أن الاستغراب العربي الإسلامي قد غفل عن حقيقة أن المصطلحات والمفاهيم هي الحاصل المنطقي للحادث الحضاري الغربي. وإن المفاهيم والتعريفات لا تتخذ مسارها على خط مستقيم، وإنما تشكل دائرة رؤية وعبرة فحسب. فليس المهم من أين يبدأ المرء وإنما في الكيفية التي تمكننا المفاهيم من بلوغ الغاية التي تتحرر فيها مما نحن فيه من استفهامات عصية على الإجابة.
البيِّن في الصورة الراهنة أن التفكير العربي – الإسلامي لم يفارق مباغتات الحداثة، بل ربما صار في أكثر الأحيان، أشدّ تكيفاً مع إيقاعاتها ولنا أن نقرأ المشهد من ثلاثة أوجه:
ـ الأول، يتماهى مع الحداثة ومنجزاتها تماهياً ختاميًاً لا محل فيه لمساءلة أو نقد.
ـ والثاني، يتبدَّى على صورة معارضات انفعالية لا تكاد تؤتي أُكْلَها حتى تذوي في محابسها الأيديولوجية.
ـ وأما الثالث فهو ما يجيئنا على هيئة محاولات ووعود، ثم لا يلبث بعد هنيهة حتى يظهر لنا فقْرَه وقصورَه عن مجاوزة مشكلات الانسداد الحضاري.
في ضرورة التنظير وواجبيته
يفضي الكلام على واجبية التنظير وضرورته، إلى استغراب الأمر من غير وجه:
أولاً: لأنه ينطوي على استدارج السامع إلى مطرحٍ معرفي لا يُفهم منه للوهلة الأولى، إلا أنه دعوة إلى إنشاء لفظي لا حظ له من الواقع في شيء. الباعث على مثل هذا الفهم السلبي للتنظير يرجع –على غالب الظن- إلى واحدة من أشقّ الابتلاءات التي سكنت تفكير النخب في مجتمعاتنا وتجذرت فيه. عنينا بها القطيعة بين الفكر والحدث سحابة تاريخ كامل. فلقد بدا كما لو أن الحدث يسير من تلقائه على غير هدى، وإن الفكر ليس غير سلوى بمحكيَّات لا موطن لها ولا مستقر. لكأن شيطان الوهم استحكم بالمستغرِبِ العربي فدعاه إلى الاشتغال عن ظهر قلب بالمنقول من وافد المفاهيم، والإعراض عن معاينة الخاص من الهوية ببعديها الوطني والحضاري.
ثانياً: لأن فكرة التنظير، وإن كانت تحظى بمشروعية معرفية وتاريخية، فقد بدت لنسبة وازنة من الأنتلجنسيا العربية، ولا سيما تلك العاملة في الحقل الأكاديمي وكأنها خارج السياق. ربما التَبَسَ الأمر على البعض فأرجأ ما كان ينبغي أن يدلي به إلى وقت لاحق.. فيما شريحة واسعة من هؤلاء أخذتهم الحوادث اليومية بغتة فاستغرقوا بدنياها وغفلوا عن أسئلة المابعد.
ثالثاً: لأن مشروع التنظير ينتمي إلى مقام مخصوصٍ ذي صفة متعالية لا ينالُها إلاّ الأقلون. أولئك الذين كتبوا على أنفسهم متاخمة الحدث ومعاينته وتأويله ليتبيَّنوا ضميره المستتر، ثم ليدركوا منتهاه، فيبنون على ذلك المنتهى مقتضاه.
رابعاً: من المفارقات الغريبة أن يُطرح سؤال التنظير وسط وهنٍ فكري يلقي بأظلّته على أوسع البيئات المشتغلة بعالم الأفكار. ولو دلَّ هذا على شيء، فعلى حالين:
أ- تراجع جاذبية المدوَّنة الأيديولوجية بمدارسها وتياراتها الكلاسيكية (القومية والليبرالية والماركسية). ثم لتَدَع الميادين ومن عليها إلى الفراغ. حتى إذا استحلّت النيوليبرالية عرش العالم هبط القول الفلسفي إلى دنيا الانتفاعية ولم يعد لهذا القول أمام سطوتها من جدوى.
ب- الإسلام الأيديولوجي الذي قدم نفسه كحامل مفترض لمهمة النهوض لم ينجُ من التموضع في القلاع الصماء التي انتصبت بصورة مباغتة في ما سمي اشتباهاً بـ “ربيع العرب”. ففي الخطبة الأيديولوجية للإسلام السياسي المستحدث وقفت مقولة الأحياء الحضاري على أبواب السلطة طلباً للقربى أو طمعاً بها. جلّ ما كان في الخطبة من متساميات أمسى رهينة اللحظة ومقتضياتها. حركات إسلامية في مواطن شتى انبرت إلى الأخذ بالفكرة الإحيائية لتسوِّغ مسعاها إلى الحكم، أو أقله لتمنح نفسها مشروعية حضورها في المجتمع السياسي. وعلى الإجمال، لم يرقَ همّ النهضة في إنشاءات النخب بمنوعاتها القومية والعلمانية والنيوليبرالية فضلاً عن الإسلامية، إلى المقام الذي يصبح فيه همّاً تنظيرياً مسهماً في هندسة “كوجيتو” عربي يسدد التنظير ويمهِّد السبيل لقول فلسفي من طراز جديد.
خامساً: حداثة الغرب في العقل النخبوي العربي، لا تزال تستعاد على النشأة التي قرأها أصحابها الأصليون قبل أكثر من أربعة قرون. ما هو أدهى، أن العقل المشار إليه، وعلى الرغم من الميراث النقدي الهائل الذي زخر به تاريخ الحداثة، بقي حريصاً على متاخمة سيرة الحداثة الأولى ومقالتها البكر: أي بوصفها أطروحة لمدينة فاضلة جاءت تستنقذ العالم من فوضاه وجاهليته. ما يعني أن عقلاً كهذا لا يملك أن يرى إلى حداثات الغرب المتعاقبة إلا بوصفها عالماً متخيلاً لا حظَّ له من الحقيقة الواقعية في شيء.
يفعل ذلك المعاصرون من المثقفين العرب كما فعل الأوائل من قبل. أولئك الذين اجتمعوا على مقالة النهضة حتى سمي الزمن الذي عاشوه باسمها. فكان ختام القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين عامراً بفردوس الشعارات الكبرى: الدولة الأمة، والديمقراطية، والمجتمع المدني، والتحرر من الاستعمار، والعدالة الاجتماعية، والتعددية، ونقد طبائع الاستبداد.
أكثر هؤلاء حملوا سؤال التقدم التاريخي على حسن الظن وسلامة النية. إلا أنهم لم يفارقوا دهشة الحداثة وما بعدها. ثم لم يدرك أن “أنوار الغرب” مكثت في الغرب ولم تتعدّ حدوده، ثم لم يأتِنا من حصاده سوى شراهة السيطرة ورعاية الاستبداد والعناية بالجاهليات المستحدثة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القرآن والحياة في الكرات الأخرى
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 معنى (كدح) في القرآن الكريم
معنى (كدح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

خلاصة تاريخ اليهود (2)
-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى
-

معنى (كدح) في القرآن الكريم
-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ









