علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالتسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (3)
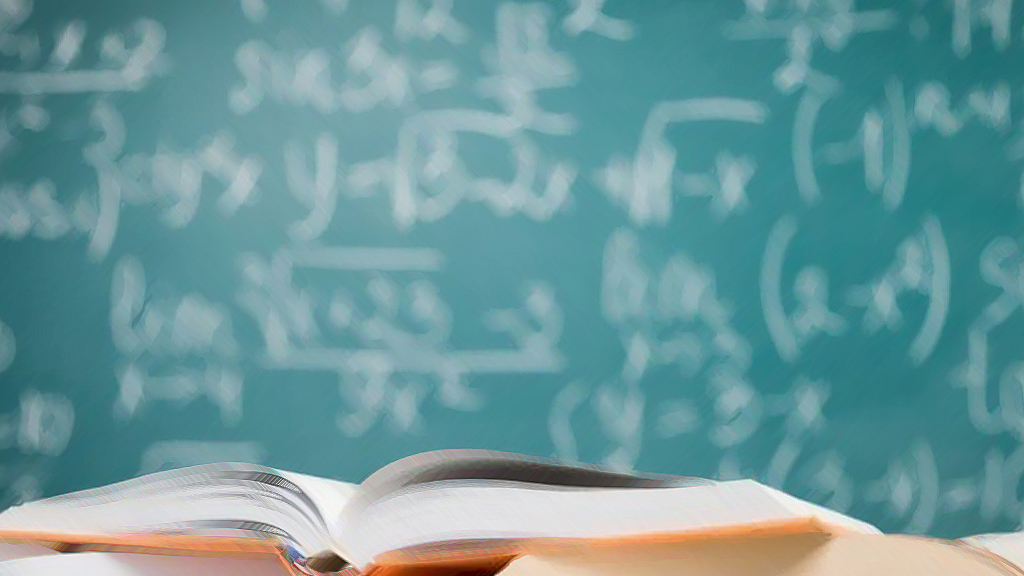
التحيز المعرفي:
التحيز هو حصر الشخص نفسه في حيز ومكان مسوّر بسور متميز عن غيره، وهذا هو المعنى الحسي للكلمة، والاستعمال الشائع للكلمة هو استعمال مجازيّ خاصة في المسائل الفكرية والمعنوية، فالتحيز له حقيقة في اللغة ومجاز في الاستعمال.. وهناك علاقة بين التحيز وبين مسألة العدل والهوى، فالتحيز ينبغي أن يكون منه الممدوح والمذموم، فالممدوح هو ما وافق العدل، بحيث تكون قيمة العدل هي الدافع والحافز لتبني المواقف والآراء والأفكار، والعدل ما طابق الواقع، والحق هو ما طابقه الواقع من العدل.. وهناك فرق بين التحيز وبين الرأي الموضوعي على مستوى الواقع من جهة وعلى مستوى الأمل (ما ينبغي أن يكون) من جهة أخرى، والتحيز قد يتعارض أو يتوافق مع الرأي الموضوعي، فالرأي الموضوعي قد ينصب على الحكم على موضوع الكلام، أما التحيز فهو منشئ ذلك الرأي [1].
ولقد أشار الله تعالى في محكم كتابه الكريم إلى مرجعية العدالة كقيمة معيارية كمعالجة لموضوع التحيز، سواء في الحكم أو في القول أو في الموقف، مؤسسًا لقاعدة عامة تعالج التحيزات بكافة أشكالها حيث قال جل شأنه في سورة المائدة الآية الثامنة: ”يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ”.
والتحيز المعرفي هو مصطلح عام يستخدم لوصف العديد من الآثار الملاحظة في أداء العقل البشري، فالبعض منها قد يؤدي إلى تشويه الإدراك الحسي، والى اتخاذ حكم أو قرار غير دقيق، أو تفسير غير منطقي. هذه الظاهرة العقلية تم دراستها في العلوم المعرفية وعلم النفس الاجتماعي [2].
وهناك من يشير إلى أن التحيز المعرفي يعتبر خطأ في التفكير والتقييم والتذكر، أو إدراكًا إجرائيًّا يحدث أحيانًا نتيجة قناعات وإيمانيات مترسخة، تجعل الفرد يلتزم بها بغض النظر عن أي معلومات مغايرة، والتي قد تكون أكثر عقلانية. مثال ذلك، التحيز التأكيدي، الذي هو ميل للبحث في المعلومات التي تتوافق مع قناعاتنا فقط، فالذاكرة هنا تؤدي غرض التحيز، بحيث أنها وبسهولة تؤثر في كيف وماذا تريد أن تتذكر، فالناس وبشكل جلي يتذكرون المواقف الممتعة وتلك التي تذكرهم بأنفسهم وكم هم مهمّون.
إذًا التحيز المعرفي هو خطأ في التفكير الذي يحدث عند الناس، نتيجة معالجة أو تفسير معلومة معينة بشكل خاطئ. بمعنى أنه غالبًا ما تكون هذه الأخطاء نتيجة محاولتنا لتبسيط معالجة المعلومات على ضوء خبراتنا ومعارفنا التي تشغل حيزًا عريضًا في أذهاننا، وهنا يكمن التسارع المعرفي في تبني النتائج كمعتقدات نهائية، والتي لا نعلم غيرها وفي الغالب أيضًا لا نود معرفة ما يتصادم معها. إنها ببساطة تشكل قواعد أساسية في طريقة تفكيرنا، والتي من خلالها تجعلنا نصيغ ونُكَوّن أفكارنا وتصوراتنا عن العالم من حولنا بالطريقة التي ترسمها لنا، والتي تساعدنا في اتخاذ القرارات بسرعات متفاوتة، لكن مما يؤسف له أن هذه الأفكار والتصورات والتي تفرز وجهات نظر أو قرارات نقوم باتخاذها والتي تبدو لنا عقلانية ومنطقية إلا أنها تكون غالبًا غير صحيحة [3].
إلا أن إطلاق الحكم بكون التحيز المعرفي خطأ في التفكير، هو تحيز أيضًا باتجاه فكرة أحادية الجانب، كون هناك تحيزات معرفية إيجابية صحيحة، خاصة إذا تطابق التحيز المعرفي مع معيار العدالة، والتأني والتباطؤ في البحث والتنقيب المعرفي والتدليل عليه بأدلة منطقية وعقلانية، بالتالي يكون تحيزًا للحق وهو بذاته صحيح وليس مذمومًا. وغالب التحيزات المعرفية وخاصة تلك المتعلقة بالعقيدة يكون سببها ذاتيًّا في بنية الإنسان الدماغية التي تميل للتبسيط، وتبتعد عن التعقيد، بل تعود أيضا لميل الإنسان للكسل، وهروبه من البحث العميق في الأفكار وتمحيصها والعجلة التي وصفه بها الله في محكم كتابه العزيز حيث قال: ”خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَلْ”[4]، والعجل من السرعة والتسارع وهو عكس الأناة والتباطؤ، وتلاها بقوله “سأريكم آياتي فلا تستعجلون” والآية هي الدليل القطعي للمعرفة التي يطرحها نبي الله (ص)، وهو الإنسان المقصود بها النوع الإنساني، فيكون الطريق الأسهل لعامة الناس هو التبسيط والتحيز، للتخلص من أي تعقيدات ذهنية تشعرهم بالاضطراب المعرفي، وتسلب منهم اطمئنانهم المتسالم عليه والمتوارث.
فالرحلة التي يقطعها العقل من المجهول إلى المعلوم، ومن ثم من المعلوم إلى المعلوم والتي تبحر في خضم المعلومات والأفكار التي تختزنها الذاكرة، والتي شكلتها خبرات الشخص، هنا تقع كثير من التحيزات خاصة إذا لم يحاول الشخص الخروج من ذاتياته وأفكاره، ومحاولة البحث عن المعلومات خارج الإطار المعرفي الذي اعتاد عليه، فهو هنا يقع في تحيز شديد الانغلاق، بالتالي وصوله إلى معلوم يكون خاضع لهذه التحيزات، وقد يكون وصولاً آمنًا صحيحًا، ولكن غالبًا ما يكون الوصول غير آمن ويرتبط المجهول بمعلوم غير واقعي وغالبًا ليس صادقًا.
ولكن لو امتلك هذا الشخص في رحلته هذه المعرفية أدلة قطعية على معارفه وعلى نتاج رحلته البحثية، والتباطؤ في فهم الموضوع محل البحث، والتباطؤ هنا يعني التبحر في الآراء حول الموضوع، والآراء المتعارضة والمتوافقة، وبحث معطياته ومفاهيمه ودلالاته، حتى مع عدم خروجه خارج هذا الصندوق، فإن منهجه يكون منهجًا علميًّا لكنه متسارع، وقد يحتاج هنا للتباطؤ الذي يعني مزيدًا من التأمل حت فيما لديه من أدلة ومعطيات، من خلال محاولة الإبحار خارج صندوق عقله وأفكاره، هذا التباطؤ يمكنه من تفعيل أدوات المعرفة وتعميق البحث للخروج بمعارف ترفع الجهل من جهة، وترفعه بشكل أقرب للواقع بعيدًا عن الوهم من جهة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]إشكالية التحيز/ رؤية نقدية معرفية ودعوة للاجتهاد/ تحرير عبد الوهاب المسيري/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي/١٩٩٨م/ بحث بعنوان كلمة في التحيز ـ د. علي جمعة ص ١٧ـ ١٨ بتصرف
[2] د.سالم موسى/ جامعة الملك خالد/ أبها / التحيزات المعرفة التصديق الزائف / https://middle-east-online.com/التحيزات-المعرفية-والتصديق-الزائف/ تم الاطلاع في ١٥/ مايو / ٢٠١٩م
[3] كندرا تشيري /خبيرة علم النفس/ المصدر السابق بتصرف
[4] الأنبياء/٣٧
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القرآن والحياة في الكرات الأخرى
القرآن والحياة في الكرات الأخرى
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 معنى (كدح) في القرآن الكريم
معنى (كدح) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
محمود حيدر
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

خلاصة تاريخ اليهود (2)
-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى
-

معنى (كدح) في القرآن الكريم
-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)
-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك
-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ










