قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد هادي معرفةعن الكاتب :
ولد عام 1348هـ بمدينة كربلاء المقدّسة، بعد إتمامه دراسته للمرحلة الابتدائية دخل الحوزة العلمية بمدينة كربلاء، فدرس فيها المقدّمات والسطوح. وعلم الأدب والمنطق والعلوم الفلكية والرياضية على بعض أساتذة الحوزة العلمية، عام 1380هـ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف لإتمام دراسته الحوزوية فحضر عند بعض كبار علمائها كالسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة والتحق بالحوزة العلمية هناك وحضر درس الميرزا هاشم الآملي. من مؤلفاته: التمهيد في علوم القرآن، التفسير والمفسِّرون، صيانة القرآن من التحريف، حقوق المرأة في الإسلام.. توفّي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من عام 1427هـ بمدينة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلامموسيقى القرآن، النّظم والجاذبيّة (1)

مقدمة
لقد اقتضت القدرة الإلهية أن تجري سنن الله في هذا الكون، واقتضت حكمته أن يغشّي جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال. فهذا القرآن أنزله على نبيه الخاتم هدى للبشرية، تجد فيه ما يحملها نحو الكمال، مشرِّعاً ومرشداً. ولم تكن الكلمات والعبارات وحدها مظهر إعجازه، بل كانت أنغامه وأصواته مظهر الإعجاز، ومظهر القداسة فيه. فقد نقول: فيه كلمات وأصوات، فنكون قد أحدثنا ثنائية اعتبارية في الوصف، لكن الحقيقة أن لا ثنائية، بل هناك وحدة خارجية بين الكلمة والصوت؛ لأنه لا يمكن التفكيك بينهما في الوجود، وفي الغاية.
فكما أن الكلمات معجزة في معانيها فهي كذلك معجزة في نظمها، فأصواته ونغماته، ككلماته وعباراته، كلها تحلق بالنفس نحو السماء، حيث الصفاء والطهر، حيث لا وجود إلا وجود الله تعالى. كلماته ونغماته أمسكت ألسن أرباب البلاغة والفصحاء، فلم يجدوا قِبَلها سوى أن يخرّوا إلى الأرض، معترفين بإعجازه، ومقرّين له بعلوّ وشرف المكانة. لقد تحيرت قلوب العرب فيه منذ البدء، كيف به الآذان يصدون، وأيّ قول به القلوب يمنعون، فقالوا: شعرٌ، لا بل هو أعذب من الشعر، فقالوا: سحرٌ وأيُّ سحر هو؟! و«إن من البيان لسحراً…»([1])، فأبت قلوبهم ذلك، ليقولوا في صمت ـ بعد أن أعيتهم المذاهب ـ: ليس بقول بشر.
القرآن وفصحاء عصر الرسول الأكرم
لقد رُتّبت الكلمات والعبارات في القرآن، وتم نظمها، بحيث ترى فيها انسياباً، ووحدة، وانسجاماً، وتآلفاً، لا نظير لها ولا مثيل، بل إن حروفه وكلماته من حيث امتدادها الصوتي تسير وفق لحن وموسيقى جذابة تظهر ـ بحقٍّ ـ سماويته، وأنه ليس من صنع البشر.
فرغم تحلّي القرآن بخصوصيات «الكلام المنثور» إلا أنه شبيه إلى حدٍّ كبير بالكلام «المنظوم»، ورغم كونه يحمل خطاب الترغيب والترهيب إلا أنه يؤثّر في النفس بحيث تنجذب إليه كانجذاب المسحور إلى الساحر، مع وجود الفارق؛ فالأول انجذاب نحو الحق، نحو الله؛ والآخر انجذاب نحو الباطل، نحو الشيطان.
والقرآن بما له من خصوصيات في النظم وترتيب الكلمات والعبارات قد أدخل على اللغة العربية أنماطاً جديدة في الأسلوب وطرق النظم، حيث عرض للعالم أجمع نمطاً جديداً في النظم والتأليف فاق ما علموا به في النثر والشعر، وهو ما أدخل المتكلّمين بالعربية، وكل البشرية، في دوامة الحيرة والتعجب.
فهذا «الوليد بن المغيرة»، وهو من أرباب عصر الجاهلية، وفطاحلة لسانها، وقف عاجزاً أمام ما سمعه من الآيات، فلم يجد ما يقوله سوى إقراره : «فيا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة ـ يقصد رسول الله ـ، والله ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بهذا من الجنون، وإنّ قوله لمن كلام الله».
فلما سمعت قريش مقالته في حق القرآن غضبت منه، وسألته عن سبب قوله كلاماً يؤلِّب القوم عليهم، ويعلي من شأن محمد (ص) وأصحابه؟ فأجابهم: «لقد ذهبت البارحة إلى محمد (ص)، والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه».
وقبل أن يحلّ موسم الحج ذهب صناديد قريش إلى الوليد بن المغيرة، يطلبون منه أن يجد لمعضلتهم حلاًّ، فهم يرغبون في إيجاد حيلة يمنعون بها الناس من الالتفاف حول النبي الأكرم (ص)، فقالوا له: ماذا نقول في ما يتفوه به محمد من دجل؟ ماذا لو تقول بأنه كلام ساحر؟ فأجابهم: لقد سمعت همهمات السحرة، وكلام محمد لا يشبهها أبداً، فقالوا: إذاً قل: هو مجنون، فأجاب: أبداً، ما رأيت فيه هيجان المجنون، فقالوا: إذاً إنه ساحر، وإن هذا من صنع سحره، فقال بعد أن فكَّر ملياً: خداع السحر أعرفه جيداً، فقد رأيته بأم عيني، وسمعته، وما ينطق به محمد أعلى وأجلّ من السحر، وأعظم من أن يكون ترهات مجنون أو مشعوذ، فقالوا: فماذا إذاً؟ فقال: كلّ ما تقولونه لن يصدقه أحد، وسيجعلكم محطّ السخرية والاستهزاء بين الناس. وإذا كان ولا بدّ فقولوا: إنْ هو إلا سحرٌ يؤثر؛ لأن كلامه يفعل في النفس ما يفعله السحر، فقد فرق بين الأبناء وآبائهم، وبين النساء وأزواجهن، وفصل الأفراد عن قبائلهم… ومن هذه الزاوية يمكن عد كلامه ـ القرآن ـ سحراً ودجلاً([2]).
وقد شهد عصر النزول العديد من مثل هذه المواقف والتحركات، التي تكشف في الجملة عن اضطراب وخوف عرب الجاهلية، وكيف أنهم وقفوا عاجزين أمام القرآن، لا يجدون ما يقابلونه به، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. فقد سجل التاريخ أسماء شخصيات كانت تعدّ من أشراف العرب وشعرائها الكبار، والمتضلعين في صناعة الكلام ونظمه، أمثال: «طفيل بن عمر» و«النضر بن حارث» و«عتبة بن ربيعة»، وهذا الأخير كان من الكهنة، وكان يتمتع بمكانة خاصة بين عرب الجاهلية، وغير هؤلاء كثير([3])، كلهم عبّروا عن عجزهم، وخرّوا إلى الأرض معترفين بأن لا قدرة لهم على المقاومة والمواجهة بالمثل…
وقد ذكر القرآن على ألسنتهم ما كانوا يجدونه من الاضطراب، وما كانوا يعيشونه من الاستقرار النفسي أمام القرآن، قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (الأنبياء: 5).
وقال في الوليد بن المغيرة، الذي يعبّر في حقيقة الأمر في موقفه عن موقف العديد من صناديد العرب آنذاك، ومن كان على ملتهم: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (المدثر: 24).
وفي تأنيبهم وتوبيخهم على عدم تدبرهم، ومقايستهم التي تكشف في حقيقتها عن افتقارهم للحكمة والبصيرة، وافتقادهم للحجة، قال تعالى: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ﴾ (الطور: 15)، ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ﴾ (الحاقة: 41).
لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن الفيصل بين القرآن وما وصفه به عرب الجاهلية وكفار قريش آنذاك، وكان قوله فصلاً، وقضى بأنه ليس بسحر، وليس بشعر، بل هو شيء آخر، وليس بسجع الكهنة، وليس من صناعة البشر، شيء جديد أعلى وأعظم ممّا تعرفه الإنسانية على مر التاريخ من أنواع الكلام والخطابات. جاذبيته تشدهم إليه، وتلألؤه زرع الرعب في قلوبهم، فوقفوا وجلين، وغطوا عن مشاعرهم تلك، وما يعانونه من العجز قبله، مرة بقولهم: إنه شعر؛ وأخرى سحر، وهم أكثر الناس معرفة بأنه لا هذا ولا ذاك، هو أشعر من الشعر، وأسحر من السحر، لكن كفر قلوبهم، وعمى بصيرتهم، ألجم ألسنتهم عن قول ما أقرّت به عقولهم، فأنّى لهم ما يحكمون، وقد عيوا به وهو منهم على طرف الثُّمام!!
القرآن في عيون أدباء العصر
أدباء العصر ومن يزاولون صناعة الشعر أو الكتابة يتبنون رأي أسلافهم نفسه في نظرتهم إلى القرآن، فكلهم يرون فيه تناسق الموسيقى الصوتية للحروف والكلمات، أعلى من الشعر وأفصح من كل كلام، لا نظير له ولا مثيل، إنه بحقّ كلام الله مبدع كل الكون، وخالق كل لسان.
وفي هذا المضمار يقول الأستاذ محمد عبد الله دراز : «…دع القارئ المجوّد يقرأ القرآن، يرتله حق ترتيله، نازلاً بنفسه على هوى القرآن، وليس نازلاً على هوى نفسه، ثم انتبذ منه مكاناً قصياً، لا تسمع فيه جرس حروفه، ولكن تسمع حركاته وسكناته، ومدّاتها وغنّاتها واتصالاتها وسكتاتها، ثم ألقِ سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريداً، وأرسلت ساذجة في الهواء، فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جُرِّد هذا التجريد وجود هذا التجويد. ستجد اتساقاً وائتلافاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى، ولا بأوزان الشعر، وستجد شيئاً آخر لا تجده في الموسيقى، ولا في الشعر…، بينما أنت من القرآن لو أن آية منه جاءتك في جمهرة من الأقوال لدلّت على مكانها…»([4]).
كذلك وجدنا الأستاذ محمود مصطفى يقول في هذا الشأن: إنه قد أدرك وهو في سن الصغر أن لكلمات القرآن وعباراته موسيقى داخلية خاصة، والتي لعمري هي أعظم أسرار هذا الكتاب المقدَّس، فهي بادية يشعر بها كل من يستمع آياته تتلى، فقد تم نظم عباراته وآياته وفق نسيج فني في كامل الروعة والجمال، وكانت الألفاظ ـ والتي تحمل في ذاتها موسيقى خاصة بها ـ قد وضعت إلى جانب بعضها الآخر، فتكاملت الصورة، وانسجم الإيقاع، وأتت الموجات الصوتية مناسبة للصورة الفنية، ولما تحكيه الكلمات والعبارات، فصرت تقرأ وفي الآن نفسه الصورة حاضرة أمامك كأنك تعيش الأحداث في واقعيتها، فلا هو يشبه النثر، ولا هو يشبه الشعر.
ويضيف: إن الفرق واضح بين تلك «الموسيقى الخارجية» التي يتمتع بها الشعر والنثر الأدبي، والتي هي نتاج الصناعة والتكلّف، حيث يتم تركيز كل الجهد في إيجاد القافية والنظم المناسب؛ لأنها المقومات الذاتية للشعر…، وبين «الموسيقى الداخلية» في القرآن، التي حصلت من جعل الألفاظ ونظمها في سياق خاصّ جعل العبارات والآيات تترنم وفق موسيقى منسجمة الإيقاع، لا تشعر فيها بأيّ نوع من التنافر، بل كل ما تراه وتسمعه هو التآلف والانسجام، وكأن الكلمات وإيقاعها صوتي حبيبين تعاهدا وعد وفاء أن لا انفكاك. بذلك اختلف القرآن عن كل أشكال الكتابة الأدبية…([5]).
أما السيد قطب فقد أعطى للتصور الفني، ولجانب الإيقاع والموسيقى الداخلية للكلمات والعبارات في القرآن، معنى آخر، وعبّر عنها بموسيقى ونغمات فنية تكشف بحقّ عن عمق إحساسه وتأثره بهذه النغمات والإيقاعات الداخلية في القرآن. فقد كتب يقول : «وصدق القرآن الكريم، فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين، ولا جاهلين بخصائص الشعر، يوم قالوا عن هذا النسق العالي: إنه شعر. لقد راع خيالهم بما فيه من تصوير بارع، وسحر وجدانهم بما فيه من منطق ساحر، وأخذ أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل، وتلك خصائص الشعر الأساسية، إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل. على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً. فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية المتقاربة التي تغني عن القوافي، وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا، فنشأ النثر والنظم جميعاً»([6]).
كذلك كان رأي الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، حيث قال: «حين قرئ القرآن على العربي أدرك أن حروف كل كلمة منه وكلمات كل جملة وعبارة منه تحمل في ذاتها نغمة وإيقاعاً عالياً، بحيث إنها في نظمها البديع داخل القرآن، وفي شكل وضعها إلى جانب بعضها البعض، كأنها في نغماتها «قطعة موسيقية»، تصعد فيها النغمة وتنزل بشكل منسجم يسري في الروح كأنه البلسم. إن كلّ من مُنَّ عليه من طرف الرحمن باستشعار بعض أسرار موسيقى القرآن وفلسفتها يقرّ معترفاً بأن لا شيء في الوجود مثل القرآن، بكلمات تنساب في انسجامها مع بعضها البعض، من دون أن تشعر أن هناك أدنى تكلُّف أو تصنُّع، تشعر كأن المسألة تنساق وما تخلفه في النفس من أثر لتجعل النفس تستشعرها جزءاً من طبيعتها، وشيئاً ينسجم وفطرتها نحو الكمال، وأن إيجاد هذا الانسجام مع الكيفيات النفسية لا يمكن أن يكون من إنجاز البشر، ولا أن يكون في مقدور البشر ـ مهما علا شأنه في الفن وصناعة الكلام ـ أن يوجد مثل القرآن، وأن يجعل كلامه ينطق بهذه النغمات وهذا الإيقاع العجيب والمعجز الذي يتعالى على الموسيقى، وليس بالموسيقى التي نعرفها. لم يخف على العرب، وهم أصحاب العربية والناطقين بها، لا عن تعلم، ولكن عن سليقة، هذا البعد الخاصّ بالقرآن، ولذلك هم يقرّون أن لا مقاومة لهم أمامه، وأن أنفسهم تعترف بأن الانجذاب نحو هذا الخطاب السماوي نور حق لا يقبل المقاومة، ولا يستطيعون له سبيلاً([7]).
فالشعر شعر بلحاظ كونه يتحكم في الشعور، يوجد انفعالات نفسية وهيجاناً روحياً، فله القوة في إيجاد ردات فعل نفسية وفق ما يريد، ونحو الاتجاه الذي يريد. فعندما تلقى القصيدة الشعرية بصوت دافئ، وبنغمات رقيقة تسحر القلوب وتخلق جلبة، تؤثِّر بشكل عميق على القلوب، وبالتالي على العقول.
فمن خصوصيات الشعر التي تميزه عن باقي الصناعات الكلامية طرق نظمه وتأليفه، ونمطه وبنيته الأساسية، ونغماته وموسيقاه الداخلية، والإيقاع الذي يكون للكلمات التي يتم انتقاؤها، بحيث تضفي روحية خاصة على أبياته وعباراته، فالكلمات تترنح في نغماتها بين الشدة والرقة، وكلٌّ في موضعه المناسب، إلى جانب ما يتناسب معه، بحيث تجد أن الواحد منها يطلب قرب الآخر ووصاله… كل هذه العناصر تتواصل فيما بينها وتلتحم، لتشكل وحدة منسجمة لا مكان للنفور بينها.
فالشعر تنساب عباراته وكلماته كانسياب الماء نحو الوادي، فتراه يسير كالمحتسي كأساً يترنم من الثمالة، إذا لقيه انخفاض أو ارتفاع لامسها بعطف، كلمسة الأم الحنون وجنتي رضيعها، أو كأنه نسيم الصباح ينساب بين الأشجار والأغصان فتبادله الوجد بالهبوب، وتتفتح البراعم لقطرات نداه كأنها ثغر إليه من نشوته يبسم، فتارة كالنسمة وتارة لعوباً، كذلك هو الشعر العذب يملأ تلك القلوب فما يجد منها سوى الخضوع.
القرآن الكريم له مثل ذلك، لكنه أسمى من الشعر، وليس بالشعر، لكنّ له نظماً ليس له أوزان، لكن فواصله سجدت أمامها كل القوافي، وانحنت إكباراً وإجلالاً([8])، وليس بالسجع، هو نثر، وهو قصيدة نثرية، وكلام في شكل السجع، وليس بذلك، له مزايا كل أنواع الكلام، لكن ليس فيه قافية الشعر ولا تكلف السجع، بل نستطيع أن نقول: هو كل ذاك، ويختلف عن كل ذاك، أخذ من النثر جلاله، ومن الشعر جماله ومتعته.
القرآن في سبكه وفي بنائه شيء جديد، وبذلك خلق طفرة في الثقافة العربية، أبهر عقولهم، وأعجز أفواههم، وأعجز من أتى بعدهم ومن سيلحق بهم. فالكل يعترف أن له جاذبية لا تقبل المقاومة، يزرع في النفس الاطمئنان، ويدعو الفطرة، فتجد له معها انسجام، متوافق مع كل ما في الكون، يخاطب الوجدان فلا تجده يلوح له بالأسرار، بل كل شيء فيه ينفتح، فوحده القرآن له مفتاح شفرة الوجدان، كذلك النفس بما هي عليه من الغموض والأسرار لا يملك مفتاحها سوى القرآن، وهو الوحيد الذي يعرف أين وكيف يخاطبها؟ وقد خاطبها في عالم البرزخ فأقرت واعترفت، ويخاطبها في عالم المادة فتنصاع وتلبي داعي الله.
القرآن أكثر نظماً من السجع، وأكثر سحراً من السحر؛ لأن السحر يغالط الخيال بالمغالطات، بينما القرآن يصارح العقل والوجدان باليقين والقطع. لذلك يزول سحر الساحر، وخسر هنالك المبطلون، وتسرمد سحر القرآن، ليرقى بالإنسان نحو الكمال.
ــــــــــــــــــــــــــ
([1]) مسند أحمل بن حنبل 1: 269.
([2]) مستدرك الحاكم النيشابوري 2: 507.
([3]) يرجع إلى: السهيلي، الروض الأنف 2: 21؛ سيرة ابن هشام 1: 288؛ أسد الغابة 2: 90؛ الإصابة 1: 410؛ الاستيعاب في حاشية الإصابة 1: 412؛ تفسير الطبري 29: 98؛ الدر المنثور.
([4]) يرجع إلى: الدراز، النبأ العظيم: 95 ـ 106.
([5]) فصل «المعمار القرآني» في كتاب «محاولة لفهم عصري»، لمحمود مصطفى: 12 ـ 19.
([6]) السيد قطب، التصوير الفني في القرآن: 80.
([7]) الرافعي، إعجاز القرآن: 209 ـ 299.
([8]) أصول الكافي 2: 614، ح8.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 معرفة الإنسان في القرآن (8)
معرفة الإنسان في القرآن (8)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر
-

معنى (ستر) في القرآن الكريم
-

أداء الأمانة والنقد الذاتي في شهر رمضان
-

حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
-
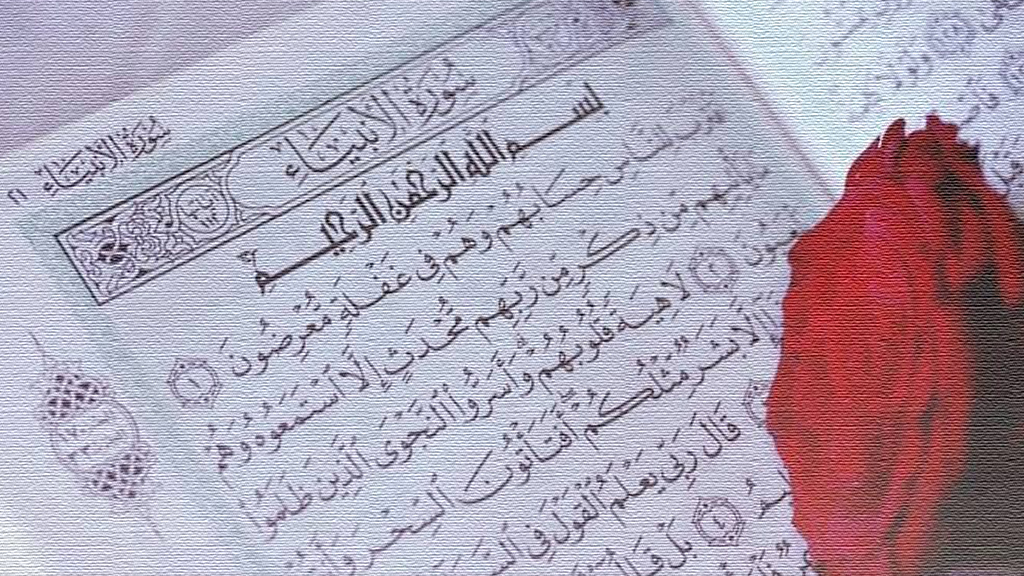
معرفة الإنسان في القرآن (8)
-

شرح دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان
-

خصائص الصيام (2)
-

الإرادة والتوكل في شهر رمضان
-
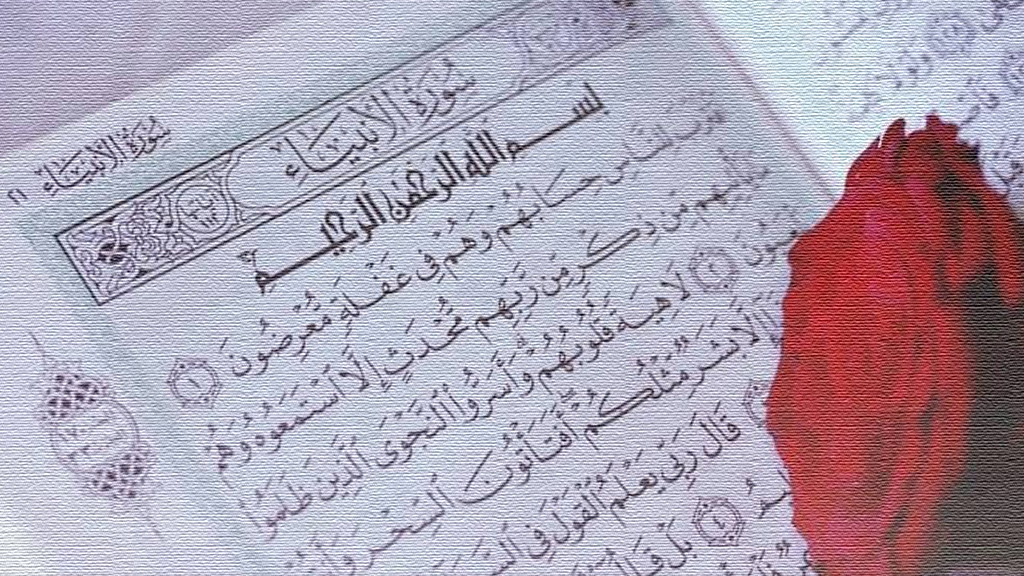
معرفة الإنسان في القرآن (7)
-

شرح دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان










