مقالات
سوء الظن بالخالق والمخلوق

الشيخ محمد مهدي النراقي
وهو من نتائج الجبن وضعف النفس، إذ كل جبان ضعيف النفس تذعن نفسه لكل فكر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه، وقد يترتب عليه الخوف والغم وهو من المهلكات العظيمة، وقد قال الله سبحانه:
"يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثمٌ ". وقال تعالى: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم". وقال: "وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ".
وقال أمير المؤمنين (ع): "ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً". ولا ريب في أن من حكم بظنه على غيره بالشر، بعثه الشيطان على أن يغتابه أو يتوانى في تعظيمه وإكرامه، أو يقصر فيما يلزمه من القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه وكل ذلك من المهلكات. على أن سوء الظن بالناس من لوازم خبث الباطن وقذارته، كما أن حسن الظن من علائم سلامة القلب وطهارته، فكل من يسيء الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعثراتهم فهو خبيث النفس سقيم الفؤاد، وكل من يحسن الظن بهم ويستر عيوبهم فهو سليم الصدر طيب الباطن، فالمؤمن يظهر محاسن أخيه، والمنافق يطلب مساويه، وكل إناء يترشح بما فيه.
والسر في خباثة سوء الظن وتحريمه وصدوره عن خبث الضمير وإغواء الشيطان: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لأحد أن يعتقد في حق غيره سوءاً إلا إذا انكشف له بعيان لا يقبل التأويل، إذ حينئذ لا يمكنه إلاّ يعتقد ما شاهده وعلمه، وأما مالم يشاهده ولم يعلمه ولم يسمعه وإنما وقع في قلبه، فالشيطان ألقاه إليه، فينبغي أن يكذبه، لأنه أفسق الفسقة، وقد قال الله:
"إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ".
فلا يجوز تصديق اللعين في نبأه، وإن حف بقرائن الفساد، ما احتمل التأويل والخلاف فلو رأيت عالـماً في بيت أمير ظالم لا تظنن أن الباعث طلب الحطام المحرمة، لاحتمال كون الباعث إغاثة مظلوم. ولو وجدت رائحة الخمر في فم مسلم فلا تجزمن بشرب الخمر ووجوب الحد، إذ يمكن أنه تمضمض بالخمر ومجه وما شربه، أو شربه إكراهاً وقهراً. فلا يستباح سوء الظن إلا بما يستباح به المال، وهو صريح المشاهدة، أو قيام بينة فاضلة.
ولو أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم، وجب عليك أن تتوقف في إخباره من غير تصديق ولا تكذيب، إذ لو كذبته لكنت خائناً على هذا العدل، إذ ظننت به الكذب، وذلك أيضاً من سوء الظن، وكذا إن ظننت به العداوة أو الحسد أو المقت لتتطرق لأجله التهمة، فترد شهادته، ولو صدقته لكنت خائناً على المسلم المخبر عنه، إذ ظننت به السوء، مع احتمال كون العدل المخبر ساهياً، أو التباس الأمر عليه بحيث لا يكون في أخباره بخلاف الواقع آثماً وفاسقاً. وبالجملة: لا ينبغي أن تحسن الظن بالواحد وتسيء بالآخر، فتذكر المذكور حاله على ما كان في الستر والحجاب، إذ لم ينكشف لك حاله بأحد القواطع، ولا بحجة شرعية يجب قبولها، وتحمل خبر العدل على إمكان تطرق شبهة مجوزة للإخبار، وإن لم يكن مطابقاً للواقع.
ثم المراد بسوء الظن هو عقد القلب وميل النفس دون مجرد الخواطر وحديث النفس، بل الشك أيضاً، إذ المنهي عنه في الآيات والأخبار إنما هو أن يظن، والظن هو الطرف الراجح الموجب لميل النفس إليه. والإمارات التي بها يمتاز العقد عن مجرد الخواطر وحديث النفس، هو أن يتغير القلب منه عما كان من الألف والمحبة إلى الكراهة والنفرة، والجوارح عما كانت عليه من الأفعال اللازمة في المعاشرات إلى خلافها. والدليل على أن المراد هو ما ذكر، قوله (ص): ثلاث في المؤمن لا تستحسن وله منهن مخرج، فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه، أي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل، لا في القلب ولا في الجوارح.
ثم لكون سوء الظن من المهلكات، منع الشرع من التعرض للتهمة، صيانة لنفوس الناس عنه، فقال (ص): "اتقوا مواقع التهم". وقال أمير المؤمنين (ع): "من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن". وروى: "أنه (ص) كان يكلم زوجته صفية بنت حي ابن أخطب، فمر به رجل من الأنصار، فدعاه رسول الله، وقال: يا فلان! هذه زوجتي صفية. فقال: يا رسول الله أفنظن بك إلا خيراً؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يدخل عليك "فانظر كيف أشفق رسول الله (ص) على دينه فحرسه وكيف علم الأمة طريق الاحتراز عن التهمة، حتى لا يظن العالم الورع المعروف بالتقوى والدين أن الناس لا يظنون به إلا خيراً، إعجاباً منه بنفسه، فإن ما لا جزم بتحققه في حق سيد الرسل وأشرفهم، فكيف يجزم بتحققه في حق غيره، وإن بلغ من العلم والورع ما بلغ. والسر في ذلك: أن أورع الناس وأفضلهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل إن نظر إليه بعضهم بعين الرضا ينظر إليه بعض آخر بعين السخط:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
فكل عدو وحاسد لا ينظر إلا بعين السخط، فيكتم المحاسن ويطلب المساوي وكل شرير لا يظن بالناس كلهم إلاّ شراً، وكل معيوب مفتضح عند الناس يحب أن يفتضح غيره وتظهر عيوبه عندهم، لأن البلية إذا عمت هانت، ولأن يشتغل الناس به فلا تطول ألسنتهم فيه. فاللازم لكل مؤمن ألا يتعرض لموضع التهمة حتى يوقع الناس في المعصية بسوء الظن، فيكون شريكاً في معصيتهم، إذ كل من كان سبباً لمعصية غيره يكون شريكاً له في هذه المعصية. ولذا قال الله تعالى:
"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علمٍ".
وقال رسول الله (ص): " كيف ترون من يسب أبويه؟ فقالوا: هل من أحد يسب أبويه؟ فقال: نعم! يسب أبوي غيره فيسبون أبويه".
ثم طريق المعالجة في إزالته ـ بعد تذكر ما تقدم من فساده وما يأتي من فضيلة ضده ـ أنه إذا خطر لك خاطر سوء على مسلم، لا تتبعه، ولا تحققه ولا تغير قلبك عما كان عليه بالنسبة إليه، من المراعاة والتفقد والإكرام والاعتماد بسببه، بل ينبغي أن تزيد في مراعاته وإعظامه وتدعو له بالخير، فإن ذلك يقنط الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقى إليك خاطر السوء خوفاً من اشتغالك بالدعاء وزيادة الإكرام. ومهما عرفت عثرة من مسلم فانصحه في السر ولا تبادر إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على عيبه، لتنظر إليه بعين الحقارة، مع أنه ينظر إليك بعين التعظيم، بل ينبغي أن يكون قصدك استخلاصه من الإثم، وتكون محزوناً كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان، وينبغي أن يكون تركه ذلك العيب من غير نصيحتك أحب إليك من تركه بنصيحتك، وإذا فعلت ذلك جمعت بين أجر نصيحته وأجر الحزن بمصيبته وأجر الإعانة على آخرته.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم
أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 باسم الله دائمًا وأبدًا
باسم الله دائمًا وأبدًا
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 لا تستسلم وحقّق أهدافك
لا تستسلم وحقّق أهدافك
عبدالعزيز آل زايد
-
 مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها
مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها
عدنان الحاجي
-
 أيّ نوع من المربّين أنت؟
أيّ نوع من المربّين أنت؟
السيد عباس نور الدين
-
 كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)
كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
 معنى (هنأ) في القرآن الكريم
معنى (هنأ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 المنّ يزيل الأجر
المنّ يزيل الأجر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية
الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية
محمود حيدر
-
 أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟
أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟
الشيخ علي رضا بناهيان
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

(مشكاة العظمة.. الأمين الهادي والهداة من آله) كتاب للشّيخ باقر أبو خمسين
-
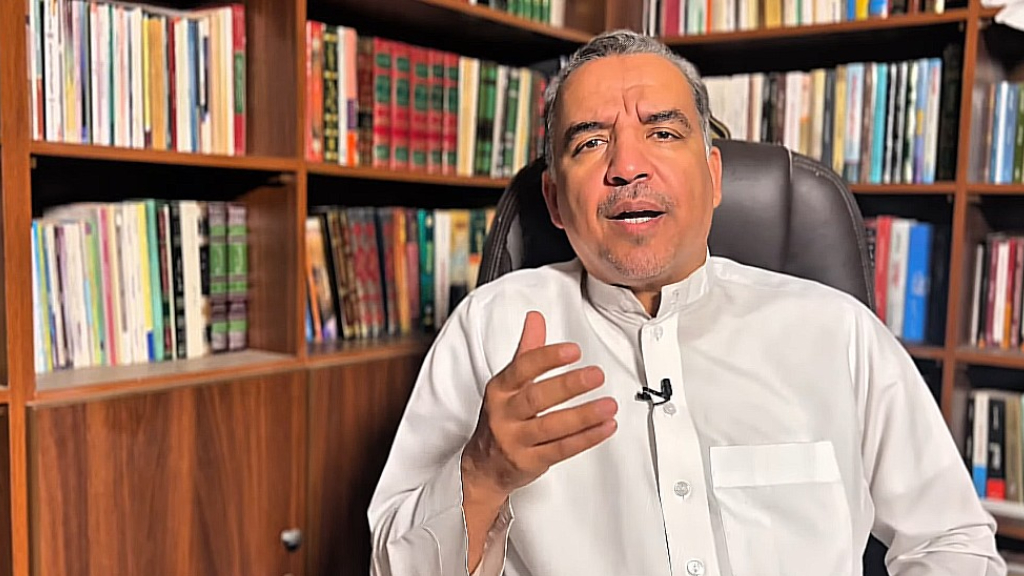
زكي السالم: (كيف تفصّل قصيدتك على مقاس المسابقات)
-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم
-

باسم الله دائمًا وأبدًا
-
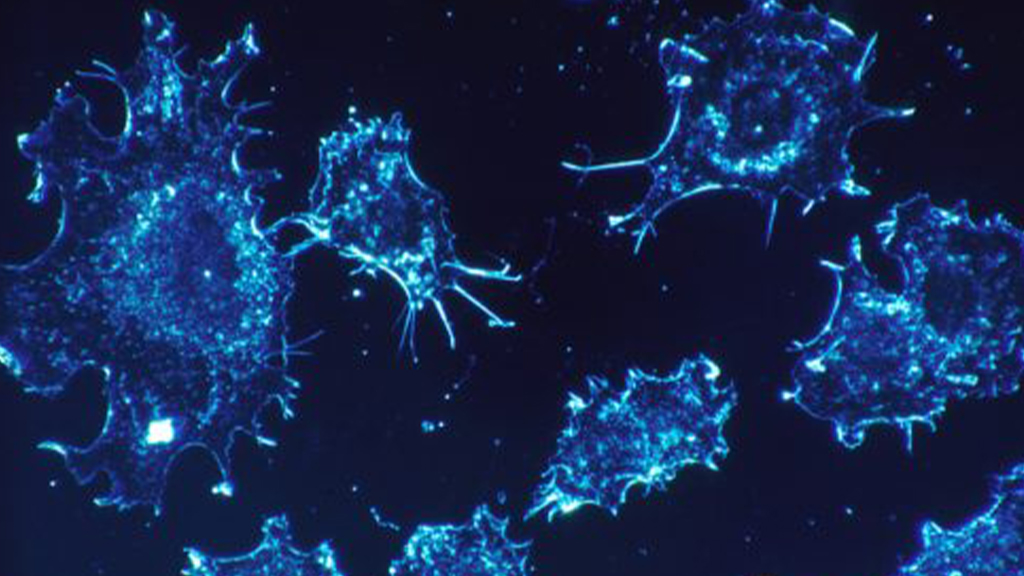
اختبار غير جراحي للكشف عن الخلايا السرطانية وتحديد موقعها
-

أمسية أدبيّة لغويّة بعنوان: جمال التراكيب البلاغية، رحلة في أسرار اللغة
-

لا تستسلم وحقّق أهدافك
-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها
-

أيّ نوع من المربّين أنت؟
-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)









