مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالقانون والإيمان باللّه

لا يستطيع الإنسان أن يبلغ كماله النوعي ويكون سعيدًا في حياته إلّا إذا اشترك مع الآخرين في الاجتماع الإنساني، بحيث يتعاون مع الباقين في الاضطلاع بإنجاز مهمات الحياة، هذه المهام التي بلغت قدرًا من التشعّب والتّعقيد بحيث يعجز الإنسان عن النهوض بها بمفرده.
إنّ هذا الباعث يجعل الإنسان الاجتماعي بحاجة إلى ضوابط وقوانين تحفظ حقوق الأفراد، وتجعل حظ كل واحد منهم ونصيبه من المزايا الاجتماعية محددًا واضحًا. فالأشخاص يعملون بما يتناسب مع طاقتهم، ثم توزّع ثمار الأعمال بينهم، بحيث يستفيد كل إنسان من أعمال الآخرين بما يتناسب مع قيمة عمله ووزنه الاجتماعي، من دون ظلم واستضعاف ينتجان عن التعسف في استخدام القوة أو العجز عن نيل الحق المقرّر.
ومن الطبيعي أنّ هذه القوانين والضوابط لا تكون مؤثرة إلّا إذا كان وراءها مجموعة أخرى من النظم والقوانين الجزائية التي تهدّد المتخلف بالعقاب وتعد الملتزم بالثواب. ووجود النظم الجزائية لا يكفي في حماية المجموعة الأولى من القوانين إلّا إذا ترافق مع سلطة تتسم بالعدل ولها قوة النفوذ على المجتمع بأسره.
بيد أنّ المشكلة لا تحل حتى مع توافر هذه المستلزمات، لأنّ القوة التنفيذية لن يكون بمقدورها أن تنزل العقاب بالمجرم إلّا إذا عرفت بالجرم وأحاطت به وكان لها القدرة على العقاب. أما إذا ارتكب الإنسان الجرم من دون أن يطلع عليه أحد (ومثل هذه الجرائم التي لا يطلع عليها أحد ليس قليلاً) فلن يكون ثمة ما يحول دون ارتكاب الجريمة بعد أن أضحى المجرم قادرًا على الانفلات من الجزاء من زاوية عدم إحاطة القوة التنفيذية بجرمه وعدم معرفتها به.
ويمكن أن نتصوّر أيضًا شيوع التخلف عن القانون وظهور حالات التعدّي على حقوق الآخرين في الوقت الذي لا يكون فيه للحكومة عناصر تنفيذية كافية للتصدّي للمتخلفين عن القانون ومجازاتهم، أو حين تميل إلى الضعف أو إظهار الميوعة في تنفيذ القوانين. فالإنسان حينئذ سيتحرك لجلب المنافع إلى نفسه حتى لو كان في ذلك ضرر على الآخرين، لأنّه ميّال لتحصيل النفع وتسخير جميع الموجودات واستخدامها لما ينفعه.
إنّ البلاء الكبير يمثل في تمركز جميع القدرات في السلطة التنفيذية ومن يمسك زمام أمرها، بحيث إنّ الاتكاء لهذه القوة المتمركزة الهائلة ينتهي في نهاية المطاف إلى النظر لسائر الناس نظرة تتسم بالاستضعاف، بحيث لن تبقى ثمة قوة بمقدورها أن تعدّل إرادة السلطة التنفيذية ومن يمسك بزمامها، مما يحوّل إرادة هذه السلطة والقيّمين عليها إلى إرادة مطلقة حاكمة على الجميع.
التأريخ مليء بنماذج لهؤلاء الطغاة الجبارين الذين أخضعوا الناس لإرادتهم المطلقة دون حق، وأشادوا وجودهم على أساس البطش والظلم، ولا يزال المسرح الإنساني يزخر بأمثلة كثيرة لهؤلاء الطغاة. نخلص مما مرّ أنّ القوانين والضوابط مهما اتسمت بالعدالة، ومهما كان من ورائها من نظم جزائية متشدّدة، فإنها لا تستطيع أن تحول دون التخلف عن القانون وارتكاب الجريمة، إذا لم تعضد بسند من الأخلاق الإنسانية الفاضلة تحميها وتشدّ من أزرها.
ويجب أن لا تخدعنا في هذا المقام النظم والعدالة السائدة في بعض الأمم المتقدمة بحيث نحسب أنّ القوانين والضوابط هي التي أثمرت استقرار العدالة. والسبب في ذلك أن طراز تفكير تلك الأمم يختلف عن طراز تفكير الآخرين، فأولئك يفكرون بطريقة اجتماعية، بحيث يعتبرون أنّ الخير والشر الفردي الذي يصيبهم معيار للخير والشر الاجتماعي.
بيد أن هؤلاء أنفسهم لا يتوانون عن استغلال الأمم الضعيفة واستعمار البلاد المتخلفة، وفي الوقت الذي يتظاهرون بالعدل تراهم ينزلون بالأمم التي تحت سيطرتهم ما كان ينزله العتاة والجبارون الماضون بالأفراد. وإذا كان ثمة فارق بين الماضي والحاضر، فإنّ المتظاهرين بالعدل راهنًا يسومون المجتمعات ظلمًا بعد أن كان ينزل سابقًا بالأفراد. بالإضافة إلى ما أصاب الألفاظ من تغيّر فاحش في معانيها بحيث أخذت تطلق على أضدادها، إذ أضحت مصطلحات الحرية والشرف والعدالة والفضيلة، تطلق على أشياء وممارسات هي في واقعها مصداق للعبودية والذل والظلم والرذيلة.
وما نخلص لتأكيده هو هذه الجدلية بين القانون والأخلاق والعقيدة. فالقوانين والضوابط لا تملك عادة ما يضمن لها عدم التخلف إلّا إذا استندت إلى قاعدة الأخلاق الإنسانية الفاضلة. والأخلاق لا يمكن أن تحقق سعادة الإنسان وتدفعه للنهوض بالأعمال اللائقة إلّا إذا استندت إلى التوحيد. فالتوحيد يوفر اعتقادًا للإنسان بأنّه والعالم الذي يعيش فيه لهما خالق واحد كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد؛ لا يعزب عن علمه ولا يخفى عنه شيء؛ قدرته مبسوطة وظاهرة على كلّ شيء؛ وهو (سبحانه) خلق الأشياء على أحسن شكل وأفضل نظام دون حاجة منه إليها، وأخيرًا سيكون المنتهى إليه، حيث يرجع إليه الجميع فيجازي المحسن ويكون في نعمة دائمة أبدية ويعاقب المسيء فيكون في عذاب دائم مخلّد.
حين تقوم الأخلاق على مثل هذه القاعدة العقيدية الصلبة لا يبقى أمام الإنسان إلّا أن يراقب في أعماله رضا اللّه بحيث تحرسه تقواه عن ارتكاب الحرام. أما إذا قامت الأخلاق على غير هذا الأساس العقيدي فلن يكون أمام الإنسان من هدف سوى أن ينتفع من لذائذ الدنيا العابرة، ولن يكون - لمنافعه - حدّ يرضخ إليه ولا يتخطاه؛ إلّا الحدود التي تضمن بقاء المجتمع ككل، ولن يقف إلّا بما يعود إليه بثناء الآخرين ومدحهم بحيث يكون له الذكر الحسن بعد موته، حتى يكتب اسمه على صفحات التأريخ الذهبية.
ولكن مدح الناس وثناءهم لا يطال إلّا الأمور والأعمال التي عرفوها عن الإنسان علنًا وجهرًا، لذلك لا يصلح أن يكون باعثًا لكي يقدم الإنسان على الأعمال الحسنة ويترك الأعمال السيئة في حالات السرّ والخفاء. أما ما يقال عن الأعمال التي تخلد اسم الإنسان بعد موته وتبعث على اللذة - وهذه ترتبط في الغالب بما يبذله من تضحية للوطن وبذل وعطاء للنظام - فهي لا تنطوي بالنسبة لمن لا يؤمن بالحياة بعد الموت، سوى على عقيدة وهمية خرافية سرعان ما تذوي وتزول بانتباهة يسيرة.
فأولًا، كيف يلتذ الإنسان بعد موته، وقد حل به الفناء، بمدح يأتيه من الناس أو ثناء يلحقه منهم؟ وثانيًا، أيّ عاقل مستعدّ للتضحية بحياته وسعادته في سبيل أن يدخل البهجة على الآخرين، ومن دون أن يحصد أدنى فائدة ونفع لنفسه؟ وهكذا نستنتج أنّ مثل هذه الأمور - البواعث - ليس لها قيمة إزاء باعث التوحيد والإيمان باللّه، وهي في الوقت نفسه لا تستطيع أن تردع عن ارتكاب الذنب أو تحول دون التخلّف عن القوانين والأنظمة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
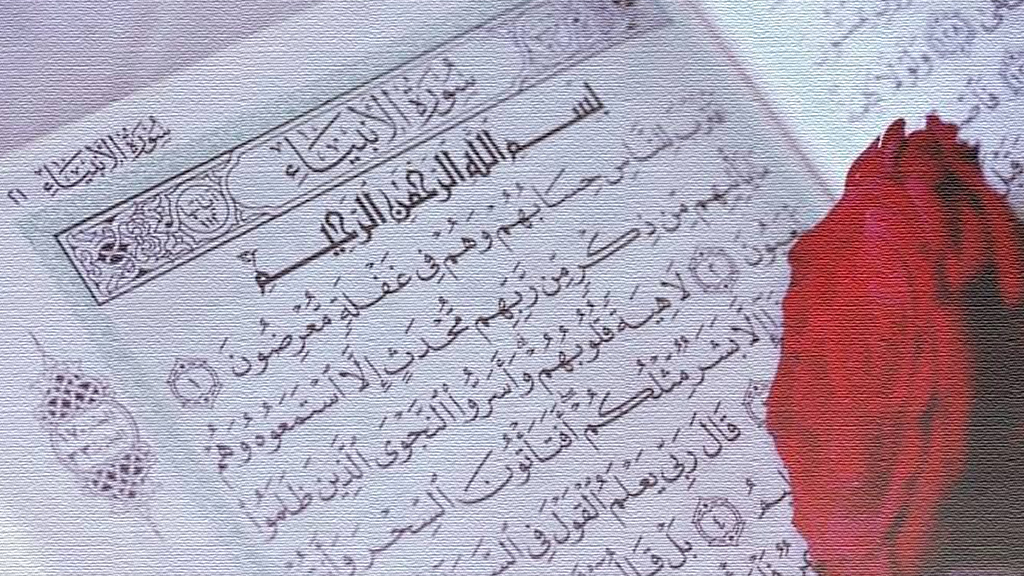
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










