فجر الجمعة
الشيخ عبد الجليل الزاكي: الاستبشار الإلهي بثلاثة أصناف من العباد

عنوان الخطبة: الاستبشار الإلهي بثلاثة أصناف من العباد
الخطيب: الشيخ عبد الجليل الزاكي
المكان: مسجد عيد الغدير بسيهات
التاريخ: الجمعة ٤ أبريل ٢٠٢٥م – الموافق ٥ شوال ١٤٤٦هـ
أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم.
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم.
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حمدًا لا انقطاعَ له إلا برضاه، وبعد الرضا، الحمدُ للهِ من أوّلِ الدنيا إلى فنائِها، ومن الآخرةِ إلى أبدِ الآخرة، الحمدُ للهِ على كلِّ نعمة.
أستغفرُ اللهَ ربّي من كلِّ ذنبٍ وأتوبُ إليه.
ثمّ الصّلاةُ والسلامُ على جميعِ الأنبياءِ والمرسلينَ والأوصياءِ والصالحين، لا سيّما المبعوث رحمةً للعالمين، المسمّى في السماءِ بأحمد، وفي الأرضِ بأبي القاسم المصطفى محمدٍ.
اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد.
وعلى آلِه الطيّبينَ الطاهرينَ المعصومينَ المنتجبين، لا سيّما بقيّةِ اللهِ في الأرضين، صاحبِ العصرِ والزمان، أرواحُنا لِترابِ مقدمهِ الفداء.
اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد.
اللهمّ بلّغ مولايَ صاحبَ الزمان صلواتُ اللهِ عليه عن جميعِ المؤمنينَ والمؤمنات، في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، وبرّها وبحرِها، وسهلِها وجبلِها، حيِّهم وميِّتهم، وعن والديَّ وولدي وعمَّن تعلَّق بي، منَ الصلواتِ والتّحيات، زينةَ عرشِ الله، ومِدادَ كلماته، ومنتهى رضاه، وعددَ ما أحصاه كتابُه، وأحاطَ به علمُه.
اللهمّ إنّي أُجدِّدُ له في هذا اليومِ وفي كلِّ يومٍ عهدًا وعقدًا وبيعةً في عنقي.
اللهمّ كما شرَّفتني بهذا التّشريف، وفضّلتني بهذه الفضيلة، وخصَصتني بهذه النعمة، فصلِّ على مولايَ وسيّدي صاحبِ الزمان، واجعلني من أنصارِه وأعوانِه، والذّابِّينَ عنه، والمستشهدينَ بين يديه، طائعًا غيرَ مُكرَه، في الصفِّ الذي نعتَّ أهلَه في كتابِك، فقلتَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف: 4]، على طاعتِك وطاعةِ رسولِك وآلِه عليهمُ السّلام.
اللهمّ هذه بيعةٌ لك في عنقي إلى يومِ القيامة.
اللهمّ كُن لوليِّك الحُجَّةِ بنِ الحسن، صلواتُك عليه وعلى آبائِه، في هذه السّاعةِ وفي كلِّ ساعة، وليًّا وحافظًا، وقائدًا وناصرًا، ودليلًا وعينًا، حتّى تُسكِنَه أرضَك طوعًا، وتمتِّعَه فيها طويلًا، وامِنُن علينا برضاه، وهبْ لنا رأفَتَهُ ورحمتَه، ودُعاءَه وخيرَه، ما نَنالُ به سعةً من رحمتِك، وفوزًا عندك.
اللهمّ هَبْ لنا رعايتَه، ولُطفَه، ودعاءَه، يا ربَّ العالمين، ولا تحرِمْنا من دعواتِه ولطفِه، يا كريم، ببركةِ الصلاةِ على محمدٍ وآله الطاهرين.
اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد.
فيما وردَ عن النّبيِّ الأكرمِ صلى الله عليه وآله – متابعةً لأحاديثنا في الجمعةِ السّابقة – رُويَ عنه أنه قال: "ثلاثةٌ يحبّهمُ اللهُ، ويضحكُ إليهم، ويستبشرُ بهم: الّذي إذا انكشفتِ الفئةُ، قاتلَ وراءَها بنفسِه للهِ عزَّ وجلَّ، فأمّا أن يُقتلَ، وأمّا أن ينصرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا، كيف صبرَ لي بنفسِه! نفسي نفسي... والّذي له امرأةٌ حسنة، وفراشٌ ليِّنٌ حسن، فيقومُ منَ الليلِ، فيَدَعُ شهوتَه ويذكرني، ولو شاءَ رَقَدَ.
والثالثُ: الّذي كان في سفرٍ، وكان معه رَكْبٌ، فسهروا ثم هجَعوا – أي ناموا – فقامَ في السَّحر، في ضرّاءَ وسرّاء، يعني قامَ للهِ..."
اللهُ العالِمُ – هنا – ليسَ المرادُ الاستمراريّة بهذه الأمور يوميًّا، بل تكفي مرّةٌ واحدةٌ في عمره، أن يقومَ بمثلِ هذا المعنى، فيُستبشرُ به أيضًا.
وفي مقدّمةِ هذه الروايةِ نجد كنايةً، وهذه الكنايةُ موجودةٌ في اللغةِ العربيّةِ، وموجودةٌ في القرآنِ الكريم، كما في قولِه تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]
اللهُ ليسَ لهُ يدٌ مجسّمة، كما قد يذهبُ البعضُ أنّ لهُ يدًا "كما تليقُ بجلالِه" أو غيرِ ذلك.
فمجرّدُ أن تقول: "يدانِ حقيقيّتان"، فقد جسّدته، وإذا جسّدتَ فقد كيفتَه، وجعلتَه محتاجًا، لأنّ كلَّ جزءٍ يحتاجُ إلى غيرِه. {وتعالى اللهُ عن ذلك علوًّا كبيرًا}.
فالمعنى هنا: "يدُ الله فوق أيديهم" كنايةٌ عن السيطرةِ الإلهيّة، والهيمنةِ، والقدرةِ الإلهيّة فوقَ أيديهم.
فهي قدرةُ اللهِ فوق كلِّ قدرة، وفوقَ كلِّ إمكانيّة، وفوقَ كلِّ قوّة.
وكذلك أيضًا "الضّحكُ" الواردُ في هذه الرّواياتِ هو كنايةٌ عن المحبّة، كنايةٌ عن الاستبشار، كنايةٌ عن السّرور، لا أنّه ضحكٌ حسّيّ.
أنّه ماذا؟ يُسرّ لعبدِه، أنّ هذا العبدَ قامَ بمثلِ هذه الأعمال، هؤلاء الثلاثة من الفئات، اللهُ يستبشرُ بهم.
هذا المعنى - "يستبشر بهم" - أي يفرحُ بهم، لا كفرحِك وفرحي، بل استبشارٌ لهم في الحقيقة.
فاللهُ سبحانهُ وتعالى غنيٌّ عن العباد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15] لا يحتاجُ إلى شيء، ولا تضرُّه معصيةُ العصاة، ولا تنفعهُ طاعةُ الطائعين، إنما يُسرّ لعبدِه من أجلِ عبدِه.
قال في الحديث القدسي: "كنتُ كنزًا مخفيًّا، فأحببتُ أن أُعرف، فخلقتُ الخلقَ لكي أُعرف".
حينما نقرأ في القرآنِ الكريم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] أي: ليعرفون.
فحقيقةُ العبادةِ هي المعرفة، ومن خلالِ العبادةِ المعرفيّة، أنتَ تعبدُ اللهَ عن معرفةٍ وبصيرة.
وفي المقابل، تقول الرواياتُ الشريفة: "إنما خلقتُكم لِتربحوا عليَّ، لا لأربحَ عليكم".
فاللهُ لا يحتاجُ لعبادتِك، إنما أنتَ المنتفع.
إذًا، الضحكُ هنا بمعنى الاستبشارِ والسرور من أجلِ العبد، من أجلِ عبدِه.
ألا تستبشرُ - الآن - حينما يعملُ ابنُك عملًا صالحًا، أو ينجحُ في امتحانٍ ما، دنيويًّا أو دينيًّا؟
ألا تشعرُ بالسّرور؟ كذلك ربُّ العالمين.
كما تحزنُ - أيضًا - إذا انحرفَ ابنُك، فالمعنى هنا أنّه سرورٌ من أجلِ عبدِه، لا أنّ اللهَ ينتفعُ أو يتضرّر.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] فاللهُ يستبشرُ بهؤلاءِ العبادِ لأنهم عملوا الصّالحات في أحلكِ الظروف، ومع ذلك لم ينسوا ربَّهم.
لكن، من هؤلاءِ الثلاثة؟ انظروا، أول فئةٍ أمرُها صعبٌ جدًّا، ليس من السهل.
وهو الّذي يكونُ في ميادينِ القتال، فتنفرُ الجماعةُ من الزحف، ويولّونَ الأدبار، ويبقى هو وحدَه يقاتلُ في سبيلِ اللهِ عزّ وجلّ.
فإمّا أن يُقتل، وإمّا أن ينصرَهُ اللهُ عزّ وجلّ ويكفيه، فيقول اللهُ عزّ وجلّ: "انظروا إلى عبدي كيف صبرَ لي نفسَه".
أي صبرَ على الألم، على الجراح، على شدائدِ القتال، في سبيلِ الله.
القومُ هربوا، وهو بقيَ وحيدًا يقاتلُ، هذا موقفٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى توفيقٍ إلهيٍّ كبير.
ولكي ينالَ هذا التوفيق، لا بدَّ أن تكونَ له مقدّماتٌ روحيّةٌ: طاعةٌ لله، معرفةٌ بالله، بصيرةٌ بالدنيا، وبصيرةٌ بالآخرة، التي من أجلِها خُلق.
فمن أجلِ هذهِ الرؤيةِ والبصيرة، يَثبتُ في الميدان، ويفضي به ذلك إلى مقامٍ يستبشرُ به اللهُ سبحانهُ وتعالى، ويُسرّ له.
الفئةُ الثانيةُ: تتعلّقُ بالشباب، خصوصًا حديثي العهدِ بالزواج.
هو الذي يقومُ من الليل، فيدع شهوته، ويقول: "يا رب، أريد أن أناجيك".
يقفُ بين يدي اللهِ سبحانهُ وتعالى، رغم أنّه على فراشٍ مريح، وبين يديه زوجته، ويملكُ ما يُشتهى... ومع ذلك يذرُ كلَّ ذلك، ليقفَ بين يدي ربّه.
أرأيتم حنظلة؟ لماذا سُمّي غسيلَ الملائكة؟ كان في ليلةِ زواجه، وسمعَ نداءَ النبيِّ، فهبّ مسرعًا للقتال، ولم يغتسل بعد، فاستُشهد، فغسلَتهُ الملائكة.
وهذا هو حالُ أصحابِ الحسينِ عليه السلام كذلك، مثل "الأنصاري" الّذي كان نصرانيًّا فأسلم، وترك زوجتَه، وكان حديثَ عهدٍ بالزواج، ثم قاتلَ واستُشهد.
من قامَ اللّيل في هذا الوضع، وفضّل مناجاةَ اللهِ على شهوته، فإنّ اللهَ يستبشرُ به، لأنّه فضّل لقاءَ الله على متعةِ الدنيا، وتركَ الترفيهَ من أجلِ الطاعة. هذا أيضًا يستبشرُ اللهُ به.
الفئةُ الثالثةُ: عبدٌ بابُه مفتوحٌ، لا فرق فيه بين شابٍّ أو شيخ. مثلُ "الديوانية"، لكن ليست كالديوانياتِ المعتادة التي يُقصدُ فيها اللغوُ واللهو، بل المقصودُ هنا مَن يفتحُ بابَهُ للهِ في كلِّ حال.
هو في سفرٍ مع جماعة، ناموا بعد السّهر، وهو قامَ في السَّحر ليناجي ربَّه، سواءٌ كان في بلدانٍ غربيّة، أو أجواءٍ بعيدةٍ عن الإيمان، لكنه ثبت، وقام للهِ في تلك اللحظة. هو الوحيدُ الذي اختارَ اللهَ في وقتٍ الجميعُ فيه غارقٌ في نومِه أو لهوه.
هنا يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وآله: "يضحك اللهُ إليه، ويستبشر به، ويباهي به". وهذه مباهاة إلهيّة بعبدٍ، اختار مناجاةَ اللهِ في وقتٍ لا أحدَ يفعل ذلك من حوله.
وإن ربّ العالمين، إذا نظرَ إلى منظرٍ كهذا، يفرحُ ويستبشرُ ويُسرّ، ولهذا العبد من الجوائز ما لا يخطرُ على قلبِ بشر. كما نفرحُ نحن بنجاحِ أولادِنا، أو بعملهم الصالح، ونكافئهم، كذلك الله يُكرمُ عبدَه حين يُقبلُ عليه بإخلاص.
وإذا كان الأبُ يُكافئُ ابنَهُ بهديةٍ بسيطة، فاللهُ سبحانهُ وتعالى بيده خزائنُ السماواتِ والأرض، ويُكرمُ عبدَه بما لا يُقارن. ففرحُه بعبده - إن صحَّ التعبير - هو تكريمٌ للعبد، لا حاجة منه إليه.
لذا ينبغي للمؤمن أن يسعى ليكون من هذه الأصناف الثلاثة ولو مرّةً واحدةً في العمر. فمن ذاقَ لذّةَ المناجاةِ الإلهيّة، لا يستطيعُ بعدها أن يستغني عنها.
هو قد تعرّضَ لنورِ الله، فأشرقَ عليه النورُ، وعلى قلبه وروحه، وتغيّر وجهُه بنورِ الإيمان. قال الإمام: قد لا يكونُ أبيضَ الوجهِ، لكنّ وجهه متلألئٌ بالنور، لأنّه تعرّضَ لنورِ الله. ولذلك قال اللهُ سبحانهُ وتعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: 26]
انظر إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله، خذ القرآنَ كدستور، وتشبّهْ به، ولو بما تستطيع، ولو بالقليل. قال تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 2–4] الليلُ فيه ثقل، نعم، لكنّه أيضًا أشدُّ وطأةً على النفس، وأعمقُ في التأثير.
قال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 6] ربّما لا تستطيع أن تقرأ كثيرًا، فاقرأ صفحة، رتّل آية، المهم أن تنشئ علاقةً مع الله سبحانه وتعالى.
ثمّ يقول الله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾، والسجودُ - مع كونه خضوعًا - هو في ذاته ارتقاءٌ وسموٌّ، فهو يُوصلك إلى العرش، إلى الرضا الإلهي. هي سجدةٌ ترفعُك، لا تُنزلُك، على خلاف كلِّ الاحتمالاتِ الماديّة. ويقول تعالى أيضًا: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: 17]
ومن مصاديق هذا الاستغفار، ما ورد عن الإمامِ الصادق عليه السلام، أنّه قال: "من قال في وتره إذا أوتر: أستغفرُ اللهَ ربّي وأتوبُ إليه، سبعين مرّة، وواظبَ على ذلك حتّى تمضيَ سنة، كتبَهُ اللهُ عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة". وفي رواية أخرى: "...وهو قائم".
ولا ننسى أنّ هناك محطة استغفارية نهاريّة، كما في الروايات، وهي بعد صلاة العصر.
فهاتان محطّتان:
محطة ليلية
محطة نهارية
كأنّك تستحمّ - تعبيريًّا - صباحًا ومساءً، فتزيل أدران الذنوب، وتبقى في حالة نقاءٍ روحيٍّ دائم. لكن بشرطها وشروطها، لا أن تلتزم بها يومًا أو يومين فقط، بل استمرّ.
استغفر سبعين مرة بعد العصر، وسبعين مرة في صلاة الوتر، فهذا يغسل قلبك، ويطهّر روحك. فحافظوا على هاتين المحطّتين: محطة الاستغفار الليلي، ومحطة الاستغفار النهاري.
لكن تذكّروا: الأمور لها شروط. كما ذكر الإمام عليه السلام: "سبعين مرة، وهو قائم، ومواظب، حتى تمضي سنة...". عندئذٍ يُكتبُ عند الله عزّ وجل من "المستغفرين بالأسحار". وهنا يوجب الله سبحانه وتعالى له مغفرتَه، وهذه من أعظم بركات صلاة الليل.
في الروايات: "من أراد الدنيا، فعليه بصلاة الليل. ومن أراد الآخرة، فعليه بصلاة الليل".
تركيزٌ شديدٌ على هذا المعنى العظيم، حيث تأتي المناجاة: "أناجيك يا موجودًا في كلِّ مكان، لعلّك تسمعُ ندائي، فقد عَظُمَ جُرمي، وقلّ حيائي...". عجيبةٌ هي كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام، في دعاء أبي حمزة الثمالي. اقرأ العبارة الأولى فقط، وستشعرُ بقشعريرةٍ تهزّ كيانَك: "إلهي، لا تُؤدّبني بعقوبتك، ومن أين لي الخير يا ربّ، ولا يكون إلّا من عندك...". هذا التأديب الإلهي أمرٌ عظيمٌ، فكن على حذر أن لا تكونَ موردَ التأديب.
إن حصلت على موضع التأديب، فقد يكون ذلك صعبًا على النفس، لأنه لا يُحتمل بسهولة، ولذلك ابقَ ضمنَ إطار الرحمة الإلهية.
نعم، التأديب قد يكون من مظاهر الرحمة أحيانًا، لكن ليس كلّ أحدٍ يتحمّله. فما الذي يمنع الإنسان من قيام الليل؟ أحد الأسباب الرئيسة: مرض الذنوب والمعاصي. هي التي تحرمه من هذه الميزة الإلهيّة العظيمة.
قال تعالى في آيةٍ عظيمة التأثير: ﴿وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ﴾ [التوبة: 46] تأمّل هذه الآية.
كرهَ اللهُ انبعاثَهم للجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله، بسبب الذنوب، وربما النفاق، فثبّطهم، وقيل لهم: "اقعدوا". يعني قد يُنزلُ اللهُ على أحدِهم النعاسَ كعقوبة، أو يُغلق عليه بابَ الليل، فلا يستطيعُ القيام.
كأنّ ملكًا يمرّ على رؤوسهم ويضربها قائلًا: اقعد.
فربّما ينام الإنسان أكثر من مرّة خلال الليل لقضاء حاجته، لكنه لا يستيقظ لصلاة الليل، لا توقظه منبّهات، ولا حتى زوجته أو العكس، كأنّه مغمًى عليه.
ما الفرق؟ السبب ما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام.
جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: "يا أمير المؤمنين، إنّي قد حُرمتُ قيام الليل!". فقال له الإمام: "أنتَ رجلٌ قد قيّدتكَ ذنوبك".
فالسبب الرئيس غالبًا ما يكون الذنوب والمعاصي، وإن كان أحيانًا قد يكون من باب التأديب الإلهي، لكن الأغلب أن الذنوب تقيّد العبد.
اغتاب إنسانًا؟ ذنب.
نميمة؟ ذنب.
فتنة بين الناس؟ ذنب.
حقد، حسد، بغضاء، افتراء، ظلم... كلّها ذنوبٌ تأكل الحسنات.
وقد يشتكي البعض من تكرار الفشل في حياته، من عمل إلى عمل، ومن خسارة إلى أخرى، من إخفاق إلى إخفاق…
لماذا؟ قد يكون السبب الحقيقي: ذنوبٌ لم يُتَب منها.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: "إنّ الرجلَ ليكذبُ الكذبة، فيُحرَم بها صلاة الليل، فإذا حُرمَ صلاة الليل، حُرِمَ الرزق".
الرزق هنا ليس فقط ماديًّا، بل رزقٌ معنويٌّ وأخرويٌّ أيضًا، فيُحرَم كلّ ذلك بسبب ذنبٍ واحد.
فالتوصيات العملية لقيام الليل، وكيفية المحافظة عليه، وماذا يصنع الإنسان لو لم يتمكن من القيام - سنتناولها في حديثٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى.
والحمد لله ربّ العالمين.
اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد.
اللهمّ كُن لوليِّك الحُجّةِ بنِ الحسن، صلواتُك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًّا وحافظًا، وقائدًا وناصرًا، ودليلًا وعينًا، حتى تُسكِنَه أرضَك طوعًا، وتمتّعه فيها طويلًا.
اللهمّ فرّج به عنّا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، واقضِ به حوائجهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، وارزقنا وإياهم من الحلال، واشفِ مرضاهم، وارحم موتاهم، وموتى المؤمنين والمؤمنات، وموتى من مات على الإيمان وولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهمّ انصر الإسلام والمسلمين، واقتل الكفر والكفّار والمنافقين، وأيّد المؤمنين بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واحفظهم بحفظك، وارحمنا برحمتك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا [النصر: 1–3]
صدق الله العلي العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (خفى) في القرآن الكريم
معنى (خفى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 التجارة حسب الرؤية القرآنية
التجارة حسب الرؤية القرآنية
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك
مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)
اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)
الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)
محمود حيدر
-
 كيف تُرفع الحجب؟
كيف تُرفع الحجب؟
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب
عدنان الحاجي
-
 الدّين وعقول النّاس
الدّين وعقول النّاس
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 ذكر الله: أن تراه يراك
ذكر الله: أن تراه يراك
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
الشعراء
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال
حسين حسن آل جامع
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة
-

خلاصة تاريخ اليهود (1)
-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ
-
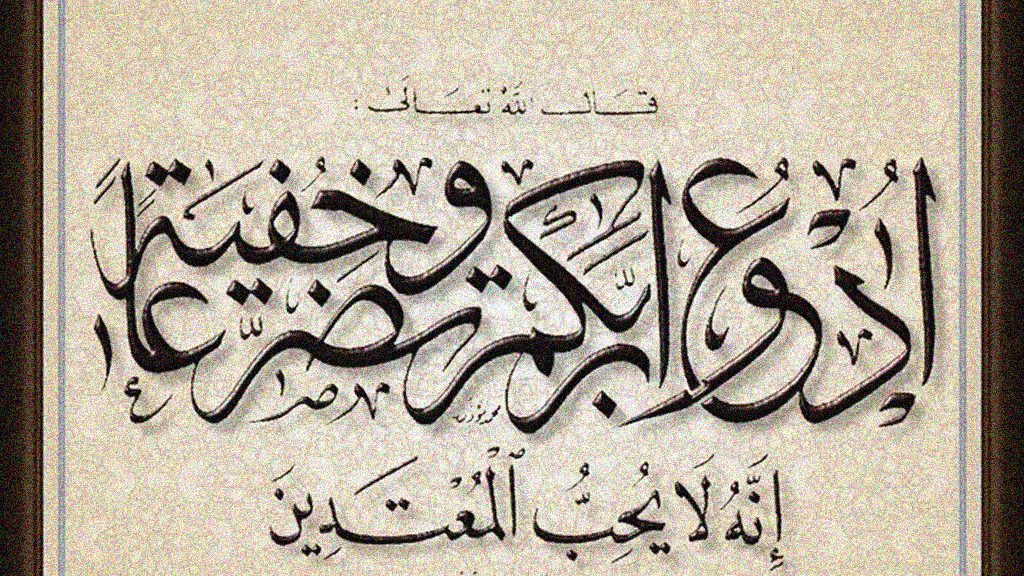
معنى (خفى) في القرآن الكريم
-

التجارة حسب الرؤية القرآنية
-
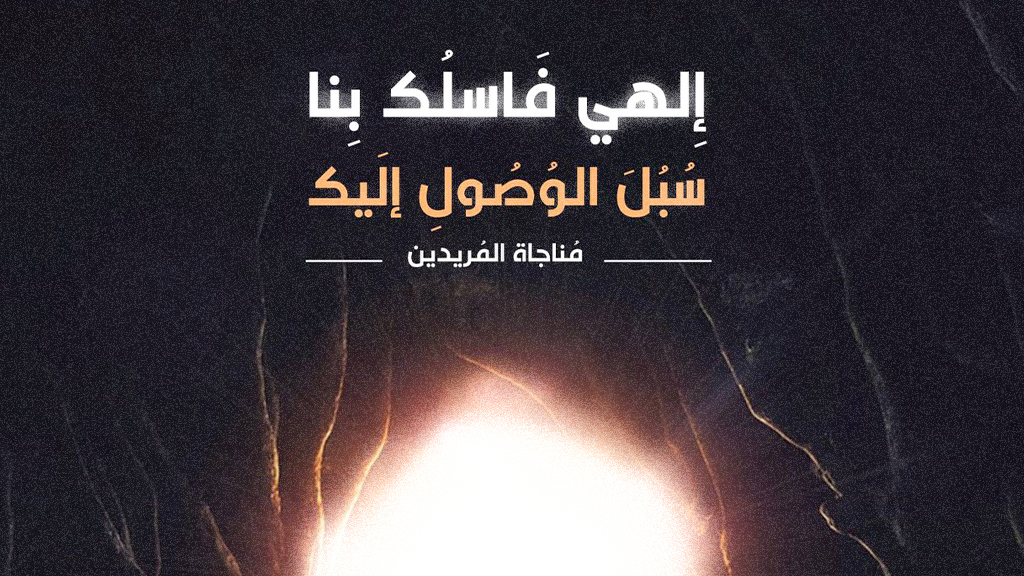
مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك
-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)
-

مواد جديدة تعزّز أداء رقائق ذاكرة الحاسوب
-
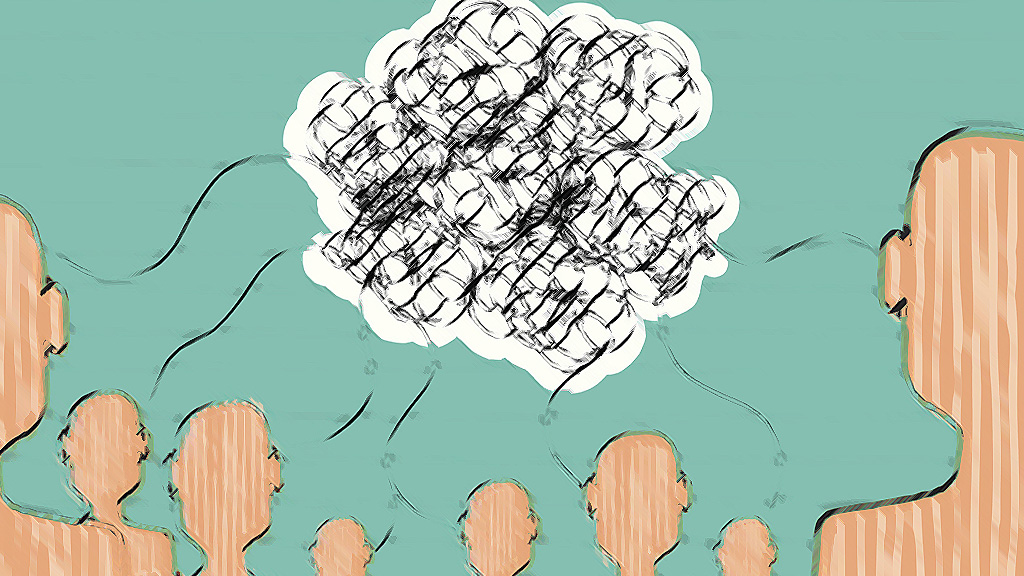
الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)
-

الأسرة والحاجة المعنويّة









