علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :
ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.الحرية في الحضارة الرأسمالية

نشأت الحرية في الحضارة الرأسمالية تحت ظلال الشك الجارف المرير، الذي سيطر على تيارات التفكير الأوروبي كافة، نتيجة للثورات الفكرية التي تعاقبت في فجر تاريخ أوروبا الحديثة، وزلزلت دعائم العقلية الغربية كلها.
فقد بدأت أصنام التفكير الأوروبي تتهاوى الواحد تلو الآخر بسبب الفتوحات الثورية في دنيا العلم، التي طلعت على الإنسان الغربي بمفاهيم جديدة عن الكون والحياة، ونظريات تناقض كل المناقضة بديهياته بالأمس، التي كانت تشكل حجر الزاوية في كيانه الفكري وحياته العقلية والدينية.
وأخذ الإنسان الغربي عبر تلك الثورات الفكرية المتعاقبة ينظر إلى الكون بمنظار جديد، وإلى التراث الفكري الذي خلفته له الإنسانية منذ فجر التاريخ نظرات شك وارتياب. لأنه بدأ يحس أن عالم (كوبر نيكوس) الذي برهن على أن الأرض ليست إلا أحد توابع الشمس، يختلف كل الاختلاف عن العالم التقليدي الذي كان يحدثنا عنه (بطليموس)، وأن الطبيعة التي بدأت تكشف عن أسرارها لجاليليو وأمثاله من العلماء، شيء جديد بالنسبة إلى الصورة التي ورثها عن القديسين والمفكرين السابقين أمثال القديس توماس الأكويني ودانتي وغيرهما.
وهكذا ألقى فجأة وبيد مرعوبة كل بديهياته بالأمس، وأخذ يحاول الخلاص من الإطار الذي عاش فيه آلاف السنين. ولم يقف الشك في موجه الثوري الصاعد عند حد، بل اكتسح في ثورته كل القيم والمفاهيم التي تواضعت عليها الإنسانية وكانت تعتمد عليها في ضبط السلوك وتنظيم الصلات. فما دام الكون الجديد يناقض المفهوم القديم عن العالم، وما دام الإنسان ينظر إلى واقعه ومحيطه من زاوية العلم لا الأساطير فلا بد أن يعاد النظر من جديد في المفهوم الديني، الذي يحدد صلة الإنسان والكون بما وراء الغيب، وبالتالي في كل الأهداف والمثل التي عاشها الإنسان، قبل أن تتبلور نظرته الجديدة إلى نفسه وكونه.
وعلى هذا الأساس واجه دين الإنسان الغربي محنة الشك الحديث، وهو لا يرتكز إلا على رصيد عاطفي، بدأ ينضب بسبب من طغيان الكنيسة وجبروتها. فكان من الطبيعي أيضًا أن تذوب في أعقاب هذه الهزيمة كل القواعد الخلقية، والقيم والمثل التي كانت تحدد من سلوك الإنسان، وتخفف من غلوائه. لأن الأخلاق مرتبطة بالدين في حياة الإنسانية كلها، فإذا فقدت رصيدها الديني الذي يمدها بالقيمة الحقيقية، ويربطها بعالم الغيب وعالم الجزاء أصبحت خواء وضريبة لا مبرر لها. والتاريخ يبرز هذه الحقيقة دائمًا، فقد كفر السفسطائيون الإغريق بالآلهية على أساس من الشك السفسطي، فرفضوا القيود الخلقية وتمردوا عليها، وأعاد الإنسان الغربي القصة من جديد، حين التهم الشك الحديث عقيدته الدينية، فثار على كل مقررات السلوك والاعتبارات الخلقية وأصبحت هذه المقررات والسلوك مرتبطة في نظره بمرحلة غابرة من تاريخ الإنسانية. وانطلق الإنسان الغربي كما يحلو له يتصرف وفقًا لهواه، ويملأ رئتيه بالهواء الطلق الذي احتل الشك الحديث فيه موضع القيم والقواعد حين كانت تقيد الإنسان في سلوكه الداخلي وتصرفاته.
ومن هنا ولدت فكرة الحرية الفكرية والحرية الشخصية: فقد جاءت فكرة الحرية الفكرية نتيجة للشك الثوري والقلق العقلي، الذي عصف بكل المسلمات الفكرية، فلم تعد هناك حقائق عليا لا يباح إنكارها ما دام الشك يمتد إلى كل المجالات.
وجاءت فكرة الحرية الشخصية تعبيرًا عن النتائج السلبية التي انتهى إليها الشك الحديث في معركته الفكرية مع الإيمان والأخلاق، فقد كان طبيعيًّا للإنسان الذي انتصر على إيمانه وأخلاقه أن يؤمن بحريته الشخصية، ويرفض أي قوة تحدد سلوكه وتملك إرادته.
بهذا التسلسل انتقل الإنسان الحديث من الشك، إلى الحرية الفكرية، وبالتالي إلى الحرية الشخصية. وهنا جاء دور الحرية الاقتصادية، لتشكل حلقة جديدة من هذا التسلسل الحضاري: فإن الإنسان الحديث بعد أن آمن بحريته الشخصية، وبدأ يضع أهدافه وقيمه على هذا الأساس، وبعد أن كفر عمليًّا بالنظرة الدينية إلى الحياة والكون وصلتها الروحية بالخالق وما ينتظر الإنسان من ثواب وعقاب عادت الحياة في نظره فرصة للظفر بأكبر نصيب ممكن من اللذة والمتعة المادية، التي لا يمكن أن تحصل إلا عن طريق المال.
وهكذا عاد المال المفتاح السحري والهدف، الذي يعمل لأجله الإنسان الحديث، الذي يتمتع بالحرية الكاملة في سلوكه. وكان ضروريًّا لأجل ذلك أن توطد دعائم الحرية الاقتصادية، وتفتح كل المجالات بين يدي هذا الكائن الحر للعمل في سبيل هذا الهدف الجديد (المال) الذي أقامته الحضارة الغربية صنما جديدا للإنسانية، وأصبحت كل تضحية يقدمها الإنسان في هذا المضمار عملًا شريفًا وقربانًا مقبولًا، وطغى الدافع الاقتصادي كلما ابتعد ركب الحضارة الحديثة، عن المقولات الروحية والفكرية التي رفضها في بداية الطريق، واستفحلت شهوة المال فأصبح سيد الموقف، واختفت مفاهيم الخير والفضيلة والدين، حتى خيل للماركسية في أزمة من أزمات الحضارة الغربية أن الدافع الاقتصادي هو المحرك الذي يوجه تاريخ الإنسان في كل العصور.
ولم يكن من الممكن أن تنفصل فكرة الحرية الاقتصادية عن فكرة أخرى، وهي فكرة الحرية السياسية، لأن الشرط الضروري لممارسة النشاط الحر على المسرح الاقتصادي، إزاحة العقبات السياسية والتغلب على الصعاب التي تضعها السلطة الحاكمة أمامه وذلك بامتلاك أداة الحكم وتأميمها، ليطمئن الفرد إلى عدم وجود قوة تحول بينه وبين مكاسبه وأهدافه التي يسعى إليها.
وبذلك اكتملت المعالم الرئيسية أو الحلقات الأساسية، التي ألف الإنسان الغربي منها حضارته، وعمل مخلصًا لإقامة حياته على أساسها، وتبنى دعوة العالم إليها. وعلى هذا الضوء نتبين الحرية في هذه الحضارة بملامحها... فهي ظاهرة حضارية بدأت شكًّا مرًّا قلقًا، وانتهت إلى إيمان مذهبي بالحرية، وهي تعبير عن إيمان الإنسان الغربي بسيطرته على نفسه وامتلاكه لإرادته بعد أن رفض خضوعه لكل قوة. فلا تعني الحرية في الديمقراطية الرأسمالية رفض سيطرة الآخرين فحسب، بل تعني أكثر من هذا سيطرة الإنسان على نفسه وانقطاع صلته عمليًّا بخالقه وآخرته.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (12)
معرفة الإنسان في القرآن (12)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 عروج في محراب الشّهادة
عروج في محراب الشّهادة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

من لركن الدين بغيًا هدما
-

عروج في محراب الشّهادة
-

ليلة الجرح
-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق
-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)
-

شهر الصبر
-

معنى قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ..}
-
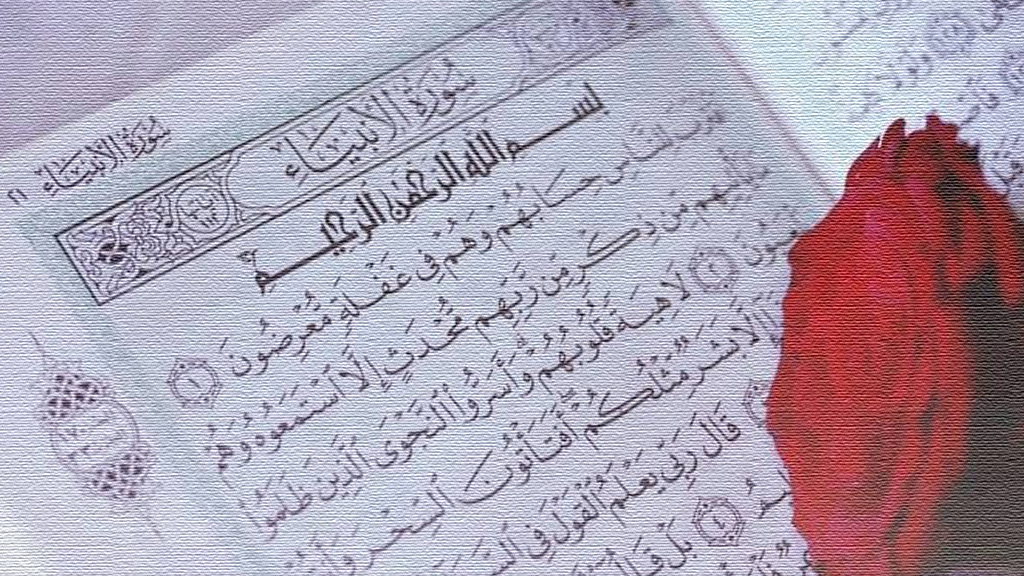
معرفة الإنسان في القرآن (12)
-

شرح دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان
-

مركّباتٌ تكشف عن تآزر قويّ مضادّ للالتهاب في الخلايا المناعيّة










