قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيممعنى العذاب في القرآن

القرآن يعدّ معيشة الناسي لربّه ضنكاً وإن اتّسعت في أعيننا كلّ الاتّساع. قال تعالى: (من أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكاً) طه - 124، ويعدّ الأموال والأولاد عذاباً وإن كنّا نعدّها نعمه هنيئة. قال تعالى: (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنّما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) التوبة - 85.
وحقيقة الأمر كما مرّ إجمال بيانه في تفسير قوله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة) البقرة – 35، أنّ سرور الإنسان وغمّه وفرحه وحزنه ورغبته ورهبته وتعذّبه وتنعّمه كلّ ذلك يدور مدار ما يراه سعادة أو شقاوة هذا أوّلاً. وأنّ النعمة والعذاب وما يقاربهما من الأمور تختلف باختلاف ما تنسب إليه، فللروح سعادة وشقاوة وللجسم سعادة وشقاوة، وكذا للحيوان منهما شيء وللإنسان منهما شيء وهكذا وهذا ثانياً. والإنسان المادّىّ الدنيويّ الّذى لم يتخلّق بأخلاق الله تعالى ولم يتأدّب بأدبه يرى السعادة المادّيّة هي السعادة ولا يعبأ بسعادة الروح وهى السعادة المعنويّة فيتولّع في اقتناء المال والبنين والجاه وبسط السلطة والقدرة. وهو وإن كان يريد من قبل نفس هذا الّذى ناله لكنّه ما كان يريد إلّا الخالص من التنعّم واللذّة على ما صوّرته له خياله وإذا ناله رأى الواحد من اللذّة محفوفاً بالألوف من الألم. فما دام لم ينل ما يريده كان أمنيّة وحسرة وإذا ناله وجده غير ما كان يريده لما يرى فيه من النواقص ويجد معه من الآلام وخذلان الأسباب الّتى ركن إليها ولم يتعلّق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب والسلوة عن كلّ فائتة، فكان أيضاً حسرة فلا يزال فيما وجده متألّماً به معرضاً عنه طالباً لما هو خير منه لعلّه يشفى غليل صدره، وفيما لم يجده متقلّباً بين الآلام والحسرات. فهذا حاله فيما وجده، وذاك حاله فيما فقده.
وأمّا القرآن فإنّه يرى أنّ الإنسان أمر مؤلّف من روح خالد وبدن مادّي متحوّل متغيّر وهو على هذا الحال حتّى يرجع إلى ربّه فيتمّ له الخلود من غير زوال، فما كان فيه سعادة الروح محضاً كالعلم ونحو ذلك فهو من سعادته وما كان فيه سعادة جسمه وروحه معاً كالمال والبنين إذا لم تكن شاغلة عن ذكر الله وموجبة للإخلاد إلى الأرض فهو أيضاً من سعادته ونعمت السعادة. وكذا ما كان فيه شقاء الجسم ونقص لما يتعلّق بالبدن وسعادة الروح الخالد كالقتل في سبيل الله وذهاب المال واليسار لله تعالى فهو أيضاً من سعادته بمنزلة التحمّل لمرّ الدواء ساعة لحيازة الصحّة دهراً.
وأمّا ما فيه سعادة الجسم وشقاء الروح فهو شقاء للإنسان وعذاب له والقرآن يسمّى سعادة الجسم فقط متاعاً قليلاً لا ينبغي أن يعبأ به قال تعالى: (لا يغرّنّك تقلّب الّذين كفروا في البلاد متاع قليل ثمّ مأويهم جهنّم وبئس المهاد) آل عمران - 196، 197.
وكذا ما فيه شقاء الجسم والروح معاً يعدّه القرآن عذاباً كما يعدّونه عذاباً لكن وجه النظر مختلف فإنّه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح وعذاب عندهم لما فيه من شقاء الجسم وذلك كأنواع العذاب النازلة على الأمم السالفة. قال تعالى: (ألم تر كيف فعل ربّك بعاد إرم ذات العماد الّتي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الّذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الّذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبّ عليهم ربّك سوط عذاب إنّ ربّك لبالمرصاد) الفجر - 6، 14.
والسعادة والشقاوة لذوي الشعور يتقوّمان بالشعور والإدراك، فإنّا لا نعدّ الأمر اللذيذ الّذى نلناه ولم نحسّ به سعادة لأنفسنا كما لا نعدّ الأمر المؤلم غير المشعور به شقاءً، ومن هنا يظهر أنّ هذا التعليم القرآنيّ الّذى يسلك في السعادة والشقاوة غير مسلك المادّة والإنسان المولع بالمادّة لا بدّ من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادة الحقيقيّة الّتي يشخّصها القرآن سعادة والشقاوة الحقيقيّة شقاوة، وهو كذلك فإنّه يلقّن على أهله: أن لا يتعلّق قلوبهم بغير الله ويروا أنّ ربّهم هو المالك الّذي يملك كلّ شئ فلا يستقلّ شيء إلّا به ولا يقصد شيء إلّا له.
وهذا الإنسان لا يرى لنفسه في الدنيا إلّا السعادة: بين ما كان فيه سعادة روحه وجسمه، وما كان فيه سعادة روحه محضاً وأمّا ما دون ذلك فإنّه يراه عذاباً ونكالاً وأمّا الإنسان المتعلّق بهوى النفس ومادّة الدنيا فإنّه وإن كان ربّما يرى ما اقتناه من زينة الدنيا سعادة لنفسه وخيراً ولذّة، فإنّه سوف يطّلع على خبطه في مشيه وانقلبت سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه. قال تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الّذي يوعدون) المعارج - 42، وقال تعالى: (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد) ق - 22، وقال تعالى: (فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلّا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم) النجم - 29، على أنّهم لا يصفو لهم عيش إلّا وهو منغّص بما يربو عليه من الغمّ والهمّ.
ومن هنا يظهر: أنّ الإدراك والفكر الموجود في أهل الله وخاصّة القرآن غيرهما في غيرهم مع كونهم جميعاً من نوع واحد هو الإنسان وبين الفريقين وسائط من أهل الإيمان ممّن لم يستكمل التعليم والتربية الإلهيّين.
فهذا ما يتحصّل من كلامه تعالى في معنى العذاب وكلامه تعالى مع ذلك لا يستنكف عن تسمية الشقاء الجسمانيّ عذاباً لكن نهايته أنّه عذاب في مرحلة الجسم دون الروح. قال تعالى: حكاية عن أيّوب (عليه السلام): (أنّي مسنّي الشيطان بنصب وعذاب) ص - 41، وقال تعالى: (وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفى ذلكم بلاء من ربّكم عظيم) الأعراف - 141. فسمّى ما يصنعون بهم بلاءً وامتحاناً من الله وعذاباً في نفسه لا منه سبحانه.
قوله تعالى: (إنّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) إلخ قد علّل تعالى عذاب الّذين كفروا بآياته بأنّه عزيز ذو انتقام لكن لـمّا كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمة تنضمّ إليه ليتمّ المطلوب فإنّ العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر بعض من كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام فعقّب لذلك الكلام بقوله: إنّ الله لا يخفى عليه فبيّن أنّه عزيز لا يخفى عليه شيء ظاهر على الحواسّ ولا غائب عنها. ومن الممكن أن يكون المراد ممّا في الأرض وما في السماء الأعمال الظاهرة القائمة بالجوارح والخفيّة الكامنة في القلوب....
قوله تعالى: (هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء) التصوير إلقاء الصورة على الشيء والصورة تعمّ ما له ظلّ كالتمثال وما لا ظلّ له والأرحام جمع رحم وهو مستقرّ الجنين من الإناث.
وهذه الآية في معنى الترقّي بالنسبة إلى ما سبقها من الآيتين فإنّ محصّل الآيتين: أنّ الله تعالى يعذّب الّذين كفروا بآياته لأنّه العزيز المنتقم العالم بالسرّ والعلانية فلا يغلب في أمره بل هو الغالب. ومحصّل هذه الآية أنّ الأمر أعظم من ذلك ومن يكفر بآياته ويخالف عن أمره أذلّ وأوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه واعتماد على قدرته من غير أن يأذن الله في ذلك فيغلب هو على أمره تعالى ويبطل النظام الأحسن الّذى نظم الله سبحانه عليه الخلقة فتظهر إرادته على إرادة ربّه بل الله سبحانه هو أذن له في ذلك بمعنى أنّه نظم الأمور نوع نظم يؤدّي إلى وجود الاختيار في الإنسان وهو الوصف الّذي يمكنه به ركوب صراط الإيمان والطاعة أو التزام طريق الكفر والمعصية ليتمّ بذلك أمر الفتنة والامتحان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما يشاؤون إلّا أن يشاء الله ربّ العالمين.
فما من كفر ولا إيمان ولا غيرهما إلّا عن تقدير وهو نظم الأشياء على نحو يتيسّر لكلّ يءئ ما يتوجّه إليه من مقاصده الّتي سوف يستوفيها بعمله بتصويره بصورته الخاصّة الّتي تمهّد له السلوك إلى ما يسلك إليه. فالله سبحانه هو الغالب على أمره القاهر في إرادته المهيمن على خلقه يظنّ الإنسان أنّه يفعل ما يشاء ويتصرّف فيما يريد، ويقطع بذلك النظم المتّصل الّذي نظمه الله في الكون فيسبق التقدير، وهذا بعينه من القدر.
وهذا هو المراد بقوله: يصوّركم في الأرحام كيف يشاء أي ينظّم أجزاء وجودكم في بدء الأمر على نحو يؤدّي إلى ما يشاءه في ختمه مشيّة إذن لا مشيّة حتم.
وإنّما خصّ الكلام بالتقدير الجاري في الإنسان ولم يذكر التقدير العامّ الجاري في العالم كلّه لينطبق على المورد ولما مرّ أنّ في الآيات تعريضاً للنصارى في قولهم في المسيح (عليه السلام) والآيات منتهية إلى ما هو الحقّ من أمره فإنّ النصارى لا ينكرون كينونته (عليه السلام) في الرحم وأنّه لم يكوّن نفسه.
والتعميم بعد التخصيص في الخطاب أعني قوله: يصوّركم بعد قوله: نزّل عليك للدلاله على أنّ إيمان المؤمنين أيضاً ككفر الكافرين غير خارج عن حكم القدر فتطيب نفوسهم بالرحمة والموهبة الإلهيّة في حقّ أنفسهم ويتسلّوا بما سمعوه من أمر القدر ومن أمر الانتقام فيما يعظم عليهم من كفر الكافرين.
قوله تعالى: (لا إله إلّا هو العزيز الحكيم) فيه عود إلى ما بدئ به الكلام في الآيات من التوحيد، وهو بمنزلة تلخيص الدليل للتأكيد.
فإنّ هذه الأمور المذكورة أعني: هداية الخلق بعد إيجادهم، وإنزال الكتاب والفرقان، وإتقان التدبير بتعذيب الكافرين أمور لا بدّ أن تستند إلى إله يدبّرها وإذ لا إله إلّا الله تعالى شأنه فهو الّذي يهدي الناس وهو الّذي ينزّل الكتاب والفرقان، وهو يعذّب الكافرين بآياته، وإنّما يفعل ما يفعل من الهداية والإنزال والانتقام والتقدير بعزّته وحكمته.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (2)
خصائص الصيام (2)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 معرفة الإنسان في القرآن (7)
معرفة الإنسان في القرآن (7)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (2)
-

الإرادة والتوكل في شهر رمضان
-
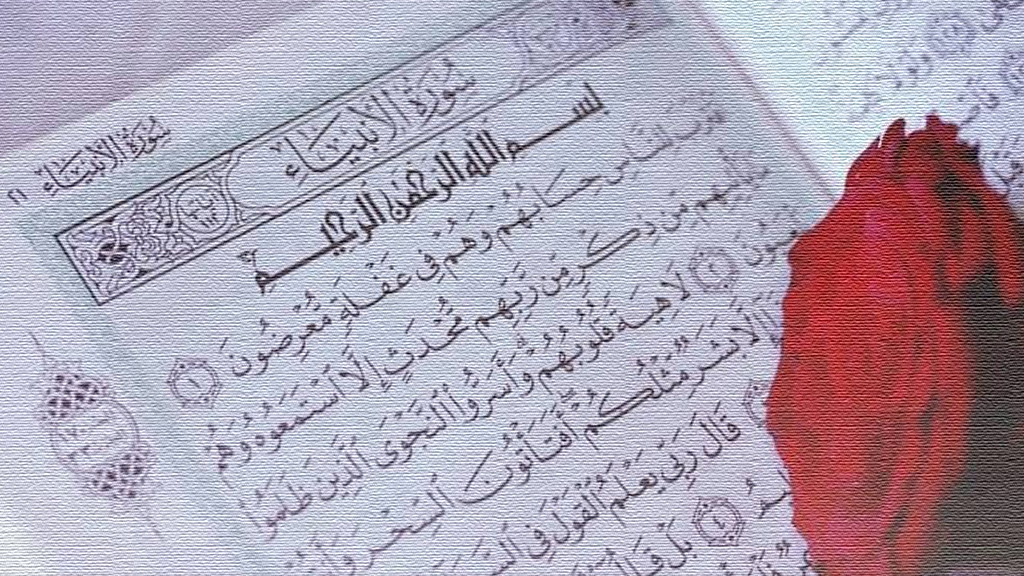
معرفة الإنسان في القرآن (7)
-

شرح دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-
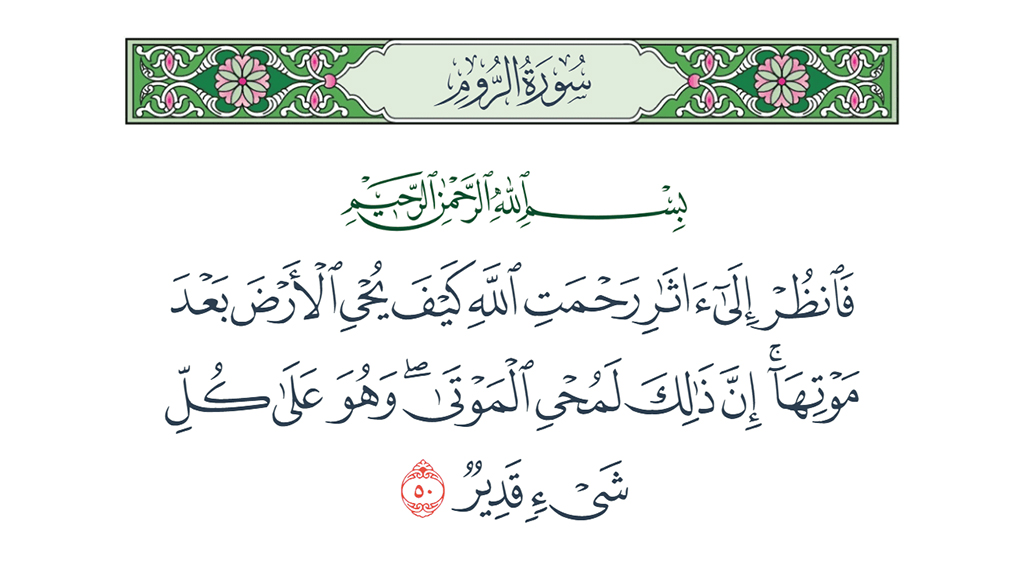
البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان










